الحكيم.. فيلسوف الأدب الباحث عن ملامح الشخصية المصرية

ينتمى توفيق الحكيم «9 أكتوبر 1898م- 26 يوليو ١٩٨٧»، إلى جيل كانت المسألة المصرية المحور الأساسى والبنية العميقة لمشروعه الأدبى، ولن نبالغ إذا قلنا إن الحبكة الرئيسية لأعمالهم هى مصر وتاريخها فى صور متعددة، فقد كتب الحكيم رواية «عودة الروح» وقال بعد ذلك: «لم يكن قصدى تأليف رواية بل إقناع نفسى بأنى أنتمى إلى بلد له كيان محدد ومستقل، وتاريخ طويل نمنا فيه، وآن لنا أن نستيقظ وتعود الروح»، ثم كتب مسرحية أهل الكهف التى جسَّد من خلالها المراحل التاريخية التى مرت بها الشخصية المصرية، ممثلة فى الوثنية والمسيحية والإسلام، بالإضافة إلى مشروع طه حسين وسلامة موسى، فقد كتب الأول «مستقبل الثقافة فى مصر» بعد توقيع معاهدة 1936، وكتب الثانى «مصر أصل الحضارة» 1947، ومن بعدهم نجيب محفوظ الذى قدم أربعة أعمال تاريخية فى بداية حياته، لا تخلو موضوعاتها من دلالة للإجابة عن سؤال الهوية «رادوبيس ــ عبث الأقدار ــ كفاح طيبة، مصر القديمة» وكتب شفيق غربال «تكوين مصر»، وصبحى وحيدة «فى أصول المسألة المصرية» وصبرى السوربونى «نشأة الروح القومية المصرية»، بالإضافة إلى الكتاب الأهم «شخصية مصر» لجمال حمدان.. فقد كانت المسألة المصرية المحور الرئيسى للثقافة فى النصف الأول من القرن العشرين للجيل الذى ينتمى إليه توفيق الحكيم.

البحث عن روح الشخصية المصرية كان محورًا أساسيًا لكل أعمال توفيق الحكيم، يبحث فى تكامل ملامحها بين مصر الفرعونية والمسيحية والإسلامية، ويؤمن إيمانًا عميقًا بحضارتها وتاريخها وشعبها، توفيق الحكيم الذى صعد بالأدب المسرحى بكامل هيئته إلى خشبة المسرح، أدهشنى لأنه ليس كغيره من المفكرين الذين يقذفون بما حفظوا من نظريات جامدة، بل كانت النظريات تخرج من فمه حية تمشى على الأرض لها يدان وساقان ووجه ولسان فى كل أعماله الروائية والمسرحية والفكرية يناقش قضايا اللحظة الراهنة، حيث شارك فى كل الأحداث التى مرت بمصر فى حياته ولكن بأسلوبه هو، لأن الفن لا يعيش بالغاية، الغاية فانية، إنما الفن يعيش بالأسلوب، ولن أبالغ إذ قلت إنه كاتب شعبى لا بد أن يقرأه الجميع، لأنه أجمل من كتب عن مصر، فكما كان فلاسفة الإغريق ينفقون أعمارهم فى البحث عن قضايا الوجود، أنفق هو عمره فى البحث عن ملامح الشخصية المصرية، ليكتبها فيما بعد فى كل رواياته ومسرحياته ومقالاته الفكرية، ولم يكن لديه سقراط يكتب من خلال شخصيته فلسفته وأفكاره فى صورة حواريات بل عشرات فى صور وأشكال مختلفة، وعبر هذه الشخصيات أبطال محاوراته طرح مئات الأسئلة حول الشخصية المصرية، حتى فى أعماله غير الأدبية ثمة أسلوب أدبى، شجرة الحكم السياسى، محاورات درامية للسخرية من أهل السياسة، فلا بد من أسلوب بكل جمالياته حتى يتكلم توفيق الحكيم، لذلك أشعر أن كل أعماله كتاب ضخم يضم أجزاء عديدة، عنوانه البحث عن الشخصية المصرية.

لأن قضية توفيق الحكيم الرئيسية هوية مصر حين عاد من رحلته الطويلة فى باريس كتب مسرحية «أهل الكهف» ١٩٣٣ ومن خلالها كان يبحث عن الشخصية المصرية ورأى أن مصر الحية تتكون من حلقات عمرها الطويل من تيارات فكرية شتى فى عهود متباينة من الوثنية إلى المسيحية إلى الإسلام، ويؤكد أن شخصية مصر فى تكامل ملامحها ومسار تفكيرها عبر القرون، و«أهل الكهف» مأخوذة عن القرآن فى موضوع مسيحى، وعن تفكير فى الزمن الوثنى، حيث كان يحاول ربط حلقات هذه التيارات الفكرية فى العصور الثلاثة، ولم يختلف الأمر كثيرًا فى رواية «عودة الروح» التى أكد فيها على قدرة هذا الشعب على التقدم والنهوض، فهى قراءة عميقة فى الشخصية المصرية بكل تجلياتها الفلاح وابن البلد والأفندى ابن الطبقة الوسطى وابن البلد والفتاة التى ترمز لإيزيس، وفى خضم المناقشات التى وضعها الحكيم فى الرواية وتدور بين المفتش الإنجليزى والمصرى فى بيت والد محسن، يقول المفتش «جىء بفلاح من هؤلاء وأخرج قلبه تجد فيه رواسب عشرة آلاف سنة، من تجارب ومعرفة رسب بعضها فوق بعض وهو لايدرى! نعم هو يجهل ذلك، ولكن هناك لحظات حرجة فيها هذه المعرفة وهذه التجارب فتسعفه وهو لا يعلم من أين جاءته»، وسوف تتردد هذه الأفكار بقوة فى الرواية التى تغوص فى أعماق الحضارة المصرية، فقد كان يعى جيدًا وضع مصر أو المسألة المصرية فى تلك لفترة ليذكر بعد سنوات فى كتابه بين عهدين ما حدث بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية أو الرجل المريض حين ذهب زعماء مصر يسألون الإنجليز عن وضعهم، ويصف الحكيم هذه اللحظة كمشهد درامى «فسألهم الإنجليز عما يقصدون فقالوا: زوال الاحتلال البريطانى، فسألهم الإنجليز: وماذا بعد الاحتلال؟ هل تعودون إلى الدولة العثمانية المنهزمة؟ فقال الزعماء: بل نعود إلى مصر، فدهش الإنجليز وسألوا: ما هى مصر؟ فإننا لا نعرف شيئًا اسمه القطر المصرى. وكما هو موجود على الخرائط الرسمية يتبع سياسيًا الدولة العثمانية وحضاريًا العربية حسب الدين واللغة، أما مصر فأين هى؟ وما هى مقوماتها؟ وما هى شخصيتها؟»، وظنى أن هذه الكلمات ظلت فى عقل توفيق الحكيم ووجدانه حتى بعد زوال الاحتلال، فمصر بالنسبة لتوفيق الحكيم ليست وطنًا يحبه بل عقيدة يؤمن بها، عقيدة قوية وراسخة، والصورة المناسبة له تمثال الكاتب المصرى، حيث يحلو لى كثيرًا أن أنزع رأس التمثال وأضع رأس توفيق الحكيم.

توفيق الحكيم فيلسوف الأدب الذى أعترف أننى أتوقف عن التجول بين أعماله، إذ يحلو لى بين الحين والحين أن أعود إليه «رحلة بين عصرين، أهل الكهف، عودة الوعى، عودة الروح، راقصة المعبد، بنك القلق، الطعام لكل فم، تحت شمس الفكر، شجرة الحكم السياسى»، وغيرها من الأعمال، ليس شرطًا أن أقرأ الكتاب كاملًا، ألهو كمن يتنزه فى حديقة ويقطف من ثمارها، الثمار التى تذوق حلاوتها من قبل ويعرفها جيدًا، لذلك ينهل منها دون حساب سعيدًا مطمئنًا، وأنا أعيد قراءة «رحلة بين عصرين» الذى كتبه عام ١٩٧١ حين قام برحلة إلى باريس ليقارن بين حياته هناك حين سافر عام ١٩٢٧ والحياة بعد نصف قرن، فماذا حدث؟ وهذه الرحلة تكشف لى كلما قرأتها عن خبايا سيرته الذاتية «زهرة العمر وسجن العمر»، وخاصة زهرة العمر التى تدور أحداثها فى باريس، وحين أقرأ ما يكتبه الحكيم عن سيرته الذاتية، لا أعرف إذا كان يسرد أحداثًا واقعية حدثت بالفعل أم أن الخيال يعمل فى أقصى تجلياته؟!، فالواقع عنده يختلط بالخيال والخيال يهاجم الواقع، وهذا ما يحدث لى حين أقرأ أعمالًا أخرى مثل يوميات «نائب فى الأرياف، وراقصة المعبد» وغيرها، لا تعرف أين حدود الواقعى الذى عاشه وأين الخيال، أعرف أنه من البديهى أن ينطلق الكاتب من الواقع ويلعب الخيال دوره فى الكتابة، ولكننى كقارئ، لا يختلط علىّ الأمر مع الكتّاب الآخرين، لأننى أعرف أن هذه رواية، وتلك سيرة ذاتية، ولكن مع توفيق الحكيم لا أعرف، فالحدود الفاصلة تمت إزالتها، ظننت حين قرأت «راقصة المعبد» لأول مرة، وخاصة فى الصفحات الأولى أنها ذكريات ليس فقط لأنه يضع عنوانا فرعيًا إلى جانب العنوان الرئيسى «ذكرى سالزبورج، صيف ١٩٣٦»، بل إنه بارع فى خداع قارئه بمهارة شديدة أليس هو القائل فى هذا الكتاب «إن الكذب المتسق هو أصدق من الصدق.. ما لفن إلا كذب متسق جميل» وكان دائم الدعاء: اللهم نسق لى كذبى، وما البرج العاجى إلا خدعة كبرى «ليس لنا أن نسأل عن غاية الحياة، ولا عن غاية الفن، ولا عن غاية العلم! الأسلوب كل شىء عند كل خالق، إن الخالق أعظم من أن يحبس إرادته الخالدة فى حدود-غاية- الغاية مفردة من صنع العقل البشرى الصغير، الفن لا يعيش بالغاية، لأن الغاية فانية كاسمها، إنما يعيش الفن بالأسلوب».. فهل يضع هذا الكلام توفيق الحكيم فى البرج العاجى؟
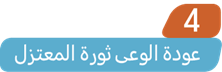
كان الحكيم بالنسبة لى لغزًا، أقرب إلى مدينة حصينة أحاول اقتحام أسوارها، وفى كل محاولة أرتد حزينًا، ففى بداية مشوار القراءة كان نجيب محفوظ ويوسف السباعى وإحسان عبدالقدوس وحتى طه حسين، جبالًا شاهقة لكننى كنت أستطيع تسلقها حتى ولو بصعوبة، كنت أقرأ هؤلاء وغيرهم فى سن مبكرة، ولكن كلما اقتربت من توفيق الحكيم عُدت أجر أذيال الخيبة، أعرف قيمته ولكن لا أجيد التواصل معه، ثمة حلقة مفقودة لا أعرف أين هى، أخاف الاقتراب منه وكلما اقتربت تبعدنى أسئلته العصية على الفهم، وذات يوم وأنا أتجول بين المكتبات فاجأنى العنوان المكون من سطرين مع صورة للحكيم فى ملابسه الرسمية على الغلاف «ثورة المعتزل- توفيق الحكيم.. الجيل والطبقة والرؤيا» بقلم الدكتور غالى شكرى، وتقريبًا التهمت الكتاب الذى فتح لى كل أسوار المدينة الحصينة، بل ورأيت الحكيم يتجول فى الطرقات بملابس النوم يمسك عصاه ويلهث هنا وهناك، يجلس قليلًا بين «أهل الكهف»، يرتب طبقات الحضارة المصرية ويبتسم أو يلتقى «السلطان الحائر» يسأله: هل يختار السيف أم القانون؟ أو يصرخ أمام «بنك القلق» مطالبًا القيادة السياسية بحرية المواطن.. لقد تحطمت كل أبواب المدينة فى هذا المجلد، ففى الكتاب الأول «ثورة المعتزل» الذى صدر عام ١٩٦٦ لم يعد الحكيم الكاتب الغارق فى المطلقات المجردة بعيدًا عن قضايا الناس، أما الكتاب الثانى والذى نشره لأول مرة عام ١٩٩٠ لم يكن قراءة فى أعمال فيلسوف الأدب، بل معركة ضارية بينهما حول كتاب «عودة الوعى»، الصورة الأخرى والتى وضع غالى شكرى خطوطها الأولى فى اعترافات الزمن الخائب، ثم بعد ذلك فى الوثيقة الأهم «من الأرشيف السرى للثقافة المصرية» والتى تدور كلها حول سؤال ظل يتردد كثيرًا ألا وهو: هل كان صاحب عودة الروح فاقدًا للوعى طيلة حكم عبدالناصر؟ وما زلت أذكر ثراء الحوار بينهما حول الكتيب الصغير أو المنشور السياسى «عودة الوعى» كما يصفه غالى شكرى، حوار أقرب إلى مصارعة شرسة فى حلبة الملاكمة.
