الحنين للقرن الـ20.. أسرار الستينيات والثمانينيات والتسعينيات فى 3 كتب جديدة

- أبرز نجوم هذه الفترة الذهبية بوب ديلان الحاصل على جائزة «نوبل»
- أجندة أنشطتها اليومية تتراوح بين عروض أفلام وسهرات وحفلات «أندرجراوند»
- كان عدم القيام بأى شىء عن قصد خيارًا صالحًا فلم تكن التسعينيات عصرًا للطامحين
- تحوّلت الثقافة الشعبية فى الثمانينيات إلى ساحة مواجهة بين المقدّس والدنيوى
- الكنيسة تطارد مارتن سكورسيزى بعد «الإغواء الأخير للمسيح»
- التسعينيات فترة سهلة للغاية للعيش فيها
فى مطلع الألفية الجديدة، تنبأت المفكرة الروسية الراحلة، سفيتلانا بويم، فى كتابها الشهير «مستقبل الحنين» (2001)، بأن الحنين إلى الماضى سيصبح «مرض العصر الذى لا شفاء منه». اليوم، وبعد أكثر من عقدين، يبدو أن نبوءتها قد تحققت، حيث تحولت «النوستالجيا» من مجرد حالة نفسية فردية إلى ظاهرة ثقافية وجيلية تطبع المشهد العالمى.
ويشهد النصف الأول من العام الجارى موجة غير مسبوقة من الإصدارات الأدبية والفكرية التى تعيد اكتشاف القرن العشرين بكل تفاصيله الثقافية والسياسية والاجتماعية، من موسوعات توثيقية ومذكرات شخصية إلى دراسات نقدية وروايات تستلهم الماضى، وكأن العالم يعيش حالة جماعية من التوق إلى الزمن الماضى.
فى السطور التالية، تفتح «حرف» نافذة على أبرز هذه الإصدارات العالمية التى تقدم قراءات متنوعة لهذا الحنين الجمعى، لتطرح أسئلة مفادها: لماذا نلتفت إلى الماضى فى زمن التطور التكنولوجى المتسارع؟ وهل يعكس هذا التوجه رغبة فى الهروب من حاضر معقد، أم محاولة لفهم الحاضر من خلال استعادة الماضى؟
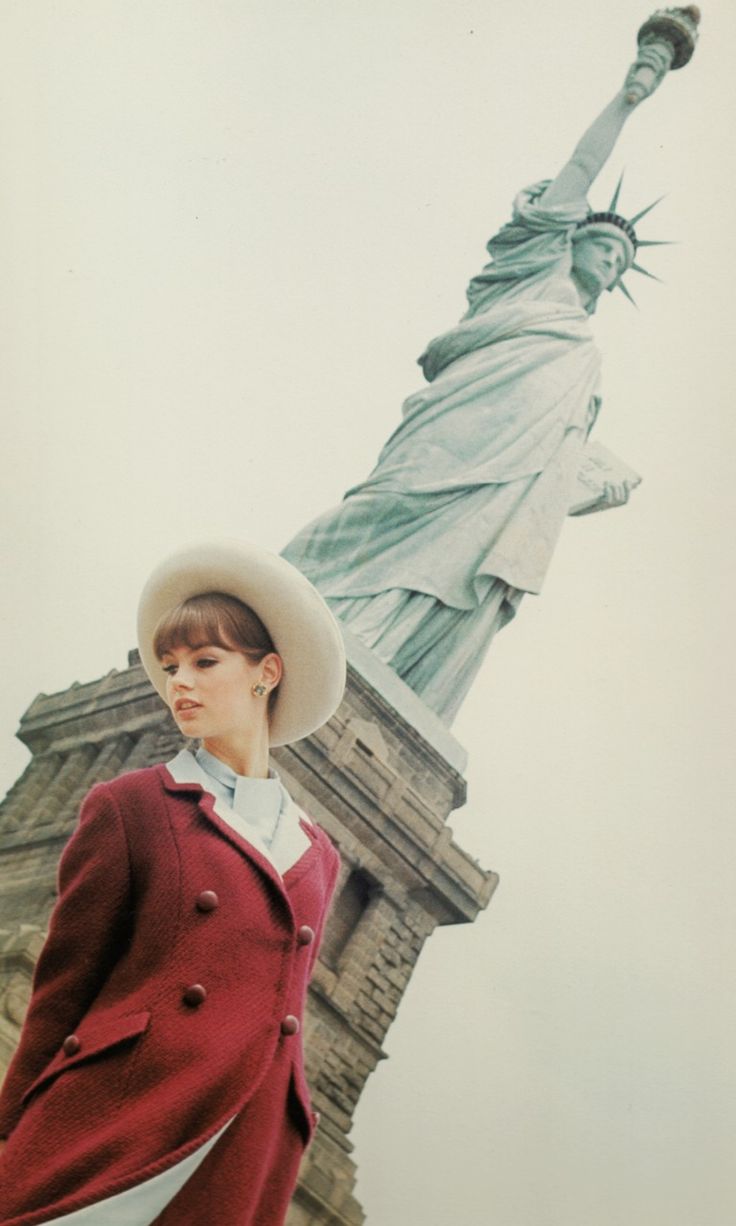
«نيويورك الستينيات»: وكر السينمائيين المفلسين وعازفى «الجاز» والشعراء الصعاليك
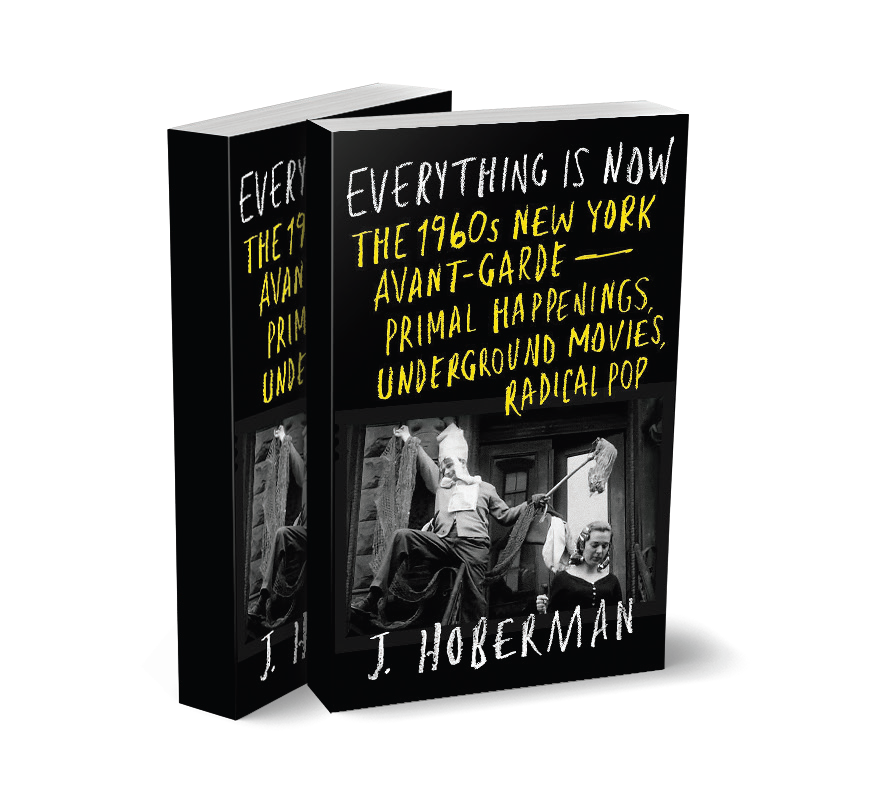
صدر مؤخرًا عن دار النشر الأمريكية المرموقة «فيرسو»، فى ٢٧ مايو ٢٠٢٥، كتاب بعنوان: «Everything Is Now: The ١٩٦٠s New York Avant-Garde—Primal Happenings. Underground Movies. Radical Pop» أو «كل شىء الآن: نيويورك فى الستينيات- أحداث بدائية، أفلام سرية، موسيقى بوب راديكالية»، من تأليف الناقد والصحفى الأمريكى المخضرم جيه هوبرمان.
ويأخذنا الكتاب فى رحلة إلى نيويورك الستينيات، حين كانت المدينة تمتلئ بالفن والثقافة، فى كل زاوية منها: المقاهى والحانات والشقق، والمسارح، بل وحتى الشوارع، ويسعى «هوبرمان» من خلال هذا العمل للإجابة عن سؤال قد يشغل بال الكثيرين: هل نحن مهووسون بالستينيات أكثر مما ينبغى؟!
ويكشف المؤلف، فى كتابه المكون من ٤٦٤ صفحة، أنّ نيويورك فى ستينيات القرن العشرين كانت تعجّ بصانعى أفلام مفلسين، وموسيقيّى جاز، وشعراء وصحفيين، إلى جانب فنانين من مختلف الحركات، من بينهم «بوب ديلان»، و«ألين جينسبيرج»، و«يايوى كوساما»، و«يوكو أونو»، و«نام جون بايك»، و«كارولى شنايمان»، و«جاك سميث»، و«آندى وارهول»، وغيرهم الكثير، واندمجت كل هذه الثقافات فى بوتقة واحدة غيّرت وجه المدينة وأمريكا والعالم بأسره.
الكتاب، الذى دخل قائمة الأكثر مبيعًا على موقع «أمازون» فى أقل من شهر على صدوره، يُضفى إحساسًا حيًا بروح الطليعة فى الستينيات، بوصفها جماعة مترابطة جسديًا وشخصيًا، ويفسّر الفن الذى أبدعوه كمشروع جماعى، كما أن الأفلام والمسرحيات والحفلات الموسيقية و«الفعاليات» المستلهمة من كلاسيكيات موسيقى «الأندرجراوند»، تُجسّد روح تلك الفترة التى كانت تُمارس فيها كل أشكال الفنون.
ويسعى المؤلف إلى إحياء فترة الستينيات فى كتابه، مستندًا إلى نشأته فى حى «كوينز»، وتردده فى مراهقته وشبابه إلى أحياء وسط «مانهاتن»، وخلال سرده، يعيد أحيانًا، كمؤرخ، إحياء أحداث كان شاهدًا عليها، بل وحتى شارك فيها، ويقول فى السطر الأخير من كتابه: «هذا الكتاب، الذى أعتبره مذكرات، وإن لم يكن مذكّراتى».
وينقسم الكتاب إلى قسمين بعنوان «الثقافات الفرعية» و«الثقافات المضادة»، ويتناول ثورات موسيقى «الجاز»، و«البيت»، والسينما التجريبية، إلى جانب رموز تلك الحقبة، من بينهم «آندى وارهول»، و«ألين جينسبيرج»، و«يايوى كوساما»، و«جوناس ميكاس»، و«بوب ديلان»، و«أميرى باراكا»، وهؤلاء، كما يرى «هوبرمان»، كانوا مسئولين عما يسميه «تطبيع الجنون الثقافى الذى ميّز الستينيات».
ويسعى الكتاب إلى فهم هذا الجنون، ويعتمد «هوبرمان» فى تناوله للمادة على التسلسل الزمنى الدقيق والذكى، مستندًا إلى مقابلات موسّعة وبحوث أرشيفية، ما يمنح القارئ إحساسًا واضحًا بالتحولات الأوسع التى تتشكل من تراكم التفاصيل اليومية من عروض أفلام، وسهرات ليلية، وحفلات غير مرخصة فى أماكن «تحت الأرض»، كما يبرز باستمرار التقاطعات بين النشطاء الفنيين والسياسيين فى نيويورك آنذاك، وأماكن تجمعهم المشتركة، وآفاقهم وتطلعاتهم المتشابكة.
وعمل المؤلف «جيه هوبرمان» ناقدًا سينمائيًا فى صحيفة «ذا فيليج فويس» من عام ١٩٧٨ إلى عام ٢٠١٢، وهو صريح فى حديثه عن الدور المحورى الذى أدّته هذه الصحيفة الأسبوعية المؤثرة، إلى جانب صحف وسط المدينة الأخرى، فى صياغة مضمون كتابه.
ويقول: «لتأليف هذا الكتاب، لم أُجرِ مقابلات مع شهود ومشاركين فحسب، بل قرأتُ تقريبًا جميع أعداد صحيفة (ذا فيليج فويس) بين أواخر عام ١٩٥٨ وأوائل عام ١٩٧٢ قبل انضمامى للعمل بها، بالإضافة إلى معظم صحف (إيست فيليج) و(نيويورك فرى برس) وغيرها، والنتيجة هى تاريخٌ يستحضر الحماس الفنى الجامح لتلك الفترة، ويرسم ملامح العديد من الأصوات البارزة فيها».
أما الشخصيات التى تُؤثّث كتاب «كل شىء الآن»، فهى تشكّل طاقمًا استثنائيًا، يأخذ القارئ فى جولة عبر مدينة «نيويورك» على امتداد عقد من الزمان، رفقة نخبة مدهشة من الرفاق: فنانين، وشعراء، ونشطاء، وصحفيين، وكُتّابًا، ومغنّين.
ويُبرز الكتاب توق الإنسان إلى أن يعيش على سجيّته فى الفضاء العام، كما يصف «هوبرمان» مركز «نيويورك» فى ستينيات القرن العشرين بالعالم الإعلامى، قائلًا: «المشهد الفنى آنذاك لم يكن منفصلًا عن الطريقة التى صوّرته بها وسائل الإعلام وأسهمت فى تضخيمه، ولا عن قدرة الفنانين وسواهم على اجتذاب الأضواء الإعلامية، فهو عقد أدائى اصطدمت فيه الصورة بالواقع، وتقاربت معه، بل وأصبحت جزءًا لا يتجزأ منه، ومع ذلك لم تتحكّم به».
يوضّح «هوبرمان» عاملًا حاسمًا فى ازدهار الطاقة الإبداعية فى «نيويورك» خلال الستينيات، وهو «الإيجارات الرخيصة»، حيث كانت بعض مناطق وسط المدينة مهجورة، وأخرى قيد الهدم، كما أُدرجت منطقة خالية من المبانى الصناعية سابقًا تُعرف باسم «الوادى» ضمن تقرير رسمى باعتبارها من «الأراضى القاحلة فى نيويورك».
ومع تحوّل الطليعة الفنية، تغيّر المشهد الإعلامى أيضًا؛ إذ أولت الصحافة السائدة، بل وحتى التليفزيون، اهتمامًا واسعًا للأحداث الفنية والسياسية فى وسط المدينة.
ولعب حضور المشاهير دورًا كبيرًا، خاصة مع بروز موسيقى «الروك» على حساب «الفولك»، وتداخل موسيقى «الكانترى» مع عروض فرق مثل «رولينج ستونز»، و«ذا دورز»، و«جانيس جوبلين»، و«جيمى هندريكس»، ونجوم فرقة «فيلفيت أندرجراوند» المحلية، فى قلب الحياة البوبّية.
كما طوّرت الساحة السياسية إعلامها البديل، وكان من أبرز رموزه «آبى هوفمان»، أحد مؤسسى «حزب الشباب الدولى»، الذى شبّهه كاتب فى صحيفة «التايمز» بـ«شكسبير» فى «عبقريته فى مخاطبة جمهور متعدد المستويات».
ورغم طابعه الفنى والثقافى، يُعدّ الكتاب أيضًا تأريخًا سياسيًا نابضًا، حيث يسلّط الضوء على تداخل الحياة الثقافية فى «نيويورك» مع السياسة اليسارية، من خلال أنشطة مثل الاحتجاجات، والاضطرابات، وأحيانًا التدمير، ويولى المؤلف اهتمامًا خاصًا بالأحداث الوطنية والدولية الكبرى التى أثرت فى المدينة، مثل حركة الحقوق المدنية، وحرب فيتنام، والاغتيالات السياسية، إلى جانب القضايا المحلية كالنشاط النسوى.
ويشير «هوبرمان» إلى التقاء الفن والمال والسلطة فى ستينيات القرن الماضى، موضحًا كيف أصبح عالم الفن ومصادر تمويله بحد ذاتهما قضية سياسية، وضرب مثالًا بالحفلات الخيرية التى كانت تُقام آنذاك، وتضم فعاليات أدبية وفنية، شارك فى رعايتها السيناتور «روبرت كينيدى».

«الثمانينيات الصاخبة»: مطاردة «آيات شيطانية».. والاسترخاء على مزيكا «الوكمان»
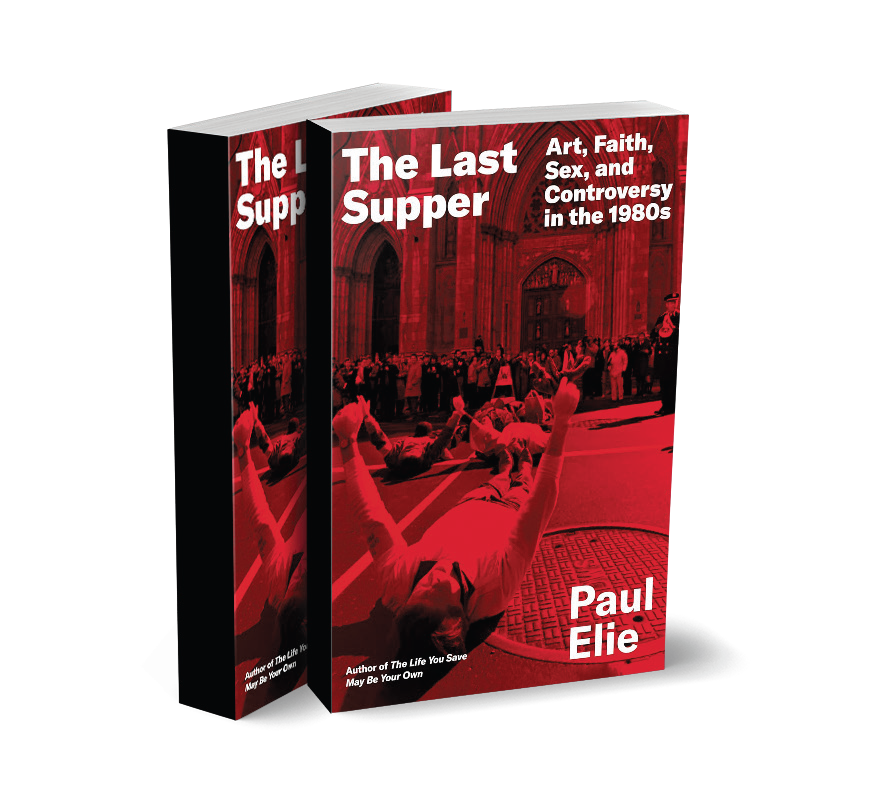
فى ٢٧ مايو ٢٠٢٥ أيضًا، صدر كتاب «The Last Supper: Art. Faith. Sex. and Controversy in the ١٩٨٠s» أو «العشاء الأخير: الفن والدين والجنس وإثارة الجدل فى الثمانينيات»، عن دار النشر الأمريكية «فارار، شتراوس وجيرو».
الكتاب من تأليف الكاتب الصحفى بول إيلى، الباحث فى مركز «بيركلى» للدين والسلام والشئون العالمية بجامعة «جورج تاون»، ويرسم عبره لوحة بانورامية للمشهد الثقافى والدينى والفنى خلال تلك الحقبة.
ويُظهر المؤلف فى كتابه كيف تحوّلت الثقافة الشعبية فى الثمانينيات إلى ساحة مواجهة بين المقدّس والدنيوى، ممهّدةً الطريق أمام بعض أبرز الصراعات السياسية والثقافية المعاصرة.
ففى تلك الحقبة، أعاد آندى وارهول تقديم لوحة «العشاء الأخير» لليوناردو دافنشى بأسلوبه الخاص، وأخرج مارتن سكورسيزى فيلمه «الإغواء الأخير للمسيح»، فيما نشر سلمان رشدى روايته المثيرة للجدل «آيات شيطانية»، وقدّمت مادونا أغنيتها «مثل الصلاة»؛ وغيرها من الأعمال التى فجّرت نقاشات لا تزال أصداؤها تتردد فى خضمّ الحروب الثقافية الراهنة.
ويستقصى «العشاء الأخير»، الواقع فى ٤٩٦ صفحة، الأشكال الجريئة وغير المتوقعة التى يمكن أن يتجلّى فيها التماس مع الإيمان، ويستعرض ملامح بزوغ عصر ما بعد العلمانية، حيث شهد ازدهار الدين وتراجعه فى آنٍ واحد، كما يوثق كيف استثمر كتّاب وموسيقيون وفنانون المواضيع الدينية فى أعمالهم، لتتحوّل إلى مساحة حوار وصراع وإبداع فى آنٍ واحد.
ويجمع بول إيلى فى كتابه «العشاء الأخير» أطيافًا متباينة من الشخصيات، تمتد من اليسار الراديكالى إلى اليمين الراديكالى: سياسيين، فلاسفة، شعراء، مخرجين، فنانين تشكيليين، مؤلفين، ومعظمهم موسيقيون.
ما يربط بينهم فى روايته لا يقتصر على عقد الثمانينيات أو أعمالهم ونبوغهم وشهرتهم، بل يتمثل فى الدين، إذ يكشف المؤلف عن حضورٍ خفى للدوافع الكاثوليكية فى حياة عددٍ من أكثر الفنانين تأثيرًا فى مطلع ذلك العقد، من «مادونا» إلى آندى وارهول ومارتن سكورسيزى.
ويرصد «إيلى» لحظة محورية فى التاريخ الاجتماعى للقرن العشرين، عندما اصطدمت رؤى متضاربة بشأن الدين والفن والجنس فى عقدٍ دأب كثيرٌ من المؤرخين على اعتباره فترةً انتقاليةً ساكنة، تفصل بين فضائح السبعينيات السياسية وثورة التسعينيات الرقمية، غير أن المؤلف يرى فيها حقبةً زاخرة بالحراك الإبداعى، انشغل خلالها الفنانون بما يسميه «الدين السرى»؛ ذاك الفضاء الهامشى بين الإيمان واللا إيمان، الذى أفرز موجةً من الفنون الشعبية المثيرة للتفكير.
ويقدّم الكتاب أيضًا لوحةً بانورامية لمبدعين ورفاق دربهم، وجدوا أنفسهم فى مفترق طرقٍ دامٍ ضمن الحياة الأمريكية، عقب صعود رونالد ريجان إلى سدة الحكم عام ١٩٨١، ما أدى إلى تقويض الحواجز بين الكنيسة والدولة، وإشعال ثورة مضادة فى الحقل الفنى، فقد اعتبره بعض ناخبيه منقذًا انتشل أمريكا من موجةٍ من التراخى الدينى والعلمانية الصدامية التى سادت عقدين سابقين، ودفع بها نحو زمن جديد من «القيم العائلية» المؤسسة على النصوص الدينية، مدعومًا من الكنيسة الكاثوليكية والبابا يوحنا بولس الثانى، الذى تولى البابوية منذ عام ١٩٧٨، ومحتضنًا رموزًا دينية محافظة كجيرى فالويل، فى دعوةٍ إلى العفة، وإنقاذ الجنين، وتكريس الزواج بين الجنسين.
وأسفرت تلك الطفرة الثقافية عن ازدهار فنى متنوع، تناول مباشرةً القضايا التى لطالما تجاهلتها المؤسسة الدينية، إذ انخرط الفنانون فى استكشاف ما يُعرف بـ«المساحة الحدّية بين الإيمان والكفر». ويستعرض بول إيلى قائمة انتقائية من الشخصيات التى تميزت بهذا التماس، منهم آندى وارهول، وسينيد أوكونور، وبوب ديلان، وبونو، وتشيسلاف ميلوش، ومارتن سكورسيزى، وروبرت مابلثورب ، وجميعهم بدرجات متفاوتة أبناء الكنيسة، ممن اعتنقوا مبادئها فى سياقٍ كان فيه الدين لا يزال يشكل جوهر الحياة فى أمريكا وأوروبا خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضى.
ويتناول الكتاب عددًا من المحطات الفنية التى تجسّد هذا الاشتباك بين الفن والدين والجدل العام، أبرزها فيلم «الإغواء الأخير للمسيح» (١٩٨٨) للمخرج مارتن سكورسيزى، الذى نشأ فى أسرة كاثوليكية متشددة بحى ليتل إيتالى فى نيويورك.
وعُرف عنه اشتباكه المتكرر مع أفكار الإيمان فى أفلامه، غير أن هوسه بتحويل رواية نيكوس كازانتزاكيس (١٩٥٥) إلى عمل سينمائى استغرق سنوات من البحث عن تمويل.
وعندما خرج الفيلم إلى النور، شنّ التيار الدينى المحافظ حملة شعواء لوقف عرضه، فقدّم سكورسيزى صورة للمسيح تتسم بإنسانية مفرطة، ممتلئة بالشك والمعاناة والاضطراب النفسى، ما فاقم موجة الاستياء.
ويخلص المؤلف إلى أن «المساحة الحدّية» تلك قد أُغلقت فى الزمن الراهن، رغم استمرار تراجع التدين المؤسسى وتنوّع أنماطه، فاليوم، عام ٢٠٢٥، لم يعُد للدين ذات الحضور فى مسيرة الفنانين، ربّما لأنه فقد موقعه كمصدر إلهام أو صراع فى عالم مفتوح على الخارج، يفتقر إلى الروحانية.
ويُعد كتاب «العشاء الأخير» تذكرة قوية بقدرة الفن العميقة على النفاذ إلى شئون القلب والروح، فى زمنٍ تزداد فيه الحاجة إلى مثل هذا التماس.
وفى مارس ٢٠٢٥، صدر عن دار النشر العالمية الفاخرة «تاشين» كتاب «الثمانينيات «Eighties» للمصوّر البريطانى الشهير ديفيد بيلى، أحد أعمدة التصوير الفوتوغرافى المعاصر، والذى يعود من خلاله إلى عقدٍ ترك بصمته العميقة على الثقافة البصرية.
ويؤكد «بيلى» فى عمله أن إرث الثمانينيات، الحاضر بوضوح على شاشاتنا، ومنصات عروض الأزياء، ومسارح الموسيقى، يجعل من الوقت الراهن فرصة مثالية لإعادة قراءة تلك الحقبة الزاخرة.
ويكشف الكتاب المؤلَّف من ٢٩٦ صفحة عن هوس تلك الحقبة الصاخبة، ممتدًا من ثوران جبل سانت هيلينز إلى صعود مادونا واغتيال أنديرا غاندى، فى بانوراما حافلة بالأحداث التى شكّلت وعى جيل بأكمله.
وكان ختام عقد الثمانينيات صاخبًا كما بدايته، إذ اجتاحت موسيقى الأسيد هاوس أنحاء المملكة المتحدة، مُطلقة موجة من الحفلات غير القانونية التى رقص فيها المحتفلون لساعات بلا انقطاع، وفى الهند، أدى اغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندى إلى إشعال أعمال شغب عارمة، ممهّدةً لتحوّل سياسى بالغ التأثير.

«التسعينيات»: حكاية عصر «سيطرنا فيه على التكنولوجيا»
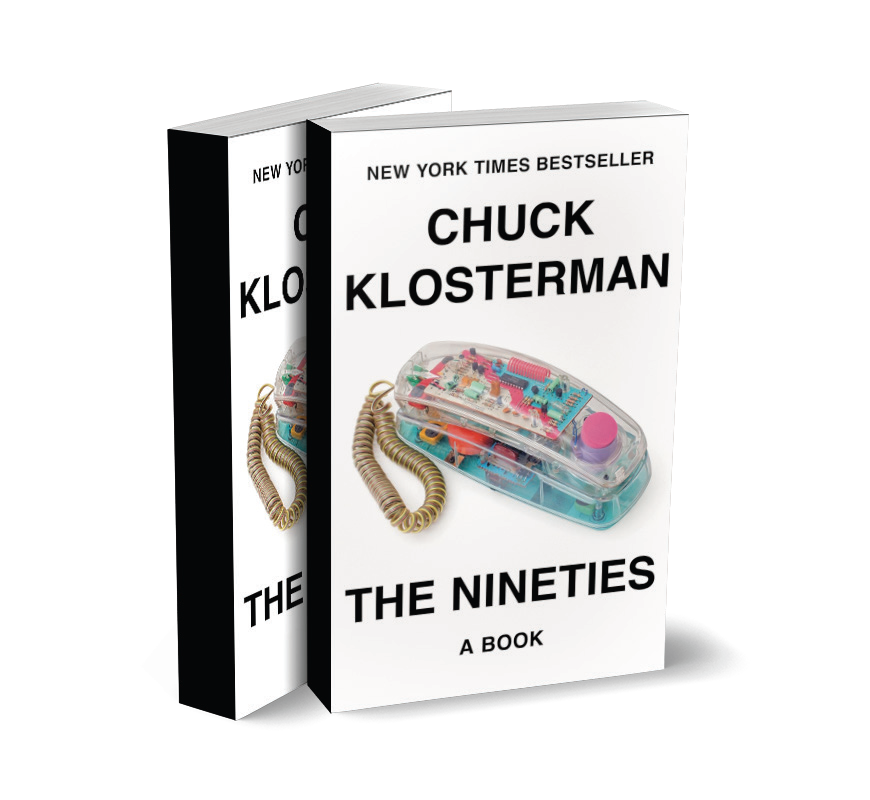
حالة الحنين لسنوات القرن العشرين ليست جديدة أو وليدة عام ٢٠٢٥، وهو ما يؤكده كتاب «The Nineties» أو «التسعينيات»، الذى صدر فى عام ٢٠٢٢، عن دار النشر المعروفة «بنجوين راندوم هاوس»، من تأليف تشاك كلوسترمان، المؤلف الأكثر مبيعًا لـ٨ كتب غير روائية، والذى يشرح فى هذا الكتاب كيف أحدثت التسعينيات ثورة فى الحالة الإنسانية التى ما زلنا نحاول فهمها.
يركز المؤلف- فى الكتاب المكون من ٣٨٤ صفحة- على التحولات الشاملة فى المجتمع خلال فترة التسعينيات، والتى بدأت بإعادة توحيد ألمانيا كحدث تاريخى كبير، مستعرضًا شكل السياسة قبل أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١، وكيف كانت الفترة ككل مليئة بالتناقضات.
وجاء فى الكتاب أن عقد التسعينيات بدأ زمنيًا فى الأول من يناير عام ١٩٩٠، لكنه لم يبدأ ثقافيًا فى الوقت نفسه، لأن الإدراك المعرفى والثقافى لا يمكن قياسه بزمن محدد. مثلًا، بدأت خمسينيات القرن الماضى عمليًا فى أربعينياته. فيما بدأت الستينيات عندما طالب جون كينيدى بالذهاب إلى القمر عام ١٩٦٢، وانتهت بحوادث إطلاق النار بجامعة ولاية «كينت»، فى مايو ١٩٧٠.
أما السبعينيات فولدت فى صباح اليوم التالى لـ«مذبحة ألتامونت» عام ١٩٦٩، ثم انتهت خلال العرض الأول لفيلم «العشيق الأمريكى» للنجم ريتشارد جير، ما يعنى أن هناك ٥ أشهر تزامن فيها عقدا الستينيات والسبعينيات. وحين بدا وكأن الثمانينيات ستعيش إلى الأبد، سقط جدار برلين، فى نوفمبر ١٩٨٩، لكن سقوطه كان فى الواقع بداية مرحلة «القتل الرحيم»، لأن هذا العقد استغرق عامين آخرين حتى «مات المريض» بإعلان سقوط الاتحاد السوفيتى قبيل نهاية عام ١٩٩١.
عند الكتابة عن التاريخ الحديث -والحديث لا يزال لمؤلف الكتاب- يميل المرء إلى الإدعاء بأن كل ما نفكر فيه عن الماضى هو فى ظاهره رجعى. يكتب المؤرخ بروس شولمان، فى كتابه «السبعينيات»: «يُعتبَر معظم الأمريكيين السبعينيات عقدًا قابلًا للنسيان تمامًا. هذا الانطباع خاطئ تمامًا». وفى الجملة الافتتاحية لكتاب «الخمسينيات»، يُشير الصحفى ديفيد هالبرستام إلى أن الخمسينيات تُستدعى حتمًا كسلسلة من الصور بالأبيض والأسود، على عكس الستينيات التى التُقطت كصور متحركة بألوان زاهية، وهذا «يُرسّخ ذكرى وهم الخمسينيات بأنها أبطأ بل شبه راكدة».
هناك دائمًا انفصال بين العالم الذى يبدو أننا نتذكره، والعالم الذى كان فى الواقع. أما تعقيد التسعينيات فيكمن فى أن الوهم المركزى هو الذاكرة نفسها. فالصورة النمطية للتسعينيات الأمريكية تجعل العصر بأكمله يبدو كرسوم كاريكاتورية، وهذه الصورة ناقصة. ومع ذلك، هى ليست خاطئة تمامًا. لقد كان العقد مُعتمدًا بشكل كبير على الوسائط، لكنه لم يكن منحرفًا ومشوهًا بسبب الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، كما الآن.
يمكن تتبع مسار هذا العقد بدقة، فقد تم التقاط كل لحظة ذات مغزى تقريبًا فى التسعينيات على شريط فيديو، إلى جانب آلاف وآلاف اللحظات التافهة التى لم تعنى شيئًا على الإطلاق. السجل مكتمل نسبيًا. لكن هذا الطوفان من البيانات ظل، فى ذلك الوقت، سريع الزوال وغير متاح.
لجزء كبير من العقد، كان مسلسل «ساينفيلد» هو المسلسل الأمريكى الأكثر شعبية والأكثر تحولًا على التليفزيون، لقد غير اللغة و«الحساسيات الكوميدية»، وشاهد كل حلقة عشوائية منه تقريبًا عدد أكبر من مشاهدى الحلقة النهائية من «صراع العروش» فى ٢٠١٩.
مع ذلك، إذا فاتتك حلقة من «ساينفيلد»، فقد فاتتك ببساطة، إذ كان عليك الانتظار حتى إعادة بثه فى الصيف التالى، حين كان بإمكانك محاولة تسجيله يدويًا على شريط فيديو. وإذا فاتتك الفرصة مرة أخرى، كان الخيار الوحيد هو الذهاب إلى أرشيف عام فى لوس أنجلوس أو مانهاتن، وطلب مشاهدة خاصة على شريط فيديو مقاس ٨ مليمترات.
لكن بالطبع، لم يكن هذا القيد مصدر قلق للناس، لأن الاهتمام بأى مسلسل تليفزيونى بهذا القدر لم يكن طبيعيًا. وحتى لو فعلت ذلك، فستتظاهر بأنك لا تملكه، لأننا فى التسعينيات. من المرجح أن تدّعى أنك لا تملك جهاز تليفزيون.
وبحسب مؤلف الكتاب، يفترض كل جيل بشكل مبالغ فيه أنه سيكون الأخير بطريقة ما، وكان هناك بعض من ذلك لدى جيل التسعينيات، ولكن ليس بقدر العقد الذى سبقه، وأقل بكثير مما كان عليه فى العقود التى تلته.
ويرى «كلوسترمان» أن التسعينيات هى الفترة الأخيرة فى التاريخ الأمريكى التى كان يُنظر فيها إلى المشاركة الشخصية والسياسية على أنها اختيارية، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا الاستقطابية التى تهيمن على الخطاب المعاصر كانت مطروحة بالفعل، لكنها تخفت كتجارب فكرية فى الأوساط الأكاديمية.
وبالنظر إلى الماضى، كانت التسعينيات فترة سهلة للغاية للعيش فيها. الأسلحة النووية لا تزال موجودة، لكن لم تكن هناك حرب نووية، الإنترنت حاضر، لكن على مضض. كما شهدت الولايات المتحدة آنذاك فترة مطولة من النمو الاقتصادى، دون التعقيدات المطولة لـ«حرب ساخنة» أو «باردة»، ما أتاح التركيز على المعيشة.
ويقول: «فى التسعينيات، كان عدم القيام بأى شىء عن قصد خيارًا صالحًا، وأصبح نوع معين من البرودة أكثر أهمية من أى شىء آخر تقريبًا. كان مفتاح هذه البرودة هو عدم الاهتمام بالنجاح التقليدى، فلم تكن التسعينيات عصرًا للطامحين».
المفارقة أن غرس هذه المواقف لم يكن له تأثير يُذكر على مسار العقد، فقد ترسخت قيم التسعينيات بعمق، لكنها طُبقت بشكل متقطع. ازداد عدد المشاهير من الطبقة المتوسطة، وكذلك شهية الجمهور للأخبار التى تُحركها الشخصيات. بلغت البطالة ذروتها فى عام ١٩٩٢، لكنها انخفضت بعد ذلك.
ازدهر الاقتصاد بشكل أكبر بكثير مما كان عليه خلال إدارة رونالد ريجان المهووسة بالمال والثروة. حررت عمليات القطاع المصرفى البنية الفوقية المالية من قيود التقاليد الاقتصادية، وأبرزها إلغاء التشريع الذى يفصل بين المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية عام ١٩٩٩.



