مدموازيل نفيسة المجهولة.. قصة السرد عند صلاح جاهين

- كان يمارس كل الفنون قاطبة الرسم وكتابة شعر الفصحى وجرّب العامية
- سمة السرد ظلّت لصيقة ومنبثة فى كل إبداعاته المتنوعة
كانت بدايات الشاعر صلاح جاهين متعددة المواهب، عندما كان منخرطًا فى الحركة الوطنية المصرية بكل مشاعره وروحه المقاتلة الدءوبة والأمّارة بالفن دومًا، وكانت مصر عندما تفتح وعيه فى عقد الأربعينيات من القرن العشرين تغلى وتنتفض كل يوم غضبًا بالثورة ضد الاستعمار وأعوانه، وكان ذلك الاستعمار وعملاؤه فى الداخل يحاولون الفتك بكل العناصر الوطنية المصرية، بل بالشعب كله،
فى عام ١٩٤٦ كان صلاح طالبًا فى مدرسة المنصورة الثانوية، وكانت المنصورة ثائرة بشكل متفاقم احتجاجًا على مذبحة كوبرى عباس، وكان قد سقط أحد شهداء الحركة، وجرّب صلاح أولى كتاباته الشعرية بالفصحى، فكتب:
«كفكف دمعى فلم يبق سوى جلدى
ليت المراثى تعيد المجد للبلد
صبرًا فإنّا أسود عند غضبتنا
من ذا يطيق بقاء فى فم الأسد»..
ومرّت سنوات وسنوات، وازداد انخراط الشاعر فى الحركة الوطنية الديمقراطية، وانضم إلى صفوف اليسار، وكانت معه حفنة من رموز ذلك اليسار، مثل يوسف إدريس، وإبراهيم عبدالحليم، وعبدالرحمن الشرقاوى، وعبدالرحمن الخميسى، وفؤاد حداد، وغيرهم من الذين صاغوا وجدان الناس بقوة وعزم وحماس وفن.

وكان صلاح فى تلك الفترة يمارس كل الفنون قاطبة، الرسم، وكتابة شعر الفصحى، وجرّب العامية بعد حوار طويل وعميق ومؤثر مع أستاذه فؤاد حداد، كما أن أثر دكتور لويس عوض عليه كان كبيرًا، خاصة فى ديوانه «بلوتلاند» الذى صدر فى عام ١٩٤٧، وكان قد تعرّف كذلك على قادة الحركة اليسارية، ومن هؤلاء الكاتب والمفكر والشاعر مصطفى هيكل- ابن شقيق الدكتور محمد حسين هيكل مؤلف رواية زينب-، الذى هاجر بعد ذلك إلى ألمانيا، وكان صديقًا تاريخيًا للفنانة برلنتى عبدالحميد، وكانت خطواتها الأولى فى حياتها تلميذة له، وكتبت عنه فى مذكراتها «المشير وأنا»، فهو الذى جذبها إلى عالم السياسة بشكل مباشر، ولأنها كتبت عنه مطولًا، سأقتبس مجرد سطور من حديثها عنه قائلة: «كانت قراءاتى الكثيرة، ومجادلاتى مع مصطفى هيكل قد جعلت منى محدثة لبقة..»، «.. وتطورت علاقتى بمصطفى هيكل فأصبح اللقاء لا يتم بيننا فقط، وإنما تعداه إلى لقاءات خارج البيت، وكان أكثرهم يتم فى حديقة الأزبكية، وكان كل لقاء أتعلّم منه شيئًا جديدًا، أو أقرأ كتابًا جديدًا، ويناقشنى فيه بعد قراءته، ليعلمنى كيف أحلل ما أقرأه وأفهم أبعد مما يوحى به ظاهر الكلمات».

وهذا ما جذب الشابة برلنتى عبدالحميد أن تكون إحدى المشاركات فى بعض تفاصيل الحركة الشيوعية، وفى تلك الفترة، تبنّى مصطفى هيكل- الذى له الكثير من المؤلفات فى الأدب والفكر والسياسة- الشاب الفنان الموهوب صلاح جاهين، وفى مايو ١٩٥٢، أصدر مصطفى هيكل ديوانًا شعريًا عنوانه «مع الجماهير»، وجاء الغلاف والرسوم بريشة الفنان صلاح جاهين، كما جاء فى متن الديوان، وبالإضافة إلى ذلك، أعجبت الدكتور هيكل إحدى مقطوعات جاهين الشعرية، ونشرها له فى متن الديوان، وقال فى مقدمتها «الغضب.. استمعت إلى هذه القطعة للفنان صلاح جاهين، فضممتها إلى نماذجى كقطعة من الشعر الواقعى الواضح الأهداف»، يقول جاهين فى قصيدته تلك التى لم يضعها فى أى ديوان:
«إنه الغضب إنه الغضب
إنه اللهب يطلب الحطب
ذلك الرضيع سوف لا يجوع
أمه الجموع أقبلت تثب
أمه الحياة قد حمت حماه
ترعب الطغاة والذى اغتصب
إنها تقول اقرعوا الطبول
طاردوا الفلول وهى تنسحب
إنها تصيح أيها الجريح
ضمد الجروح ثم قم وثب
أدرك الطعام فى يد اللئام
فهو بالحسام سوف يجتلب
إنه الغضب إنه الغضب
إنه اللهب يحرق الحطب»
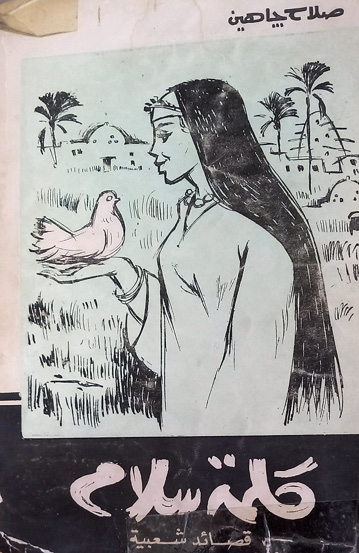
فى تلك المرحلة كان صلاح جاهين لم يعثر على أدواته الكبيرة التى برزت فيما بعد، فجرّب الشعر الفصيح، والرسم التعبيرى، وكان قد التحق فى بدايات عام ١٩٥٣ إلى أسرة تحرير مجلة «بنت النيل» بواسطة زميله ورفيقه لطفى الخولى، وكان جاهين هو المشرف الفنى للمجلة، وكان بالإضافة لذلك يكتب بعضًا من الشعر وينشره فى المجلة، وكتب القصة القصيرة، ونشر فى عدد مارس ١٩٥٣قصة الذهب، ونشرناها فى جريدة لأخبار الأدب منذ أكثر من عشر سنوات، وها هى قصة أخرى كتبها ونشرها فى جريدة «بنت النيل السياسية» فى عدد يوليو ١٩٥٣، وكان قد تمرّس على كتابة القصة، ورغم أنه قد تخلّى عن كتابة القصة القصيرة بشكل ما، إلى أن سمة السرد ظلّت لصيقة ومنبثة فى كل إبداعاته المتنوعة، ومن يتأمل أوبريت الليلة الكبيرة، سيكتشف أنها قصة فى منتهى العبقرية، وذلك الأمر يحتاج إلى دراسة طويلة وعميقة لكشف تلك التيمات السردية عند ذلك العبقرى الذى ملأ حياتنا بكل البهجة والجمال.
وأنتهز هذه الفرصة التى نتحدث فيها عن أمير شعر وشعراء العامية المصرية صلاح جاهين، وفى الذكرى التسعين لميلاد الشاعر الكبير محمد عفيفى مطر، لنشر شهادة نادرة عنه، وكان قد نشرها فى منتصف عقد التسعينيات فى جريدة الدستور.

القصة
كانت مدموازيل نفيسة تشعر بأنها جميلة، أو على الأقل تعرف أن لها فمًا أنيقًا، تزيد فى أناقته فورمة «الروج» الرشيقة التى تضيفها إليه، فهى مدببة من أعلى الشفة العليا، مقوسة من أسفل الشفة السفلى، وكان لون «روجها» واحدًا دائمًا لا يتغير، فهو أحمر عميق خفيف، ما يدل على أنها تمسحه قليلًا قبل أن تخرج من المنزل، أو أنه هو يفقد ثقله بعد قهوة الصباح، أو أنها تراه أكثر أناقة وهكذا.
وكنا نحن أيضًا، طالباتها المراهقات نشعر بأن لها فمًا أنيقًا، وأنه يكون أكثر أناقة عندما تميل برأسها إلى اليمين، وتقول بالفرنسية: «وى»، إجابة على أسئلتنا وطلباتنا التى تبدأ بكلمة «مدموازيل..» و «وى» هذه كانت تضم فمها وتزمه أولًا فتجعله فى حجم النص فرنك، ثم تعود فى المقطع الثانى، فتنشره فيما يشبه الابتسامة، فتظهر أسنانها الجميلة، وتتركه هكذا لحظة قصيرة، ثم لا يلبث أن يعود إلى وضعه الطبيعى.
- مدمواززيل.. !!
- وى..؟!
- أروح أشرب؟
- بارليه فرانسيه..»
وتكرر الطالبة طلبها بالفرنسية، فتقول مدموازيل نفيسة «وى»..!، ونتمتع بهذه المسرحية التى يمثلها فمها، ويكررها، ولا نملّها..!
تلك كانت هى مدرسة اللغة الفرنسية التى تلقيت على يديها أولى معلوماتى عن تلك اللغة، فى السنة الأولى الثانوية بمدرسة من مدارس البنات فى الوجه البحرى، وكنا جميعًا نحبها، وفى الرحلات كانت دائمًا تعدنا بأن نطلب من إدارة النشاط المدرسى، تنظيم رحلة لنا فى الإسكندرية، حيث تكون معنا- فقد كانت الإسكندرية بلدها- وفيها عائلتها، وإليها كانت تسافر مرة فى كل شهر.
وكان أبى يلاحظ تقدمى فى اللغة الفرنسية بعين الرضا، ويرتب لى مستقبلى بخياله إلى هذا الأساس، وكنت أنا أيضًا أحب أن أكون مدرسة اللغة الفرنسية، فقد كانت درجاتى فى امتحانى الأول سنة ١٩٤٥ تبلغ النهاية الكبرى.
والآن أنا أعمل فى شركة من شركات القاهرة، ويعجب، ويعجب أبى لنهايتى فيسألنى مستفسرًا:
«غريبة إنك لا تكادين تعرفين كلمة فرنسية واحدة، هل تذكرين ما كنا نقوله..؟ عن أنك ستصبحين مدرسة اللغة الفرنسية..؟».
ثم يسكت متعجبًا..!
أما أنا فأعود بذاكرتى إلى السنة الثانية الثانوية، عندما دخلنا الفصل لأول مرة، وكانت الحصة اللغة الفرنسية، ودخلت مدموازيل نفيسة، وكانت شاحبة، هزيلة، ولا أثر للروج على شفتيها، ثم جلست على مقعدها..!
ووقفت أنا، وقلت: مدموازيل...!
فقالت: وى..؟!
وذهلت، وذهلنا كلنا، كانت فى فمها حفرة عميقة كالقبر..!
لقد فقدت أسنانها..!
وانحدرت الدموع على وجناتنا.. ونظرنا إليها من خلال الدموع..
فرفعت رأسها، وقصّت علينا بالعربية كيف تعرض منزلها إلى غارة عنيفة فى ذلك الصيف فى الإسكندرية، وكيف سقطت على وجهها وهى تجرى نحو أخيها الصغير، وقد أصابته شظايا الزجاج، وكيف نهضت من سقطتها، وبصقت أسنانها.. أربعة أسنان بيضاء كاللؤلؤ..!
ولم نر المدموازيل نفيسة بعد ذلك، ولم نسمع عنها شيئًا، وكرهنا اللغة الفرنسية، ورسبنا فيها، ولم نستطع بعدها أن نصبح فيها شيئًا مذكورًا.
وأنا الآن.. لا أكاد أعرف من هذه اللغة ذات الآداب العظيمة غير كلمة.. «وى».







