قصّة قصيرة
فادى زغموت يكتب: جاهة فى الميتافيرس

لا أحب الأمور الغريبة وأبتعد عن كلّ ما هو مجنون وغير تقليدى. أُتقن التّحكّم بجسدى وتحريك عضلاتى لأُظهر ما أراه مناسبًا من وقار وحياء حسب ما يقتضيه الموقف وتطلبه الحاجة. إلا أنّ عضلة واحدة طالما أعجزتنى، تعاندنى كلّما سنحت لها الفرصة وتأبى أن تطاوعنى، مصرّة على هدر الجهود التّى أبذلها فى رسم صورة جميلة عن نفسى. ورغم محاولاتى السّابقة فى ترويضها واعتقادى الساذج بنجاحى، إلا أنّها خانتنى فى لحظة خاطفة سقطت فيها دفاعاتى. انقلبت علىّ وفرضت سيطرتها بشكل كامل يوم وقع بصرى على سعيد النّضوة. فلتت زمام أمورها وهاجت وماجت تتخبّط فى مكانها كالمجنونة بين انقباض وانبساط كما لم أرها سابقًا، وكأنّها فقدت عقلها مثلما فقدته أنا.
علىّ الاعتراف قبل متابعة سرد قصّتى، ومن أجل الحق والإنصاف، بأن سعيد خدعنا يومها. «مخبّّى فى قشوره»، كما يقولون، فهو مثلى، سيطر على عضلات جسده كافّة إلا واحدة منها. ولكن بخلاف عضلتى التى اختبأت فى قفص صدرى، فإنّ عضلته «النمرودة» احتلّت جمجمة رأسه.
تعوّد مفاجأتى بأفكاره المجنونة من حين إلى آخر ويتركنى فى حيرة من أمرى، متسائلة إن ٍأصبت بالوقوع فى حبّه أم لا. ضحكت على أفكاره الغريبة فى بداية علاقتنا وحسبتها نكاتًا، محاولة منه للتودّد لى والتقرّب منّى. وطالما وصفته لصديقاتى فى تلك الفترة على أنّه «خفيف دم» لا «مجنون». لم أجده جادًا فيما يقوله ولم أحسب أفكاره الغريبة قابلة للتطبيق، ولم أتخيّل أن يأتى يوم أنجر فيه لأصبح شريكة مباشرة له فى تجسيدها.
وهنا تعود بى الذاكرة إلى أوّل مرة خرجنا معًا وجلسنا فى أحد المقاهى فى منطقة عبدون، حين مرّ أمامنا فى الشّارع رجل غريب الشّكل أشعث الشّعر مُمزّق الملابس. بدا تائهًا يحدّث نفسه بشكل يوحى إلى أنّ مسًا من الجنون أصاب عقله. حسبته شحّاذًا حين وقع بصرى عليه وكنتُ فى العادة أبتعد عن الرّجال الغرباء غريبى الأطوار أمثاله تفاديًا للمشاكل، وأجده التّصرّف المنطقى والطبيعى الذى يتبعه كلّ أحد عرفته فى حياتى فى تلك المواقف، رجالًا كانوا أم نساءً. إلا أنّ سعيد النّضوة فاجأنى يومها ولم يترك الرّجل يمر فى حال سبيله. أشار له من مسافة وناداه طالبًا منه الاقتراب منّا. وحين اقترب منّا ووقف إلى يمين سعيد، لم يتردد سعيد بفتح حديث مطوّل معه. سأله عن اسمه وعن حاله وعمّا يفعل فى حياته، ولم يتوقّف عند أجوبة الرّجل اللا منطقيّة ولا إلى صعوبة نطقه الكلام. أنهى كلامه بعد لحظات، مخرجًا دينارًا من جيبه وضعه فى يد الرّجل، بسؤاله، «كيف شايف صاحبتى؟». أضاف محاولًا استنطاق الرّجل المُحرج من السّؤال: «حلوة؟».

استغربت سؤاله ولم يعجبنى تصرّفه، فأى رجل يسأل رجلًا غريبًا آخر عن جمال امرأته؟ لكنّى حافظت على هدوئى ولم أتخلّ عن وقارى. رشفت من كوب الشاى ووضعته على الطاولة وابتسمت ابتسامة صفراء، أتبعتها بالمبالغة بفتح عينى والضغط على أسنانى لتحذيره كى لا يتمادى فى فعله، نهرته بصوت خافت: «سعيد!».
من حسن حظّى أن الموقف المحرج كان على وشك الانتهاء، وسعيد لم يبالغ فى عرض جمالى على الرّجل غريب الأطوار، لذلك تخطيّت الأمر ولم أعلّق عليه. إلا أنّى أُعجبت بثقة سعيد بنفسه يومها وأحببت سهولة تواصله مع الغرباء وكرم أخلاقه فى كسر الحواجز الطبقيّة. بررت ما حصل بكونه يملك قدرة أكبر على تقدير الأخطار وأقنعت نفسى بأنّه أصاب بالاعتقاد أنّ الرّجل لم يكن ليشكّل خطرًا علينا بأى حال. لم يكن هنالك من داعٍ للقلق الذى شعرت به. لكنّ طريقة تعامل سعيد مع الموقف دفعتنى لمساءلة نفسى: هل وجب علىّ مراجعة تصرّفاتى لأكون أقلّ تحفظًا وأكثر عفويّة فى تعاملى مع الآخرين؟
وهذا بالفعل ما فعلت بعدما تقرّبت من سعيد واعتدت على وجوده إلى جانبى. بت أراقبه بحذر أحيانًا، وإعجاب فى أحيان أخرى، أتابع تفاصيل المواقف التى ورّط نفسه فيها وأتعلّم من إدارته لها بحرفية وإنهائها بسلام، حتّى حين تحتد الأمور بينه وبين الرّجل المقابل وتقترب من العراك. امتلك قدرة غريبة على قلب الطاولة على خصمه وإنهاء الأمور لمصلحته وكان لديه نفس طويل، وكأنه وجد متعة بالأجواء المتوتّرة.
أمّا أنا فكنت على النقيض منه، «أتكركب» من أبسط التّوترات، حتى تلك التى لا تستدعى القلق. إلا أنّى لِنتُ مع الأيّام وبتّ أكثر قدرة على مجاراته فى مغامراته، وأصبحتُ، حين يبدأ صداقة عفويّة مع أحد الغرباء، أسارع بالانضمام إلى حديثهم دون تشنّج أو توتر. وفى أحيانٍ قليلة تماديت بجرأتى ودعوتهم للجلوس معنا للتعرّف عليهم أكثر. لم أعد أتردد بقبول اقتراحات سعيد بالخروج فى مغامرة ما خارج المدينة، كأن نمضى يومًا فى البحر الميّت أو نذهب فى نزهة فى سيّارته حول ضواحى عمّان إلى ما بعد مغيب الشّمس. لكنّى أعترف بأنّى لم أنجح بالحفاظ على ذاك اللين وتلك العفويّة سوى فى حضرته وبوجوده إلى جانبى، وهذا ما جعلنى أتعلّق به ولا أقدر على فراقه.
تعددت مغامرات سعيد وأفكاره الخلاقة التى لم أستطع توقّعها، وكان له التفوّق على نفسه ذات يوم حين عزمنى إلى أحد مقاهى «الصويفيّة فيليج»، وانتهز فرصة هدوئى وانسجامى معه ليقترح علىّ طريقة، قدّمها لى على أنّها «مبتكرة» و«ثوريّة»، لجاهتنا.
عدّل من جلسته وسألنى فجأة دون مقدّمات: «شو رأيك نعمل جاهتنا فى الميتافيرس؟»، متابعًا يشرح لى، رغم انفجارى ضاحكة، حاسبة ما تفضّل به نُكتة، أنها ستكون الجاهة الأولى فى العالم التى تتم فى العالم الافتراضى.

شعرت بجديّته بعد لحظات حين لم يبادلنى الضحك. أردت التأكد مما قال، فسألته مباشرة: «إنتَ من كل عقلك بتحكى؟».
«آه من كل عقلى أكيد»، أجابنى بجديّة وأسرع يشرح لى الدافع خلف فكرته الغريبة: «شوفى تمارة حبيبتى.. إنتى بتعرفى أبوكى عقله خرا وأبوى لمّا بدّه يتيّس بتيّس. مستحيل أجمعهم تحت سقف واحد. بكرا إذا صار ما صار واختلفوا فى الجاهة بدبحوا بعض!».
كان معه حق، وكلانا يعرف أنّ عداوة قديمة نمت بين أبى وأبيه منذ اجتمعا فى صف دراسى واحد. تجدّدت العداوة حين التقط فاعل خير صورة لنا معًا فى سيّارة سعيد وأرسلها إلى أبى. جُنّ جنونه واتّصل بعمّى أبوسعيد وتوعّد وهدد بأن الأمر لن يمر بسلام إن لم يبتعد سعيد عن طريقى. لم يكن أمام والده سوى الانصياع للتهديد والعمل بما تقتدى به الأعراف والتقاليد. اعتذر من والدى مجبورًا ووعده بإصلاح الأمر. أنزل جُلّ غضبه على سعيد وتحلّف له بعقاب شديد إن لم يقطع علاقته بى.
لم يرضخ أىّ منّا لتهديداتهما لأنّها لم تكن أمرًا نستطيع التعايش معه. تورّطت بحب بسعيد، وهو لم يكن يملك القدرة على ترويض عقله للالتزام بما يمليه الآخرون عليه. وجدنا أمامنا خيارين لا ثالث لهما، إمّا مواصلة علاقتنا بالسّر والمخاطرة مجدّدًا بالوقوع فريسة سهلة لأحد فاعلى الخير «وما أكثرهم»، أو محاولة إقناعهما بأنّ السبيل الوحيد لإصلاح الأمر هو الإسراع بإجراءات الارتباط الرّسمى بينى وبين سعيد. كان الخيار الأول محفوفًا بالمخاطر بعد أن كلّف والدى أخى الصّغير «مقصوف الرّقبة»، طالب الجامعة، بمراقبة تحرّكاتى، والذى رغم احتيالى عليه وشرائى صمته بمبلغ زهيد ووجبة مشاوى مشكّلة من مطعم القدس، إلا أنّى لم أضمن صمته. أمّا الخيار الثانى فلم يكن أقل صعوبة لأنّه تطلّب مواجهة كلّ من والدينا وتحدّيهما والضّغط عليهما للامتثال لرغبتنا. ومع أنّ الأمر كان فيه مخاطرة من نوع آخر إلا أنّها كانت مخاطرة محسوبة ومدعومة أخلاقيًا فى كوننا لا نقوم بعمل شائن حين نصر على الزواج على سُنّة الله ورسوله. ومع أنّنا اكتسبنا دعم كافّة أفراد العائلة إلا أنّ أبى لم يرضخ لرغبتنا سوى بعد أن هدّدته بالهرب مع سعيد خارج حدود البلاد.
لم أعارض فكرة سعيد بترتيب الجاهة فى الميتافيرس من حيث المبدأ. وجدتّه محقًا رغم غرابة الحل الذى طرحه علىّ، فاجتماع والدينا تحت سقف واحد قد يؤدى إلى نتائج لا يُحمد عقباها. إلا أنّى سألته عدّة أسئلة لأتأكد من قدرتنا على إتمام هذه الجاهة بنجاح. أهمّها كان خوفى من رفض والدى الفكرة تحت ذريعة تقليلها من هيبتنا كعائلة ومن قيمتى كعروس، لكنّ سعيد أقنعنى بكونه قادرًا على إحضار عدد لا بأس به من وجوه العشائر ورجال بمناصب مهمّة بمن فيهم «إنفلونسرز» لا يختلف على محبّتهم أحد. وحين سألته عن قدرة رجال العائلة المسنيّن على التعامل مع الميتافيرس، ذكّرنى بكونه أبسط لهم من التنقّل من مكان إلى مكان والتواجد فى الجاهة بشكل شخصى. عدّل من جلسته وقال ببرود: «بالعكس إحنا هيك بنريّحهم أصلًا.. بيحضروا الجاهة من بيوتهم».
أقنعنى فوافقت على فكرته وأسرعنا فى اليوم التالى بزيارة أحد أهم منظمّى حفلات ومناسبات الميتافيرس الخاصّة فى مكتبه فى منطقة العبدلى بوليفارد، وكُنّا محظوظين بالحصول على ميعاد معه بعد توسّط ابن عم سعيد لنا الذى عرفه معرفة شخصيّة. لو لم نحصل على تلك المعاملة الخاصّة لتأجلّت جاهتنا لأسابيع ولربّما أشهر.
طُلب منّا التواجد قبل الموعد بساعتين على الأقل والانتظار فى القاعة المزدحمة ريثما يحين دورنا، مدة أمضيناها بالتّعرف على الخيارات المختلفة المتوفّرة من قاعات وأماكن ومساحات ميتافيرسيّة لترتيب حجزها، وكان علىّ بذل جهد مضاعف للحد من جموح سعيد باختيار أغرب الأماكن. ففى وقت بحثت فيه عن مكان تقليدى راقٍ يصلح للمناسبة، تحمّس سعيد لكل ما هو مختلف ومجنون.
سحبنى معه بدايةً إلى قاعة على سطح القمر تُشعر الحاضرين فيها بضعف الجاذبية. قفز فى الهواء ضاحكًا مستمتعًا بخفّة وزنه وكأنه استرجع طفولته وسألنى: «ها.. شو رأيك؟».

تلقّى الإجابة فى تعابير وجهى مباشرة، فهرب منها بالانتقال بنا إلى قاعة أخرى تطفو على مساحة كبيرة من الرّمل الأحمر، أدركته سطح كوكب المريّخ. وهناك لم أنتظره ليسألنى عن رأيى. مِلت بجسدى عليه ودفعته بقوّة لإخراجنا منها. بدّلت تعابير وجهى ونهرته بعصبية ورجوته أن يتعامل مع الأمر بجديّة أكبر. تعقّل بعض الشىء واختار واحدة فسيحة معلّقة بين السّحب وتُطل على مدينة عمّان. ومع أنّ المشهد بدا لى ساحرًا خلف نوافذها العريضة إلا أنّ ارتفاعها أشعرنى بالغثيان، تمسّكت بذراعه ورجوته أن يعود بنا إلى الأرض، فعدنا لكنّه لم يكفّ عن إغاظتى، مُنتقلًا بنا بين الغريب والعجيب إلى أن انقلب مزاجى تمامًا وهدّدته بالخروج من الميتافيرس وإلغاء المشروع كاملًا. حاول دفعى لاختيار قاعة «شِرحة» تحمل إطلاله جميلة على عمّان القديمة فى أعلى جبل القلعة، لكنّى فقدت صبرى وصرخت به: «إحنا عم بندوّر على قاعة لجاهة مو لعرس. ركّز معى. بعدين معك؟!!».
لم ينقذنى من جنونه سوى حلول دورنا ودخولنا إلى مكتب منظّم الحفلات، سامى، الذى ما إن عرف غرضنا وإذ به يسألنا بحماس للتأكّد مما سمعه: «بدكم تعملوا جاهة؟ جاهة؟!».
«برافو»، أضاف وهو يصفّق كفيّه بعد أن أكّدنا له طلبنا.
قام بعد ذلك برفع إبهام يده اليمنى وقال: «أوّل شى حبيّت الفكرة». أضاف بعد إلحاقه بفرد سبّابته: «وتانى شى حبيّت الجرأة».. «أنا من الأشخاص اللى بحبو التّراث كتير وبخاف على الأشياء اللى عم بتضيع منّا وما عم نعرف ننقلها معنا للعوالم الجديدة».
أكّد على الفور دعمه لنا ثمّ فاجأنا بإعلانه عن تنازله عن أتعابه مدّعيًا أنّها مساهمة رمزيّة منه لإعجابه بالفكرة الجريئة ورغبته بإنجاحها بغرض الحفاظ على الهويّة الأردنيّة من خلال تطوير الجاهة بما يتناسب مع روح العصر. إلا أنّى أعتقد أنه وجد فيها بداية لخط جديد من الأعمال يدر عليه دخلًا. أدركت أنّى أصبت حين عرض علينا قاعات مختلفة، مصنّفة فى درجات حسب السّعر وعدد المعازيم والخدمات المضافة.
بعد أن عرض علينا عدّة قاعات أنيقة، أعجبتنى واحدة من تصميم مصمم الأزياء الشهير «زهير مراد». لكنّها لم تُعجب سعيد. اعترض: «كثير عاديّة هالقاعة وغالية»، مُكملًا كلامه بالطلب منّى اختيار واحدة أخرى أرخص ثمنًا: «شوفى غيرها. حرام ندفع هالمبلغ بس عشان ساعة».
فى تلك اللحظة لم أرد سواها ولم أكن لأترك له حريّة الاختيار بعد أن طاف بى فى أنحاء الكون وطار بى إلى القمر والمريخ، لذلك لم أتردد بتذكيره: «سعيد حبيبى مين العروس هون؟».
«إنتى»، أجابنى.
«ومين رح يتحمّل تكاليف الجاهة؟»، سألته.
«أبوكى».
«طيب صف على جنب لو سمحت»، طلبت منه.
استطعت تحييده واخترت ما وجدته مناسبًا واتفقت مع سامى على ترتيبات الكراسى والطاولات وفناجين القهوة وصحون الكنافة والحلويات الافتراضيّة التى ستُوزّع على الحضور بعد قبول والدى طلب يدى من رجال عائلة سعيد. كان همّى الأكبر هو اختيار تصميم مميز لفناجين القهوة التى باتت تحمل أهميّة خاصّة فى المناسبات الافتراضيّة ويحتفظ بها المعازيم كقطع فنيّة للذكرى يضيفونها إلى مقتنياتهم. وجدت مجموعة مميّزة أعجبتنى، فطلبتها.
«طيّب كيف راح يدخلوا رجال عيلتك على القاعة؟»، فاجأنا سامى.
اعتقدت أنّهم سيظهرون داخلها عند ولوجهم للعالم الافتراضى مثلما سيظهر رجال عائلتى، وذلك ما افترضه سعيد أيضًا. إلا أنّ افتراضنا لم يُعجب سامى الذى هزّ رأسه ممتعضًا وقال: «قلّة احترام إلكم وإلهم». تابع كلامه مقترحًا علينا تخصيص منطقة قريبة لهم للتجمّع واستقلال سيّارات افتراضيّة فاخرة توصلهم إلى باب القاعة. وكون هذه الجزئيّة خصّت عائلة سعيد، وجدته يتصدّى لها بحماس، مطلقًا العنان لأفكاره وطالبًا من سامى إضافة مجموعة من الجِمال والأحصنة لترافق موكب السيّارات المهيب.
«جِمال وأحصنة؟»، تفاجأت من طلبه وهممت بالاعتراض: «سعيد حبيبى مالك انجنيت!».
التفت إلىّ بهدوء وسألنى مع ابتسامة خبيثة علت وجهه: «مين رح يدفع للموكب؟».
«أبوك».
«طيّب صفّى على جنب لو سمحتى».
ردّها لى، فصمتُ ولم أناقشه. تجاهلته وتخطيّت الأمر وتابعت كلامى مع سامى للاتفاق على التفاصيل المتبقيّة والتكاليف الماديّة النهائيّة. عرض علينا إضافة مصوّر لالتقاط صور وفيديوهات من زواية مختلفة خلال الجاهة ليكتمل توثيق المناسبة فوافقنا. أكرمنا بعد ذلك بخصم خاص للمدعوّين مُقدّم من متجر «ميتافيرس زارا للأزياء» على كافة البدل والملابس الرّجاليّة الرسميّة.
حدّدنا موعد الجاهة لتكون بعد أسبوعين وأخبرنا عائلتينا.
وفى اليوم الموعود، دخل والدى وأخى وأبناء عمومتى إلى غرفة الضيوف وأغلقوا الباب خلفهم محضّرين أنفسهم للولوج إلى قاعة الجاهة فى الميتافيرس. وجب عليهم التواجد فيها قبل وصول موكب عائلة سعيد كما جرت العادة، فيما اجتمعت نساء العائلة حول المطبخ وفى غرفة الجلوس لأنّنا نسينا إضافة قاعة خلفيّة للنساء يوم زرنا سامى. طلبنا منه إضافتها بعد أيّام لكنّه أخبرنا أنّ سياسة شركتهم لا تسمح لهم بالتعديل على المساحات المعروضة، ولم يسمح عقدنا معه بتبديل القاعة المختارة بأخرى، لذلك حُرمت النّساء من المشاركة فى الجاهة.
وقفت بينهم فى المطبخ مبتسمة أحاول اخفاء توتّرى عنهم. أنظر تارة فى ساعتى وتارة خلف الشبّاك بانتظار حضور ابن عمّى كريم. اقتربت من زوجة عمّى للمرة الثالثة وسألتها بهدوء: «وينو كريم ليش اتأخر؟».
أجابت: «فى الطريق حبيتى.. هلأ بوصل فى أى لحظة ما تقلقى».
لكنّى قلقت وخفت أن يتأخر أو يخلف بوعده لى.
لجأت إلى كريم قيل يومين ليجد لى حلًا لمشكلتى بعد أن تجاهلنى سعيد تمامًا حين صرّحت له عن استيائى من غيابى عن الجاهة. أردت حضورها ولو فى قاعة مطبخ افتراضيّة. أتلصص عليهم من خلف الجدران وأشاهد سعيد جالسًا بينهم وأسمع كبير عائلتهم يطلبنى. لكن سعيد لم يهتم لأمرى ولم يعنِ طلبى له شيئًا. لم يجد من ضرورة لحضورى ولم يتحمّس لمساعدتى أو يقترح علىّ أيًا من حلوله العبقرية، لذلك قررت استعارة جنونه وأوجدت حلًا بنفسى. وكان لجوئى لكريم طلبًا للمساعدة بديهيًا لأنه طالما عُرف فى الأوساط العائليّة بقدراته التقنيّة فى تطويع واختراق بوّابات الأمن السيبرانية. ويومها لم يكن فى عقلى سوى حلّ واحد عرضته عليه، يتطلّب دخولى الجاهة بالأفاتار الخاص به.
تفاجأ من فكرتى حين سمعها واعترض عليها مباشرة مدّعيًا أنه لم يعد يقوم بأعمال مخالفة للقانون. إلا أنّى لم أرضَ برفضه وعرفت كيف أطوعه. تذكرّت إعجابه بصديقتى المقرّبة، فاستخدمتها كرتًا للمساومة وعرضت عليه التعاون بترتيب لقاء له معها إن ساعدنى بحضور جاهتى. وافق على الفور واتّفقنا على ألا نخبر أحدًا كى لا نعرّض أى منّا للخطر.
اتّصلت بكريم عدّة مرات ووجدت هاتفه مغلقًا فازددت قلقًا وتوتّرًا. كدت اتّصل بسعيد وأطلب منه إلغاء الجاهة كاملة، لكنى لم أجرؤ على إحراج الجميع. لم أكف عن النظر من شبّاك المطبخ والالتفاف حول نفسى بعصبية ولم يعد يعنينى إن انتبه أحد إلى توتّرى أم لا.
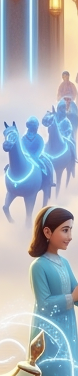
كدت أنفجر فى وجه كريم غاضبة حين ظهر أخيرًا، متأخرًا نصف ساعة عن موعده. سحبته من ياقة قميصة وأسرعت بإدخاله إلى غرفتى وأغلقت الباب خلفنا. أردت ضربه لكنى لم أملك الوقت لتوبيخه على تأخيره. أجّلت معاتبتى له لوقت لاحق وتابعته بعصبيّة وهو يجلس بكامل هدوئه على المقعد إلى جانب سريرى. أسرعت بخطف شنطته من بين يديه وأخرجت منها نظّارات العالم الافتراضى الخاصّة به. سحبتها ووضعتها على عينى، وسمعته يضحك وينبّهنى ببرود أعصاب: «استنى استنى».
نظرت له كاتمة غضبى مع وقوفه أمامى ليُخرج جهازًا صغيرًا من جيب بنطاله، مدّه لى، طالبًا منّى النظّر فيه كى ينسخ بصمة عينى الخاصّة. وبعد أن أنهى الجهاز مسح عينى مصدرًا صوتًا خافتًا، سحبه وضغط عليه مخرجًا منه شريحة إلكترونيّة أدخلها فى نظّاراته. سلّمها لى قائلًا: «تفضّلى».
وضعتها على عينى على عجل وولجت إلى قاعة الجاهة والتفت يمينًا ويسارًا لأتعرّف على مكانى فيها.
سُررت برؤية رجال العائلة فى كامل أناقتهم يتسامرون قبل وصول رجال عائلة سعيد. جُلت بنظرى حول القاعة وتأكدت من أن الترتيبات التى اتفقتُ مع سامى عليها نُفّذت كما طلبتُها. وجدت طاولة صغيرة أمامى وُضع عليها إبريق قهوة سادة وفناجين القهوة بالتصاميم التى اخترتها. حملت الإبريق وشممت رائحة القهوة المنبعثة منه وتمنيّت لو كان بالإمكان تذوّقها. بحثت عن المصوّر لأتأكد من حضوره ووجدته.
تفاجأت بعد لحظة بأحدهم يدفعنى من الخلف ولم أعرف إن كان أحد من الحضور أم كريم الذى تركته فى غرفتى، لكنّى ما إن التفت خلفى وإذ بى أجد «مقصوف الرّقبة» مبتسمًا.
نادانى بحماس: «كريم!!».
ترددت فى الرد عليه خوفًا من أن يكشفنى لكنّى تجرأت وناديته بالحماس ذاته: «محمد!!».
ارتحت لسماع كلامى يخرج بصوت كريم فلم أتردد بتقمّص شخصيّته، فردت ذراعى وأسرعت بحضن محمد وباركت له: «مبروك لتمارة». أضفت: «عقبالك!».
بحثت عن حجة للابتعاد عنه وجدتها بعمى فسألته: «وين عمّو؟»، واعتذرت منه بهدوء حين أشار لى إلى مكان جلوس أبى. «طيّب خلينى أروح أسلّم عليه».
تخطّيته وتظاهرت بالتّوجه نحو أبى ثم غيّرت مسارى وأسرعت بالوقوف إلى جانب باب القاعة حين سمعت صوت وقع أقدام وصهيل أحصنة. أوشك موكب رجال عائلة سعيد على الوصول، فالتزمت الصمت وراقبت دخولهم من مكانى وارتحت لدى رؤيتى لسعيد يدخل بمشيته المعتادة، ببطنه الساحل وركبه المتنافرة وأقدامه المنفرجة، فى الأفاتار الخاص به مثلما هو فى حياته العادية. راودتنى رغبة بالركض نحوه وإخباره بفخر بما فعلت. أردت رؤية ردّة فعله لدى إدراكه أنّنى بت مُغامرة مثله وأكثر جرأة منه، لكنى تمالكت نفسى ورفعت يدى لرد تحيّته بعد أن نظر باتجاهى وابتسم لى معتقدًا أنّى كريم. أسرعت، بعد احتلال رجال عائلته مقاعدهم، فى صفّ واحد مقابل لصّف رجال عائلتى، بالبحث عن مقعد بينهم أردته قريبًا من الحدث، ووجدت «مقصوف الرّقبة» يشير لى للجلوس فى المقعد الفارغ إلى جانبه فلم أتردّد.

جُلت بنظرى على الرجال التى أحضرها سعيد معه لأتعرّف عليهم، وابتسمت حين أدركت أنّه لم يخيب أملى. وفّى بوعده وأحضر ثلاثة من الإنفلونسرز المهمّين معه؛ اشتهر الأوّل منهم بنشره محتوى عن الرحلات والثانى بوصفات الطبّخ الشّهية، أمّا الثّالث، الأكثر شهرة بينهم، فعُرف بالمحتوى الكوميدى الخاص بحياته الزوجيّة. ينشر مقاطع يوميّة عن المقالب التى يقوم بها بزوجته، وعادة ما ينتهى بهم الأمر فى نهاية اليوم بالطّلاق، لكنّهم يتصالحون ويعيدون الكرّة فى اليوم التالى.
جلس الإنفلونسرز الثلاثة بين سعيد وأبيه وكبار رجال عائلته فى المقاعد الأماميّة فيما احتل صاحب المقالب منهم مقعد الوسط المقابل لأبى. توتّرت لإدراكى أنّ سعيد قد يكون أوكل له مهمّة خطبة طلب يدى. هل جُنّ؟ كدت أقوم من مقعدى وأتّجه نحوه وأوبّخه لكنّى لم أفعل بعدما تخيّلت ردّة فعل الجمع لرؤيتهم كريم ابن عمّى يوبّخ عريسى فى جاهتى. أغمضت عينى متأمّلة أن أكون مخطئة. ولكن للأسف، لم أكن! ما إن فتحتهم مجددًا وإذ بى أرى أبو المقالب واقفًا أمام الجميع، يضحك معهم قبل إلقائه كلمته وكأنّه وقف أمام جمهور مسرح واسع يقدّم «ستاند أب كوميدى» لا جاهة.
بدأ كلامه بعد لحظات بإلقاء السّلام: «سلام يا إخوان». أتبع سلامه بسؤال خبيث: «مين فيكم متزوّج؟».
رفع بعضهم أيديهم.
«الله يكون فى عونكم»، علّق ضاحكًا: «شر لا بد منّه!».
انفجر الجمع بالضحك بمن فيهم والد سعيد، لكنّ أبى بقى عابسًا لا يضحك. كذلك كريم «أنا» بدا غاضبًا لا يعرف ما يفعل.
حوّل الإنفلونسر من نبرة صوته وقال باحترام: «خلّينا نحط المزح على جنب. أوّل شى بحب أشكر عائلة سعيد الكرام بسماحهم لى طلب إيد ابنتكم تمارة لابننا سعيد على سنّة اللّه ورسوله».
التفت نحو سعيد وأشار له بالوقوف إلى جانبه وقال: «عريسنا الكريم يا إخوان غنى عن التعريف.. مش محتاج شهادة حد.. زلمة محترم ابن عيلة ومتعلّم».
قطع كلامه مازحًا مع سعيد بصوت منخفض ولكنّه مسموع: «يا زلمة ما بتغيّر رأيك؟».
هزّ سعيد رأسه مؤكّدًا إصراره على الزواج منّى، فيما ارتفعت ضحكات الرّجال مع محاولة الإنفلونسر إقناعه: «قول وغيّر يا زلمة، فى عاقل بعملها هالأيّام؟».
وضع يده على كتف سعيد وقدّمه لنا: «طيّب سعيد ما رح يغيّر رأيه. بس قبل ما توافقوا عليه بدى أسأله ٣ أسئلة. هيك امتحان بسيط قبل ما تتورطوا فيه».
نظر إلى سعيد وسأله: «جاهز؟».
هزّ سعيد رأسه وأجابه: «جاهز».
«السؤال الأول سهل.. إذا رجعت يوم على البيت وتمارة ما كانت طابخة، شو بتعمل؟».
قاطعه قبل أن يهم سعيد بالإجابة: «رح أعطيك خيارات.. الخيار الأول.. بتطلّقها.. الخيار التانى.. بترجعها لبيت أهلها.. والخيار التالت.. بتطلب أكل من برّة».
أجاب سعيد بهدوء وثقة: «بطلب أكل من برّة».
«طيب السؤال الثانى.. إذا اجت تمارة ليوم وحكتلك حبيبى لازم نتقاسم شغل البيت بيناتنا. شو بتكون ردّة فعلك؟».
«فى خيارات؟»، استفسر منه سعيد قبل أن يجيب.
«لأ ما فى.. جاوب على كيفك».
«إحنا هيك متفقين من الأوّل أنا وتمارة.. رح نتقاسم شغل البيت بيناتنا.. ما فيها شى».
لم تعجبنى الأسئلة ولا طريقة طرحها لكن إجابات سعيد لم تكن سيّئة. ويبدو أن فضول الجميع دفعهم للصمت بانتظار سماع السؤال الثالث الذى لم يكن بسهولة السؤالين الأولين.

«طيّب سعيد، أظن الكل بتّفق معى إنّك نجحت فى أوّل سؤالين. هلأ بدى أصعّبها عليك. السؤال التالت والأخير.. إذا كنت على قارب إنت ووالدتك وتمارة وإجت عاصفة وغرق القارب.. مين فيهم بتنقذ أول والدتك ولا زوجتك؟».
سؤال سخيف ومكرر وطفولى لكنّ سعيد أجاب بذكاء: «لازم تسأل تمارة مين رح تنقذ أوّل لأنّى لا أنا ولا الوالدة منعرف نسبح».
استغربت اعترافه بعدم قدرته على السّباحة رغم حبّه للمغامرات وتعامله معى على أنّى الحذرة والجبانة فى العلاقة. عزمت على مواجهته بذلك لاحقًا، وابتسمت وصفّقت له يدى مع باقى الرّجال، فيما وجّه الإنفلونسر كلامه إلى رجال عائلتى قائلًا: «طلع عريسنا ما بعرف يسبح. بترضوا فيه ولاّ غيّرتوا رأيكم؟».
حوّل بعد ذلك نبرة صوته لتكون أكثر جديّة واحترامًا وقال: «من جهتنا إحنا لسّاتنا طمعانين بإيد بنتكم تمارة لإيد ابننا سعيد».
أضاف موجّهًا حديثه إلى أبى: «بتمنى ما تبرد قهوتنا».
ساد صمت بعد ذلك، سكت الجميع بانتظار رد أبى، لكنّ أبى بقى ساكنًا فى مكانه لا يتحرّك. اعتقدت لوهلة أنّه زعل من هرج الإنفلونسر وقرر صد طلبهم، لكنّه أطال الصّمت. خاطبه الإنفلونسر مجددًا: «شو عمّى أبو تمارة؟»، ولم يلقَ إجابةً. حاول أبو سعيد من طرفه وقال غاضبًا: «شو أبو تمارة بدّك تفشّلنا؟»، لكنّ أبى لم يرد.
خفت أن يجيبه أبى بمثل عصبيّته وتفلت الأمور لتتطّور إلى عراك، وحمدت ربّى أنّى سمعت كلام سعيد وعملنا الجاهة فى الميتافيرس. مِلت إلى الأمام فى مقعدى لأرى إن كان أبى غاضبًا أم صامتًا يفكّر. وبدا لى صامتًا بلا حركة حين علّق الإنفلونسر قائلًا بصوت مرتفع: «الزلمة مو معنا». أضاف: «ليكون صرله شى».
أسرعت مع «مقصوف الرّقبة» بالاقتراب من أبى للتأكد، وفعلًا لم يكن له وجود، تجمّد الأفاتار الخاص، لرّبما قرر الانسحاب من الجاهة دون إخبار أحد، لكنّه إن أراد فعل ذلك لاختفى كاملًا ولم يترك الأفاتار فى حالة جمود مكانه. خفت أن تكون أصابته ذبحة صدريّة أو حصل له مكروه، فأسرعت بالانسحاب والعودة إلى غرفتى، رفعت نظّارات العالم الافتراضى عن عينى ووجدت كريم يسألنى بقلق: «شو كشفوكى؟».
«لأ ما كشفونى»، أجبته بعصبيّة واتّجهت إلى غرفة الضّيوف أبحث عن أبى، لم أجده، وجدت «مقصوف الرّقبة» ما زال جالسًا فى مكانه واضعًا نظّاراته على وجهه دون أن يترك الجاهة. أسرعت إلى المطبخ وسألت أمّى عن أبى وأجابتنى بشىء من الحيرة: «أبوكى فى الجاهة؟ شو فى؟». أضافت تسألنى: «وإنتى وين اختفيتى؟».
تركتها وبحثت فى أرجاء البيت ووجدت باب حمّام غرفتهما مغلقًا. طرقته وناديت عليه: «يابا؟»، وسمعت صوته هادئًا يجيبنى من الداخل: «آه يابا حبيبتى».
«يابا وينك؟ شو بتعمل؟ عم يستنوك فى الجاهة»، لم أصدّق أنه ترك الجاهة فى تلك اللّحظة الحرجة ليقضى حاجته.
«هينى جاى يابا».
«يابا يالّا يابا.. الرجال رح يمشوا.. مش عارفين إنّك فى الحمام!».
لم يخرج من الحمّام قبل مضى خمس دقائق بالتّمام والكمال، الأطول فى حياتى. وحين فتح الباب جررته جرًا ودفعته ليسرع ويعود إلى الجاهة. جلست إلى جانبه فى غرفة الجلوس على أعصابى ولم أتجرّأ بالعودة إلى غرفتى والدخول مرّة أخرى إلى الجاهة. لم أرد أن أرى ما حصل وكيف كان للأمور أن تتطوّر وللتوتّر أن يُحل. راقبته يهز رأسه ويبتسم وسمعته يعتذر ثم يوافق ويبارك لهم.
ارتحت إلى أن الجاهة انتهت على خير، وشاركت النّساء فى المطبخ فى توزيع الكنافة على أفراد العائلة، وتأكدّت من وصول طلبيّة الكنافة التى وصّينا عليها إلى منزل سعيد.
وفى اليوم التالى تصّدرت جاهتنا عناوين الصّحف وطافت فضيحتنا أنحاء المعمورة. أرادت جموع الناس معرفة تفاصيل الخبر المعنون بـ«قضاء والد العروسة لحاجته كاد أن يُفشل أوّل جاهة فى الميتافيرس».
لم يعرف أى منهم بالطّبع أن تفصيلة اختراقى غير القانونى للجاهة هو من أنقذها. لكنّ اليوم انتهى على خير وبقيت تلك الجاهة ذكرى مضحكة لا أنفك باستخدامها حجّة كى أصد أى فكرة مجنونة يقترحها سعيد «النّضوة» علىّ. وما زال سعيد، بعد سنوات من جاهتنا، يعصر عقله محاولًا إيجاد حلّ لحاجة الناس قضاء الحاجة فى الميتافيرس، مُصرًا على أنّنا لو لم نكن السبّاقين بنقل الجاهة إلى الميتافيرس لكانت اختفت ولم يعد لها وجود اليوم.








