فى ذكرى رحيله الخمسين «1»
زكريا الحجاوى.. أسطورة الأدب والفنون الشعبية

- الرجل يحتاج إلى نوع من البحث الموسع والتنقيب الهادئ وذلك للإشارة إلى كل آثاره العظيمة
- لم يأخذ قدرًا من البحث الوافى لمسيرته العظيمة ولا لأبحاثه الوفيرة
ليس من الضرورى أن تحلّ ذكرى رحيل أو ميلاد لكى نتذكر أعلامنا وأساتذتنا وقادتنا الكبار الثقافيين فى كل مجال، ولكن العادة صارت هكذا لكثرة الرموز والأعلام والفاعلين الذين كانت أدوارهم مساحة ضرورية لقراءة المشهد الثقافى بشكل كامل وشامل وعميق، فلا يمكن التعرف على مسارات وتحولات وتبدلات المشهد الفكرى والثقافى والأدبى على مدى قرن من الزمان، إلا إذا أعدنا قراءة إنجازات مثقفين وكتاب وأدباء من طراز فاعل ومؤثر مثل الدكتور طه حسين الذى كان حجة وعلامة على إرساء معالم النهضة الثقافية منذ العقد الثانى، ثم الثالث من القرن العشرين، فلا يمكن تجاهل معاركه الفكرية حول كتبه «فى الشعر الجاهلى، ومستقبل الثقافة فى مصر، والفتنة الكبرى» على سبيل المثال، ولا يمكن تصور باكورة الرواية المصرية، دون أن نستدعى مؤسسيها الأوائل مثل محمد المويلحى فى «سيرة عيسى بن هشام»، ومحمد حسين هيكل فى روايته «زينب».
هكذا نجد أنفسنا أمام حشد من الكتاب والمفكرين والأدباء من الضرورى أن نعمل على استعادتهم وقراءة منجزاتهم الفكرية والأدبية مثل: سلامة موسى وأحمد لطفى السيد، وإبراهيم عبدالقادر المازنى، وأحمد أمين، ومنصور فهمى، ودرية شفيق، ولطيفة الزيات، وعلى عبدالرازق، ونجيب محفوظ، وغيرهم الذين لا تستطيع مثل تلك السطور القليلة حصر ذكرهم جميعًا، لكننا نستطيع أن نقول إن الذاكرة التاريخية تستدعى يومًا بعد يوم، وعامًا بعد آخر، كثيرًا من هؤلاء.
لكن للأسف تسقط بعض الأسماء العظيمة بين الحين والآخر، رغم كل الإسهامات الجبارة التى قاموا بها، وعلى رأس هؤلاء، زكريا الحجاوى الباحث، والقاص، والمسرحى، وجامع التراث الشعبى، ومكتشف المواهب العظيمة من المنشدين ذوى الأصوات الشعبية القوية، مثل خضرة محمد خضر، وجمالات شيحة، ومحمد طه.
فهو أول من جعل الفن الشعبى يدخل دار الأوبرا الملكية التى كانت مقصورة فقط على الفنون الأوبريتية النخبوية، فكانت فكرة أوبريت «يا ليل يا عين» الذى استطاع الحجاوى أن يكسر به جمود مسرح الأوبرا، حتى نشاهد أصحاب الجلاليب والمزمار البلدى، والطبلة والرق والموال يصعدون على خشبة مسرح الأوبرا لكى تكون متاحة للجميع من طوائف الشعب وفئاته المختلفة، دون تندر على ذلك من كثير من الباحثين.
لكن بالطبع هناك من اندهشوا من تلك الفكرة، أى صعود الجلاليب والمزمار البلدى والطبلة إلى خشبة مسرح الأوبرا التى وقف عليها أرقى الفنانين والفنانات، وكان وراء ذلك يحيى حقى المسئول الأول عن مصلحة الفنون فى النصف الثانى من عقد الخمسينيات، الذى كلّف زكريا الحجاوى بذلك، والذى مرّت علينا ذكرى رحيله الـ٥٠ فى ٧ ديسمبر الماضى دون أى حس ولا خبر، رغم أنه المؤسس الأول لكثير من الفرق الشعبية، وكذلك مسرح السامر الذى أطلقوا عليه تكريمًا له «مسرح زكريا الحجاوى»، ولكن رويدًا رويدًا عاد اسمه مرة أخرى «مسرح السامر»، وكان من الطبيعى أن يسمى باسمه، لأنه مؤسسه الأول والقائد له، ثانيًا كنوع من الإخلاص من تلاميذه ومحبيه الذين تعلّموا على كتاباته التى لم تُجمع حتى الآن فى مجلدات أُسوة بغيره من الباحثين.

إن دور زكريا الحجاوى وجهوده البحثية والفنية والميدانية لم يستطع أحد أن يضاريها، ولا يبزه أو يضاهيه أحد من مجايليه، هناك أحمد رشدى صالح، وعبدالحميد يونس، وفاروق خورشيد، وحسن البقلى، وشوقى عبدالحكيم، ونبيلة إبراهيم من الأجيال السابقة، لكن لا أحد استطاع أن يفعل ما فعله الحجاوى الذى كان يذهب إلى القرى والنجوع والكفور والمراكز فى كل أقاليم مصر، وذلك من أجل اكتشاف كل المواهب المدفونة، والمستبعدة بفعل فاعل.
ورغم أن الحجاوى كانت لديه العزيمة تعمل دون انقطاع فى اكتشاف المواهب الأدبية فى كل فنون القول من الشعر والسرد والنقد والبحث فى التراث الشعبى- فإن أستاذنا يحيى حقى، استطاع أن يستثمر طاقة الحجاوى، ويفجرها داخل المؤسسة الرسمية، يقول حقى فى كتابه المهم «يا ليل ياعين... سهراية مع الفنون الشعبية»: «هل لدينا رقص شعبى؟، لم يكن السؤال مطروحًا من قبيل البحث النظرى، بل من واقع التجربة، فقد سبق لمصلحة الفنون أن أوفدت الأستاذ زكريا الحجاوى ليقوم بمسح جغرافى لفنوننا الشعبية، وطلب إليه أن يجوب بلدنا من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه ليلتقط لنا نماذج صادقة أصيلة لما يمكن أن نسميه بالرقص الشعبى، إذ كان الغرض أن نقدم عرضًا شاملًا للفنون الشعبية...».
وسافر بالفعل زكريا الحجاوى إلى كل ربوع مصر، ومن المعروف أنه قضى وقتًا طويلًا فى البحث والتنقيب، وكانت ركوبته الأساسية- كما يكتب يحيى حقى- الحمار بلا سرج ولا بردعة، يشق مدقًّا متربًا وسط أعواد من الذرة الشامى أو القصب، عملًا بحكمة «خطى القنا، بدلًا من أن تمشى سنة»، وبالفعل ذهب زكريا ولف ودار وعاد بثمار عظيمة، تلك الثمار التى طرحت فنونًا وأبحاثًا كثيرة، سنعود إليها لاحقًا فى حلقات مقبلة.

فالرجل يحتاج إلى نوع من البحث الموسع، والتنقيب الهادئ، وذلك للإشارة إلى كل آثاره العظيمة التى تركها لنا فى أربعة كتب فقط هى: «مسرحية بجماليون، وكتاب ملك ضد مصر، ومجموعة قصصية تحت عنوان زهرة البنفسج، ثم كتاب حكاية اليهود الذى صدر عام ١٩٦٨ بعد كارثة ١٩٦٧»، ولم تجد تلك الجهود من يجمعها، وهذا عدا مئات الأبحاث والدراسات والجمع الميدانى لكثير من السير الشعبية، وأنا شخصيًا لدىّ مخطوطان لم يُنشرا حتى الآن، الأول عن ابن عروس، والثانى عن أيوب المصرى.
ولا أذيع سرًا أن أقول بأن اتفاقًا كان بينى وبين الدكتور أحمد بهى الدين لإحياء ذكرى الرجل فى معرض الكتاب المقبل ٢٠٢٦، ونشر كل تراثه المطبوع والمخطوط والمنشور فى كثير من الصحف والمجلات، ولكن دائمًا تأتى السفن عكس رياح البحر، فاستقال دكتور أحمد بهى، وهاتفنى بعد أن ترك الهيئة، وقال لى بأن الدكتور خالد أبوالليل القائم بأعمال رئيس الهيئة لديه علم بما يخص زكريا الحجاوى، والذى كنا نجهّز لاحتفالية تليق به فى معرض الكتاب، ولكن يبدو أن انشغالات دكتور خالد أبوالليل الكثيرة، جعلته لا يتذكر ذلك الأمر، وليس من طبيعتى أن أعمل على تذكير ذوى المناصب العليا بأى أمور، حتى لو كانت أمورًا ضرورية، وهكذا ضاع المشروع فى زحمة أشياء كثيرة.
جدير بالذكر أن الرجل منذ رحيله الفاجع وكان خارج البلاد فى ٧ ديسمبر ١٩٧٥، لم يأخذ قدرًا من البحث الوافى لمسيرته العظيمة، ولا لأبحاثه الوفيرة، فقط كتب عنه محمود السعدنى فى كتابه «مسافر على الرصيف»، كذلك كتب عنه الكاتب الصحفى يوسف الشريف كتابًا مستقلًا عنوانه «زكريا الحجاوى.. موال الشجن فى عشق الوطن»، وكتب عنه أيضًا الدكتور سمير سرحان فى كتابه «على مقهى الحياة»، لكنها كلها كتابات تناولت سيرة الرجل من الذاكرة، وجهوده فى اكتشاف وتوجيه ورعاية الأدباء من أحد مقاهى الجيزة «مقهى محمد عبدالله»، والذى التقى فيه مع كثير من الأدباء الذين نمت مواهبهم تحت يديه، ولكن ما عدا الذكريات التى تأتى من الذاكرة، وتضم حكايات طريفة مع كثير من الأدباء والشعراء مثل صلاح عبدالصبور، وعبدالقادر القط، وأحمد عبدالمعطى حجازى، ورجاء النقاش، وأنور المعداوى، ونجيب سرور، وغيرهم، وبالتالى لا توجد مجالات فى تلك الكتابات للبحث العميق عن جهود الرجل الاستثنائية، وبالعكس هناك بعض الأخطاء الفادحة فى كثير من المعلومات التى يسوقها، مثلما كتب يوسف الشريف بأن زكريا الحجاوى كتب مسرحية «بجماليون» قبل أن يفكر توفيق الحكيم فى كتابة مسرحيته بالاسم ذاته.
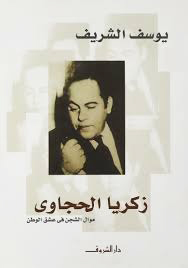
والصحيح أن مسرحية توفيق الحكيم نشرها فى عام ١٩٤٢، وكان قد كتبها قبل ذلك بعدة أعوام عندما كان يكتب لخشبة المسرح فقط، ولم يكن مقتنعًا بأن ما يصلح للخشبة يجوز أن يكون نصّا أدبيًا كما كتب فى مسرحيته تلك، لذلك بادر الحكيم بنشر كثير من النصوص المسرحية التى عثر على مخطوطاتها، وظلّ الكثير من مخطوطاته غير منشور، حتى عثر على بعضها الناقد فؤاد دوارة، ونشرها تحت عنوان «مسرحيات مجهولة لتوفيق الحكيم»، أما مسرحية الحجاوى فقد نشرت فى عام ١٩٤٦، وأهداها إلى صديقه الدكتور يس عبدالغفار الذى أصبح وزيرًا مهمًا للصحة فيما بعد، وكتب الحجاوى فى إهدائه: «إلى أسطورة الحكمة تلثغ حقائق الأرض فى آفاقها وتبين، إلى صديقى الدكتور يس عبدالغفار ريحانة أولى فى إعطاء الحب والتقدير».
ونُشرت المسرحية على نفقة مكتبة «الجيزة الحديثة»، وقدمها الناشر قائلًا: «هذا كتاب جديد لمؤلف لم تطبع له كتب من قبل، أخرجته دار للنشر لم يكن لها من بعد الصيت مدى، ذلك لأن صاحبها لم يكن معنيًا بنشر الكتب قبل اليوم، حتى شاء الله سبحانه أن يعطيه بين المكتبات مكانًا ملحوظًا فى القاهرة..».
وكتب الحجاوى مقدمة مستفيضة، وتحدث فيها عن أسباب كتابته للمسرحية، رغم مواهبه المتعددة، واستهل مقدمته قائلًا: أما الكتاب «قصة بجماليون»، عذراء الأساطير، وأما المؤلف، فابحث عنه بين السطور، وكثيرون من أبناء العربية قد صاحبوا بجماليون طويلًا فى دوائر المعارف المختلفة، وفيما كتب عنه باللغات الحية شعرًا ونثرًا، والكثير قد صاحبوا بجماليون فى تواليف ملخصة، وفى كتب ضئيلة.
وأظن أن الحجاوى كان قارئًا للأدب العربى بغزارة فى ذلك الوقت، ولذلك قد أشار فى مقدمته إلى انشغال المثقفين المصريين والعرب بما كان رائجًا فى ذلك الوقت، وكانت قصة أو أسطورة بجماليون واحدة من تلك القصص التى تم تداولها، خاصة بعد رائعة توفيق الحكيم عنها، وقبلها عندما كتب الكاتب المسرحى والفيلسوف الأيرلندى برنارد شو عن الأسطورة ذاتها.
بعد ذلك انشغل الحجاوى بالعمل فى الصحافة، وبعد أن كان مجرد كاتب صحفى يكتب فى بعض الصحف مقالات وانفرادات مهمة، منها مذكرات «منيرة المهدية» التى نشرها فى جريدة الوادى، انتقل إلى وظيفة سكرتير تحرير أهم جريدة فى مصر فى ذلك الوقت، وهى جريدة الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد، وكذلك جريدة المصرى، ولا يخفى علينا تلك الأهمية والشعبية الكاسحة لجريدة المصرى آنذاك، فضلًا عن ضلوعه فى تهريب الضابط محمد أنور السادات عندما كان متهمًا فى قضية اغتيال أمين عثمان، وكان الحجاوى قد تعرّف عليه بواسطة الفنان أحمد طوغان، وعمل على إيوائه فى بلدته «المطرية دقهلية» لمدة ليست قصيرة، وكان السادات وقتذاك يعمل فى عدد من المهن الشعبية، وكان رفيقه ضابط الطيران «حسن عزت» قد كتب كتابًا مهمًا عن تلك المرحلة، وسرد فيها وقائع كثيرة عن تلك الفترة، وقام الفنان طوغان بإعداد عدد من رسومات كاريكاتورية للسادات عندما كان هاربًا فى ذلك الكتاب الذى صدر عام ١٩٥٣، وكتب له عدد من القادة والساسة مجموعة مقدمات، منهم القائمقام محمد أنور السادات عضو مجلس قيادة الثورة.

وعندما قامت ثورة ٢٣ يوليو، كان لا بد أن تنشأ صحافة جديدة لكى تعبّر عن الخطاب الجديد للثورة، فتم تأسيس جريدة الجمهورية وجاء ترخيص الجريدة باسم الرئيس جمال عبدالناصر، وتولى رئاسة مجلس الإدارة أنور السادات، وقرر الاستعانة بصديقه زكريا الحجاوى، ليس لرد الجميل له الذى قام به تجاهه بعد اتهامه فى قضية مقتل أمين عثمان، ولكن لخبرات الحجاوى الفائقة فى الصحافة الفنية والثقافية وكذلك السياسية، وبالفعل تمت الإجراءات كما يسرد يوسف الشريف فى كتابه عن الحجاوى لإعطائه مهمة قوية فى الجريدة، ولكن فوجئ الجميع فى الجريدة وأولهم الحجاوى ذاته، بأنه تم تعليق منشور على باب الجريدة بمنع دخول زكريا الحجاوى الجريدة، واندهش الجميع من ذلك القرار الغريب، ولكن سرد الشريف أسبابًا كانت خافية على الجميع، وهى أن الحجاوى كان رجلًا شعبيًا، وبسيطًا، وعفويًا، وكانت تربطه بالقائمقام أنور السادات علاقة صداقة متينة، مما جعله يتعامل معه بين المحررين بالبساطة التى تهيمن على سلوكه، فكان يناديه بـ«يا أنور» مجردًا من الألقاب والرسميات التى كان كل أهل المهنة ينادون بها السادات عضو مجلس إدارة المؤسسة، ومن قبل عضو مجلس قيادة الثورة، ولكن الحجاوى لم يحفل بتلك الصفات والمناصب الجديدة التى أضيفت إلى صديقه، ومما زاد وغطى، أن الحجاوى لم يقتصر على مناداة السادات باسمه مجردًا فقط، بل كان يوجه له ملاحظات تصل إلى الانتقادات فى العمل الصحفى، اعتقادًا بأنه هو الأكثر فهمًا لعمل وطبيعة الصحافة وفنياتها المتعددة من أنور السادات ذاته، حتى لو كان رئيسًا للمؤسسة الصحفية، وذلك أثار غضب السادات بشدة، فقرر فصل الحجاوى من الجريدة قبل أن يبدأ العمل بها.

هذه رواية يوسف الشريف فى كتابه عن الحجاوى، لكن الشريف سرد تلك الحكاية التى تركت ألمًا كبيرًا فى نفس الحجاوى وحياته، وكذلك سرد آخرون أيضًا نفس التفاصيل بطرق أخرى، لكن كل من سردوا تلك الواقعة، أغفلوا عن عمد- ربما- أو عن عدم إدراك- يجوز- أن الحجاوى لم يتولّ وظيفة صحفية فى الجريدة الناشئة فى ذلك الوقت، ولكن هناك مجلة ثقافية وفكرية تم تأسيسها فى المؤسسة، وهى مجلة التحرير التى صدر عددها الأول فى ١٥ سبتمبر ١٩٥٢، وكان الحجاوى هو فارس الكتابة فيها منذ العدد الثالث، وكانت مجلة التحرير ضمن مطبوعات مؤسسة الجمهورية، والتى تقع تحت إدارة أنور السادات ذاته، وتم تخصيص عدة أبواب للحجاوى فى المجلة يحررها ويكتبها منذ العدد الثالث، وكان أشهر تلك الأبواب «رواد الحرية»، وكان أول موضوعاته عن بيرم التونسى، وهذا ينفى فكرة الإقصاء التى أصر على روايتها بعض أصدقاء زكريا الحجاوى، ولو كان السادات يريد إقصاء صديقه زكريا الحجاوى عن العمل، لما أتاح له الكتابة فى المجلة، وهذا كان أمرًا بسيطًا فى مرحلة صعود خطاب ثورة يوليو متعدد الوجوه، والأكثر إثباتًا لما نذهب إليه، أن فور صدور مجلة «الرسالة الجديدة» عن ذات المؤسسة التى يرأس مجلس إدارتها السادات فى يونيو ١٩٥٤، تم استكتاب الحجاوى منذ الأعداد الأولى، ولم تنقطع دراسته المهمة فى المجلة حتى توقفها، وكانت أهم كتاباته الفكرية والفنية والثقافية فى تلك المجلة، وهذا دليل آخر لعدم إقصاء الحجاوى من قادة ثورة يوليو فى ذلك الوقت، ولست هنا أدافع عن تبنى المسئولين لزكريا الحجاوى فى تلك المرحلة، ولكن الأهم أن المسئولين كانوا يدركون جيدًا من الذى يخدم الثقافة والفكر والفن، وبالتالى كانوا حريصين على استقطابهم، واستثمار طاقاتهم، وهناك دليل قوى على ذلك بالنسبة للحجاوى، وهو تكليف الأستاذ يحيى حقى مدير مصلحة الفنون آنذاك، بإسناد أوبريت يا ليل يا عين للحجاوى، ذلك الأوبريت الذى كان مفاجأة كاملة فى ذلك الوقت، مما سنكتب عنه لاحقًا فى الحلقات المقبلة إن شاء الله.









