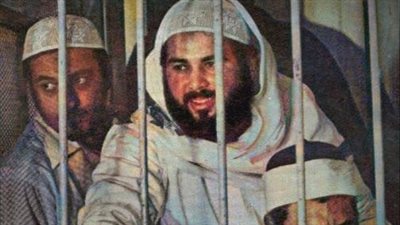القلقاس.. أقوى من الجدل العقيم

عيد الغطاس فى مصر لم يكن فى يومٍ من الأيام مناسبة تخص الأقباط وحدهم بالمعنى الضيق، ولا طقسًا كنسيًا معزولًا عن النسيج العام للمجتمع، بل كان جزءًا من إيقاع الحياة المصرية نفسها، من دورتها السنوية التى تتكرر دون إعلان، ومن عاداتها التى تُمارَس قبل أن تُفسَّر. كان العيد يُعاش بوصفه فصلًا من فصول الشتاء، لا مناسبة دينية مغلقة، ويُستقبل باعتباره عادة مألوفة قبل أن يكون رمزًا عقائديًا
فى ذلك الزمن، لم يكن الناس يتوقفون طويلًا أمام سؤال: لمن هذا العيد؟ بل أمام سؤال أبسط: ماذا نأكل؟ القلقاس والقصب والبرتقال لم تكن علامات هوية دينية، بل علامات موسم، إشارات يعرفها المصريون جيدًا، تدخل البيوت كما يدخل الشتاء نفسه، بلا استئذان، وتجلس على الموائد باعتبارها طعام الوقت لا طعام الطائفة. كانت المشاركة سابقة على الوعى، والعادة أسبق من المعنى.
القلقاس، الخارج من الطين والماء، كان أكلة شتوية ثقيلة، تحتاج إلى صبر فى إعدادها، وتُطهى على نار هادئة، مثل كثير من الأشياء التى تتطلب وقتًا كى تكتمل. فى الوعى القبطى يحمل القلقاس دلالة روحية مرتبطة بالمعمودية والتحول، بالخروج من الماء إلى النور، ومن القشرة الخشنة إلى القلب الأبيض. غير أن هذا المعنى لم يكن مطروحًا بوصفه شرطًا للفهم أو سببًا للمشاركة. فى بيوت المسلمين، كان القلقاس يُطهى ويُؤكل ببساطة، بوصفه أكلة موروثة، اعتادها الناس كما اعتادوا غيرها من أكلات الشتاء. لم يكن أحد يسأل عن رمزيته، لأن الرمز لم يكن حاجزًا، بل ظل ساكنًا فى خلفية العادة، لا يطالب بالتصريح ولا يفرض نفسه على المائدة.
القصب، بدوره، لم يكن رمزًا بقدر ما كان بهجة خالصة. طعم حلو مباشر، لا يحتمل التأويل، ولا يحتاج إلى شرح. أطفال من كل البيوت يقضمون أعواده فى أيام الغطاس، فى الشارع نفسه، وعلى الأرصفة نفسها، دون أن يخطر ببال أحد أن هذه الحلاوة قد تكون موضوع جدل أو موضع ريبة. القصب كان مصريًا خالصًا، ينتمى للأرض والماء والشمس، ويجمع حوله الناس كما تجمعهم أشياء كثيرة بسيطة، لا تُثير الأسئلة لأنها لا تدّعى أكثر مما هى عليه.
أما البرتقال، بلونه المشرق فى قلب الشتاء، فكان جزءًا من المشهد العام، لا من طقس مغلق. ثمرة شتوية يعرفها الجميع، تُقشَّر بسهولة، وتُوزَّع على الجيران والأقارب، دون وعى بأنها تنتمى إلى مناسبة دينية بعينها. كان البرتقال رمزًا للوفرة، للحياة التى تستمر رغم البرد، وللبهجة التى تظهر فجأة وسط الرماد. هنا كانت الفرحة أسبق من التصنيف، والمشاركة أسبق من السؤال، والإنسان أسبق من اللافتة.
هذه التفاصيل الصغيرة لم تكن هامشية، بل كانت جوهر العلاقة بين المصريين. فالعيش المشترك لم يكن شعارًا يُرفع، ولا ملفًا يُفتح عند الأزمات، بل ممارسة يومية، تتجلى فى الطعام، فى الشارع، فى التحية العابرة، وفى تبادل الأطباق. لم يكن أحد يشعر بأنه «يشارك» فى مناسبة الآخر، لأن فكرة الآخر نفسها لم تكن حاضرة بهذا الثقل. كان الجميع داخل المشهد، لا خارجه.
غير أن هذه الصورة البسيطة بدأت تتغير تدريجيًا منذ سبعينيات القرن الماضى، مع صعود خطاب وافد على المجتمع المصرى، خطاب أعاد تعريف العادة باعتبارها شبهة، والمشاركة باعتبارها خروجًا، والفرح المشترك باعتباره تهديدًا للهوية. خطاب لا يرى فى الطعام جسرًا، بل علامة، ولا يرى فى العادة تراكمًا إنسانيًا، بل انحرافًا يستوجب التصحيح.
ما يمكن تسميته بالغزو الوهابى الثقافى لم يدخل فقط عبر المنابر أو الكتب، بل تسلل إلى التفاصيل اليومية، إلى الأسئلة الصغيرة، وإلى الشكوك التى لم تكن موجودة. فجأة صار القلقاس «سؤالًا»، وصارت الزيارة «موقفًا»، وصار الامتناع عن المشاركة يُقدَّم بوصفه فضيلة. هكذا تحوّل ما كان طبيعيًا إلى مادة للجدل، وما كان بديهيًا إلى ساحة صراع، وانكسر شىء ما فى العلاقة بين الناس دون ضجيج، ولكن بأثر عميق.
الأخطر فى هذا التحول أنه لم يلغِ العادات، بل فرغها من معناها الإنسانى، وحمّلها أعباء أيديولوجية لم تكن لها. صار الناس يمارسون أشياء أقل، ويتساءلون أكثر، ويخافون من الخطأ فى مساحة كان الخطأ فيها مستحيلًا. هكذا تراجع العيش المشترك من كونه تجربة حية إلى كونه موضوعًا للنقاش، ومن كونه ممارسة يومية إلى كونه ملفًا سياسيًا أو دينيًا.
ومع ذلك، يظل عيد الغطاس شاهدًا على زمن آخر، زمن كانت فيه الوحدة الوطنية تُعاش ولا تُعلَن، وتُمارَس دون أن تُكتب فى بيانات. زمن كانت فيه المائدة أصدق من الخطب، والعادة أقوى من الجدل، والطعام أقدر على بناء الجسور من آلاف الكلمات. القلقاس والقصب والبرتقال لم تكن مجرد أكلات موسمية، بل ذاكرة مشتركة، تقول إن المصريين عرفوا يومًا كيف يختلفون فى العقيدة ويتشابهون فى الحياة، دون صخب، ودون خوف، ودون حاجة إلى تبرير.
وربما يكون استدعاء هذه الذاكرة اليوم ليس حنينًا إلى الماضى بقدر ما هو تذكير بأن ما جُرِّب مرة يمكن أن يُستعاد، وأن ما جمع الناس طبيعيًا لا يحتاج إلى إذن كى يعود. فالقلقاس لم يكن يومًا مسألة فقهية، والقصب لم يكن بيانًا سياسيًا، والبرتقال لم يكن رمزًا خلافيًا. كانت أشياء بسيطة، لكنها كانت كافية لتقول إن المجتمع حين يترك نفسه للحياة، تكون الحياة أذكى من كل الجدل العقيم.
وللقلقاس، خارج المطبخ وداخل الذاكرة الثقافية، حضورٌ أدبى لا يخلو من الدلالة. فقد تسلّل هذا الطبق الشتوى البسيط إلى واحدة من أشهر طرائف الشعر العربى الحديث، حين اجتمع كبار الشعراء فى دعوة غداء عند أمير الشعراء أحمد شوقى، وكان القلقاس سيّد المائدة بلا منازع. فى هذا السياق الطريف، طُرح تحدٍّ شعرى عابر: نظم بيت يتضمن كلمة «قلقاس». فجاء رد حافظ إبراهيم، شاعر النيل، لا بذكر الكلمة صراحة، بل بالتحايل عليها لغويًا، مطلقًا بيته الشهير: «لو سألوك عن قلبى وما قاسَى… فقُل قاسى… وقُل قاسَى… وقُل قاسى». لم يكن البيت غزلًا ولا شكوى عاطفية، بل دعابة لغوية ذكية، تحوّل ثِقَل الطبق إلى ثِقَل على القلب، وتكشف فى الوقت نفسه عن قدرة اللغة على اللعب، وعن حضور القلقاس فى الوعى الجمعى بوصفه شيئًا مألوفًا يسمح بالضحك والسخرية، لا بالتحفّظ أو النفور.
وتكمن أهمية هذه الطرفة الأدبية فى أنها تؤكد أن القلقاس لم يكن مجرد طعام عابر، بل عنصرًا مستقرًا فى الحياة اليومية إلى حد دخوله مجال المزاح الشعرى بين أعلام الأدب. فهو هنا ليس رمزًا دينيًا، ولا علامة هوية، بل مادة حياتية مشتركة، يتعامل معها الشعراء كما يتعامل الناس فى الشوارع والبيوت: بألفة، وخفة ظل، ودون حساسية زائدة. ومن هذه الزاوية، يصبح القلقاس شاهدًا ثقافيًا على زمن كانت فيه الأشياء البسيطة قادرة على الجمع بين الناس، حتى فى فضاءات النخبة والصالونات الأدبية.
أما إذا نظرنا إلى القلقاس من منظور أعمق زمنيًا، فإن السؤال عن جذوره الرمزية يقودنا إلى المخيال المصرى القديم، وإن كان بحذر معرفى واجب. فلا توجد نصوص فرعونية صريحة تُسمى القلقاس باسمه المتداول، ولا تشير إليه بوصفه نباتًا طقسيًا مركزيًا. غير أن طبيعته النباتية تضعه ضمن سياق رمزى أوسع عرفته الحضارة المصرية القديمة، حيث ارتبطت النباتات الخارجة من الطين والماء بفكرة الخلق الأول، وبالبعث والتجدّد، وبالخروج من الظلمة إلى النور. فالقلقاس، بنموّه فى بيئة رطبة موحلة، وبقلبه الأبيض الذى لا يُنال إلا بعد الصبر والتطهير، يجاور رمزيًا تلك التصورات القديمة عن الحياة التى تنبثق من الطمى، وتستعيد معناها عبر التحوّل.
من هنا، يمكن النظر إلى القلقاس بوصفه حلقة ثقافية غير منظَّرة، تصل بين القديم والحديث، بين الأسطورة والعادة، دون ادّعاء أو افتعال. فهو لم يحتج يومًا إلى تأصيل فكرى كى يكون حاضرًا، ولم يتطلب شروحًا دينية كى يُمارَس. ظل دائمًا فى منطقة الحياة البسيطة، حيث العادة أسبق من الرمز، والمشاركة أسبق من السؤال. وفى هذا المعنى، يصبح القلقاس- مرة أخرى- مثالًا على كيف يمكن لأبسط الأشياء أن تحمل ذاكرة مجتمع كامل، وأن تكون أصدق من الخطابات، وأبقى من الجدل.