أثـر «صُنع الله».. رحلة «الطائر الذى يضع منظارًا»

- الكاتب الكبير يعانى كسرًا فى الحوض ونزيفًا فى الجهاز الهضمى
- والده سماه «صنع الله» بعدما فتح القرآن ووضع يده على أول آية وكانت تحمل نفس المعنى
هل سمعنا من قبل عن عصر كامل يتجلى فى هيئة رجل واحد؟ نعم هو رجل واحد، بقامة قصيرة، وجسد نحيف، وذقن منحوت، وجبهة مسحوبة إلى الرأس تشبه الصحراء المليئة بالمعادن النفيسة، وعظام متآكلة بفعل 88 عامًا من التفكير والتأمل والتجريب والانفجار على الورق، هذا الرجل الواحد هو الروائى الكبير صنع الله إبراهيم.
إذن لم يكن غريبًا ولا مفاجئًا أن تنتفض الأوساط الثقافية بهستيرية لنبأ تعرضه لوعكة صحية شديدة، واحتياجه إلى المساعدة العاجلة، فنحن لسنا أمام كاتب عظيم فقط، بل حالة فكرية وأدبية وتاريخية بكل ما تحمله من مكانة ورمزية.
ولا شك أن ما تسرب من أخبار حول الحالة الصحية لـ«صنع الله»، يصيب محبيه وقراءه ومريديه بحالة قلق كبير، فى ظل تداخل وتكالب الأمراض على جسده النحيل، وهو ما قد يكون شفيعًا لحالة الاندفاع لدى البعض ممن وزعوا اتهامات التقصير هنا أو هناك من أجل إنقاذ الكاتب الكبير.

الجسد العليل
المفكر والطبيب الدكتور خالد منتصر كشف فى محاولة لتهدئة قلق محبى «صنع الله»، عن تفاصيل الحالة التى ترقد حاليًا فى الدور السابع بمعهد ناصر الطبى بالقاهرة.
وخاطب «منتصر» من انتقدوا أو زعموا تعرض الكاتب الكبير للإهمال من قبل الجهات المختصة، قائلًا إن ذلك المعهد هو أفضل الجهات التى يمكن أن تتعامل مع الحالة المصابة بكسر فى الحوض ونزيف فى الجهاز الهضمى ومشكلات مرضية أخرى.
وكتب خالد منتصر على صفحته بموقع «فيسبوك»: «كنت أول من طلب الاهتمام بحالة المبدع الكبير صنع الله ابراهيم ، وتواصلت مع صديقى وزميل دفعتى د.حلمى الغوابى، مدير مستشفى وادى النيل، فأوضح لى أن معهد ناصر الذى استقبل حالة كاتبنا الكبير هو من أفضل الجهات التى تتعامل مع مثل هذه الحالة».
ووجه رسالة إلى كل محبى «صنع الله» القلقين عليه، قائلًا: «أنا متفهم لكل القلق على الأستاذ الكبير، وأنا قلق وحزين وكلى أمل أن يعود إلينا سليمًا معافى، لكنى غير متفهم للحملة غير المبررة من بعض المثقفين على وزيرى الثقافة والصحة، فقد تواصلت معهما ومع المستشفى وعرفت أبعاد الحالة بالتفصيل».
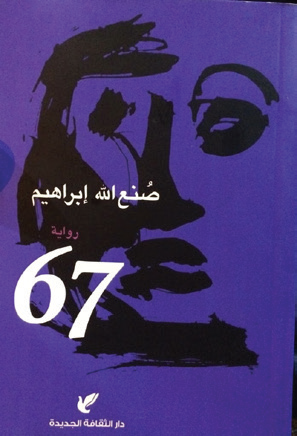
وشرح تفاصيل الحالة: «بالفعل الحالة طبيًا فى منتهى التعقيد، وجراحة كسر الحوض تحتاج قبل التدخل إلى أن يكون المريض مستعدًا لجراحة كبيرة بهذا الحجم، لكن للأسف هناك بعض المتاعب التى تؤجل التدخل وتمنعه حاليًا، مثل نزيف الجهاز الهضمى، الذى استدعى منظار قولون لكنه تأجل لضبط الارتفاع الشديد بالضغط».
وأكمل: «هو يتلقى كامل الرعاية الطبية وفى غرفة خاصة ومعه ممرضة خاصة، ولكن توجد مشاكل صحية عديدة ومشاكل بالكليتين والضغط والقلب وارتفاع بنسبة الصديد بالبول، وتم بالفعل عمل منظار علوى ومسح ذرى على الكليتين وأخذ مزارع، وجار تحسين حالته الصحية لإجراء جراحة تغيير المفصل وهو بالفعل يتلقى كامل الرعاية الطبية».

وتابع: «وزير الصحة يطمئن بنفسه على الحالة يوميًا، وهذا عرفته من المقربين، وأتمنى عدم التحامل والنظر للأمر بموضوعية، وكلنا ننتظر بإذن الله الأستاذ صنع الله بيننا بكل حيويته المعهودة، وإبداعه المتدفق، وأتمنى تجاوز تلك المشاكل الصحية للتدخل الجراحى، لأن هناك مشوارًا طويلًا من العلاج الطبيعى بعد تلك الجراحة الصعبة».
وقال «منتصر» إنه يثق فى فريق معهد ناصر لجراحة العظام، لكنه فى الوقت نفسه يتمنى فقط أن يتعاون معه فريق من أساتذة «قصر العينى» أو جامعة عين شمس فى تحديد ميعاد وإجراء الجراحة، مفسرًا ذلك بأنه ليس من باب قلة الثقة ولكن من باب تحقيق عامل «الكونسلتو».
القلق على الكاتب الكبير تسرب ليس فقط إلى قلوب قرائه، بل إلى أجيال المبدعين والكتاب على اختلافهم، والذين ملأوا الفضاء الإلكترونى والصحفى خلال الأيام الماضى، بالكتابة عن تاريخه ومكانته الأدبية ساردين ملامح من تجربته الهائلة على مستوى النضال الوطنى أو العمل الأدبى.
الشاعر الكبير فاروق جويدة، كتب فى مقالته بـ«الأهرام»: «سافرتُ كثيرًا فى أعماله وكنت أتابع مشواره وكان متفردًا وسخيًا، واختار مناطق الظل، وإن أثار جدلًا كبيرًا فى مشواره ومواقفه، قدرتُ كثيرًا كتاباته ولم أختلف معه كثيرًا، وإن جمعتنا الحرية والعدالة واحترام الذات».
وواصل: «اختار أن يبتعد عن الأضواء، رغم أنه مبدع متفرد، فإنه اختار الوحدة أسلوب حياة، كان يسارى الهوى باحثًا عن العدالة، وعاش وسط البسطاء من الناس، وجرب الصدام مع السلطة وسجن عدة سنوات مع مواكب اليسار المصرى، ولم تغيره سنوات السجن، ولم ينل ما يستحق من البريق والشهرة، ورفض جائزة الرواية العربية، وكان قرار الرفض موقفًا اختلف الناس عليه بين الرفض والقبول».

أما الروائى أشرف العشماوى، فقال إن صنع الله إبراهيم ليس روائيًا قديرًا فقط، بل مؤرخ بديل، يوثق المسكوت عنه فى يوميات الشعوب، ولا أبالغ إن قلت إنه لم يكتب الرواية بقدر ما أعاد تعريفها، فمنذ ستينيات القرن الماضى وحتى اليوم، ظل هذا الكاتب العنيد يسير عكس التيار، متسلحًا بوعى حاد وثقافة رفيعة، وإيمان لا يتزعزع بدور الأدب فى فضح الزيف وكشف ما يُراد له أن يُنسى.
الكتابة على جدار الزنزانة
لو أردنا أن نضع عنوانًا عريضًا لتجربة «صنع الله» فى الحياة وفى الكتابة سيكون العنوان هو «كسر التقليد»، فهو ينطبق عليه قول الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور: «كان يريد أن يرى النظام فى الفوضى، وأن يرى الجمال فى النظام».

«صنع الله» الذى ولد عام ١٩٣٧ اتخذ طريق الكتابة فى وقت كانت مصر تشهد فيه أوج النهضة الفنية والأدبية الحديثة، على كل المستويات ما بين الشعر والقصة القصيرة والأدب والفن التشكيلى وكذلك السينما.
لكنه قبل أن يكون كاتبًا كانت تنمو فى داخله بذور موهبة جارفة تنبئ عن ميلاد مبدع غير عادى، وكان يحمل فى ذاكرته أطيافًا من طفولة مليئة بالحكايات التى كانت تحتاج فقط إلى أن تتفجر على الورق، ونشأة متقلبة وعلاقة غير تقليدية تربطه بوالدته التى اختتمت حياتها بمصير صعب.
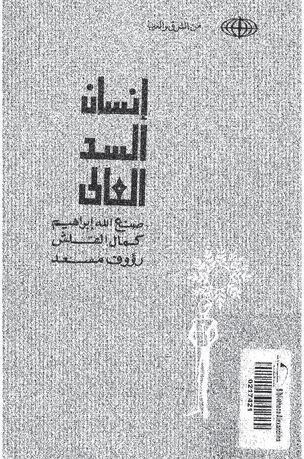
يحاول «صنع الله» وصف تلك النشأة فى حوار صحفى أجرته معه مجلة «الدوحة» فى عدد سبتمبر ١٩٨٥، فيقول: «طفولتى كانت شقية، فقد كان أبى موظفًا من الطبقة الوسطى وكانت زوجته الأولى من نفس مستواه، وكنت أنا ابن الزوجة الثانية التى كانت أقل اجتماعيًا منهما، وكانت تتعامل كممرضة لزوجته الأولى المشلولة».
يضيف «لقد كانت أمى صغيرة وجميلة ومتعلمة ومتدينة، وكانت حريصة على تسجيل يومياتها، وعانت فى حياتها ضغوطًا نفسية قادتها إلى مستشفى الأمراض العقلية، وأنا ما زلت فى السادسة من عمرى، وكان ذلك حكمًا على تلك المرحلة المبكرة بالنفى النفسى».
ولم يجد «صنع الله» حرجًا فى الكشف عن سبب تسميته بهذا الاسم، فيقول ضاحكًا: «لقد طرحت هذا السؤال على أبى فأخبرنى أنه بعد ولادتى احتار فى تسميتى فاستخار الله وفتح القرآن الكريم ووضع يده على أول آية وكانت تحمل معنى يقول إن كل شىء من صنع الله، فحملت أنا معنى هذه الآية الكريمة».
كل تلك العوامل الفطرية والموروثات الإنسانية المكتسبة من الطفولة، أودعت فى داخله ملكات روائية مختلفة تنحاز دائمًا إلى كسر الروتين والنمط، فيحكى: «كأى واحد من أبناء جيلى لم تكن لدى أى اهتمامات علمية، ولكن ظروفى الخاصة أيقظت حواسى الخمس يومًا نحو ما يحيط بنا من أشياء: السماء، الشجر، التراب، الشمس، الحجر، الحشرات والحيوانات، وبدأت أطرح على نفسى أسئلة كثيرة وقد انغمست فى عالم الحيوانات، كيف تعيش، كيف تحب، كيف تتوالد، وهل تحلم؟».

من هنا يمكننا أن نفهم لماذا اختار «صنع الله» الرواية دون غيرها من الأجناس الأدبية التقليدية مثل الشعر والقصة، فقد كان يحتاج إلى مساحة واسعة تمكنه من الانفراط مثل حبات العقد دون قيود إيقاعية كالموجودة فى الشعر أو تكثيف سردى مثل المتبع فى القصة القصيرة.
يقول «صنع الله»: «هناك ثلاثة أشكال للأدب لا أحبها أو لم أحب قراءتها: القصة القصيرة والشعر والمسرح، الرواية هى عالمى الحقيقى، وقصصى القصيرة التى كتبتها ما هى إلا حالات نادرة أردت أن أسجل فيها حاجة للكتابة ملحة وسريعة، كانت الرواية هى الإناء الذى اخترت لهذا الفيض المتدفق والمقلق فى نفسى».
وكانت تجربة السجن التى عاشها على خلفية انتماءاته السياسية اليسارية سببًا فى إبحاره فى عالم الرواية الشاسع، فيروى: «اتخذت قرارى بكتابة الرواية تأكيدًا لذاتى ودفاعًا عنها فى ظروف صعبة للغاية هى ظروف السجن، فكان الحصول على الورقة والقلم الممنوعين ثم توفير المخبأ الملائم لهما، يمثل انتصارًا على القضبان، وعلى الورقة كان بوسعى أن أمارس كل الحرية المفتقدة، ومارست الكتابة التى أورثتنى بعد ذلك العلل والأمراض».

ويخوض «صنع الله» أولى تجاربه الروائية من داخل السجن التى ستكتمل بعد خروجه منه وسيكون عنوانها «تلك الرائحة»، التى تداخلت فى تفاصيلها رغبات التجريب وأحلام الطفولة والنشأة، فيقول: «كان من الطبيعى أن تتحول الطفولة التى استيقظت أدق لحظاتها فى أيام السجن ولياليه الطويلة إلى منجم غنى بالنسبة للعمل الأول، لكنى لم أكتب غير بضعة فصول توقفت بعدها عندما واجهت المشاكل التى يواجهها كل كاتب فى بداية عمله، وأحيانًا كثيرة بعد الرواية الأولى».
ويواصل: «ما زلت أحتفظ بأرق المشاعر لتلك اللحظات التى كنت أنفرد فيها بنفسى إلى جوار سور السجن، مشرفًا على مساحات شاسعة من رمال الصحراء، لأكتب فصولًا من رواية ثانية، لم يقيض لها، هى الأخرى، أن تكتمل».
دوستويفسكى مصر
الميلاد الجديد لـ«صنع الله» كان لحظة خروجه من السجن، وهى لحظة فُتح له خلالها باب على اكتشاف الواقع وحقيقة الأفكار السياسية التى طالما ناضل من أجلها وسجن بسببها.
يحكى قائلًا: «عثروا علىّ فجأة فى منتصف عام ١٩٦٤، قبل أيام قليلة من تحويل مجرى النيل وانتهاء العمل فى المرحلة الأولى من السد العالى، وخرجت إلى الحرية بعد خمس سنوات ونصف السنة من السجن، لأواجه عالمًا مختلفًا بحكم ما تعرضت له أنا شخصيًا من تغيرات بالغة، بالإضافة إلى التغيرات التى لحقت بالمجتمع نتيجة الثورة الاجتماعية التى قام بها جمال عبدالناصر فى أوائل الستينيات».
ويصف تلك التغيرات: «أُلقيت طبقات قد اندثرت وطبقات غيرها ظهرت. وجدت أجهزة التليفزيون تحتل أغلب البيوت، والناس تعانى همومًا مختلفة للغاية، وكان ثمة أشياء غير مفهومة: الحديث يجرى عن اشتراكية تطبق، هى ما كنت أحلم به ودخلت السجن من أجله، أما الذين يطبقونها فهم المنتفعون بها بأجنحة متعددة من البرجوازية الصغيرة، هذا عالم مختلف إذن عما كنت أحلم به».
ويتابع: «كان من الصعب علىّ أن أحبس نفسى عما يحدث حولى وأدفنها فى منجم الطفولة الذاخر، وفشلت كل محاولاتى فى استكمال الرواية الثانية التى بدأتها فى السجن، وبدلًا من ذلك كنت أعود كل مساء إلى غرفتى، لأنسخ فى سطر، مجموعة أحداث».

تلك الرواية الثانية ستصبح فيما بعد «نجمة أغسطس»، التى يصفها بقوله: «تمخضت عن سجن بارد من القواعد الصارمة التى تُخيل إلى أنها تمثل طريقى الخاص، وهى ليست مجرد قواعد فى تقنية الكتابة فحسب، بقدر ما هى أيضًا نظرة إلى الحياة أساسها المراقبة والتوتر».
لكنه يعود إلى «تلك الرائحة» مجددًا ويواصل تجريبه حتى يصل إلى صيغة يرضى عنها وتعبر عن ما فى داخله من أفكار ورؤى، فيقول: «عندما كتبتها كنت خارجًا لتوى من السجن، خاضعًا للرقابة القضائية التى تستلزم التواجد فى المنزل من غروب الشمس حتى شروقها. وكنت أقضى بقية اليوم فى التعرف على عالم ابتعدت عنه أكثر من خمس سنوات. وما أن أوى إلى حجرتى، حتى أجد نفسى مدفوعًا لأن أسجل بلمسات سريعة ما مر بى من أحداث ومشاهدات، كانت تهزنى بعنف وتبدو لى عجائبية».

وأحدثت «تلك الرائحة» صدى مدويًا فى الأوساط الأدبية، فبينما انتقدها الكاتب الكبير يحيى يحقى بشدة ووصفها بأنها غريبة الخيال وتحتوى أوصافًا فيسيولوجية مزعجة، احتضنها عراب القصة يوسف إدريس، وهو احتضان ربما لا يخلو من هوى يسارى، لدرجة أنه كتب مقدمة أولى طبعاتها.
فى تلك المقدمة، كتب يوسف إدريس: «عرفتُ صاحب هذا الكتاب منذ أكثر من عشر سنوات، دقيق الجسم، دقيق ملامح الوجه، أحيانًا أُحسُّ به كالطائر الذى يضع منظارًا. ومنذ عرفتُ صنع الله وهو أصيل، لم أشهَده مرةً متلبسًا بخاطرٍ ليس من صنعه أو بفكرةٍ لم يَشقَ فى تحصيلها، وأسماء كثيرة أطلقتُها عليه، أوَّل ما عرفتُه سمَّيتُه داستايوفسكى أو كما تعوَّدنا تَسميتَه دوستويفسكى؛ فقد كان يكتب بطريقةٍ منسابة فياضة تُحسُّ أن وراءها نبعًا لا ينضب».

