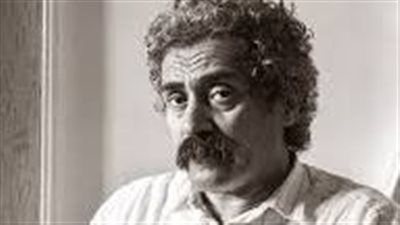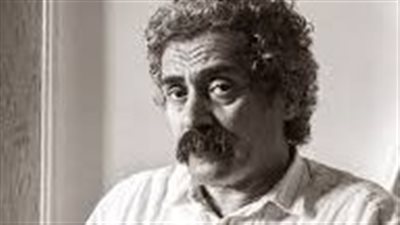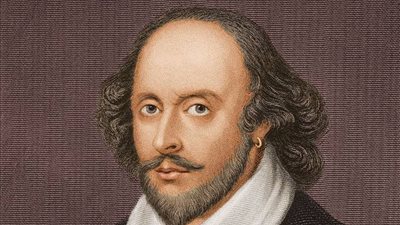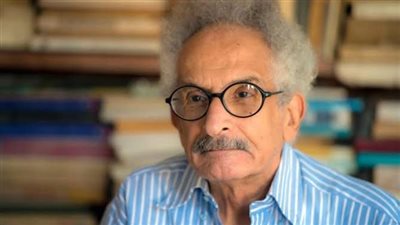«نزوات شعرية».. إعادة تشكيل العالم عبر ألعاب الحضور والغياب

- اللغة تجمع بين الصوفية والسخرية المرة
- يحمل القسم الأول من الديوان عنوانًا مخاتلًا «بهجة الحضور»
فى ديوانه «نزوات شعرية» يقدم الشاعر هشام محمود نموذجًا مكثفًا للشعرية الحديثة التى تتخذ من الذات منطلقًا لاستكشاف القضايا الوجودية الكبرى، ويمارس لعبة جمالية تعيد تعريف الحضور والغياب وفق بنية ثلاثية مركزية يعتمدها الديوان.
يتجاوز الديوان كونه مجرد تسجيل للحظات شعورية ليقدم بناءً فكريًا متماسكًا، يمكن مقاربته كشهادة وجودية مرتبة فى ثلاثة فصول أو حركات، لكل منها وظيفتها فى المسار العام للنص.
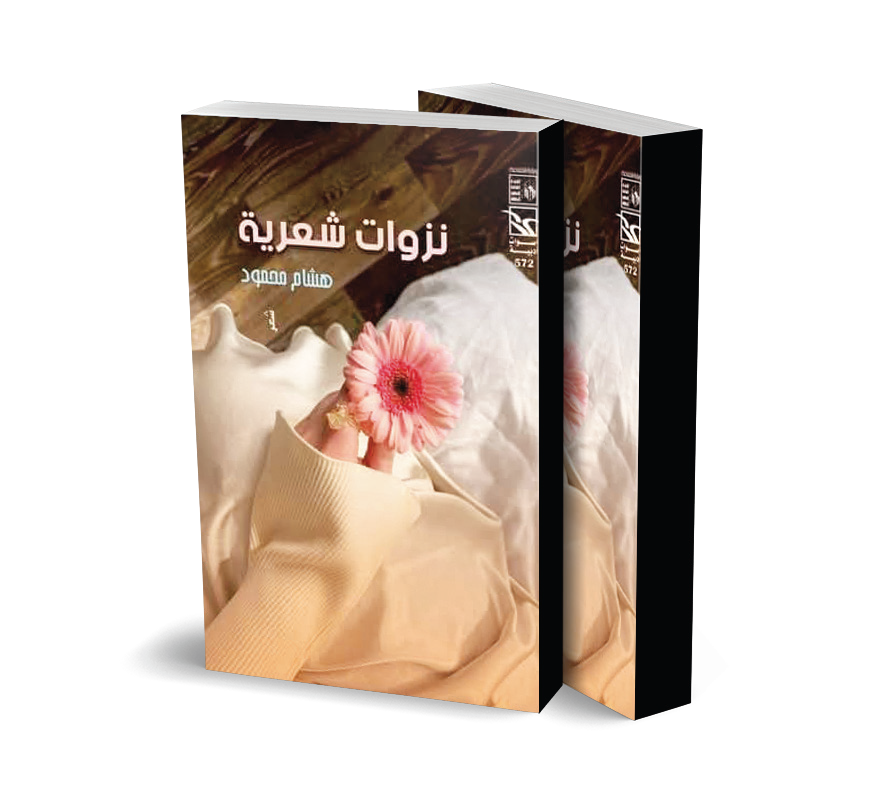
يرسم الشاعر من خلال هذا البناء رحلة الذات الشاعرة من حالة الانغلاق فى ألم الماضى وثقل الحضور، مرورًا بمرحلة التحول عبر الحب، وصولًا إلى حالة من التصالح الفلسفى مع مفاهيم الغياب والموت.
منذ مفتتحه، يعلن الشاعر نزوعه الفادح إلى «الافتراع الآمن»، كما يسميه، ويفضح ازدواجية المشاعر فى أقسى صورها، حيث يقول فى قصيدة «بهجة الحضور»:
«النص بالغ الكوميديا،
ولهذا سأرتق جروحًا...
آلمتنى كثيرًا،
بينما كنت أبحث..
عن جُملٍ عاطفية مناسبة..
لإغواء الرقيب...».
هنا تتجلى السخرية القاتمة بوصفها تكتيكًا شعريًا لا وسيلة للهروب، بل للاشتباك، كما يتقاطع الحس التهكمى مع فضاء من الحزن المعتم، يجعل الشاعر أشبه بعازف منفرد على حافة قبر مفتوح.
الزمن، وهو الشخصية الثانية فى هذا الديوان، ليس زمنًا خطيًا، بل زمنًا متكسرًا، مُفتّتًا إلى شذرات من «ثلاثين عامًا»، ترد كأنها لعنة تكرارية تؤثث أغلب المقاطع الطويلة، كما فى المقطع الذى يقول فيه:
«ثلاثون عامًا مرّت،
لم تنسَ فيها أحزانًا نبيلة...
تحزنها من أجلك..
حبيبة متخيلة…». «بهجة الحضور».
لا يعمل تكرار هذا الرقم، فى بنيته الزمنية والسيكولوجية، كإطار فقط، بل كرمز ثقيل المعنى لانغلاق الزمن وتوقف التحقق، حيث يظل الحبيب حجرًا أثريًا فى متحف عينين، لا أكثر. لا يتغير، ولا يُحرّر.
وليس حضور المرأة هنا حضورًا ناعمًا، ولا هى مصدر إلهام تقليدى. بل كينونة مرآوية، تتقاطع مع الذات الشاعرة، وتعيد تشكيلها وابتلاعها. فى قصيدة «حضور الحضور» يكتب هشام محمود:
«المرأة الوحيدة
القادرة على أن تغزونى بدفئها،
وحضورها عندما تغيب...».
والغياب ذاته يتحول إلى حضور كلى، يحلّ محل الأشياء، وينسج شعرية مغايرة لا تقوم على فعل الحضور بل على أثره، على ظله، على فراغه المحموم.
الموت، من جانبه، ليس نهاية، بل «تجربة» مكرورة تُستعاد بشغف غريب. فى واحد من أكثر مقاطع الديوان تماسًا مع العبثية الوجودية، يقول:
«جربته من قبل
وكان لذيذًا،
وكنت مستمتعًا للغاية
بممارسة نفس الطقوس:
الدهشة،
والبكاء حتى جفاف الروح،
والوحشة». «بهجة الحضور».
إنه طقس حياة مضاد، ممارسة وجودية لا تهدف للهروب، بل للتطهير من رتابة الحياة اليومية، حيث تنقلب التجربة إلى احتفال جمالىّ بائس، يعيد للعدم طراوته المفقودة.
يبدأ الشاعر الديوان بتقديم صورة ذاتية مركزية تعمل كمفتاح لفهم نصه، فهو «عُصْفُورٍ مَكْسُورِ الجَنَاحَيْنِ»، لكن هذا الكسر لا يمثل عجزًا مطلقًا، إذ يؤكد الشاعر أن هذا العصفور «بِالتَّأْكِيدِ قَادِرٌ عَلَى الطَّيَرَانِ.. فِى آفَاقٍ يَعْلَمُهَا.. مِنْ رُوحِهِ» «من قصيدة (بهجة الحضور)». هذه الافتتاحية تحدد مسار القراءة عبر تتبع آفاق هذا الطيران الروحى، الذى ينبع من الجرح نفسه.
بهجة الحضور
يحمل القسم الأول من الديوان عنوانًا مخاتلًا، «بهجة الحضور». فالبهجة هنا غائبة تمامًا، والحضور هو حضور الألم والذاكرة والزمن الراكد. يستخدم الشاعر هذا العنوان على سبيل المفارقة، ليؤكد على أن الحضور المادى، بمعزل عن أى أفق روحى، هو عبء ثقيل. ويتجلى هذا الثقل فى لازمة «الثلاثين عامًا» التى تتكرر كصدى مؤلم، وتعمل كإطار زمنى يحدد حجم المعاناة واستمراريتها. هذه الأعوام ليست مجرد قياس للزمن، بل هى رمز لعمر من الجروح المفتوحة ومحاولات العلاج الفاشلة: «ثَلَاثُونَ عَامًا/ تَتَأَمَّلُ جُرُوحَكَ الغَضَّةَ/ وَتُحَاوِلُ تَجْرِيبَ أَدْوِيَةٍ جَدِيدَةٍ/ عَلَّهَا تُفِيدُ». يمتد هذا الشعور بالزمن العالق حتى فى التفاصيل اليومية الصغيرة، ليتحول الألم الوجودى إلى حالة عبثية تقريبًا، كما فى محاولته علاج «ظفْرٍ ضَلَّ طَرِيقَهُ» لمدة ثلاثين شهرًا، وهى مدة كافية، كما يقول بسخرية مريرة، «لِإِقَامَةِ عَلَاقَةٍ مِنْ الوُدِّ.. / بَيْنِى وَبَيْنَ هَذَا الأَلَمِ».
هذا الألم المستمر يؤدى إلى حالة من الاغتراب عن الذات، تصل إلى ذروتها فى الإعلان الصادم والمباشر: «أَنَا لَا أُحِبُّنِى/ وَلِهَذَا لَنْ أَكْتُبَنِى../ بَعْدَ الآنَ». هنا، تفشل الكتابة، التى يُفترض أن تكون أداة للخلاص أو الفهم، وتصبح الذات نفسها موضوعًا مرفوضًا. فى هذا السياق. كما تظهر الحبيبة كجزء من منظومة الألم، فهى ليست المنقذة بعد، بل هى التى «تُحْدِثُ فِى قَلْبِكَ شَرْخًا/ لَنْ يَنْدَمِلَ بِمُرُورِ الوَقْتِ». وتتحول الذات الشاعرة فى حضرتها إلى مجرد شىء، فاقد للإرادة والحياة، مجرد «حَجَرٍ أَثَرِى/ فِى مُتْحَفِ عَيْنَيْهَا».
حضور الحضور
يمثل القسم الثانى، «حضور الحضور»، نقطة تحول حاسمة فى البنية الفكرية للديوان. ينتقل الشاعر هنا من الحضور المادى الثقيل إلى حضور من نوع آخر، حضور روحى يتجسد فى الحبيبة، التى تتحول من كونها جزءًا من منظومة الألم لتصبح هى نفسها أداة الخلاص. تتغير اللغة الشعرية بشكل ملحوظ، فتصبح أكثر احتفاءً وإشراقًا. الحبيبة هنا هى «المَرْأَةُ الوَحِيدَةُ/ القَادِرَةُ عَلَى أَنْ تَغْزُوَنِى بِدِفْئِهَا/ وَحُضُورِهَا عِنْدَمَا تَغِيبُ». هذا البيت هو مفتاح فهم منطق الديوان، فهو يقدم فكرة أن الغياب يمكن أن يكون شكلًا من أشكال الحضور الأسمى، وهى الفكرة التى سيصل بها إلى ذروتها فى القسم الأخير.
يبنى الشاعر صورة الحبيبة من خلال سلسلة من المتناقضات التى تعكس ثراء التجربة وتعقيدها، فهى «الطَّيِّبَةُ كَوَرْدَةٍ»، و«الشَّفَّافَةُ كَدَمْعَةٍ»، ولكنها فى الوقت نفسه كائن مراوغ يجمع بين «قِطِّيَّتَهَا اللَّعُوبَ» و«إِنْسَانِيَّتُهَا المُدْهِشَةُ». هذا التعدد فى الصفات يجعل منها رمزًا للحياة نفسها، بكل جمالها وغموضها، لا مجرد صورة نمطية للمرأة فى الشعر الغزلى. ويقوم الشاعر برفع هذه التجربة الإنسانية إلى مصاف التجربة الروحية عبر استعارة مفردات من الحقل الدينى، فيصف نفسه بأنه «قِدِّيسٌ../ لَمْ يَرُقْ لَهُ التَّنَسُّكُ../ إِلَّا فِى مَعْبَدِ عَيْنَيْهَا». يتحول الحب هنا من علاقة شخصية إلى قوة كونية قادرة على منح معنى للوجود، ويصبح حضور الحبيبة هو الحضور الحقيقى الذى يطرد وحشة الحضور المادى الأول.

تجليات الغياب
يصل الديوان إلى خلاصته الفلسفية فى القسم الأخير، «تجليات الغياب». تتقلص القصائد هنا فى حجمها، وتكتسب طبيعة شذرية مكثفة، كأنها خلاصة الحكمة التى توصلت إليها الذات بعد رحلتها الطويلة. فى هذا الفضاء الشعرى، يتم حل التناقض الأساسى الذى بدأ به الديوان. لم يعد الغياب نقيضًا للحضور، بل هو تجلٍ لأرقى صوره. تتردد المقولة المحورية للديوان هنا بصيغ مختلفة، وأوضحها: «غِيَابُهَا../ يَخْلُقُ حُضُورًا../ فَوْقَ الحُضُورِ». يتحرر الشاعر تمامًا من وطأة الحضور المادى ليعانق حضورًا روحيًا مطلقًا، لا يعتمد على الوجود الجسدى.
هذا الفهم الجديد للغياب يغير علاقة الشاعر بالموت أيضًا. فالموت، الذى كان شبحًا فى بداية الديوان، يفقد سطوته ويتحول إلى موضوع للتأمل الهادئ، بل وحتى التحدى الساخر. فى واحدة من أكثر الصور الشعرية جرأة فى الديوان، يقول الشاعر: «لَيْسَ فِى مَأْمَنٍ../ ذَلِكَ المَوْتُ مِنِّى/ سَأَزْرَعُهُ أَسْلَاكًا شَائِكَةً/ وَزُهُورًا سَامَّةً/ وَأَبْتَهِجُ بِالغِيَابِ». هذا التحدى لا ينبع من العدمية، بل من إدراك عميق بأن الروح قادرة على تجاوز الجسد، وأن الغياب ليس نهاية، بل هو استمرار للحضور بشكل آخر. وتتوج هذه المرحلة بمجموعة من الأقوال الشعرية التى تشبه الحكم الفلسفية، مثل: «كُلَّمَا اِتَّسَعَتْ الرُّؤْيَةُ/ ضَاقَ بِىَ الكَوْنُ/ كُلَّمَا ضَاقَ../ وَسِعَتْنِى الرُّؤْيَا». هنا، تصل الذات إلى حالة من التوازن، حيث يصبح عالمها الداخلى أوسع من الكون الخارجى.
ينسج هشام محمود، إذن، عالمًا شعريًا مكثفًا، يرتقى فوق كونه مجرد تجميع قصائد إلى سيرة وجودية مفتوحة. الديوان- ببنائه الثلاثى (بهجة الحضور، حضور الحضور، تجليات الغياب)- ليس مجرد تقسيم فنى، بل جغرافيا نفسية تعكس رحلة الذات من التوهج إلى الفقد، ومن الكينونة إلى السؤال عن الموت، فى لغة تجمع بين الصوفية والسخرية المرة، بين الحنين التشكيلى والتفكيك الوجودى.