حياة أورجانيك.. نصف «جيل زد» فى بريطانيا يكرهون الـ«سوشيال ميديا»

أصدر نيك كليج، نائب رئيس الوزراء البريطانى خلال الفترة من 2010 إلى 2015، المسئول التنفيذى السابق فى شركة «ميتا»، كتابه الجديد: «كيف ننقذ الإنترنت»، والذى يستعرض فيه تجربته الممتدة بين عالمى السياسة والتكنولوجيا، وما رافقها من محاولات لبناء جسور بين قوى متعارضة مثل «المحافظين» و«الليبراليين» فى بريطانيا، ثم بين «وادى السيليكون» والعواصم السياسية الكبرى فى واشنطن وأوروبا.
الكتاب يمثل شهادة شخصية ورؤية تحليلية حول مستقبل العلاقة بين شركات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية، وكيف يمكن تحويلها من صراع إلى تعاون أكثر فاعلية. ونظرًا لأهميته الكبيرة، كتب عالم نفس الاجتماع الأمريكى جوناثان هايدت، مقالًا عن الكتاب فى صحيفة «الجارديان»، تترجمه «حرف» فيما يلى.

إضعاف الديمقراطية
يقول نيك كليج، فى كتابه الجديد: «كيف ننقذ الإنترنت؟»: «الغاية الحقيقية من هذا الكتاب ليست الدفاع عن نفسى أو عن (ميتا) أو عن التكنولوجيات الكبرى، بل دق ناقوس الخطر عما أراه من مخاطر كبيرة على مستقبل الإنترنت، ولمن سيحظى بثمار هذه التقنيات الثورية».
لكنه فى الواقع يكرس جزءًا كبيرًا من الكتاب للدفاع عن «ميتا» و«التكنولوجيات الكبرى»، ويبدأ هذا الدفاع بخلط مقصود بين «الإنترنت» الذى يحظى بشعبية واسعة، ووسائل التواصل الاجتماعى، وهى جزء من نشاط «الإنترنت» المثير للاختلاف والالتباس فى المواقف.
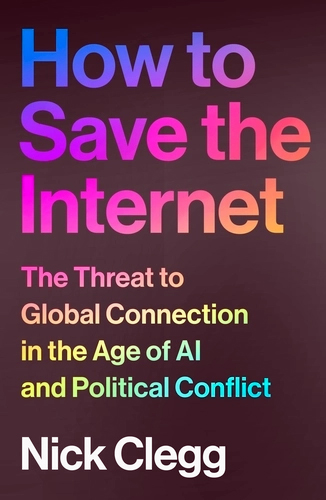
فى حديثه عن «ردة الفعل ضد التكنولوجيا» فى أواخر العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، يسأل: «هل كنا سنختار إيقاف بعض التقنيات لو أمكننا ذلك؟ هل كنا سنحرم أنفسنا من الابتكار التالى؟ هل كنا سنكون أفضل حالًا من دون حريات الإنترنت المفتوح؟».
وقد أجريت مؤخرًا استطلاعًا للرأى بالتعاون مع مؤسسة «هاريس بول»، شمل عينة من الشباب الأمريكيين المنتمين لـ«جيل زد»، الذى تشكّلت مراهقته تحت تأثير عدد قليل من شركات التواصل الاجتماعى. سألنا هؤلاء الشباب عمّا إذا كانوا يتمنون لو أن بعض المنصات أو المنتجات «لم تُخترع أصلًا».
جاءت نسبة الندم على الإنترنت عمومًا منخفضة «١٧٪»، وكذلك على الهواتف الذكية «٢١٪». لكن عند الحديث عن منصات التواصل الاجتماعى الكبرى، ارتفعت النسبة بشكل ملحوظ: ٣٤٪ عبّروا عن الندم على اختراع «إنستجرام»، و٤٧٪ على «تيك توك»، بينما وصلت النسبة إلى ٥٠٪ لـ«إكس» أو «تويتر سابقًا».

وفى استطلاع آخر شمل الآباء ظهرت نسب ندم أعلى، وهو ما تؤكده دراسات أخرى بنتائج مشابهة.
بمعنى آخر، نعم، كثيرون كانوا سيفضّلون الاستغناء عن بعض التقنيات لو كان الأمر بيدهم. غير أن «كليج» يقدّم القضية وكأنها خيار صارم بين أمرين: إما الإبقاء على «الإنترنت» بشكله المفتوح أو التخلى عنه تمامًا. بينما الحقيقة أن المشكلات الأشد خطورة ترتبط تحديدًا بوسائل التواصل الاجتماعى، وهى منصات يمكن إخضاعها للتنظيم والرقابة من دون المساس بوجود «الإنترنت» نفسه، كما أن الدفاع عنها بات أصعب بكثير.

ومع ذلك، يصرّ «كليج» على الدفاع عن موقفه. ففى الفصل الأول يعالج تهمتين أساسيتين: أن وسائل التواصل الاجتماعى أضعفت الديمقراطية حول العالم، وأثّرت سلبًا على الصحة النفسية للمراهقين. وهو لا ينكر تراجع الديمقراطية أو تفاقم أزمة الصحة النفسية خلال العقد الأخير. لكنه يعتبر أن ما حدث مجرد تزامن وقتى مع انتشار وسائل التواصل، لا نتيجة مباشرة لها.
ولإثبات وجهة نظره، يستند إلى عدد من الدراسات الأكاديمية التى تتماشى مع خطاب «ميتا» الرسمى، متجاهلًا فى الوقت نفسه الكمّ الكبير من الأبحاث التى تقول بعكس ذلك. بل إن دفاعه يكاد يكرر بالحرف ما جاء فى بيان نشرته «ميتا» عام ٢٠٢٢، ردًا على مقالة كنتُ قد عرضتُ فيها أدلة على أثر وسائل التواصل فى إضعاف الديمقراطيات الحديثة.

نفسية المراهقين
فى كتابه يردد «كليج» ما تقوله «ميتا» رسميًا. لكن موقفه من قضية الصحة النفسية للمراهقين كان مختلفًا فى وقت سابق. فاليوم تواجه الشركة دعاوى قضائية رفعها عدد كبير من المدعين العامين فى الولايات المتحدة، والوثائق التى ظهرت توضح ما كان يعرفه المسئولون داخلها.
تكشف إحدى هذه الوثائق، التى قدّمها المدعى العام لولاية نيو مكسيكو، عن أنه فى ٢٧ أغسطس ٢٠٢١، أرسل «كليج» رسالة إلى مارك زوكربيرج، نقل فيها طلب أحد الموظفين بزيادة الموارد المخصّصة لمعالجة مشكلات الصحة النفسية للمراهقين. وأضاف «كليج» تعليقًا شخصيًا قال فيه إن التعامل مع هذه المخاوف أصبح «أمرًا عاجلًا»، مؤكدًا أن «عمل الشركة فى هذا المجال يعانى نقصًا فى الموظفين وتشتتًا فى الجهود». لكن «زوكربيرج» لم يرد على الرسالة.

يزعم «كليج» اليوم أن الأدلة على ضرر وسائل التواصل مجرد «ارتباطات إحصائية» ضعيفة. لكن هذا الادعاء يتعارض مع ما كشفه موظفون فى «ميتا» ومتعاقدون وأشخاص سرّبوا معلومات من داخل الشركة، إضافةً إلى وثائق داخلية سُرّبت للرأى العام.
أحد أبرز الأمثلة ما ورد فى ملف للمدعى العام بولاية تينيسى، عن دراسة أجرتها «ميتا» عام ٢٠١٩ عن الصحة النفسية للمراهقين. الدراسة حذّرت بوضوح من أن «المراهقين مدمنون رغم شعورهم بالسوء. إنستجرام يسبب الإدمان، والوقت الذى يقضونه على المنصة يضر بصحتهم النفسية». وأضاف الباحثون: «إنستجرام هو أسوأ منصة على الإطلاق فيما يخص الصحة النفسية».

إنقاذ الإنترنت
يقدّم «كليج» فى كتابه مقترحين أساسيين لما يراه طريقًا لـ«إنقاذ الإنترنت»: الشفافية الكاملة والتعاون الدولى. فهو يطالب شركات التكنولوجيا بالكشف بوضوح عن كيفية عمل «خوارزمياتها» وآلية اتخاذ قراراتها، محذرًا من أنه إذا استمرت هذه الشركات فى الغموض، فلن يبقى القرار بأيديها.
ويقترح كذلك إنشاء ما يسميه «تحالف الديمقراطيات الرقمية» مبررًا ذلك بخوفه من أن الصين تستخدم التكنولوجيا لـ«تعزيز نظامها السلطوى». ويرى أن «على الدول الديمقراطية أن تتعاون معًا حتى يظل الإنترنت أداة داعمة للديمقراطية، كما كان يُتخيَّل فى تسعينيات القرن الماضى».
لكن هل سينجح مقترح «كليج» فعلًا؟
من الناحية النظرية، تبدو الشفافية فكرة رائعة، لكن أخشى أن الأوان قد فات لتطبيقها على الشركات العملاقة التى باتت تسيطر على معظم «الإنترنت». الصحفية التقنية كارا سويشر عبّرت عن ذلك بعبارة شهيرة عام ٢٠١٩، حين قالت إن «زوكربيرج» وبقية المؤسسين «بنوا مدينة بلا لافتات طرق، بلا مجارٍ، بلا شرطة، بلا عمال نظافة. تخيّل تلك المدينة: ليست مكانًا صالحًا للعيش، ومع ذلك يجمعون الإيجار من الجميع».

لهذا السبب تنتشر فى هذه المنصات عمليات الاحتيال والابتزاز الجنسى وتجارة المخدرات والتطرف السياسى، ما يشكل تهديدًا للمراهقين ولديمقراطيات العالم، فى وقت تبدو الشركات الكبرى عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية. وبحلول عام ٢٠٢٦ قد لا يكفى «المزيد من الشفافية» لإصلاح البنية الفاسدة التى وُضعت قبل ٢٠ عامًا.
أما عن فكرة التعاون، فمن الصعب تخيل شركات مثل «ميتا» وهى تتخلى عن بياناتها أو سيادتها. ويزداد الأمر تعقيدًا فى ظل الدعم الكبير الذى يتلقاه عمالقة التكنولوجيا من إدارة «ترامب»، التى لا تتردد أيضًا فى ممارسة الضغط على دول أخرى. وإذا كان قادة «وادى السيليكون» سيرفضون التعاون، فليس من الواضح فعلًا من الجهة التى ستجبرهم على ذلك.
قال عالم الأحياء الكبير المتخصص فى دراسة النمل، إدوارد أو. ويلسون، ذات مرة عن «الماركسية»: «أيديولوجيا جيدة، لكن للنوع الخطأ». وبعد قراءة هذا الكتاب، إلى جانب العديد من الكتب التى تناولت ثقافة «ميتا» غير الأخلاقية والمتهورة، التى تقوم على ثقافة «تحرك بسرعة وحطم الأشياء»، فضلًا عن مئات الصفحات من وثائق التسريب عام ٢٠٢١ المعروفة باسم «ملفات فيسبوك»، والدعاوى القضائية الجارية، يمكن أن نقول شيئًا مشابهًا عن مقترحات «كليج»: «خطة جيدة، لكن فى الصناعة الخطأ».
