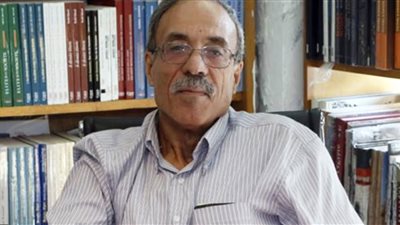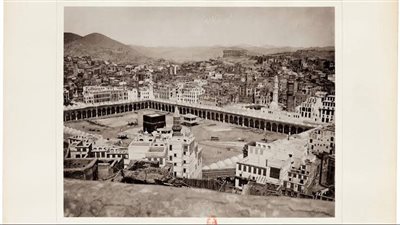مهرجان القاهرة السينمائى الدولي
كلنا بنحب السيما.. من كتاب «أفضل ٢٥ فيلمًا مصريًا»

السينما واحدة من العناصر الثقافية التى تُذكر كلما ذُكرت مصر، فالسينما فى الشرق الأوسط مصرية المولد، ولا تزال مصر هى صاحبة صدارة وريادة «الفن السابع» فى المنطقة، تلك الريادة التى علمت العالم كله اللهجة المصرية من خلال الأفلام على مدى سنوات طويلة.
حملت السينما المصرية إلى عرش التتويج مجموعة من الأفلام الرائعة، منذ تقديم «برسوم يبحث عن وظيفة»، أول فيلم روائى مصرى صامت، فى عام 1923، وصولًا إلى القرن الحالى الذى نعيشه الـ«21»، والذى شهد الربع الأول منه تقديم مجموعة من الأعمال السينمائية الخالدة.
وعلى هامش الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تعاونت إدارة المهرجان مع كل من الاتحاد الدولى للنقاد السينمائيين «فيبريسى»، وجمعية نقاد السينما المصريين، فى إجراء استفتاء حول «أفضل 25 فيلمًا مصريًا فى الربع الأول من القرن الحادى والعشرين».
حرف تسلط، هنا، الضوء على فيلم «بحب السيما» كواحد من أفضل ٢٥ فيلمًا.

طارق الشناوي: أقصر طريق إلى الجنة
كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، هذا هو مأزق فيلم «بحب السيما».. تنهمر عليك المعانى، وتتضاءل أمامك الكلمات، فما حدث لى بعد مشاهدة هذا الفيلم أننى أصبحت أكثر شفافية وقربًا إلى الله. إنه فيلم يتجاوز فى قراءته كل المعانى السياسية المنسوجة داخله، ويسمو على من يريد أن يقيده بِدِين أو مذهب لينطلق ويحلّق بك بعيدًا.. بعيدًا إلى الله.
كل العلاقات والشخصيات تحاول أن تعثر على صيغة للعلاقة مع الخالق. الكل مؤمن به، ولكن ما الطريق؟ هل نخشى من العقاب أم نرجو الثواب؟ هل الحرمان من ملذات الدنيا يعبر بنا إلى شاطئ الجنة ويجنبنا لهيب النار؟.. الكل يحاول، إلا أن الطريق كان ولا يزال لمن صدق، وليس لمن سبق.
كانت شخصية الطفل «نعيم» هى الأكثر قربًا إلى الله؛ لأنها بشفافية وبكارة عرفت أن الخلاص يتحقق بالحب الخالص، نصل إلى الله، وأن عدالة السماء أكثر رحابة مما يعتقد البشر.
أنا لا أرتاح إلى تلك القراءة السريعة التى تقيد الفيلم فى إطار أنه يقدم الشخصيات القبطية أو برؤية أكثر اتساعًا المسيحية، تلك التقسيمة الهندسية بين المسلمين والأقباط لا تعبر عن الروح الحقيقية للفيلم. مَن رأيناهم فقط مصريون يعيشون فى المجتمع، يخضعون للأعراف الاجتماعية التى توارثناها، وكل العلاقات بين الأب محمود حميدة وأبنائه، وبينه وبين الأم ليلى علوى، هى علاقتهم مع الله. لو أنك نزعت عنها بعض التفاصيل فى أسلوب العبادة، وليس الهدف من العبادة، لاكتشفت أن الدين هنا هو الدين فى المطلق، يحتمل أن يصبح كل الأديان.
حتى المرحلة الزمنية التى اختارها الكاتب هانى فوزى والمخرج أسامة فوزى، وهى النصف الثانى من الستينيات فى القرن الماضى، تسمح لك بأن تضيف إليها سنوات لتصل بك إلى هذه اللحظة، أو تختصم منها سنوات لتعيش فى زمن أسبق.
الطفل نعيم، الذى يؤدى دوره «يوسف عثمان»، يحب السينما. السينما هى المعادل الموضوعى للحياة، والله خلق الإنسان لكى يُعمِّر الأرض ويُجمّل الحياة، ولهذا كان الطفل فى الفيلم هو الراوى للأحداث، سواء التى شاهدها أو التى تخيل حدوثها. ويبدو حضور الطفل بوجهه البرىء، برغم تلصصه على كل ما يجرى حوله، وبتلك الابتسامة التى تفتح القلب وتوقد الذهن، وكأنه يقول لنا دائمًا إن الدنيا أجمل، وإن سماحة الله أرحب.. ولهذا عندما يموت جد الطفل، الذى أدى دوره رءوف مصطفى، نجد أن الطفل يعيد فتح جهاز التليفزيون، ليتواصل ضحكه مع اسكتش كان يقدمه فى تلك السنوات «ثلاثى أضواء المسرح»: سمير وجورج والضيف أحمد.
الطفل شديد الحب لجده، لكن الموت هو مرحلة ثانية للإنسان، يذهب جده الحبيب إليها، والحياة مستمرة، فكان ينبغى أن يكمل الاسكتش الضاحك. الأب محمود حميدة، لأنه بشر، كان عليه أن يعيش كإنسان، لكنه يحاول أن يعثر على أسلوب لا يتحمله كإنسان، وهو أن يغلق تمامًا باب السعادة الحسية التى لا تتناقض مع السعادة الروحية إلا عند بعض ضيقى الأفق. ولهذا كان السيناريو يحرص دائمًا على أن يقدمه لنا فى حرصه الزائد على فروض العبادة من صلاة وصيام، لكنه لا يلبث أن يتفوّه بلفظٍ جارحٍ؛ لأن الإيمان الحقيقى لم يسكن قلبه. الشعائر الدينية المجردة لا تهذب الروح إذا لم يدعمها العمل والتفاعل مع الحياة والتسامح حتى مع هفوات البشر!

مكان العبادة، سواء أكان كنيسة كما هو فى هذا الفيلم، أو جامعًا، هو فى النهاية تجمُّع للبشر، لا يمكن للأسوار التى تحيط مكان العبادة أن تعزله عن الحياة، ولهذا كما تظهر شرور البشر خارج الكنيسة نراها أيضًا فى صحن الكنيسة.
إننا بصدد شخصيات إنسانية بلا أوراق «سوليفان»، هو لا يستدعى شخصيات متعارفًا عليها من الأرشيف حتى لو كان أرشيفه الخاص. سيناريو هانى فوزى لا تستطيع أن تضعه داخل قاعدة محددة.
فن الحبكة الدرامية وتتابع الأحداث يجعل الكاتب هنا يمتلك مساحات من الحرية فى التعبير، لا يشعر المشاهد بأنه أمام عمل مصنوع وفقًا لخط تقليدى له بداية ووسط ونهاية، بل يتعمق فى الفكرة، يحفر فى أعماقها، ويغوص فى تفاصيلها، ولهذا فى كل مشهد يدهشنا هذا الحضور المكثف لفكرة الفيلم؛ وهى العلاقة مع الله، وفى الوقت نفسه تلك البساطة فى الحوار أو التعليق. حتى قفشات الطفل فى عتابه مع الله تمنح الفيلم عمقًا وجوديًا!
الشخصية التى يقدمها محمود حميدة تبدأ علاقتها العميقة مع الإيمان عندما تتحرر من الصرامة الظاهرية، وكأنها ثوب مفروض عليه ارتداؤه عند تشابكه مع الحياة، ولكنه يتحرر من هذا القيد، ويطلق العنان لمشاعره العميقة والصادقة مع زوجته وابنه. تحرر حميدة من القيود، وبعدها تحرر من الحياة نفسها. عاش الحياة كما يريدها لنا الله، ولكن الشخصية التى تقدمها ليلى علوى، لأنها فى النهاية مكبلة اجتماعيًا، فإن قيدها لم يكن بسبب الزوج، فالمجتمع نفسه بكل أطيافه هو الذى يحيل حياة الناس إلى جحيم، ولهذا يبدو أنها حملت الشعلة بعد الأب واستمرت، بل أمعنت فى القسوة.
إننا أمام حالة من الوهج الإبداعى على مستوى أداء الممثلين، لا شك أن ليلى علوى تصل بهذا الدور إلى الذروة. فنحن أمام ممثلة من الطراز النادر، وكأنها كانت تنتظر هذا الدور طوال عشرين عامًا، هو عمرها الفنى.
محمود حميدة بتلك النظرة الثابتة التى تخفى دائمًا ضعفًا ما، إنها نظرة صارمة تخشى أن يفتضح أمرها، ولهذا تزداد صرامة وقسوة، وكلما حدث ذلك تستطيع أن تلمح شلال الضعف الذى يكمن خلفها.. أداء يصل إلى تخوم الأستاذية.
منة شلبى فى دور شقيقة ليلى علوى نعيش معها نشوة من التلقائية، عايدة عبدالعزيز فى دور أم ليلى علوى بسمة صاخبة، أحمد كمال ممثل عتويل، ورءوف مصطفى أبوليلى علوى لا أنسى له مشهده مع حفيده عندما يبدأ فى تفنيط أوراق الكوتشينة العارية على صدره، ينقلب فى لحظة من الغضب إلى الرضا. الوجه الجديد إدوارد فى دور خطيب منة، أعتقد أن هذا الدور الصغير سوف يفتح له آفاقًا قادمة، ويطل علينا الطفل يوسف عثمان بهذا الحضور الأخاذ. ولا شك أن المخرج أسامة فوزى هو الذى اختار، وهو الذى وجّه، وهو الذى استخدم المونتاج ببراعة لتظل براءة عيون الطفل التى تجمع بين الدهشة والبسمة هى شاهد الإثبات على أحداث هذا الفيلم. ولا يمكن أن أنسى الراوى شريف منير بهذا الأداء الصوتى الذى لا يزال منتميًا إلى عالم الطفولة والبراءة.
بالفيلم عناصر تميزت وأبدعت: الإشراف الفنى لصلاح مرعى؛ لأن الفيلم هو حالة مرئية بقدر ما هو حالة فكرية، فكان ينبغى أن يضبط هذا الترمومتر المرئى صلاح مرعى. وأمامنا إبداع خاص أيضًا من مدير التصوير طارق التلمسانى، ومونتاج خالد مرعى، وموسيقى خالد شكرى، إنها التفاصيل الدقيقة التى تنتج إبداعًا خاصًا، من خلال المخرج أسامة فوزى الذى قدم أحد أهم الأفلام الاستثنائية فى تاريخنا السينمائى.
نعم، كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، ولكنى خرجت من دار العرض وأنا أشد إيمانًا وحبًا لله الذى وَسِعَت رحمته كل شىء، بينما ضاقت عقول وأفكار البعض عن استيعاب كل الأشياء!
ملحوظة: هذا المقال كتبته قبل ٢١ عامًا على صفحات مجلة «روزاليوسف»، وأعدت نشره كما هو، وسوف تلمح فى الفقرة قبل الأخيرة «بحب السيما أحد أهم الأفلام الاستثنائية فى تاريخنا السينمائى»، وهو بالطبع ما أكده الاستفتاء الذى صعد بالفيلم لتلك المكانة الاستثنائية!

ناهد صلاح: ربما لأن السخرية أكثر
قد يكون «بحب السيما» فيلمًا يُحرِّض على الحياة، فيلمًا يحمل قدرًا من الحب للمدينة وبيوتها وناسها، يوازيه حبٌّ أعظم للسينما التى يقدمها على أنها فرصة جديدة للاحتماء من واقع يتمادى فى سلفيّته، فرصة ثمينة للحصول على حصة من الجمال، تمنحها أطيافٌ وظلالٌ وأشكالٌ وألوانٌ تتحرك على الشاشة ولا يعلوها شأنٌ آخر.. لكنه أيضًا يتغلغل فى ثنائية الحياة والموت، هذه الثنائية بما تحمله من دلالات عدة كانت هاجسًا أرّق مخرجه أسامة فوزى «19 مارس 1961- 8 يناير 2019»، نلاحظه ببعض التأمل فى أفلامه التى أثارت الجدل، فى حين أنها لم تتجاوز أربعة أفلام مع اثنين من المؤلفين هما مصطفى ذكرى وهانى فوزى، أما الأفلام فهى: «عفاريت الأسفلت» (1996)، «جنة الشياطين» (1999)، «بحب السيما» (2004)، «بالألوان الطبيعية» (2009).
الحياة والموت عند أسامة فوزى فكرة مركزيّة، كان يحتفل بالحياة ثم يلعب مع الموت، وربما يسعى لتفكيكه كما فعل نعيم، الطفل الصغير فى «بحب السيما» وهو يحاول أن يفك رموز طفولته، يطل من شرفة بيته فى شبرا عام ١٩٦٦، كما تخبرنا لافتة فى مستهل الفيلم، يستعرض جيرانه تفصيليًا من الأسطح إلى داخل البيوت إلى الشرفات التى تطل على الحوارى الضيقة، ثم ينتقل إلى أهله وسطوة السلطة الأبوية، ويأخذنا معه إلى غرام بالسينما، والذى يمحو رتابة الأيام ويتغلب على خوف وفزع يتسلل إليه من خلال صوت والده: «إنت هتروح النار.. عارف ليه؟ عشان بتحب السينما.. بس مش إنت اللى هتروح النار، إنت وكل اللى بيحبوا السينما وبيروحوها!». زوغان وحزن خفيف وابتسامة ساخرة تتغلب على مخاوفه وتجعله مشاكسًا أكثر، فنتشبث معه بعالم السينما؛ حيث يختفى كل ما هو قبيح وثقيل وبارد وقاسٍ.
ربما نستسيغ تلك المسافة بين الخيال والحقيقة فى الفيلم الثالث لمخرجه الذى ينتصر للتحرر من أى قيد، ينحو صوب إنسانية مهدورة على جدران التقليدى، المؤصل، الثابت. تبدو الحكاية كما لو كانت حالة «جوانية» تتحمل التأويل، لكنها تتماهى مع الجمال والحلم والدعوة التى تتسلل من فيلم لآخر: «اخرج من حياتك إذا ضاقت على أحلامك واصنع الحياة التى تريحك». من شخصيات «عفاريت الأسفلت» التى واجهت الفقر والتهميش بجموح يتشظى بين بيوت رطبة وأسفلت لا يرحم، إلى «كانكان العوام الذى مات مرتين» للكاتب البرازيلى جورجى أمادو، كما صاغه مصطفى ذكرى فى «جنة الشياطين» دون أن يلتزم بالرواية البرازيلية الشهيرة حرفيًا وأحاله أسامة فوزى إلى صورة شديدة الخصوصية، هذه الخصوصية تجلت فى «بحب السيما» وتجاوزت ما هو أبعد من الحكاية. الخوف هو المفتاح والمبتدأ، والحب هو طوق النجاة. الخوف هو بداية طريق الموت، والحب هو الانفتاح على الحياة، والسخرية هى السلاح الذى يواجه العبث البشرى.

الأب عدلى «محمود حميدة» خائف، متعصب، مسجون فى أفكارٍ، غالبًا هو غير مقتنع بها بدرجة تساوى تعصبه، يخاطب ربه وهو ينتحب: «ما بحبكش أنا دايمًا خايف منك.. نفسى أحبك زى ما تكون أبويا». الخوف يتمكن من قلبه أكثر من اليقين، بينما نعيم «يوسف عثمان» طفله الصغير يرفض هذا الخوف، إذ يسخر منه بضحكات مكبوتة، حين يراقب والده من خلف شيش النافذة وهو يصلى منتحبًا مرعوبًا من فكرة أن يموت ولا يدخل الجنة.
لعل هذا ما جعل بعض النقاد يُدرجون هذا الفيلم تحت توصيف «الكوميديا الدرامية»، يقصدون هذا الشكل الشائع الذى يمزج عناصر من المأساة والكوميديا؛ حيث يختلط فيه الخط الفاصل بين العناصر الكوميدية والدرامية بشكل متجانس، يتفاوت هذا الخلط فى الحكاية التى تمتد لتشمل البلد بأكمله، وإن تمحورت حول أسرة مسيحية؛ طقوسها وعاداتها وتقاليدها، فالأمر لم يتعامل مع هذه الأسرة بنظرة مغلقة تتعامل مع المسيحيين على أنهم «جيتو» داخل المجتمع المصرى، بل كأسرة مصرية صميمة هى جزء من نسيج المجتمع دون مبالغة أو ادعاء.
تباينت الكوميديا من مواقف فردية: أم نعمات «عايدة عبدالعزيز» ترد على معاكسة الشاب الذى يسألها عبر الهاتف ماذا ترتدى: «يا أخويا اتوكس، لابسه جلابية شفتشى مبقعة زيت يا وسخ»، إلى مواقف جماعية مثل مشهد «خناقة» الزفاف فى ساحة الكنيسة، كانت عايدة عبدالعزيز أيضًا بطلته. كل هذا فى فيلم قائم بناؤه السردى على وجهة نظر رجل ناضج فى الأربعين من عمره، لكن الصورة من خلال طفل صغير يستعير وعى الشباب.. هناك فارق زمنى بين صوت شريف منير «الراوى» والفترة التى دارت فيها الحكاية وهى خلال سنة واحدة من ٦٦/ ١٩٦٧.. هنا ما يجعلنا نقفز فوق الحدث من حدود الأسرة القبطية إلى الأفق الأوسع للوطن والمجتمع، من «عدلى» مثل أى أب حسب النظام البطريركى.. من عبدالناصر إلى بابا الكنيسة إلى الرب.. هنا ما يأخذنا لنخرج من حدود المكان، من شبرا إلى ما هو أبعد وأشمل وأوسع، لنلمس كيف يجعل التزمُّت والصرامة الحياة غليظة، هكذا كان عدلى الأب متزمّتًا، يحاول ضبط سلوكه على مثال أخلاقى قائم على فكرة غير واقعية، أسيرًا لأفكار ملحّة تسكنه ويفرضها على أسرته، هذه الأفكار بقدر ما حرمته من متع الحياة الحسية بقدر ما جعلته ضيق الأفق، يمنع صغيره العاشق للسينما من مشاهدة الأفلام، ويمنع دخول التليفزيون بيته، كما يمارس قهرًا مختلفًا على زوجته نعمات «ليلى علوى»، يمنعها من الرسم ويحول بينها وبين موهبتها وحتى إنسانيتها.
«طول عمرى بكره الدكاترة، ومش بس الدكاترة.. كل اللى بيتحكموا فينا وفى حياتنا بحجة إنهم عارفين مصلحتنا أكتر مننا».. هذه الجملة التى جاءت على لسان الراوى عبَّرت عن موقف الفيلم الرافض أى نوع من الوصاية، كاشفة عن عمومية أحداثه التى دارت على خلفية سياسية.. ثمة ربط واضح بين مسيرة هذه الأسرة ومسار المجتمع كله، فكما كان الأب يطرح تصوراته المسبقة عن الدين والحياة ويفرضها فرضًا على أسرته، يرى الفيلم أن عبدالناصر كان بالمثل يحاول تطبيق مثال الاشتراكية.. لكن مشكلته أنه حاول ذلك من دون تأهيل كافٍ للمجتمع، فبدلًا من أن يحبه الجميع هابوه وخافوا منه. وإن كنت أرى عند هذه النقطة أن فكرة الفيلم ذاتها تناقض نفسها؛ بمعنى أنها ترفض الخضوع لنظامٍ، لكنها تخضع لفكرة هلامية عن حرية مثالية غير موجودة إلا فى الأذهان.
أراد الفيلم تحرير الطاقات المكبوتة، هذه الحرية وصلت أحيانًا إلى حد تقمص السلطة وتبادل الكراهية والوقوع فى نفس الأخطاء من زاوية معاكسة، الطغاة هم أنفسهم الضحايا: عدلى يجب أن يكذب لكى لا يتعرض للمساءلة حسب نصيحة رجل القانون.. نعمات يجب أن تمارس متعتها الحسية لكى تستعيد إحساسها بالتوازن.. أم نعمات تضع تواريخ للبيض لكى ترتب أفضل طريقة لاستخدامه فى الطعام.. بُشرى أبونعمات «رءوف مصطفى» لا يبالى بالكنيسة وبالشكل الاجتماعى لمجرد أنه شعر بالخديعة.. حتى نعيم نفسه يتحول إلى سلطة ويجلس على المقعد، طلب الشربات من خالته نوسة «منة شلبى» بطريقة قمعية، بعد أن ضبط لمعى «إدوارد» يقبّلها فى برج الكنيسة، فقد تحول نعيم فى لحظة إلى سلطة التلصص وامتلاك المعلومات واستخدامها ليُحِد من حرية الغير، حتى المثقف الشيوعى ممدوح يوسف «زكى فطين عبدالوهاب» الذى ظهر فى أول مشهد كسلطة فنية للتفتيش على المدرسة وبدا منحازًا إلى الفن أكثر من انحيازه إلى الواقع، يتحول إلى حكم ينتقد لوحات نعمات بتقييم مخالف للحرية النسبية التى ينطلق منها الفيلم.
يصبح الأمر أكثر تعقيدًا فى الجزء الأخير من الفيلم، حسب حالة المجتمع ذاته فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخه، فنرى مشهد الغروب البديع ينسحب ليملأ الشاشة، محاولًا الربط بين المناخ السياسى السائد- نكسة ١٩٦٧- وأزمة البطل وإحساسه باقتراب النهاية، مما جعله يرى الحياة بشكل مختلف، أوضح وأكثر نضجًا.. بينما أدرك جمال عبدالناصر الكثير بعد النكسة، لكنه كان يشعر بجرح عميق، وعدلى أدرك الكثير أيضًا بعد نكسة مرضه، لكنه كان أقرب إلى الرحيل منه إلى البقاء وتغيير عالمه، يركب الدراجة ويحاول أن ينفتح على الكون ويسعد مع ابنه.
فى هذا المقطع يبلغ عدلى ذروة التألق والانتصار على الخوف، المستسلم أمام بهاء الحياة وتيارها الجارف وما تغدقه من فيضٍ جمالى، ما جعله يعيش فرحًا طفوليًا، ويحظى بمتعها التى حُرم منها سابقًا. إنها وسيلته لمواجهة الموت. مشهد بصرى لا يتحقق بشكل كلى إلا عند إغماض العينين والدخول فى غيبوبة الحواس، لكن الغروب لم يترك له نهارًا آخر، يموت لتنقلب الدنيا وتصبح زوجته حاملة راية التسلط. إذن، يسلم الغروب الذى راح إثره عدلى إلى ليل طويل، ولتنتهِ ضحكات الأب والابن إلى صرخات، تعلو أكثر بعد الموت المفاجئ للجد فى جلسة عائلية، انقلبت هى الأخرى من الضحك إلى الصراخ الذى لم يهرب منه سوى الطفل الساخر من هذه الحياة بقهقهات عالية.
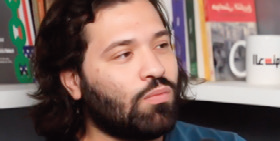
حسن سلامة: صندوق باندورا السحرى
أنتمى لجيل Z، الذى عُدَّ بمثابة نذير شؤم على صناعة السينما المصرية، حيث رافق سنين نشأته ما عُرف بتيار «السينما النظيفة»، وبذلك أصبح جيلى فى النهاية هو جيل السينما النظيفة، المخلص لها وراعيها المستقبلى، والذى رغم «روشنته» وحداثته، فقد اقترن بالضرورة بما هو محافظ ومستهلك.. بالتالى، مفهوم جدًا كيف من الممكن أن أتلقى فيلمًا مثل «بحب السيما» فى سنين تكوينى ومراهقتى! بالتأكيد هو عمل فاضح وقتها؛ لجرأته، فهو لا يختلف مثلًا عن كليب روبى «طب ليه بيدارى كده» الذى هُوجم بشدة حين ظهوره.. ومصادفة، فقد صدرا فى العام 2004 نفسه، ولذلك كان رد فعلى واحدًا حين عُرض أى منهما على شاشة التليفزيون: أُغيّر القناة إن سمعت صوت أقدام آتية من بعيد خشية الفضيحة.. تبعًا لذلك، ظل الفيلم بمثابة صندوق باندورا بالنسبة لى، أخاف التعرض له خشية معرفة ما يحتويه.
لم يخب ظنى، فلقد ظل الفيلم- مشاهدةً تلو أخرى مع مرور السنين- يحمل إلىّ جديدًا فى كل مرة، ولكن على النقيض من صندوق باندورا، فبدل الشرور التى خرجت منه، كان «بحب السيما» لا ينفك عن تقديم كل جديد ومدهش لى.. ومع قليل من الوعى، اكتسب الفيلم معانى وأبعادًا جديدة مع كل مشاهدة.. من هنا نبعت أهميته وفرادته.
يرصد الفيلم حقبة الستينيات، تحديدًا عام ١٩٦٦، وهو العام الذى سبق النكسة. وفى فن السيناريو لا يوجد ما هو عارض أو مصادفة، ولذلك فاختيار زمن الفيلم لم يكن مجرد رغبة فى العودة إلى زمنٍ ماضٍ، ولا يمكن اقتصاره على أنه مجرد اختيار جمالى، الاختيار هنا هو مدخل لا فكاك منه للفيلم.
يبدأ الفيلم بصوت الراوى، والراوى هنا هو راوٍ عليم، متمثل فى الطفل الذى يحكى من الذاكرة أحداثًا مرَّ عليها ما يقارب ثلاثين عامًا. والطفل سواء فى الأدب أو السينما هو وسيلة لحكى شاعرى؛ أى حكى منقوص ومفكك، مفتقد لحكمة الكبار ونظرتهم «السويّة» للأمور، وهو ما يتجلى مثلًا فى طفل محمد شكرى فى رواية «الخبز الحافى»؛ حيث يتصور الطفل أن الجنس هو ألم، ويرى الموت وكأنه نوم مؤقت. من هنا تنبع شاعرية السرد من تلك الرؤية غير المكتملة للأمور. بعد المشاهد التأسيسية فى الفيلم لكلٍّ من «الحقبة والحى والعائلة»، تكون الجملة الحوارية الأولى من نصيب نعمات، فتوجّه كلامها إلى نعيم الذى يقف معطيًا لها ظهره بينما تستحم وهو يحاول استراق النظر: «شايفاك.. إوعى تبص». هنا مدخل آخر عن موضوع الفيلم وتيمته.
إذن، فالفيلم يدور حول «المُحرَّم»، حول الممنوع والمرغوب، وبطلنا نعيم هو الطفل الفضولى الساعى للفهم واكتشاف العالم من حوله، وهو الذى يحب «السيما» ومُتيم حد الذوبان بها.
عند الحديث عن الأفلام التى تناولت السينما وحبها دومًا ما يذكر الأصدقاء فيلم «سينما باراديسو» لتورناتورى، فيما يذكر النخبوى منهم فيلم «وداعًا حانة التنين» لتساى مينج، أما أنا فأقول دومًا: «بحب السيما أجدع منهم».. «أجدع» هنا لا تنتمى لذلك النوع من المقارنات المفرغة، ولا أعتبرها بمثابة صيغة تفضيل، هى لفظة مصرية تمامًا، يومية ومتداولة، ولذلك أختار وصف الفيلم بها، لأن فيه ما هو أكثر من السينما، رغم أنه يحتفى بها احتفاءً صادقًا وأصيلًا، إلا أنه لا يخلو من نقد سياسى واجتماعى، وحتى وجودى، موجهًا إياه لزمنٍ مضى، وحقبةٍ مفصلية وخاصة جدًا فى تاريخ الدولة المصرية الحديثة.
نرى «عدلى» رب الأسرة فى ظهوره الأول وهو يُرهب نعيم، بينما تظهر لديه ميول تطهرية نابعة من خلفيته المسيحية الأرثوذكسية. نلحظ هوسًا عند عدلى بفكرة الجنة والنار، الثواب والعقاب، أسماء الأسرة نفسها: نعمات، نعمة، نعيم. ذلك الهوس يتجلى فى شخصية عدلى عند سؤاله عن معنى اسم «نعيم» فيجيب: لأن النعيم هو السماء، الجنة. هذا هو حلم عدلى المفتقد، وذلك هو محركه على مدار الأحداث.

وبالرجوع لزمن الفيلم، والذى نلاحظ أن الجرائد والراديو يغطيانه على مدار الحكاية فى الخلفية، فيما يظهر صوت الرئيس جمال عبدالناصر مرارًا عبر الإذاعة، نجد تماهيًا بين كلٍّ من عدلى وعبدالناصر، وكأنهما رفيقا درب وكفاح؛ حيث يتمثل ذلك فى نزعة عدلى المثالية وتطلعه للعفو الإلهى والنعيم، كمحاولته مساعدة الطلبة الفقراء، والذى يشير إليه نعيم الراوى فيقول: «كانت كل فلوسه رايحة على الطلبة الفقرا، لحد ما قرّبنا نبقى زيهم».
أيضًا شجاره مع الناظر «الحرامى»، وفيما بعد رفضه دفع رشوة للتمرجى أثناء مرض نعيم، كل ذلك يؤكد مثالية عدلى وسذاجته أيضًا، وهو نفسه الذى رغم كل ذلك لم يخلُ من نزعة سلطوية طالت أسرته، وشعورٍ بالذنب دومًا يهدد راحته.. تلك كانت يوتوبيا عدلى: تحقيق الكمال، والذى لم يختلف عن اشتراكية عبدالناصر وحلمه العربى.. فيما كانت يوتوبيا نعيم أبسط من كل ذلك، يوتوبيا نعيم كانت السينما، ولذلك فعند زيارتها لأول مرة، يصوِّرها كجنة، ويصف تَذكرتها بصك الغفران، وهى رؤية غاية فى الشاعرية للسينما، كملاذٍ ليس أرضيًا، بل أبدى، متجاوز ما هو مادى، كالحلم الرقيق، وهو ما يطغى حتى على ألوان المشهد، فنراها تميل للأبيض، على عكس «بالتة» الفيلم الصفراء على مدار الحكاية، والتى تشير بنعومة إلى زمنٍ حميمى مضى.
فى الفيلم مشهد كاريكاتيرى؛ وهو عند ذهاب نعيم للطبيب، حيث نسمعه يحكى بصوت الراوى العليم: «طول عمرى بكره الدكاترة، مش الدكاترة وبس، لكن كل اللى بيتحكّموا فينا وفى حياتنا بحجة إنهم عارفين مصلحتنا أكتر مننا».. فى مشهد آخر يسأل عدلى، نعمات: «إنتى صليتى النهارده؟»، ويبدأ بلومها عند إجابتها بالنفى، فيما نرى معلم نعمة «أخت عدلى الكبرى» فى المدرسة يتفنن فى شرح وتفصيل آليات عقابه للطلبة.. هنا مفتاح آخر للفيلم، وهو السلطة والعقاب، فنجد أن السلطة المجتمعية لا تختلف عن السلطة الدينية، ولا يختلفان عن نظيرتهما السياسية، وهى التى ظهرت فى الفيلم بشكلٍ أقل، ربما خفىّ تمامًا، لكنها الأهم، ولذلك عُدَّ الفيلم جريئًا فى خطابه، كاسرًا كل التابوهات التى- للأسف- يتم اختزالها فى مشاهد عارية وجنسية عابرة على استحياء.
وكعادة أسامة فوزى، من خلال فيلميه اللذين سبقا «بحب السيما»، وهما «عفاريت الأسفلت» و«جنة الشياطين».. يتضح هنا اهتمامه بمنظومة الأسرة وتفكيكها وإعادة النظر فى قِيمها، وحقيقة إيمان الأسرة بتلك القيم، وهو ما يتجلى فى أسرة عدلى ونعمات؛ حيث نرى المناوشات والكذب والتلفيق، حتى الخيانة. وعند فوزى دومًا ما كان الممنوع مرغوبًا، جنةً مفتقدة، ذلك ما يفسر مرض نعيم عند رفض عدلى ذهابه للسينما، أى فكرة شاعرية تلك؟! أن يمرض المرء جراء شغفه الذى لم يُحقَّق؟
يخبر الطبيب عدلى بأنه مريض بالقلب، يذهب عدلى إلى رأس البر رفقة أسرته، متجاوزًا ما مضى، مبرئًا نفسه من عُقدة الذنب التى دومًا ما طاردته، فيما يقرأ تصريحًا لعبدالناصر أمام البحر، مفاده أن وقت الرحيل ما زال مبكرًا. بعدها، ولمرةٍ أخيرة، نرى عدلى يركب العجلة وأمامه نعيم فى مشهد عند الغروب؛ حيث نسمع فى الخلفية صوت عبدالناصر فى خطاب التنحى بعد النكسة، فيما تغرب الشمس بينما عدلى يعدو بالعجلة ويظهر مرضه، وكأنها تعلن عن أفول عُمْر كلٍّ من عبدالناصر وعدلى بعد مسيرهما الطويل، ليموت عدلى بعد ذلك كما تمنى وهو يصلى، فيما ينتهى الفيلم بينما نعيم يضحك أمام التليفزيون أثناء موت جده، وكأنه إعلان لعصرٍ جديد، لا صوت يعلو فيه فوق صوت الضحك.