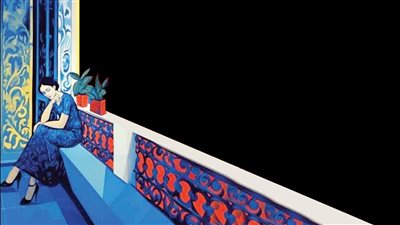انقطاعات الزمن.. سر رواية «سنوات الجرى فى المكان»

ثمة مداخل كثيرة يمكننا النظر منها إلى «سنوات الجرى فى المكان» للكاتبة نورا ناجى «رواية- دار الشروق»، فالرواية حافلة بالتجريب على مستوى تقنيات السرد، حيث تتنقل بين الراوى العليم والراوى المتكلم والراوى المخاطب مع كل حكاية، وهى رواية تتميز بشعرية النوع الأدبى والكتابة عبر النوعية بتعبير الكاتب الراحل الكبير إدوارد الخراط، فهو نص مفتوح على أجناس أدبية أخرى كالمسرح وأدب اليوميات والشعر ومفتوح على فنون أخرى، وحكاية كل شخصية من شخوص الرواية تسرد بنوع راو مختلف عن الآخر، وبتقنية سردية أو جنس أدبى يختلف عن الآخر، بالإضافة إلى ذلك، فكل شخصية فى الرواية تتعاطى مع العالم من زاوية نظر مختلفة، أو بالأحرى عبر حاسة أخرى تكون المهيمنة على سردها.
ولدينا فى هذه الرواية خمسة شخوص رئيسية، لكن الحدث المركزى يتعلق بشخصية سعد البيومى، وهو مركز الرواية لأن حادثة موته زلزلت حياة بقية شخوص الرواية. والقسم الأول المتعلق بسعد البيومى «الجرى فى المكان- مشروع تفاعلى متعدد الوسائط»، يتعاطى مع العالم عبر حاسة البصر، وبالتحديد عبر هيمنة لون محدد على كل جزء من فصول هذا القسم، بينما تتفاعل ياسمين السيد، الطبيبة الشرعية- التى شرّحت جثة سعد، مع العالم عبر حاسة أخرى وهى حاسة التذوق فى القسم الثانى «كل القطط الميتة»، بينما يسرد القسم الثالث «الانتباه إلى الصوت» حكاية مصطفى عبدالعزيز عبر حاسة الأذن، وشخصية يحيى الصاوى فى قسم «الحلاق والملك» يتعاطى مع العالم عبر حاسة الرائحة، والشخصية الأخيرة «نانا» فى القسم الخامس «كمثل تمثال فى شرفة» تتعاطى مع الألم عبر حاسة اللمس، ويمكن الوقوف على كل تقنية وتأمل تناغمها مع بناء الشخصية وميولها الفنية، لكن الزمن هو مدخلنا فى هذه الرواية.
فعنوان الرواية يضعنا وجهًا لوجه أمام الزمن، فى شطر العنوان الأول «سنوات» وشطر العنوان الثانى «الجرى فى المكان»، والجرى فى المكان هو أول معرض فنى مستقل أقامه سعد البيومى، حيث كان يجرى فى مكانه داخل كرة كبيرة بلاستيكية. الثبات إذًا هو ما يقابلنا فى حركة مزعومة لا تأخذ البطل إلى أى مكان آخر، وهو ما يشير إلى تناقض الفعل مع ذاته وغياب المعنى. والثبات يوجد أيضًا فى انحراف عنوان الرواية عن عنوان المعرض الفنى «٣٠ يوم جريًا فى المكان»، فاليوم الواحد يمر ببطء وقد يصل إلى سنة كاملة مما تعدون أو ألف سنة.

لكن «ما الزمن، إذًا؟» كما أطلق القديس أوغسطين هذا السؤال فى كتابه «اعترافات». وحين يسأل القديس أوغسطين سؤاله هذا يجيب عليه قائلًا «إننى لأعرف معرفة جيدة ما هو، بشرط أن لا يسألنى أحدٌ عنه!»، وهو يشير إلى كيونة الزمن الغامض. وإننا حين نقف أمام مفهوم الزمن كذلك فى رواية نورا ناجى، نرى طبيعته الغامضة، فى حركة البطل العبثية، حيث يجرى ولا يجرى، كفعل إشكالى. والزمن، كما نعبر عنه بأفعال اللغة، هو ما كان، وما يكون، وما سيكون. وكما يصفه أرسطو فهو «رقم الحركة تبعًا لما قبل وما بعد»، لكنه مفهوم ذهنى فى الأصل، فلا مكان للزمن ولا وجود له خارج الذهن، أو كما يطلق لودفينغ فندغنشتاين سؤاله «إلى أين يسير الحاضر حين يصير ماضيًا؟ وأين هو الماضى؟»، فى السؤال عن مكان الزمان (بأين بدلًا من متى) شعرية ومفارقة لغوية، ويجيب القديس أوغسطين على ذلك بوضع الماضى والمستقبل داخل الحاضر، عبر الاستحضار بالذاكرة أو التوقع، وإن كان يتشكك أيضًا فى الحاضر بوصفه غير موجود بصورة دائمًا. تبدو الإشكالية الأخرى فى أن الزمن لا يمكن تصوره إلا بتصور الأبدية أيضًا. حيث يعرف أفلاطون الزمن بأنه الصورة الحركية للأبدية الثابتة. وبالعودة إلى رواية نورا، فالأبدية أو ثبات الزمن تتمثل فى الكرة الكبيرة البلاستيكية التى يدور فيها سعد، فى ثلاثين يومًا، أو سنوات عديدة. تبدو تلك الكرة البلاستيكية مثل عجلة الهامستر التى يستعملها الهامستر للركض فى مكانه، دون هدف فى الوصول إلى أى مكان، لكن فعل الهامستر بالجرى فى المكان ذو مغزى، وهو ممارسة التمارين الرياضية التى تساعده على الهضم، بينما يخلو فعل الجرى لدى سعد من مغزاه، وكأنه يحاول أن يحرك الزمن إلى الأمام بلا جدوى. فالمسافة هى انتقال بين نقطتين زمنيتين أو مكانيتين، والانفصال بين الزمان والمكان هنا يجعل البطل يبدو كسيزيف آخر يحمل فوق ظهره الصخرة فى عذاب دائرى.
لكن الزمن أيضًا داخل ذهن سعد يكشف عن أزمته الوجودية الكبرى، فهو لا يتحرك إلى الأمام «بتصورات الزمن الخطية: من الماضى إلى الحاضر إلى المستقبل»، لكنه يأخذه دومًا إلى الماضى عبر استدعاءات الذاكرة، ورغم انعتاقه وتحرره من الزمان بالرصاصة التى سكنت عينه وقتلته فى ثورة ٢٥ يناير، لكنه يظل أسيرًا للماضى فقط فى سرد ما كان، فالموت يقطع خيط الحاضر والمستقبل بطبيعة الحال، لكن المستقبل كان غائبًا عن ذهنه حتى أثناء حياته. عاش عمره بالكامل متذكرًا الماضى المتمثل فى وفاة والده بحادثة غرق العبارة، وكان حاضره استعادة لتلك الحادثة وإعادة تدويرها بالفن بأشكال مختلفة، سواء كانت كرة الزمن البلاستيكية الكبيرة أو معرض العبارة الغارقة، وهو ما يؤكد ثبات الزمن حتى بالنسبة لسعد فى حياته الواقعية، فحاضره هو تكرار واستعادة للماضى. وهو بذلك يحاول أن يستعيد والده الميت وأن يتضمنه فى الحاضر، عبر تكراره لأفعاله العادية أيضًا «تعلمتُ شرب الشاى والقهوة مثله، لأمسك بكوبه وكأننى أحتمى به»، وكأنه يستنسخ وجود والده فيه «كيف يموت شخص فى زمن آخر، ويظل باقيًا، مكررًا فى حيوات أخرى؟... كلنا نسخ مكررة لهاجس واحد».
وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لسعد، حيث ينقطع خيط الزمان بتجلياته الثلاثة، إثر تعرضه لصدمة غرق والده فى حادثة العبارة، فإن حادثة مقتل سعد فى الثورة برصاصة فى الرأس تسبب هزة مماثلة بالنسبة لعلاقة أصدقائه بالزمن.

إذا ما انطلقنا من إجابة القديس أوغسطين على سؤال «أين الزمن؟» حين قال إن الأزمنة المختلفة لا توجد إلا فى العقل، فماذا يكون حال الزمن حين يختل العقل إثر صدمة كبيرة يتعرض لها، كما حدث للطبيبة الشرعية ياسمين السيد، صديقة سعد، حيث تفقد صلتها بالواقع، تفقد ذائقتها بالأشياء، وبالنسبة للزمن تفقد القدرة على احتوائه، أو السيطرة عليه، أو تذكره. «مثل لوحة معلقة على حائط.. تظهر أحيانًا أمام عينى، لوحة رمادية بها ظل أحمر، أو لوحة حمراء بها ظل رمادى، لا أذكر». وتقول أيضًا «كل المشاهد تتبدد مثل بقايا حلم أصر على التمسك به وأنا أستيقظ»، ويشير فرويد إلى حقيقة أن الأحلام تتبدد فى النهار ترجع إلى ضعفها أو قلة التهييج النفسى المقترن بها، وهو ما يؤكد فقدان ياسمين أى صلة بالواقع أو الانفعال به. وقد نرى أن ياسمين ينطبق على ذاكرتها ما ينطبق على الأحلام التى يصفها لوموان بأن الخاصة الجوهرية فيها هى فقدان التناسق بين صورها، حيث يبدو واقعها الخالى من أى مذاق كالكابوس الذى يتسم بالخلط الزمنى أو فساد المنطق.
محاولة ياسمين استعادة اتزانها وشعورها بالواقع، تتم من خلال كتابة اليوميات، أى عبر محاولة إيجاد الترتيب المنطقى والطبيعى للزمن، إذا افترضنا وجود ترتيب طبيعى للزمن، فالماضى والحاضر والمستقبل هو تصور ذهنى. ومع استعادة منطق الزمن المختل إثر صدمة حادثة مقتل سعد تحاول ياسمين استعادة ذائقتها بالأشياء.
تمثل ياسمين المرضية فى متلازمة الجثة الحية، خلل فى تذوق كل شىء، الأطعمة والمشروبات، حيث تعتقد أنها ميتة تمشى على قدمين، لكن الخلل غير المادى، وغير الملموس، والناتج عن مقتل سعد وتزييفها لتقريره الطبى يتجلى فى اضطراب الزمن، وهو عرض طبيعى بالنسبة للجثث التى تموت فينتهى الزمن بالنسبة لها، ونجد ذلك فى تكرار الصور لدى ياسمين «كلما مشيتُ فى شارع رأيت قطًا ميتًا»، وتقول أيضًا «كل الأجساد على الطاولة المعدنية سواء، كلها لشخص واحد متكرر يزورنى أحيانًا فى الأحلام»، فكأن الحياة ديجافو، يعيش المرء الموقف ذاته مرة بعد مرة، تجربة سابقة مؤلمة تتكرر مرة بعد مرة، موت يعاد ولا يعتاد المرء بل يبتلعه فيعيش فيه.
بالنسبة لمصطفى عبدالعزيز، فإننا أمام حالة مرضية أمام الزمن. رجلٌ حاول أن يسير مع خط الزمن الطبيعى فبعد هجران نانا يتزوج من فتاة أخرى وتنجب له ابنة وابنًا، لكن علته أمام الزمن لحظة انكساره مع حادثة مقتل سعد، تتجسد فى محاولته الدءوبة بتسجيل أصوات كل شىء من حوله، على أمل استعادتها، مثل شريط يتكرر فى رأس المرء كوساوس. يعاد بلا إرادة على أمل الوقوف على النقطة الزمنية التى يمكن منها تحريف مسار الأحداث. ومع أول مثير، ظهور فتاة الماضى، تكر معها شريط الماضى بأكمله، ويتوهم بالقدرة على إعادة الزمان إلى الخلف. «سيعود معها بالزمن إلى الخلف، ويحاول أن يستعيد معها حياته الملونة والصاخبة.. ربما يستعيد الإحساس بأنه ينتظر شيئًا»، وهو ما يشير إلى أنه أسير ذاكرته الاسترجاعية، وأن حنينه إلى الماضى أقوى من شعوره باللحظة الراهنة، وأنه غير مؤمن بوجود زمن آخر فى المستقبل، فالزمن كله سجين فى المسجل.
إن تعلق مصطفى عبدالعزيز بالصوت هو تشبث بالزمن، الزمن الذى يريده دون غيره، فلا مكان للأصوات إلا فى الزمن، لذلك صنف إفرايم ليسنج الموسيقى والشعر من الفنون الزمانية، حيث تستعمل علاقات الزمان من الإيقاع والتتابع. إن إدمانه للماضى يجعله يسقط، كأى مدمن آخر، فى انتكاسة، حين تظهر له نانا كمثير، أو شبح من الحياة المثالية. شبح يجعله يدرك الفارق بين الزمن الطبيعى والمصطنع، بين الوردة البلاستيكية والوردة الطبيعية.
إن اضطراب الزمن أو إدمانه أو ثباته، كما فى حالة يحيى الصاوى الذى فقد حاسة الشمس، فبدأت الحياة أمامه مثل صورة ثابتة، كلها ترجع إلى حادثة زمنية واحدة، كما يشير الصاوى فى مسرحيته الحلاق والملك، حيث يعتقد أن مقتل سعد كان بمثابة لعنة أصابت جميع المقربين به، والحنين إلى الزمن يتجلى أيضًا مع مثير آخر وهو فقدان الشعور بالروائح بعد إصابة يحيى بفيروس كورونا .. و«رجل بلا رائحة هو رجل بلا ذاكرة». والعلاقة بين الروائح والزمن، كما يصفها باتريك زوسكيند فى روايته العطر بملكوت الروائح الزائلة، فهو الميدان الذى لا يترك فى التاريخ أثرًا.
لكن هل كان مقتل سعد بمثابة لعنة حقًا؟ إننا حين نقرأ رواية نورا ناجى «سنوات الجرى فى المكان»، أو مسودة «كمثل تمثال فى شرفة لنانا التى تمثل ظلها المزيف والهامش المتخيل لكيفية كتابة هذه الرواية، وكسر للجدار الرابع، فلا بد أن نرى سعد بوضوح، وهو يجرى فى الكرة البلاستيكية الكبيرة، ونعرف أنه لم يرغب فى أن يلعن أحدًا بموته حقًا، وأن كل ما عاش من أجله، كل ما فعله داخل الكرة البلاستيكية الكبيرة هو أنه أراد أن يمشى بالمدينة خطوة أخرى إلى الأمام، إلى نقطة زمنية أخرى، وأنه كان يعرف أن اللعنة الحقيقية تكمن فى الثبات.