«طوربيد».. درة يوسف إدريس.. قصة قصيرة تسجل أيامه الدمياطية

- معظم قصص المجموعة كان واقعيًا مجازيًا إذا صح التعبير
- تدور القصة فى عام 1939 أى العام الذى نشبت فيه الحرب العالمية الثانية
عندما صدرت مجموعة يوسف إدريس الأولى «أرخص ليالى»، فى أغسطس عام 1954، وكلنا يعرف الجدل الذى أثاره العنوان غير الدقيق نحويًا، وصحته «أرخص ليال»، ولكنه أصرّ وعاند لكى يصير العنوان بالصيغة التى أرادها رغمًا عن الجميع، ومع ذلك اعترف القاصى والدانى بموهبته العظيمة، حتى لو أبدوا ملاحظاتهم السلبية على توغل أو تغول «العامية» فى كتاباته الإبداعية، مثلما كتب الدكتور طه حسين فى مقدمة مجموعته الثانية «جمهورية فرحات» التى صدرت فى يناير 1956، وعزّزت وجوده الفنى والأدبى، وخاصة فى كتابة القصة القصيرة، ذلك الفن الذى ترك فيه معظم أسراره العظيمة، ورغم ما عرفناه من قصص له ومجموعات صدرت على مدى ثلاثة عقود من الزمان فإننا مازلنا نكتشف بعضًا من تلك القصص لم يدرجها كاتبنا فى أى من مجموعاته، وأنا بشكل شخصى أتوق محتارًا أمام عدم ذلك الإدراج، خاصة لو كانت القصة جيدة، ومكتملة الأركان الفنية، أكثر من قصص أخرى وضعها فى بعض مجموعاته القصصية، وها هى قصة جديدة قديمة تطلّ علينا برأسها من التاريخ القديم، وهى قصة «طوربيد» التى نشرت فى مجلة «الكاتب»، والتى كان يرأس تحريرها الكاتب والمحامى والمثقف الكبير يوسف حلمى، ورغم أن يوسف حلمى، لم يكن منتميًا إلى أى حزب يسارى أو شيوعى، فإن مجلته استدعت كثيرًا من هؤلاء، مثل عبدالرحمن الشرقاوى، وعبدالرحمن الخميسى، وسعد كامل الذى كان مدير تحرير المجلة، وإبراهيم عبدالحليم، وصلاح حافظ، ولطفى الخولى ومحمد يسرى أحمد وإنجى أفلاطون وغيرهم، وكل هؤلاء كانوا فى مكتب الأدباء والفنانين فى منظمة حدتو «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى»، ومكتب الأدباء والفنانين لم يكن مكتبًا فئويًا، ولكنه كان مستوى تنظيميًا يضع كل واحد فى ذلك المكتب، كعضو أساسى فى الحزب، وكان يوسف إدريس أحد الضالعين فى العمل بجدية مطلقة فى ذلك المكتب والحزب على حد سواء، وكان الناقد إبراهيم فتحى، هو المسئول التنظيمى له.
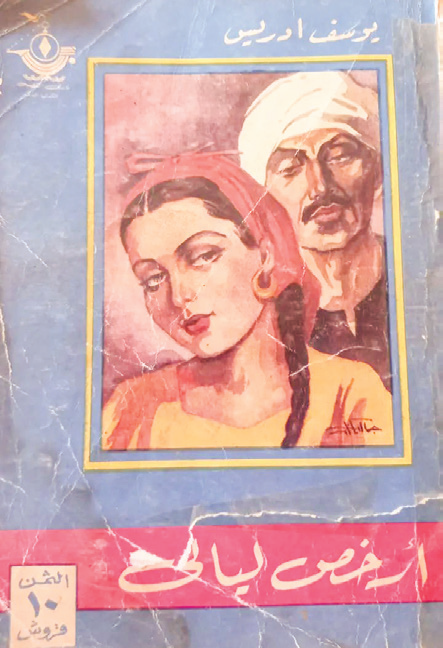
كان معظم قصص مجموعة «أرخص ليالى» يدور فى الريف، إلا القليل، وكانت هناك قصص تتحدث عن وقائع محددة فى حياته، مثل قصة «5 ساعات» التى نشرها فى مجلة التحرير بتاريخ أكتوبر عام 1952، وهى عن عملية اغتيال الحرس الحديدى للضابط عبدالقادر طه، وكان يوسف فى تلك الليلة، يعمل طبيبًا مناوبًا فى مستشفى قصر العينى، ولم يستطع إنقاذ طه بكل الطرق التى بذلها، لأن رغبة وحشية كانت خلف إنهاء حياة عبدالقادر طه، لكن معظم قصص المجموعة كان واقعيًا مجازيًا إذا صح التعبير، ولا يرتبط بحياة إدريس بشكل مباشر، ولكنه قصص عاشها متأملًا، ولكن قصة «5 ساعات» تكاد تكون جزءًا من حياته وسيرته الذاتية.
مثل قصة «5 ساعات» تأتى تلك القصة التى تتحدث عن فترة لم يفصح إدريس عنها كثيرًا، ولكنه تحدث عنها فى بعض حواراته القديمة، عندما كان تلميذًا هو وشقيقه فى دمياط، وكان عمره 12 عامًا، أى تدور القصة فى عام 1939، أى العام الذى نشبت فيه الحرب العالمية الثانية، وهو هنا يصف أهوال تلك الحرب فى دمياط، وهناك شخصية رئيسية ذكرها فى حواراته وشهاداته وهى شخصية «عم عبدالسلام»، ويقول المستشرق ب.م. كربر شويك فى كتابه «الإبداع القصصى عند يوسف إدريس»، الذى ترجمه الشاعر رفعت سلام: «.. تنقل يوسف من مدرسة ثانوية إلى أخرى، بداية من دمياط، متنقلًا منها إلى دمياط، أقام يوسف- وعمره آنذاك اثنا عشر عامًا- مع شخص أكبر منه، مرة أخرى، كان العم عبدالسلام كما أشار إليه يوسف إدريس فى الستين من عمره تقريبًا، رجلًا أجبر على الحياة قعيدًا بفعل الروماتيزم، وفى الظاهر، فقد كان يبدو مثيرًا للشفقة، ولكن سرعان ما اكتشف يوسف أنه ينطوى على روح مهتاجة، كانت حياكة الملابس هى مصدر عبدالسلام..»، هذا الشخص، هو الذى سنجده بالتفصيل فى تلك القصة، حتى الببلوجرافيا العظيمة التى وضعها الدكتور سيد حامد النساج تحت عنوان «دليل القصة الصرية القصيرة.. صحف ومجلات 1911-1961»، لم تتضمن تلك القصة النادرة، التى تخبرنا بقوة عن أيام يوسف إدريس الطفولية فى دمياط، والتى عاش فيها بدايات الحرب العالمية الثانية.
«طوربيد»
فى منزل قديم من منازل دمياط، كنت أقطن مع أخى الصغير، وكان المنزل قد بلغ درجة من القدم، جعلت صاحبه يحيل الطابق الأول كله إلى فرن، وبجواره مخزن صغير مملوء بأكوام القش والخشب، وكان يقوم بكل أعمال الفرن أخو صاحب المنزل، وكان غريبًا، فهو طويل جدًا، وذو وجه كبير، وأنف عريض، يتهدل من أسفل عينيه الواسعتين شارب ضخم، وكان ما يرهبنى أكثر هو بشاعة يديه الكبيرتين، ثم كلامه، كان يخرج مصحوبًا بضوضاء لم أكن أدرى مصدرها، كنت لا أراه كثيرًا، فهو يعمل ويقيم وينام فى الفرن، إلا أن خلقته الغريبة كانت تلازمنى ساعات كثيرة من اليوم.

ومن باب البيت يبدأ سلم طويل مظلم يتلوى إلى أن يؤدى للطابق الثانى، حيث كنت أقطن، كنت فى حجرة تلاصق الغرفة التى يقيم فيها صاحب المنزل، وكان صاحب المنزل ينفق كل يومه قابعًا فوق كنبة طويلة فى ركن الحجرة يسدد عينه إلى الباب الوحيد فى المنزل، كان مصابًا بشلل فى رجليه، فهو لا يستطيع ثنيهما، وحين يجلس تمتدان كعصاتين طويلتين من الكنبة.
وكان تحديقه الدائم، وبروز عينيه يبعثان فى جسدى قشعريرة من الخوف، خاصة حين يتلفت وهو يحدثنى فيرفع جسده كله بعد أن يستند بيديه على الكنبة.
وكلما تلفتت راودتنى الفكرة التى لم أكن أستطيع أن أزيحها عن خاطرى أبدًا: أن يذهب عنه شلله فجأة فيثب نحوى ليختفى بأصابعه الرفيعة الجافة.
وكان يفصل غرفتى عن حجرة أخرى مظلمة لا تطل على الشارع، باب نصفه من الزجاج، وكان يسكن هذه الحجرة طالب فى المعهد الدينى، طويل، أطول منى بكثير، ولكنه نحيل رفيع، وكان وجهه طويلًا هو الآخر، دائم الشحوب، كان شابًا ومع ذلك ففى وجهه بذور تجاعيد كثيرة تريد أن تنبت، وكان أكثرها ملتفًا حول عينيه الغائرتين، كل ما أعرفه عنه، أنه من بور سعيد، وأنه طالب فى المعهد الدينى، وكل ما كنت آخذه عليه هو سعاله المقلق طول الليل، وسهره الكثير، وصوته المنخفض المكتوم، وهو يقرأ على ضوء مصباحه الغازى جزءًا كبيرًا من الليل، وكانت لحجرته رائحة خاصة تأخذ طريقها إلىّ من عقب الباب، كنت أشم فيها روائح مختلطة، أبرزها رائحة «الفينيك»، وكان هذا المزيج من الروائح يبعث بكثير من الإعياء فى جسدى.
كنت يومًا جالسًا مع صاحب البيت وهو يروى لى فى صوت لاهث- وهكذا كان صوته- حلقة جديدة من قصة «سيف ابن ذى يزن»، وأنا قد امتصنى تمامًا جو العفاريت، وسحرتنى روعة الجنيات، وعلى غير انتظار سكت عم عبدالسلام، ثم التفت نحوى التفاتته التى أرعبتنى وقال بلهجته الدمياطية التى لا تزال ترن فى أذنى: إنت ما تعرفش إن الشيخ مسعد مات؟، فقلت وأنا لا أزال مستغرقانى قصة سيف: صحيح بإيه؟ّ...
- بالصدر.
وما كنت أعرف مرض الصدر هذا، ولكنى شعرت بحذاء مارد كبير يطأ صدرى ويضغط عليه فى قسوة، ومنذ هذه اللحظة كلما هبت علىّ الروائح المختلطة من تحت عقب الباب، أشعر بها تكتم أنفاسى، وكلما رأيت وجه الشيخ مسعد الأصغر الغائر أخجل من النظر إليه.
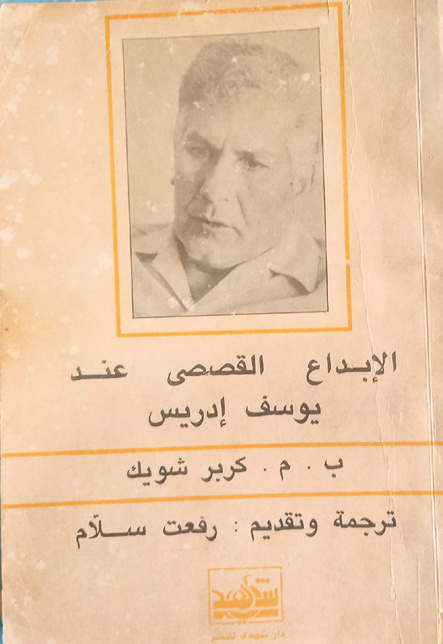
ولم أطق كتمان هذا السر الصغير عن أخى، فأخبرته به حين كنا عائدين من المدرسة، وأنا أحمل عنه بعض كتبه وأدواته الجديدة التى تسلمها ذلك اليوم، وكان أخى الصغير لا يتجاوز الثامنة، وكنت أكبره بأربع سنوات جعلتنى أبًا له، وجعلت حياتنا بريئة ساذجة لا تعقيد فيها ولا مغالاة، تبدأ سذاجتها صباح كل يوم بطبق الفول الدمياطى نتناوله فى نهم، وننتهى فى التاسعة من المساء، وقد ضمنا الفراش، صحيح كنا غريبين صغيرين، وصحيح أننا كنا نرهب معًا ذلك السلم الطويل المخيف، ويشتد بنا الهول حين نقابل الخيال الضخم فى طريقنا إلى حجرتنا، وصحيح أننا كنا نلاقى الكثير من ازدرار الناس عنا وتحرشهم بنا، ومع ذلك كنا نلهو ما تسع حياتنا هذه من لهو ، فكنت أتغاضى عن أخى حين يدس الصراصير فى حجرة الشيخ مسعد من تحت عقب الباب، وأضحك كثيرًا وهو يجلس مقلدًا صاحب البيت، بل كنت أشترك معه فى لعب الكرة مع أترابنا من الصبية بجوار الشيخ المعينى، وقليلًا ما كان يمر اللعب بسلام.
كانت ليلتها باردة كئيبة، والريح تزوم فى الخارج وأنا مغمض العينين فى الفراش، وقد احتضنت أخى الذى كان يرتجف من البرد، ومع أن النور كان ينبعث من حجرة الشيخ مسعد فيبدو كثير من ظلام الحجرة، إلا أننى كنت غير مطمئن، فهناك فى أعلى النافذة قطعة زجاج مكسورة، كانت الريح تندفع منها، فيهتز الزجاج ويصفر، حتى تخيلت أن عفريتًا طويلًا يقف فى الشارع ويمد ذراعيه محاولًا أن يقتلع النافذة من مكانها فى الجدار، فتمنيت أن يظل الشيخ مسعد ساهرًا طوال الليل ليظل النور منبعثًا، وفكرت مرارًا أن أقوم لأسد الثقب الذى فى النافذة، ولكنى لم أجرؤ على مغادرة الفراش، وظللت مغمض العينين بين نائم، مشفقًا على أخى الذى يغط فى نوم برىء وسط هذا الجو المشحون بالرعب والبرد والريح.
وتناهى إلى سمعى صوت صفير مرتفع متقطع، وما شعرت إلا بصرخة تدوى فى الحجرة وأنا أقول بصوت حاد:
- يا شيخ مسعد.
وكان الشيخ أليفًا مؤدبًا فى كلامه وحياته، وضقت بأدبه وأناقته، وهو ينظر إلى الزجاج الفاصل بينى وبينه ويقول:
- أيوه يا سيد.
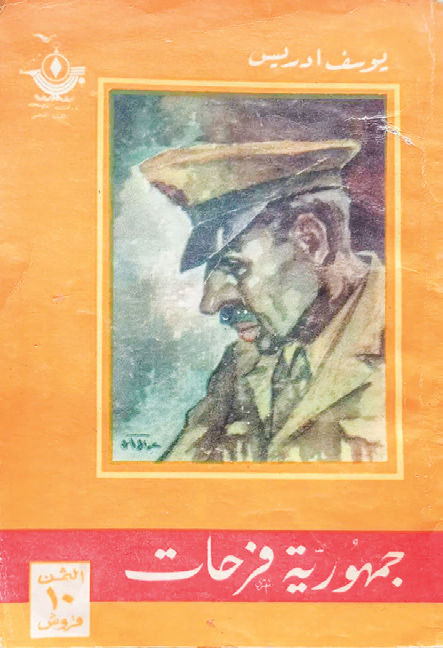
فخرج صوت أجوف غريب من حلقى الجاف وأنا أقول:
- إيه ده..؟
فى تلك اللحظة تصاعدت أصوات كثيرة من الشارع، ومن كل مكان، والتقطت أذناى لغط الناس وهم يقولون: غارةّ ! غارة!.. طفوا النور!
وقفزت من الفراش وأنا أهز أخى بشدة، واستيقظ وهو يحدق مدهوشًا، ثم اندفع واحتضننى دون أن ينطق حرفًا، وخرجت إلى الصالة وهو لا يزال متشبثًا بى، وكان الشيخ مسعد قد أطفأ المصباح وسبقنا إليها هو والخباز، وتصاعد صوت صاحب البيت يسأل فى حشرجة عما حدث، فنبهنا هذا إلى وجوده واندفع أخوه إلى حجرته، وعاد حاملًا إياه فوق كتفيه ووقفنا مترددين فى الصالة، ولكننا تبعنا الشيخ مسعد وهو يقفز السلم فى سرعة إلى السطح، وهناك وضع الخباز حمله، وأرخيت عنى يد أخى المتشبثة بى، ودرنا بأبصارنا فى الفضاء، وتوقفت أعيننا على الناس الكثيرين الواقفين فوق الأسطح يلفهم ضوء القمر الجامد فى بياضه، وكانوا كلهم يتطلعون مثلنا إلى السماء، ومن كتل الظلام المضاء فى الغرب، صك أسماعنا أزيز كان يعلو ثم ينخفض ليعود إلى العلو.
وأخذ الأزيز يقترب إلى أن أصبح فوق رءوسنا، ودوّت طلقات مدفع هزيل فى آخر البلدة، وكأنها أنين كلب واهن ينبهنا باقتراب الموت، واحتضننى أخى فى قوة واستماتة وقد أغمض عينيه حتى لا يرى الضوء المفاجئ الذى كان يصاحب انطلاق المدفع، ووقف الشيخ مسعد بوجهه الشاحب فى ضوء القمر، وشفتاه تتحركان فى تمتمة خافتة، وراح عم عبدالسلام يقول يا ساتر يا رب.. يا ساتر يا رب، وظل يكررها عددًا من المرات، ووقف أخوه صامتًا لا يتحرك، وهو يتسمع فى لهفة إلى الأزيز حين يعلو وينخفض حتى اختفى رويدًا رويدًا ناحية الشرق، واختفت بعد قليل طلقات المدفع الهزيل وزوال الخطر، ولكن أنظارنا ما لبثت أن اتجهت كلها إلى الشرق، وراحت أعيننا تتابع الأنوار الكاشفة التى تنطلق من بور سعيد، لتقترب، ثم تتباعد، وهى تبحث عن الموت الوافد، وانطلقت المدافع فى أثر الكشافات، وانقلب نور القمر الجامد البارد إلى سحابة ضخمة، من الأنوار والطلقات، واستقرت نظراتنا كلها على الشيخ مسعد، وكان وجهه قد اشتد شحوبه، وبدأت نوبة من السعال تجتاحه حتى خيل إلينا أنه يكاد يسقط، كنا نعرف أن المعارك تدور فوق بلدته، وأن الجحيم الذى انبعث فى الشرق يغلى فى صدره، ومد الخباز يده برفق لتحتوى الشيخ وهو يغمغم فى صوت غير مفهوم، ولكنه كان رقيقًا غاية الرقة، ومد الرجل يده الأخرى لتحتوينى، وما شعرت بالخوف أبدًا وكفه الضخمة تلاصق وجهى.
وتمايلت الأرض فجأة بما عليها، وأعقب ذلك دوى مكتوم، وانفلتت من شفتى عم عبدالسلام رغمًا عنه كلمة واحدة:
- قنبلة ....
وازداد سعال الشيخ مسعد كثيرًا، ثم توقفت أنفاسه فجأة فاحتضنه الخباز، وحين عاد إليه نفسه أسند رأسه إلى كتف الرجل وبكى.
وكان بكاؤه يحز فى نفسى حزًّا، ويحرك فىّ أحاسيس قديمة كلها حزن وعجز.
وشغلنى بكاء الشاب الشاحب المصدور عن كل شىء حتى وجدت الدموع تتساقط من عينىّ لتبلل يد الخباز فمضى يهدهد برفق وفى حنان غريب على كتفى.
ومرة أخرى أحسسنا بالدنيا كلها تهتز وتتأجج، وما شعرت إلا وأنا راقد فوق الأرض، وبجوارى الشيخ مسعد والخباز وأخى وقد تكومنا على السطح، استمعت إلى همسة لاهثة محروقة تخرج من فم عم عبدالسلام:
- يا ستار يا رب.
عدت من المدرسة فى الظهر، وذهبت توًّا إلى عم عبدالسلام، ويومها قال لى كلامًا كثيرًا، فقد سافر الشيخ مسعد فى الفجر وسمع أن طوربيدًا قد ألقى على بور سعيد فأصاب مخبأً كبيرًا، وقتل أربعمائة من البشر كانوا يحتمون به، وأن شوارع بأكملها قد استحالت إلى قطع من الطوب وبقايا من الخشب، وأن قريبًا للشيخ مسعد جاء فى الضحى ليخبره أن أمه وأخاه الصغير قد ماتا فى الغارة، وهمس لى عم عبدالسلام وهو يقول فى حزن عميق:
- دول لقيوا يا بنى راس أخوه معلقة فى شجرة.. وارتجفت.. فقد مرّت فى خاطرى صورة الشيخ مسعد وقد استكان إلى الخباز يعتصر صدره وهو ينشج فى أنين طويل..
وبعد قليل جاء أخى يضحك ويقفز ويرينى شهادة الفترة، ويقول بلثغة لسانه الحبيبة حين ينطق الذال: حذر أنا طلعت الكام؟.. وتناولته بين ذراعىّ وقبلته ثم احتويت رأسه الصغير بين يدىّ..... وغامت عيناى.
قصة «طوربيد» نشرت فى مجلة «الكاتب»







