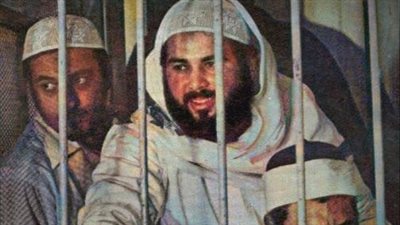فصل من رواية خانقاه الجاشنكير لـ إنجى محمد محيى الدين

موعد مع الغياب.. شتاء 1998
لم أكن أفهم تمامًا ما يدور حولى. كنت فى التاسعة، أجلس على طرف كرسى جلدى كبير، تتأرجح قدماى فى الهواء كأن لا شىء يربطنى بالأرض، ولا حتى بالزمان. الساعة الكبيرة خلف مكتب وكيل النيابة كانت تدق ببطءٍ ثقيل، كل ثانية تصفعنى على رأسى. لم أفهم لغة الكبار وقتها، لكننى كنت أسمع الجمل تتساقط من حولى كالحجارة:
- «تم حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة».
- «لم يُعثر على جثث».
كلمة «جثث» التصقت بالحائط كالبقعة السوداء.
كنتُ أراقب فم الرجل يتحرك دون صوت، كل ما سمعته كان جملة واحدة، واضحة، مفهومة:
«أبوك وأمك… ماتوا».

لكنهم لم يقولوا ذلك. لم يقلها أحد بتلك الصيغة. هم قالوا أشياء قانونية، باردة، مشفوعة بأختام رسمية. تنظر إلىّ، لم تقل شيئًا. كانت ترتدى نظارة سوداء رغم أن الغرفة مغلقة، كأنها تخفى عينين لم تبكيا بما يكفى. عرفت لاحقًا أنها كانت تكره الدموع. ربما كانت تكرهنى أيضًا… أو تكره كل ما يمتّ لعالم العاطفة بصلة.

خرجنا من الغرفة، وأنا ما زلت لا أعرف: هل سأعود إلى بيتنا؟ هل سأجد أبى يطبخ عشاءه المعتاد؟ أمى تغنى فى المطبخ؟ هل سأستيقظ من هذا الكابوس الطويل الذى بدأ منذ أن دخلا السيارة ولم يعودا؟
لا!
أحدهم كتب لى حياة جديدة بخط لا يشبه خط أبى. وقع باسمى على وثيقة لا تخصنى. وبصم على اليتُم بكفّ لا يعرفنى.
حين مرروا الملف الأزرق لخالتى، خُيّل إلىّ أنهم يسلّمونها جزءًا منى، لا ورقًا ولا توقيعًا. توقفت للحظة أمام الباب، ونظرت خلفى. الغرفة لم تكن فارغة، رغم مغادرتنا. كانت مليئة بأرواح معلّقة، بأسئلة بلا أجوبة، وبندبة بدأت تنمو فى صدرى بصمت.
«.. وبناء على ما تقدم أصدرت النيابة العامة قرارها بغلق القضية والأمر بإعادة فتحها فى حال ظهور أى أدلة جديدة»..
- شويكار : وده معناه إيه.. أختى كده خلاص؟
- المحامى: مفيش حاجة نعملها.. للأسف
- شويكار: يعنى إيه فص ملح و دابوا؟ أكيد فيه حاجة تتعمل
- المحامى: يا مدام صدقينى مفيش حل محاولناش فيه.. قانونًا الدنيا قامت وخليناها قضية رأى عام.. مفيش شخص فى مصر محاولش يدور على أختك وجوزها.. الصعيد كلها اتقلبت مش بس سوهاج بعد ما أعلنتوا عن المكافأة.. نص مليون جنيه مبلغ مش قليل.. صدقينى مالهومش أثر.. إلا لو..
- شويكار: إلا لو إيه.. أزود المكافأة.. خليها مليون المهم الاقى أختى
- المحامى: لا مش القصد.. أقصد لولا قدر الله حصلهم حاجة
- شويكار: لا محصلهمش حاجة.. هى رحلة الشؤم دى مكانش لها أى لازمة.. معبد إيه وأبيدوس إيه اللى تسيب بنتها وتروح تزوره بس. لكن أنا حاسة إنها كويسة لو كان حصلهم حاجة كانوا ظهروا.. اللى بيعمل حادثة بيظهر.. لكن شهر اختفاء أنا أعصابى إنهارت ومش عارفة أقول إيه للبنت هى لسه فاكرة كل ده إنهم مسافرين.
- المحامى: نصيحتى حاولى تمهدى لها وتبدأ تتأقلم عالوضع. حياتكم لازم تمشى وبالنسبة لى إسمحيلى هنفذ الوصية وأسلمك المبلغ اللى شويكار هانم سايباه للبنت فى حال حصل لها حاجة لكن ده محتاج شوية إجراءات لازم هنعملها.
-شويكار: بس أنا بقولك حاسة إنها هتظهر.
- المحامى: إسمحيلى للمرة التانية واضح إن فيه حاجة منعرفهاش. هى كانت عاملة ترتيبات غريبة.. توصى ان البنت تكون تحت رعايتك وتسيبها مبلغ كبير وتحت وصايتك. أكيد كانت عارفة إن فيه حاجة هتحصل. هى كانت عيانة طيب؟.
- شويكار (فى شبه إنهيار): أنا أعصابى مش مستحملة أتماسك أكتر من كده أنا تعبت ومش فاهمة حاجة ومش قادرة أواجه البنت دى فى سن صعب لا طفلة أضحك عليها ولا ناضجة تستحمل معايا الجنان اللى أنا فيه.. يا دوب ١٣ سنة.
- المحامى: أرجوكى يا مدام شويكار مش وقته خالص لازم تتماسكى والمسئولية عندك مش قليلة و مين عارف طالما مفيش أخبار سيئة جايز يظهروا زى ما بيقولوا No news good news لكن لغاية ما الغموض ده يتحل الحياة لازم تمشى.
- شويكار: الحياة...

نصف وداع.. 2010
– «هتسافرى؟ لوحدك؟»
قالتها خالتى شويكار وهى واقفة عند باب غرفتى، كتفها مائل قليلًا، وكأنها ليست متأكدة من موقفها ولا من حقى فى القرار. لم أرد فورًا. فقط أغلقت الشنطة التى جمعت فيها ما أملك من بقايا لا تشبهنى.
– «أيوه».
كعادتى، أغلقت الحوار قبل أن يبدأ.
سؤالها لم يكن يحتاج لإجابة. كنت قد قررت، ولن أسمح لها أن تسحبنى مرّة أخرى للحديث عنهم...
تجنبت دومًا الحديث عنهما، منذ اختفيا فى تلك الرحلة الغامضة إلى «العرابة المدفونة».
خالتى تسميها «أبيدوس»، أما أمى، جلفدان هانم، فكانت تقولها دائمًا وكأنها تحكى أسطورة، لا حقيقة.

كنت أظنها مجنونة.
وربما كانت كذلك.
لكن أبى...؟
كيف يترك صغيرته، أميرته، ويذهب فى رحلة عجيبة مع امرأة تؤمن بالأساطير، بالماضى، وتدّعى أنها تحلم بمعبد؟
كرهتها، أمى.
لأنها أخذته منى.
تعلّقت بتجاهلى لهم كما يتعلّق الغريق بخشبة. أتظاهر أننى لا أراهم فى أحلامى، أننى لا أسمع صوت أبى وهو يهمس باسمى فى الصمت، أننى لا أبحث عنهم فى وجوه المارّة.
كنت أهرب من نفسى، ومن الغرف، ومن المرآة. أبحث عن صخبٍ أختبئ فيه، عن ضوضاء تمنع الحلم من أن يتسلل. الهروب كان حياتى. وكل من فى هذا البيت عرف ذلك. خالتى شويكار كانت تُريحها هذه الحالة. هى لم تكن مستعدة أبدًا لتربية مراهقة غريبة الأطوار مثل جُلنار. كان يكفيها ما بها: أرملة، أمّ، خائفة من الجنون الذى كانت تشك أنه يسرى فى عائلتها مثل الدم. شويكار كانت بسيطة.تكره الأسماء القديمة، الحكايات الموروثة، الأساطير، وتعشق النظام.ابنتها شاهندة كانت نموذجًا للطفلة الطبيعية، أما أنا.. فقد كنت مرآة مقلوبة لحياتها.
ورثتُ عن أمى اسمًا عتيقًا: «جُلنار» عن جدّة لم أرها، لكن الجميع تحدثوا عنها كأنها بطلة من حكاية قديمة. أما شاهندة، فقد استقبلتنى بحماس فى أول الأمر، أختًا جديدة تُشاركها الغرفة واللعب.. لكنها سرعان ما ابتعدت عنى. أصبحت تخاف من صمتى، من استغراقى الطويل فى النظر إلى الفراغ، من شرودى، ومن الليل. كنت أسمعها تنادى أمها كل مساء لتنام بجوارها، تتركنى وحدى فى الغرفة، تحت ضوء خافت، وصوت الماضى الذى لا يسكت.

شويكار كانت تخاف من الجنون الذى حملته أختها، وتخشانى كما خشتها. كانت تنتظر اليوم الذى أرحل فيه، لكنها لا تملك شجاعة قول ذلك. فكان سفرى بحجة العمل، حلًا أنيقًا لإزاحتى..وتهدئة ضميرها.
قالت لى فى النهاية:
- «ولو حصلّك حاجة؟»
أجبتها دون أن ألتفت:
- متقلقيش
غادرت البيت. لا أذكر إن كنت بكيت. ربما لم أفعل. لكننى أذكر جيدًا أننى حين مررت بالمرآة، لم أر نفسى. رأيت ظلًا لا يُشبهنى.

إلى لندن.. 2010
تحررت.
أشعر أننى أتنفس للمرة الأولى منذ سنوات.
رفضت أن يوصلنى أحد إلى المطار. وبدا أنهم كانوا سعداء بالتخلص منى سريعًا. لا أكره خالتى، بل أحبها بطريقتى، لكنها لا تشبهنى. ولا تشبه أبى. ولا حتى أمى.
أُشبه من إذًا؟ هل أُشبه أمى غريبة الأطوار فعلًا؟ ربما.. وربما أكرهها. لكننى أدرك الآن أننى أُشبهها كثيرًا. ولذلك… لا أسامحها.لا أسامحها أبدًا على حرمانى من أبى.
سنوات طويلة وأنا أبدو كالمراهقة الغريبة، أهرب داخل رأسى، لا أضحك، لا أبتسم، لا أحب، ولا أحد يفهم أو يحاول أن يفهم. يعتقدون أننى هكذا لأننى فقدت والدىّ. لكننى لم أفقدهم فقط… أنا فقدت نفسى معهم. كنت أقرأ كثيرًا، لا حبًا فى الكتب، بل حبًا فى العوالم التى أعيشها داخلها، بينما ينشغل الجميع عنى. حاولت الاندماج.. وفشلت. قررت الهروب منذ اللحظة التى قالوا فيها «اختفوا». منذ ١٢ عامًا وأنا أخطط لهذا التحرر.
حاولت.. حاولت.. وفشلت.
ثم أخيرًا، نجحت.
هل استمددت قوتى من تلك الأيام الملوّنة قبل اختفائهم؟ حين كنت «أميرة بابا الصغيرة»؟ أم من الوحدة الطويلة بعدهم.. حين جربت الانتظار دون موعد؟
الآن.. أجلس أخيرًا فى مقعد الطائرة، وأشعر بأن الأرض كلها تبتعد عنّى. أتذكّر أن لندن كانت آخر رحلة مع أبى. كنت سعيدة إلى حد الجنون، تمنيت حينها أن نعيش هنا وحدنا، بعيدًا عن تلك السيدة غريبة الأطوار.. التى يسمونها أمى.

أتذكّر:
أوكسفورد.. بيكاديلى..
الحمام يأكل من يدى،
هارودز،
الملاهى،
عربة الآيس كريم الكبيرة فى الشارع،
الأتوبـيـس الأحمر.
كنت أصرّ أن أجلس فى الدور العلوى وحدى، حتى لو الأسفل خالٍ.
لم أكن أعلم أننى كنت أتدرّب…على الوحدة المطلقة.
تلك المدينة سحرتنى. سنوات وأنا أخطط للعودة إليها. حاولت إقناع خالتى أن أدرس هناك، رفضت.. فقررت أن أعمل هناك.ومنذ سنّ الواحدة والعشرين، وكل جهدى مكرّس للفرار.
وأخيرًا..
تحررت.
أعيش فى شقة صغيرة، بلا صور، بلا ماضٍ. أدرس الفيزياء، أحبّها لأنها باردة، منطقية، لا تطلب تفسيرًا لما نشعر به. لكن أحلامى لا تعترف بالقوانين. كل ليلة.. أرى بابًا. باب خشبى ضخم، محفور عليه رموز. يُفتح أحيانًا، وأحيانًا يبقى مغلقًا.
وفى الحلم الأخير.. سمعت أمى تنادينى:
• جُلنار.. تعالى