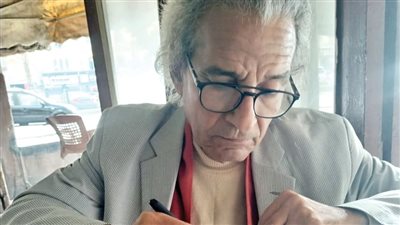اللا شىء.. من مجموعة «يوميات كاتب التاريخ الأعمى» قيد النشر

قال لى صاحب العمامة وقت فوجئت به دون سابق معرفة، قاطعًا عنى الدرب الضيق الواصل بين جوهر القائد وشارع الأزهر:
«اللا شىء لا يعنى العدم
والعدم لا ينفى الوجود
والوجود حيرة العقل
وحيرة العقل شك
والشك عتبة يقين»!
قالها وانصرف إلى حال سبيله كما جاء دون انتظار لرد أو سماع السؤال عن المعنى والسبب، تصاحبه دهشة الشرطى الواقف فى مكانه لا يبرحه مطمئنًا لوجوهنا المعتادة، نتبادل الصباحات، الآن يتأملنا أنا والرجل الغريب على وجهه رسمت علامات التعجب.
ضحك الشرطى، عينه فى عينى ككل صباح رافعًا كفه اليمنى بعلامة خاطفة كتحية نعرفها نحن أبناء الحارات الشعبية، ظننتها وقتئذ دالة على ذهاب عقل من ظهر واختفى، ولم أهتم.
بادلته الابتسام وتقدمت بخطى بطيئة، وجهى إلى الأرض البازلتية ورأسى شارد فى الملكوت، وحدى وأفكارى المتضاربة تلاحقنى بأمواج هائجة بلا اتجاه.
دخلت الحياة بغير قصد، ربما لم أكن على جدول أعمال أبى وأمى الجادة المتكررة، أو عبثهما الدائم وقت الفراغ، وحين جئت اضطرارًا، وضعت كهامش لقائمة كبرى من الفتية العدول، هكذا مثل هامش بقلم الكوبيا، هالك معتاد وضعه تاجر الأقمشة والخيوط القطّاعى.
وضيعًا بلا قيمة أو نفع..
عليك بالركض بلا انقطاع أو ندم لوقوع أو انحراف، فالزمن لا ينتظر أحدًا
عرفت فى البدايات أن الطريق إلى الحياة بمعناها، صعبة طويلة، تحفها المخاطر من كل جانب، فلم أنكر أحدًا ممن تنكروا لى، واحتفظت للمرضعات بالفضل، إلى أن لقيت صاحب العمامة صدفة:
«عليك بالركض بلا انقطاع أو ندم لوقوع أو انحراف، فالزمن لا ينتظر أحدًا، ولا يعترف بمن خانوك أو خذلوك أو قاتلوك ونهشوا لحمك بقوة وغل، لا تهتم، وادخر القليل من الوقت لتجلس هادئًا، تحكى مرارة التجربة وألم السنين بما فعلوه، وعليك تدوينه بحقيقته الكلية كرجل أعمى».
وها أنا ذا، أروى، عاريًا بكاملى أمام الآلهة..
الطريق وعر بقبحه وجماله مهما يعطى والحياة رغم بساطتها وفقرها ورضا العيش فيها والصبر على المكاره ليست سهلة يسيرة
الطريق وعر بقبحه وجماله مهما يعطى، والحياة رغم بساطتها وفقرها ورضا العيش فيها والصبر على المكاره، ليست سهلة يسيرة، ومتعة الاستغراق فى عالم افتراضى خاص من خيال ذاتى مغلق، ومنجز متحقق وهمًا ربما يحسبه التاريخ رقمًا فيدونه حال غيابى، أو يمحوه بحسب المزاجية، لا فرق.
تلك الحياة التى لا أذكر اختيارها، هل كانت بكامل حريتى، أم تحت ضغط الحاجة والمتاح، وقذفت بى فى أتونها المستعر؟!
«لا يغرنك التحقق والنجاح، فتقعد عن المعرفة والإدراك والمتابعة، تستكين إلى حائط الأنا وتضخمها، فتجهل أو تقعى تحت أقدام حاقد دعىّ بقلب معتم، يسد فى وجهك منافذ الهواء النقى، يحتقرك أو يحتكرك أو يستعبدك، واعلم أنه لا أمان لجاهل».
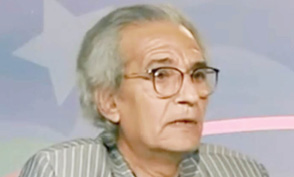
وتركنى ليهرب إلى حيث هو..
ظل صاحب العمامة، هذا المجهول، فى الظهور فجأة والاختفاء من بعد جملة محكمة مختارة، يقذفها فى وجهى وسرعان ما ينطلق كالريح، لا أعرف إلى أين يذهب أو من أين يجىء، قاطعًا طريقى فى نفس النقطة وضحكات الشرطى الواقف بتحيته الصباحية!
راوغته مرة وأكملت شارع جوهر القائد حتى آخره، وقبل الميدان بقليل وانحناءة الدرب المؤدى إلى النفق وعربة الكمين المقيم، كان صوت قارئ الذكر القابع ليل نهار والناس تميل إليه بما تيسر، يصل إلى مسامعى يهز بدنى، لقيته منزويًا، ملتصقًا بظهره إلى الحائط، بوجه غاضب مقتضب وعينين جاحظتين، حاد الكلمات:
«سمعت نقرات أصابعها فوق شباكك الوحيد، المطل على مقابر شهداء الحرب والنصب التذكارى، ولم تجب؟!».
فزعت، إذ كيف لى استقبالها وأنا على حالى كعادتى كل يوم، أرقد عاريًا فوق الأرض وأمدد ساقىَّ وذراعىَّ على اتساعهما فى منتصف المسافة بالضبط بين الباب والشباك وانتظر، علّ ملك الموت أن يأتى لينهى مهمته ويستريح؟!
ندمت لتلك المرة الوحيدة التى راوغته فيها، لطالما عرف طريقى وتربص بى، لمَ المراوغة إذن؟!
عدت مسرعًا إلى حيث أقيم ولم أنم، أخفى وجهى تحت غطائى بالساعات مؤرقًا، تلعب فى رأسى يمنة ويسرة الهواجس لا تحتمل، أيكون هو سيدى عبدالرحمن المنتظر منذ عشر سنين أو يزيد، أختار فيهن كل ليلة من لياليهن شاهد قبر، أستحسن أيها أنفع لى كقائد لفصيل، وأفاضل بين المساحات الخانقة المتراصة ما تليق بجسدى القصير النحيل إن حان الميقات وجاء لينهى؟!
«إياك والفزع حين ترى ما لا يراه الناس».
كررها أكتر من مرة على حين غفلة وركض ليختفى كعادته.
وذاك الصوت اللين القادم من بعيد لامرأة خفية، يحيط بى من كل اتجاه، يصيح باسمى مناديًا تارة، ويهمس فى ود تارة أخرى، تتبعنى حيث كنت ولا أراها، وحين أدخل بيتى ينقطع الصوت إلا من وقع أقدام زاحفة من تحت شباكى الوحيد، أو نقرات خفيفة بأطراف الأصابع، وهسيس متواتر برجاء أن خذنى إليك ولا تخف.
عشر سنين ويزيد من نقرات الأصابع لا أجيبها فى انتظار مجيئه ولم يأت، ليظهر فجأة فى العامين الأخيرين بأوامره وركضه الخفى بعيدًا عن الناظرين؟!
أنا الناجى الوحيد الباقى، قائد فصيل الحرب المتمرد رافض أوامر الإخلاء والانسحاب، تاركًا خلفى عتادنا نهبًا خالصًا لعدو يترصدنا، أحيا وحيدًا من بعد نصر فى غرفة ضيقة كالقبر، تجاور جذورى وهم فى غياب، لا أعرف لمَ تركونى ومضوا، مضربًا من وقتها عن الاقتران بواحدة أو صحبة لحظة عابرة.
فى الصباح مع صوت البروجى بنوبة الصحيان، أنتفض واقفًا أطالع قبورهم وعلامات الطريق من خلف أوراق شباكى المهترئ، أشد صدرى للأمام ورقبتى لأعلى قافزًا على أطراف قدمىَّ بين نوم وإفاقة، من خلفى رفاق السلاح بالاسم والرقم، أسمع وقع أحذيتهم الميرى يصطفون فى ترتيب معتاد، وصيحات حضورهم، يصرخ فيهم عبدالله فرج ضابط الصف الأول:
«انتباااااه».
ألتفت، لا أجد أحدًا.
هنا قبره..
فى مقدمة الصفوف كما اعتاد حيًا، ألقاه أمامى مباشرة حين أطل من فتحة شباكى أول ضوء، واسمه المحفور فوق رخامته بخط الثلث الغائر كفمه المخفى من تحت شاربه العريض شديد السواد، وصدره الواسع، بصوته الجهورى يملأ الفراغ ويرتج:
«تمام يا أفندم».
لحظة مهيبة عابرة كل صباح، تعقبها فترة من تيه حزين مقبض وصمت مقيم ملىء بالتذكر لأيام قد خلت، لم تفارقنى طوال السنين العشر، متمنيًا صحبتهم من جديد، وسؤال عالق لا يزال يؤرقنى ويقض مضجعى كل ليلة، لماذا بقيت وحدى دونهم وقد ذهب جميعهم إلى حيث هم؟!
«الندا وقت، والتلبية فرض، والمحبة دليل، فلا تعجز الناس عن فرضها، ودع محبتهم فهى رهن القبول».
واختفى كعادته..
آه، ليلة سمعت نداءها وطرقات أصابعها فوق شباكى أول مرة، فزعت من نومى والمطر شديد، صوت قطراته الثقيلة الساقطة كالحصى يطرق الأرض والجدران وشواهد القبور، الفراغ معتم إلا من وميض برق يتقاطع ورجع صدى غضب سماء آخر ديسمبر معلنة مولد العام الجديد، هو الثانى على إصابتى وفقد الوعى كآخر مقاتل، حملت بعدها إلى المستشفى العسكرى ترافقنى صناديق الأحبة، أرى أسماءهم المدونة وأرقامهم بخط قلق من خلف غلالة ضبابية، وأروح مع حركة من حملنى فى غيبة طالت لا أعلم كم من وقت مضى، أفيق على انحناءة ظهر تلازمنى بقية حياتى، والكل شهيد!
مع وميض البرق رأيت عينيها الواسعتين على غير العادة فارتجف جسدى كله وابتعدت عن شباكى المغلق، مسرعًا إلى الداخل، أحتمى بين حوائطى الصماء، أحيط صدرى بذراعىَّ محاولًا إبطاء ارتعاشة مستمرة وقلب يكاد يقفز من مكمنه.
من أتى بها إلى هنا والدرب الترابى الفاصل بينى وبين المقابر لا يعبره أحد منذ جئت إلى هذا المكان الموحش وصمته القابع بين أحجاره، وما من زائر إلا الرماد؟!
رماد شبيه بذاك الذى كان وسط الصحراء القاحلة، يغطى الوجوه النحاسية المبللة بالعرق، يكتم الأنفاس فى يوم عاصف فجأة من أيام يونيو، والحر شديد، الكل فى مكانه ومهمته على قسم ألا يتركه، يعلو صوتى بينهم أن اضربوهم بلا رأفة وأسمع صياحهم مدويًا بالتلبية، إلى آخر طلقة من ذخيرتنا وقد أوقعنا منهم العديد من القتلى والجرحى وفر البقية، مانعين تقدمهم، يحيطنا من كل جانب غبار ودخان كثيف.

تلك العيون المحدقة من بين أوراق شباكى برجاء أخذها إلىَّ، أرقتنى، أفزعتنى كل ليلة بتبدلها من اتساع إلى اتساع، وقوامها المنحوت كجذع لشجرة السيسابان، ذاك المتحول بين طول وقصر ونحافة، تجىء وتختفى لأيام ثم تعود بجديد هيئة ونفس الفعلة والرجاء، وأنا وسنينى المارة دون حساب، من حال إلى حال، شيب وانحناءة ظهر تزيد، لا أجيب مخافة التورط فيما أجهله:
«خذها ولا تخف»!
أطلقها وأسرع فى اختفائه، لتقف امرأة رءوم أمامى مقاطعة، تنظر إلى وجهى بعين جاحظة مرتابة، عاقدة جبينها كمن ترانى لأول مرة، يضحك الشرطى الواقف كعادته ونفس إشارته بيد مهتزة حول أذنه، معكوفة الأصابع، يتأكد لى عندها المعنى المراد منها وخبرها دون التباس كما عهدناها فى صبانا حين المزاح والسخرية، تتبعها مصمصة شفاة المرأة بصوت مسموع، مطأطئة الرأس فى اندهاشة، ماضية إلى حال سبيلها.
أخرج من المكان مسرعًا، عابرًا الطريق الواسع إلى وكالة الغورى وزحام الناس، بلا هدف، ناسيًا ما كنت فاعله، أمضى برأس فارغ كفاقد للذاكرة والكل من حولى فى غلالة من ضباب، لا أعرف كم من وقت مشيت، وابتسامتى البلهاء عالقة فوق وجهى.
ما حيلتى مع أهلى البسطاء من أبناء حاراتنا حين مزاحهم، يسخرون كعادتهم من كل شىء ولا مهرب، ربما فعلتها مثلهم ولا غرابة، أركن إلى مقهى قديم منزوى، فقير المقاعد، وحدى أجاور بابها وجدارها الباهت، فى حارة تاريخية صامتة، خالية من المارة إلا فيما ندر، وصوت الراديو البعيد الطالع على استحياء.
على الجانب الآخر يواجهنى بالضبط، بيت صغير متهالك، مغلق بابه الغائص قليلًا تحت مستوى الأرض بفعل الزمن والتراب، وشباك وحيد أوراقه بالية.
تشغلنى البنايات العتيقة وأشغال الأرابيسك من حولى لبعض الوقت، يضع الرجل كوب الشاى فى هدوء ويختفى، ولا أحد.
دقائق وألمحه بطرف عينى، ظل يراقبنى من خلف الشباك المغلق، أدقق النظر ولا أرى، تعود إلى وجهى تلك الابتسامة البلهاء الفائتة، أستعيد ما حدث من المرأة الرءوم والشرطى الواقف، هل أصابنى مس من جنون فعلًا وكل ما أراه وأسمعه محض وهم؟!
وماذا عن صاحبة العيون الواسعة بصوتها الرنان وطرقات أصابعها، ماذا عن رجائها الليلى؟!
«الشاى برد يا أستاذ، أعمل لك غيره؟».
أطالع وجه الرجل ولا أرد، عجز صوتى كمن أصابه الخرس، يبادلنى الابتسام الباهت باندهاشة تاركًا كل شىء فى مكانه ويعود متمتمًا بكلمات لا أفهمها، ربما كان يسبنى ولا غضاضة!
يعود الظل إلى المراوغة من جديد ويهتز بدنى بكامله، ألقف كوب الشاى إلى فمى دفعة واحدة وألقى بالقروش إلى الطاولة منتفضًا سريع الخطى، متجاوزًا كتل الزحام والعربات المارقة، إلى بيتى والمقابر.
يا لتلك الارتعاشة التى أصابتنى ليوم كامل، أحاول جاهدًا الخلاص منها لا أستطيع، تعيدنى إلى لحظة الإفاقة من بعد إصابتى التى كانت، وإخبارى بأننى الوحيد الباقى وقد ذهب الكل دونى، بكيت طويلًا واندفعت طالبًا البقاء إلى جوارهم وجسدى المحنى يرتعد!
لمّا خرجت وأنهيت أوراقى محالًا إلى التقاعد، لم أجد من ينتظر، أعرف طريقى إلى بيتنا العائلى، تفاجئنى انتهازية أخى وانفراده وحده بكل شىء، أنكرنى من بعد وفاة أمى الأرملة حزنًا لما أصابنى، أهيم على وجهى ومعاشى المحدود، من مكان إلى مكان حتى كدت أن أبيت فى الزوايا وبين الشقوق، ليهبنى رجل فقير أجهله كان يصلى وحده بغرفة بجوار المقابر، ولا أعرف إلى أين ذهب بعدها.
فى الصباح أفيق على صوت وضجيج كراكات زاحفة، أطل من شباكى الوحيد لأعرف بقرار إزالة مقابر باب النصر، فأهوى بجسدى فوق فراشى ذاهلًا.
وقت جاءت فى موعدها بالضبط ونقرت بأطراف أصابعها، اندفعت إلى شباكى أفتحه وأشرت إليها بالدخول قافزًا حدود الخوف والارتياب، أنا المقاتل فوق جسده عديد العلامات والأوسمة، لعلنى أجد لديها ولو القليل من سكينة أفتقدها، وبغير انتظار مقدمات التعارف، تلقفنى بين ذراعيها حاضنة، فألقيت بنفسى إليها تفعل ما تشاء.