البحث عن الخلاص.. ثنائيات اللغة والصورة عند ريم القمرى

«أنا لكم الآن غير أننى لا أشبه أحدًا».. هكذا تستهل ريم القمرى مجموعتها القصصية «حياة أخرى لعمر مضى»، التى أعدت قراءتها للمرة الثانية خلال الرحلة الجوية رقم 3L -423 المتجهة من القاهرة إلى أبوظبى بتاريخ 16 فبراير 2025.
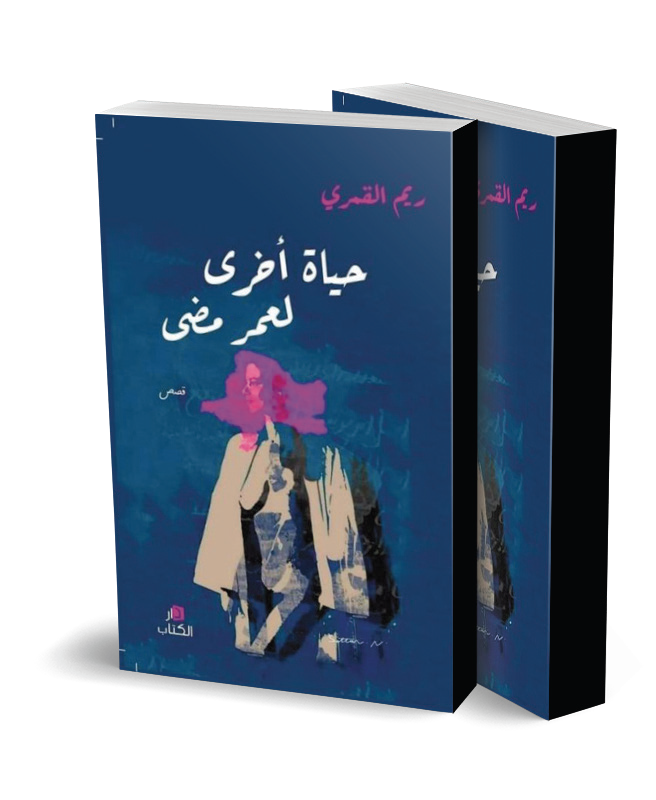
قبل بضعة أشهر قرأت المجموعة للمرة الأولى، وقررت حينها الكتابة عنها، لكن الانشغال الصحفى حال دون ذلك، فكانت القراءة الثانية ربما أكثر دهشة من الأولى.
تستخدم القمرى لغتها البكر، وتركيباتها اللغوية التى تشبه جمال تونس، رغم قسوة الصورة والدراما فى الكثير من نصوصها، لكن جراءة النص ومتعته الذهنية يحول دون أى شعور بالملل حتى الانتهاء من المجموعة كاملة.
فى بعض النصوص ترى ملامح المجتمع التونسى بتفاصيله الدقيقة، وهو ما يمنح المجموعة خصوصية هامة، وفى بعضها تتشابه أوجه المعاناة فى الثقافة الشرقية والمنطقة العربية، وهى الهموم ذاتها التى تجدها فى الرواية عند نجيب محفوظ وفى القصة عن يوسف إدريس، والكثير من الكتاب الكبار، لتقترب القمرى منهم بمجموعتها الهامة.
يشكل الأسود والأبيض فى لغة المجموعة صورة حية لمشاهد عدة «مع الأخذ بالاعتبار الآراء التى تشير إلى أن الألوان كلها هى من السواد البياض»، إذ يشير الأسود إلى الموت والشر والأسى والكآبة، لا سيما فى الأدبيات الشرقية، بينما يرمز الأبيض إلى البراءة والسلام والطهارة، ويمثّل فى الثقافات الشرقية النقاء والعذرية، فى حين أنه يرمز إلى الحداد فى بعض ثقافات دول شرق آسيا، لكن توظيفه فى النصوص ربما أقرب لما يعنيه فى الثقافات الشرقية، خاصة العذرية التى فقدها أبطال بعض نصوصها، فيما تشير فى لغتها فى بعض المواضع للون الأحمر، وما يحمله من رمزية العشق والشهوة والدم أيضًا، وهو يستخدم كثيرًا للتعبير عن المشاعر المتناقضة.
تنسج ريم القمرى مجموعتها القصصية من ثوب متجانس لغة وحكاية
فى القصة الأولى «الجسد الماخور»، تفرض اللغة سحرها، رغم جراءة الصورة الوصفية فى مشاهدها، لكن توظيفها فى بنية النص جعل منها ضرورة أدبية، إذ تكشف عدسة الكاميرا التى تحملها اللغة بين سطورها قسوة واقع ربما عاشته مئات أو آلاف الفتيات، وظل فى إطار المسكوت عنه.

كما تضىء فى قصتها الأولى بلغة رشيقة على معاناة الجسد أمام كل أوجه التطرف يمينًا ويسارًا، ما يدفع بصاحبة الجسد فى قصة «الماخور» إلى ضرورة التخلص من سبب عناء روحها، مجيبة بذلك على تساؤلات كل الضحايا من عصافير الكناريا، بعد أن قررت بطلة القصة الأولى الانتقام من العصفور والتلذذ بقتله، فى إشارة مشابهة لما عاشه جسدها مرات ومرات.
تنسج ريم القمرى مجموعتها القصصية من ثوب متجانس لغة وحكاية، كل قصة ليست شبيهة بسابقتها، لكنها ابنة بيئتها لغة ومشهدية، تمكن جيدًا أن تكون مجموعتها كلوحة فنية.. كل زاوية فيها تحمل دهشة، تقودك لزاوية أخرى أكثر دهشة، دون اضطراب أو توقف، لم أشعر فى القراءة بأن هناك قصة ما دخيلة على المجموعة وبنيتها.
تظهر ثلاثية الجسد، والرحيل، والإرهاب، بشكل واضح فى نصوص المجموعة، انطلاقًا من النص الأول، الذى قادها فيه جسدها من إرهاب زوج الأم إلى إرهاب المتطرفين فى الجبال، ثم تضىء فى نصوصها المتتالية على ذكريات الطفولة، إذ تعود فى معظم نصوصها إلى محطة البداية التى شكلت المستقبل، وكان لها أبلغ الأثر فى النهايات المأساوية، كما يتضح ملمح الهروب أو الحاجة للخلاص فى خصلة الشعر التى تركتها لبنى قبل اختفائها، فى قصة «وأُغلق الملف نهائيًا»، وفى نصها الأول «الجسد الماخور»، حين تركت رسالتها الأخيرة قبل تفجير نفسها، وفى نص «سباحة فى البياض».
فى مطلع المجموعة بدت محاولات الانحياز للغة السرد، لكن التراكيب الشعرية تسللت فيما بعد إلى بعض نصوص المجموعة القصصية دون أن تكون عبئًا على النص السردى كما يحدث فى حالات عدة حين يكتب الشعراء القصة، ويظهر ذلك جليًا فى «زوار الليل»، إذ تجد نفسك فى بداية قصيدة لتدرك فى فقرتها الرابعة التمهيد السابق.. كمن تغلف الشوك بالورد.
تحمل العديد من النصوص ملمحًا نفسيًا هامًا يرتبط بالذكريات والأحداث التى عاشها أبطالها فى الصغر، ويمكن أن نرى الملمح من خلال النظرية التحليلية لسيغموند فرويد، التى تفسر المواقف التى يتعرض لها الإنسان فى حياته وعلاقتها بسلوكه للتعامل مع الضغوط النفسية بإحدى ميكانيزمات الدفاع التى ذكرها فرويد فى نظريته، ومن بينها «النكوص» وهو العودة إلى فعل كان يفعله فى الماضى خلال طفولته لأنه قد حرم منه أو لأنه يشعر بالأمان حينما يفعله.
فى ١٦٩ صفحة بدت النصوص وكأنها فصول رواية لم تكتمل
أيضًا فى نظرية واطسن وبافلوف، والسلوكية الإجرائية لسكنر؛ يمكننا استخلاص الارتباطات الشرطية التى يعيش بها الإنسان، وهى إيجابية أو سلبية ترتبط بسن الطفولة المبكرة، وتلازم الشخص مدى حياة الإنسان بالذاكرة المؤقتة والدائمة، ويصعب معها أن ينسى الطفل تلك الصور الذهنية العالقة فى ذاكرته.
فى العديد من نصوص المجموعة يتضح جليًا أثر ذكريات الماضى فى سياق الأحداث وتصرفات الأشخاص سلبًا وإيجابًا، إذ تعد الذكريات بكل مستوياتها الهاجس الأكبر داخل بعض النصوص، بحثًا عن الخلاص من صورة الماضى التى تلازم الأبطال فى واقعهم الراهن.
فى نص «الفراشة والحرير» يبدو أقرب لقصيدة نثر تمر من مشهد إلى آخر، كما لو كانت بيدها كاميرا تلتقط بعض المشاهد لتعيد ترتيبها فى رحلة عبر طريق تسعى فيه للولادة كل مرة من جديد.
فى ١٦٩ صفحة بدت النصوص وكأنها فصول رواية لم تكتمل، فى نصوصها الـ«١٥» تمكنت الكاتبة من لغتها بشكل جيد حتى فى اختيار العناوين، التى بدأتها بـ«الجسد الماخور» وختمت بـ«جثث وأشباح»، وهى دلالة هامة فى إطار قراءة المجموعة بشكل كلى، والتى تعد محطة هامة فى مسار مبدعة تملك كل أدواتها، وتكتب بما تمليه عليها الكتابة.

