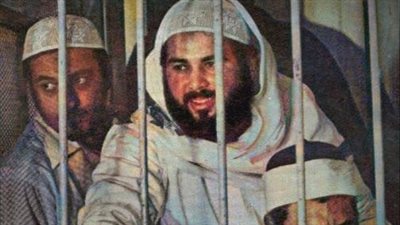هكذا تكلم أحمد عنتر مصطفى.. الرحيل الدرامى لشاعر يصعب تعويضه

رحيل المواهب الكبرى فى الشعر والفكر والعلم والفن والقيادة يعقبه فراغ واسع. ومع أن الحياة لا تتوقف فإن جودتها تقل، وجدواها تهتز. ورحيل الشعراء الكبار حدث مؤلم ومثير للحزن والأسى والشجن، وباعث على القلق والتساؤل عن جدوى الحياة. فرحيلهم يمثل فراغًا فى عقل الأمة ووجدانها لا يملؤه أحد. ومنابع الجمال والفكر التى كانت تفجّرها أخيلتهم تنضب.
رحل المتنبى فى منتصف القرن الرابع الهجرى وهو شاعر العربية الأكبر، وتوالى بعده شعراء كبار، لكن أحدًا منهم لم يكن المتنبى، ولم يكن على قدره فى الرؤية والتفرد والأصالة فى التعبير عن ذاته التى امتزج فيها الذاتى بالموضوعى والقديم بالجديد، والشجن العابر للزمن. وظللنا قرونًا طويلة فى انتظار الآتى، حتى بزغ نجمه فى مصر واجتمع الشعراء تحت رايته ونصّبوه أميرًا للشعر والشعراء، وأسس مجدًا غير مسبوق لمصر فى تاريخ الشعر. فكان أحمد شوقى صوت العروبة والتاريخ، وصوت الضمير الإنسانى العابر للجغرافيا، ومؤسسًا لفنون جديدة وقراءات جديدة للتاريخ الأدبى العربى فى بغداد وقرطبة ودمشق، وغيرها من الحواضر. وكان صوت مصر فى أفراح الشرق وفى أحزانه:
كانَ شِعرى الغِناءَ فى فَرَحِ الشَر قِ وَكانَ العَزاء فى أَحزانِه
قَد قَضى اللَهُ أَن يُؤَلِّفَنا الجُر حُ وَأَن نَلتَقى عَلى أَشجانِه
ورحل شوقى وترك فراغًا واسعًا لم يقترب منه أحد، كما رحلت أم كلثوم وعبدالوهاب ونجيب محفوظ. فرحيل هؤلاء وغيرهم من كبار المواهب، ومنهم الشعراء، فراغ عظيم فى حياة الأمم ذات الحضارة الخالدة والتاريخ العريق. ولكنهم برحيلهم، الذى لا مفر منه، صاروا منارات وعلامات على الطريق لكل من يأتى بعدهم، وحداة الركب الذى لم يتوقف.

كان رحيل صلاح عبدالصبور، فى أغسطس ١٩٨١م، فاجعة كبرى لكل من يعلم قدره وعلو مكانته، وعِظم موهبته، وعمق رؤيته للحياة والأحياء. وكان رحيل أحمد عنتر مصطفى، يوم الأربعاء السادس والعشرين من نوفمبر، حدثًا مفاجئًا ومحزنًا فى الوقت نفسه. والحزن والمفاجأة من سمات الدراما، ففى يوم الثلاثاء الواحد والعشرين من أكتوبر، تذكرت هيئة قصور الثقافة الشاعر واحتفت به فى إطار برنامج العودة إلى الجذور، وشاركت فى هذه الاحتفالية بقصر الثقافة بالجيزة، وتحدثت عن أهم معالم رحلته، وكم كان ممتنًا لهذا الحديث وكأنه كان يكتشف نفسه فى ضوء ما قدمت فى حديثى عنه. وتواعدنا أن نلتقى فى المجلس الأعلى للثقافة بعد أن يجرى فحوصًا طبية يحتاجها قلبه الواهن، وصدره الذى يئن. وذهب إلى المستشفى ولم يعد، ولم نلتق، ولم يقدر على أن يرد على رنين التليفون، ومضى وترك لنا مفاجأة الرحيل والحزن العميق. إنه رحيل درامى ولا شك، وما وجودنا فى الحياة إلا فصل من دراما الوجود.
ولم يكن وجود أحمد عنتر مصطفى «١٩٤٤م-٢٠٢٥م» إلا تجسيدًا لدراما الوجود التى بلورها فى شعره منذ منتصف الستينيات من القرن الماضى حتى رحيله. وفى مختاراته الشعرية التى قدمها للنشر تحت اسم «هكذا تكلم المتنبى» ٢٠١٦م من الهيئة المصرية العامة للكتاب، نجد تحقيقًا لما نريد من تتبع الرؤية الدرامية كما أرادها الشاعر وعاش من أجلها. وهذه المختارات الشعرية هى التى نال بها جائزة البابطين فى الشعر ٢٠١٧م.

وتكشفت لنا السمة الأنطولوجية فى هذه المختارات عن رؤية الوجود كما تجلت فى توزيع الفصول الثمانية، وكما تبلورت فى داخل كل فصل من هذه الفصول التى تفاوتت مكوناتها من حيث العدد. وتصدّر هذه الفصول الإهداء الذى قدمه الشاعر إلى شخصيتين؛ الأولى تنتمى لعالم الفكر والفلسفة «نيتشة»، والثانية تنتمى لعالم الشعر «المتنبى».
والعلاقة بين الشخصيتين ليست علاقة مباشرة ولا تنحصر فى اتجاه واحد، فكلاهما شخصية ملغزة ومتعددة الجوانب وموضوع للتأويل المفرط. والشخصيتان لا يجمعهما زمن واحد ولا جغرافيا واحدة. فالمتنبى من القرن العاشر الميلادى الرابع الهجرى، و«نيتشة» من القرن التاسع عشر. ومع ذلك جمع بينهما الشاعر ابتغاء نقطة التقاء، وهى الجمع بين المتجانسين كأنه جمع بين زمنين. فالمتنبى عاش طيلة حياته شغوفًا بفكرة القوة والأصالة الفردية. ونيتشة قضى عمره باحثًا عن التميز والأصالة الفردية ومُركزًا على فكرة القوة، وكتابه «هكذا تكلم زرادشت»، وهو من أهم كتبه، تلخيص لمبدأ الإنسان الأعلى الذى يجمع بين قوة الجسد وقوة الفكر وقوة المبدأ. والمتنبى اكتوى بنار تطلعاته الفكرية كما اكتوى بالبحث عن تجلى المبدأ فى الشخصية.

والعجيب أن كليهما، المتنبى ونيتشة، ماتا فى سن متقاربة. عاش المتنبى بين عامى ٣٠٣-٣٥٤ هجرية وعاش نيتشة بين عامى ١٨٤٤-١٩٠٠م، وكلاهما شخصية ملهمة وذات أوجه، وكما قلت موضوع للتأويل المفرط. فلماذا الربط بينهما على اختلاف ثقافتيهما وحضارتيهما فى صدر هذه المختارات التى مثّل المتنبى العتبة النصية الأولى لها؟.
فى اقتباسه من أقوال نيتشة يقول الشاعر: «ليس هناك فنان يستطيع أن يحتمل الواقع، لأن من طبيعة الفنان أن يضيق ذرعًا بالواقع»، وفى إشارته للمتنبى لم يذكر قولًا من أقواله ولكنه قال: «إليه، وإليه وحده، أحمد بن الحسين أبى الطيب المتنبى»، فإفراد المتنبى وحده بالإهداء إشارة واضحة إلى تلاقٍ بين الشاعرين فى زمنين: زمن معيش وزمن مستدعى. هذا الزمن المعيش هو نفسه الواقع الذى يضيق به الفنان على حد قول نيتشة، ولم يحتمله المتنبى وسعى إلى تغييره طموحًا إلى زمن قادم وواقع محتمل.

هذا الربط بين زمنين مختلفين ينتميان لحضارتين مختلفتين يعنى أن فكرة الوجود ليست مرتبطة بالزمن الآنى ولا بزمن حضارة من الحضارات، ولكنها مرتبطة بقضية الإنسان مهما يكن، ومرتبطة بهمومه وآلامه التى إن اختلفت أماكنها وأزمانها فهى واحدة ومتصلة ومتشابهة على الرغم من اختلاف أوعيتها.
هذه الرؤية هى التى هيأت للشاعر أن يجمع بين فيروز والفيتورى من جهة، وبين أبى تمام والمتنبى من جهة أخرى. كما هيأت له أن يجمع بين هوان الحال العربى اليوم وبين سيف أبى تمام فى عمورية، وصحبة المتنبى لسيف الدولة فى معاركه ضد الروم. فهوان الحال العربى المقابل السلبى لانتصار المعتصم المعجز كما صوره أبوتمام، بما يجعل من قصيدة أبى تمام نموذجًا شعريًا من جهة ونموذجًا للقوة والعزة من جهة أخرى. وهذا ما جعل القصيدة حاضرة فى كل العصور منذ القرن الثالث حتى الآن. وهى فى حضورها أنشأت حولها صورًا عديدة من صور التلقى الشعرى والتأويلى.
ولو عدنا إلى فصول هذه المختارات، نجد أن أكبر فصلين هما «من هشيم الذاكرة» ١٥ وحدة، و«توقيعات فى كتاب الحب» ١٦ وحدة. وفيهما نجد القصائد الغنائية القصيرة التى لا يجول فيها إلا خاطر واحد وشجن واحد، هو شجن الحب والرغبة فى المغامرة. فى الفصل الأول «من هشيم الذاكرة» استدعاء لما مر من الزمن عبر مصفاة الذاكرة التى سماها الشاعر «هشيمًا»، وفى الثانى «توقيعات فى كتاب الحب» استدعاء للحظة الآنية توكيدًا لإحساس الفرد بذاته حين يجد صداه على جسد الأنثى. فالشاعر يتجول بين أزمان يعيشها وأزمان يستحضرها وأزمان يرفضها. ومن هذه الأزمان المتقابلة تتشكل رؤية الوجود كما يرسمها عبر فصوله ووحداتها.

ويمكن أن نشير إلى مفارقة تمثل جانبًا من رؤية الوجود عنده، وهى أن هذين الفصلين «من هشيم الذاكرة» و«توقيعات فى كتاب الحب» يضمان ٣١ وحدة من القصائد القصيرة والقصائد ذات الشجن الفردى. وفى الفصل الأخير من المختارات «مرايا الحضور» نجد أن مكوناته الدلالية خمسة فقط، ولكنها خارجة عن اللحن الفردى وأدخل إلى الزمن الدرامى وأكثر دلالة على رؤية الوجود العربى عبر تداخلاته الزمنية والاجتماعية. وهذه المكونات استدعاء لزمن قريب «افتتاحية النار» يمثله أمل دنقل، واستدعاء لزمن بعيد يجاور زمن دنقل من حيث التوظيف الدلالى لعناصر الرؤية، وهذا الاستدعاء نجد فيه رمزية أبى تمام ورمزية المتنبى.
فرؤية الوجود عنده رؤية واسعة الأفق جغرافيًا وتاريخيًا، وتضم الأزمنة فى حالة تجاور أحيانًا، وفى حالة تنافر وتضاد أحيانًا أخرى. فزمن أبى تمام ليس بعيدًا عن زمن المتنبى، بل هما زمنان متجاوران ومتشابهان يوظفهما الشاعر توظيفًا جديدًا حين يضعهما فى مقابلة مع الزمن المعيش. ولا يستند هذا التوظيف إلى أبى تمام أو المتنبى بوصفه فردًا بل يستند إلى مجمل إنجاز الشاعرين من حيث ارتباطهما بالمعتصم ومجابهة الروم، وبسيف الدولة وتأكيد قيمة العروبة. والعروبة ومجابهة سطوة الروم مشروعان عربيان أصابهما التوهج حينًا، كما أصابهما الانكسار حينًا آخر. فلا يزال الواقع العربى رهين الروم الجدد، وما زالت قيمة العروبة محل توجس وريبة بل ومساومة.
واتساع دوائر الزمن فى هذه الرؤية يقابله اتساع دوائر الجغرافيا بما تحمله من مضامين ثقافية وظلال أيديولوجية. فنيتشة حاضر لا بوصفه ألمانيًا أوروبيًا فقط بل بوصفه ممثلًا لأيديولوجيا القوة أو إرادة القوة والاستعلاء العرقى على باقى الأعراق. وفيروز والفيتورى وأمل دنقل مربعات ثلاثة ليست واحدة ولا معبرة عن معنى واحد. ففيروز من جبل لبنان بما ينطوى عليه لبنان من تعدد الأعراق والثقافات التى أشعلت النار فترات مؤلمة، كما أضاءت مساحات واسعة من الحرية غير المسبوقة فى عالمنا العربى. وجاءت فيروز لتعتصر هذا المزيج فى بوتقة فنها الإنسانى الذى شدا للحب، كما شدا للجمال، وشدا لأيلول كما شدا للقدس، وشدا للبسيط العابر كما شدا بأشعار الأخطل الصغير.

والفيتورى من السودان شاعر إفريقيا والعروبة، وهو مثل الشاعر المغترب العابر للحدود. نشأ فى مصر وعمل فيها، وعارض حكومة السودان فأسقطت عنه الجنسية، ومنحته ليبيا القذافى جنسيتها ومثّلها فى محافل دولية، ثم سحبتها منه بعد رحيل القذافى، فعاش بقية عمره فى المغرب وحيدًا إلى أن مات ٢٠١٥ بعد أن رق له السودان وأعاد إليه الجنسية. ودنقل شاعر الجنوب المصرى الذى لم يهدأ قلمه وقلبه إلا بالموت ١٩٨٣م، ظل ممثلًا صوت الرفض وزرقاء اليمامة، ورمزًا للشاعر صاحب الموقف. غلب على الفيتورى الحس الصوفى وغلب على دنقل الحس الثورى، وهما متغايران وإن كان هدفهما واحدًا، وهو التغيير مع اختلاف الوسائل.
ومن الثقافة العربية، ننتقل إلى رمز ثقافى آخر، هو فيدريكو جارثيا لوركا فى واحدة من أشهر أعماله «عرس الدم»، لتتوحد الرؤية مع الشاعر الروسى سيرجى يسنين، وهو أحد أشهر الشعراء الروس فى القرن العشرين. والشاعران لقيا حتفهما لقاء مواقفهما المعارضة للنظامين الاستبداديين فى إسبانيا وروسيا البلشفية.

وتجلت هذه الرؤية الدرامية فى أشكال من القصيدة متعددة، منها القصيدة العربية فى شكلها التراثى مثل «إسكندرية» و«سيدة الأحزان» و«عفوًا أبا تمام» و«صهيل الخيول المتعبة» عن الفيتورى. و«ربى الشام» و«لا بد من صنعا» وعن بغداد تحت اسم «العنقاء». وكما كتب عن غرامه بأم كلثوم كتب عن فيروز شعرًا ذا صياغة أقرب إلى الدرامية.
وتجلت قصيدة التفعيلة على نحو أكبر فى صور شعرية درامية، مثل مجموعة «رباعية الحزن المقيم»، التى تضمنت أربعة أعمال شعرية درامية، وهى «مشاهدات فى مدينة تاريخية: حديث مسلٍ مع جوهر الصقلى»، و«مأساة الوجه الثالث: النص غير الكامل لمسرحية لم تعرض فى حفل استقبال» و«عرس الدم» (بدون اعتذار للوركا) و«ما تيسر من سورة القمع» (وفديناه بذبح سجين)، هذا بالإضافة إلى القصيدة الأم التى حملت المختارات اسمها «هكذا قال المتنبى».. لنصل فى ختام هذا المقال إلى التأكيد على ما قدمناه فى صدره، وهو أن رحيل الشاعر الكبير يمثل فراغًا يصعب ملؤه أو تعويضه.