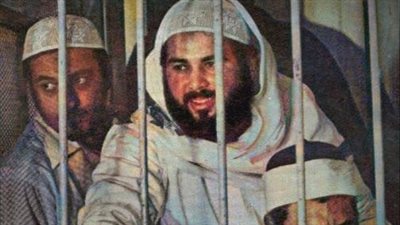فصل من رواية «داليدا تحكى».. الحب.. الألم.. والنجاح

أنا داليدا..
ابنة الهجرة، ابنة الجبل والمدينة، ابنة الماضى الذى بكى، والمستقبل الذى غنّى.
ولدتُ فى مصر.. لكن قلبى كان يحمل إيقاعين: إيقاعًا إيطاليًا يشبه خطوات جدى فوق الصخور، وإيقاعًا مصريًا يشبه نبض القاهرة حين تستيقظ كل صباح.
وهكذا.. بدأت حكايتى
1
كنتُ دائمًا أشعر أننى ولدتُ بين حلمين.. حلم تركه أجدادى خلفهم فى إيطاليا، وحلم وجدوه فى مصر، البلاد التى احتضنتنى قبل أن أصرخ صرختى الأولى.
أنا فتاة من مهاجرين إيطاليين، لم أولد فى بلد أجدادى، لكننى حملتُ قصتهم على كتفى كما حملوها يوم فرّوا من الجوع والأزمات التى نهشت بلادهم فى عهد الملك فيكتور إيمانويل الثانى. كانت نهاية القرن التاسع عشر قاسية على الإيطاليين، حتى اضطر كثيرون إلى البحث عن وطن آخر يضمّهم، وطن يستطيعون أن يعيشوا فيه دون أن يقايضهم الحياة بثمن غال من الألم.
العائلات الثرية لجأت إلى المحيط الأطلنطى، كانت تؤمن بأن البحر الواسع قد يحمى ثرواتها من الضياع، وكانت رائحة البيتزا تتبعها، كأنها تذكر أفرادها بكل ما تركوه خلفهم. أما الفقراء.. هؤلاء الذين يشبهون جدى، فقد هاجروا عبر البحر الأبيض المتوسط، اتجهوا جنوبًا فجرفهم الهواء نحو بلاد أكثر دفئًا وأقرب عهدًا بالبشر.

فى عام ١٨٩٣، حمل جدى «جيوسيب» ما تبقى من عمره، وهو رجل يناهز الستين، وغادر مدينته التى عرف ملامحها طفلًا وشابًا وشيخًا. خرج حاملاً ما استطاع من مقتنيات بسيطة، وترك لأبواب المدينة أن تغلق من خلفه دون أن يعود لها يومًا. اتجه نحو serrastretta، القرية الصغيرة المختبئة بين جبال الإسكارب فى كالابريا، حيث الهواء النقى، والطرق التى تتلوى كأنها خيوط حرير، وحيث الناس يعيشون من جمع أبوفروة وعيش الغراب، ومن نحت الخشب وصناعة الأثاث، ومن الحرير الطبيعى الذى كان سرّ رزق كثير من العائلات هناك.
كان جدى يقول إن هناك حياة يمكن أن تُصنع من الأشياء الصغيرة.. من رائحة الخشب، من تعب اليد، من عزلة الجبال التى لا يسمع سكانها سوى أصوات الريح وطقطقة الأحجار تحت أقدامهم، لكنه كان يحلم بحياة مختلفة.. حياة لها صدى، لها مدينة، لها ضجيج؛ لذلك هبط من الجبل متجهًا نحو المدينة، تاركًا خلفه سكانًا يعرف كل واحد منهم بالاسم، وترك عائلته الأصلية فى لحظة كان يعرف أنها لن تتكرر. مشى، وتاه، ثم وجد نفسه أمام طرق سنوسية قادته إلى نابولى.. وهناك تغيّر كل شىء.
فى نابولى تعرّف إلى عالم لا يشبه جباله، عالم يفتح أبوابه لكل من يبحث عن بداية جديدة، وهناك اعتنق المسيحية، ربما لأنه كان يبحث عن طمأنينة لم يجدها فى وطنٍ تركه، أو لأنه شعر بأن حياته القديمة انتهت بالفعل، وأن عليه أن يولد من جديد.
ولدتُ أنا من هذا الولادة الثانية.
على أحد الموانئ، دُفع جدى إلى باخرة كبيرة دون أن يفهم تمامًا لماذا عليه أن يغادر. وربما لم يكن الفهم ضروريًا.. فالقلب حين يكون ممتلئًا بالأمل لا يحتاج إلى تفسير.
وصل إلى القاهرة.. مدينة لم يسمع باسمها إلا قليلًا، لكنها كانت بالنسبة إليه وعدًا غريبًا.. وعدًا بحياة لم يعشها من قبل.
القاهرة فى ذلك الوقت كانت مدينة يختلط فيها التاريخ بالمرض، والأمل بالخوف. صحيح أن مرور أكثر من عشرين سنة على افتتاح قناة السويس جعل منها مركزًا اقتصاديًا مهمًا، وصحيح أن آلاف الموظفين الأجانب عملوا فيها وهم يؤمنون بأن المستقبل بدأ هناك، لكن المدينة أصيبت بالكوليرا.. المرض الذى خطف آلافًا من الأرواح، حتى إن الـ٢٨ ألف ضحية، الذين قيل إنهم ماتوا لم يكونوا سوى رقم فى سجل مأساة أكبر من قدرة البشر على الاحتمال.
وعندما انتشر المرض، هرب كثير من الإيطاليين واليونانيين والعرب والفرنسيين من الأحياء الموبوءة إلى مناطق أخرى.. لكن جدى بقى.
بقى لأن الرحيل مرة أخرى كان يعنى هزيمته الأخيرة.
كانت مصر تحت الحماية البريطانية، وكانت القاهرة تمتلئ بسكان أصليين ومهاجرين من ديانات مختلفة «مسلمين، مسيحيين، ويهود». كان أهلها يعملون فى التجارة وزراعة القطن واستغلال المناجم، بينما ساهم المهاجرون وأولهم الإيطاليون فى كل ما يتعلق بالزراعة والصناعة، فقد كانوا يأتون إلى العمل فى الصباح كما لو أنهم يزرعون المستقبل بأيديهم.
وحين وصل جدى إلى القاهرة، رأى مدينة تختلف عن أى شىء عرفه فى حياته. رأى مسارح، وضوءًا، وشوارع لا تنام، وضحكات لا يعرف أصحابها، وسكونًا داخليًا لم يشعر به منذ يوم غادر وطنه.
القاهرة كانت بالنسبة إليه نافذة من العالم.. وكان الجبل الإيطالى بالنسبة إليه مجرد ذكرى.
ولأن المدن تُعرَف من أصواتها.. أحبّ جدى صوت الترام وهو يقطع الشارع، وصوت عربات الكارو التى تجرها الحمير، وصوت النيل الذى كان ينساب كأنه أنشودة تتكرر دون أن يفقد رونقها.
ووسط كل هذا.. كانت الأهرامات قائمة كأنها تحرس المدينة، تحرس أسرارها، وتعلن أنها عاصمة لا تشبه أى عاصمة فى الدنيا.
هناك.. فى هذا الخليط من البشر واللغات والديانات.. كانت بدايتى أنا.

ولدتُ فى القاهرة لأفهم لاحقًا أن الإنسان لا يولد فى مدينة فقط.. بل يولد فى قصة. وقصتى بدأت قبل ولادتى بزمن طويل، بدأت يوم قرر جدى أن يترك وطنًا لم يعد يشبهه، ليجد وطنًا آخر كان ينتظره دون أن يعرف. لم يبقَ له هناك أى شىء.. لم يبقَ من أجورى القديم، الرجل الذى كان يملأ البيت صخبًا وذكاءً وشجاعة، والذى كان يمارس مهنة الترزى بفخرٍ يشبه فخر المقاتلين. تغيّر كل شىء.. وكأن المدينة التى تركها خلفه كانت تذوب كلما ابتعد عنها. وفى القاهرة.. قابل روزا، المرأة الإيطالية التى جاءت من نفس الجذور، لكنها كانت تحمل قلبًا لم يتعب بعد من الحب. تزوجا، وأنجبت له أربعة أبناء: فينيكو، إيجونى، بيترو، وجيورجو.
وكانت الحكايات تتردّد حول تلك الولادات.. يقولون إنهم ورثوا عن أمهم ميلًا للمغامرات العاطفية، وإنهم تركوا مواطنهم الأصلية كما تركت هى وطنها، لتلحق كل واحدة بحياة أخرى عند ذراع رجل أحبّته.
لكن تلك الحكايات لم تكن سوى ما رواه بيترو.. جدى.
كان يقولها وهو يبتسم، كأنه يعترف بنصف حقيقة ويترك النصف الآخر لخيالنا. وهو نفسه الذى أعاد لزهرة القاهرة حقها.. حين رفض العودة إلى إيطاليا بعد اختفاء جيوسيب ووفاته فى مطلع الأربعينيات.
كانت تلك اللحظة نهاية المغامرات القديمة.. ونهاية حب عاش طويلاً ثم انطفأ بوفاة زوجته.
أصبح جيوسيب أرملًا، يعيش مع حماته، ويكرّس كل ما بقى له من عمر لخدمة أولاده الأربعة.
كان الابن الأكبر فى السادسة عشرة.. وفى هذا العمر المبكر حمل ما لا يجب أن يحمله إلا الرجال الناضجون. وقف إلى جوار أبيه، وأمسك بيده، وأخذ عنه همّ البيت وألمه. فى تلك الفترة التى كان الحزن فيها ضيفًا لا يغادر، تحوّلت حياة العائلة إلى شجن طويل.. وكأن كل واحد منهم كان يعزف نغمة حزنه الخاصة.
لكن من قلب هذا الحزن.. خرج حلم.
صار جدى بيترو، بالتشجيع والإصرار، أول عازف فى الأوبرا الملكية بالقاهرة.
لم يكن الأمر سهلاً، لكنه كان يعمل بقوةٍ استمدها من الفقد، وبعنايةٍ جعلته يتمسك بكل نغمة يعزفها. وفى سن الأربعين، بدأ اسمه يلمع.. ليس فقط كعازف، بل كروح تبحث عن معنى جديد.
وحين بلغ هذا العمر.. وقع فى الحب.
وقع فى حب جوسبينا.. جدتى.
امرأة تحمل جمالًا هادئًا، كأنها تعرف منذ ولادتها أنها ستصير قدره.
تزوجها، ومن تلك اللحظة بدأ بيترو يعيش حياة جديدة.. حياة تحت شمس مصر، حياة لم تكن تشبه أى حياة أخرى عرفها قبلها.
وهكذا.. ولدتُ أنا من قصة كانت تبدأ بالحزن وتنتهى بالضوء، من رجل فقد كل شىء ليجد كل شىء فى مكان آخر.. من تاريخ لا يزال يهمس فى صدرى كلما غنّيت..
لم تكن عائلتى سوى ذلك البيت الصغير المخبّأ داخل شوارع شبرا الشعبية، حيث الجرس المعلق فوق كنيسة الحى يرنّ كل أحد كأنه يضبط نبض الزمن ويذكّرنا بأن الإخلاص عادة يومية، لا طقسًا دينيًا فحسب. هناك، وسط الجيران القادمين من كل الأفق، من الشمال ومن الشرق ومن شطآن لم نعرف أسماءها، تشكّلت تلك البذرة الأولى للثقافة الحقيقية، ثقافة تختلط فيها الروائح والألسنة واللهجات والقصص التى تتكاثر مثل النخل فى أرض خصبة. وفى هذا المناخ، وُلدت مغامرة أجدادى الذين عاشوا قصصًا عاطفية تشبه أفلام الأبيض والأسود؛ زواج، سفر، ثم ميلاد أول أبنائهم أبى فى سنة ١٩٣٠، لحظة وُصفت داخل العائلة بأنها بداية «قبيلة» جديدة لعائلة جيجليوتى فى مصر، أول فروع السلالة التى ستنمو لاحقًا على ضفاف النيل.

وبعد ثلاث سنوات، فى فجر بارد من يناير ١٩٣٣، جئتُ أنا… يولاند كريستينا، الطفلة التى لم يحتج أهلها إلى شىء لاستقبالها سوى أن يفتحوا قلبهم. لكن الحياة، كعادتها، لا تمنح هدايا دون اختبارات؛ فعمّتى، التى كانت بصحة جيدة، فقدت صوتها من كثرة الصياح، وكانت تنادى أهلها بطريقة حادة تجعلهم يهبّون لنجدتها، بينما كنت أنا أصرخ ليلًا ونهارًا كأننى أقاوم قدرى قبل أن أعرف اسمى. عشرة أشهر من البكاء المتواصل جعلت والدتى تدهن صدرى بسائل مرّ كى تتراجع الصرخات، لكن شيئًا لم ينجح، وكنت أصرخ أكثر كلما حاولت أن أهدأ.
وفى زمن آخر، زمن «جيوسينا»، جاءت المعاناة الأشد حين أصيبت بمرض خطير فى عينيها، فقرر الأطباء أن يغطّوا عينيها ورأسها بشاش كثيف لمدة أربعين يومًا. أربعون يومًا عاشتها عمتى فى ظلام دامس، تبكى لا لأنها تتألم فقط، بل لأنها كانت تشعر بأنها اختفت من العالم. وبعد انتهاء العلاج، عادت إحدى عينيها إلى الحياة بعد عملية دقيقة، أما الأخرى فبقيت ترى الأشياء «طشّاش»، وظلت آثار الألم تلازمها طوال عمرها، فكانت ترتدى نظارة سوداء أخفت خلفها كل ما تركته الأيام فيها من وجع وضوءٍ مكسور.
ولأن الخوف ابنٌ شرعى للظلام، حملته أنا أيضًا؛ كنت فتاة صغيرة ترتعب من الليل الأسود، ولا أنام إلا إذا كانت المصابيح مضاءة حولى من كل اتجاه، كأن الضوء كان هو اليد التى تنتشلنى من خوفى القديم. ومع مرور السنين، صار برونو- أخى- ظلّى ورفيقى الأقرب، فحين فقدت العائلة أحد الإخوة، كنت أنا أتشبث به كمن يتشبث بآخر حبال النجاة، بينما كانت أمى تحاول أن تطفئ رعب الظلام فى عينى كل ليلة.
ومع أن السنوات الأربع التالية خفّت فيها المياه البيضاء من عينى عمتى، إلا أننى أنا كنت أحمل عبئًا آخر: نظارات سميكة تجعلنى أشعر بأننى أملك أربعة عيون، وتفصلنى عن زميلاتى فى المدرسة الإيطالية التى دخلتها بتردد شديد، غير قادرة على تكوين صداقات بسهولة. كنت أحب دروسى- التاريخ والجغرافيا واللغات- لكننى كنت أكره الرياضيات والفيزياء كما يكره الطفل الدواء المرّ، وكنت أتجنب اللعب فى الشارع وأكتفى بعرائسى ورفقة أخى أورلاندو الذى كان عزائى الوحيد. كنت أرتدى فساتين رُقّعت مرارًا بيدى جدتى، ممزقة فى أماكن وعزيزة على قلبى فى آن واحد، وكنت أحب البالونات أكثر من أى لعبة أخرى، كأننى أبحث فى خفتها عن شىء يرفعنى فوق الحياة.
وفى وسط تلك الطفولة المربكة، اكتشفت السينما. ذهب بى عمى «إيجونيو» إلى قاعات الأفلام، وقال لى إن الدخول مجانى، فشعرت وكأن عالَمًا جديدًا يفتح أبوابه لى. كان الفن السابع فى القاهرة يعيش أزهى عصوره، وكان كل فيلم بالنسبة لى درسًا فى الحياة. فى ظلام القاعة بدأت أتعلم أولى لغات الجمال، وبدأت أقلّد النجمات اللواتى أحببتهن: ريتا هيورث، آفا غاردنر.. وكنت أحلم بأن أكون واحدة منهن، حتى لو ضحكت أمى حين رأتنى أقلدهن أمام المرآة.
وبرونو.. ذلك الأخ الحنون.. ظل يتابع خطواتى الصغيرة، يدير شئونى كأنه مدير أعمالى قبل أن أصير شيئًا. كان يجمع نقودى ويهتم بأحلامى، وكأنه يرى فىّ ما لم يره أحد. وعندما وقفت لأول مرة أمام الجمهور فى إحدى حفلات المدرسة، ضحكت أمى كما لم تضحك يومًا، وقد رأت أن الفتاة الصغيرة التى تخشاها زميلاتها بسبب نظاراتها، قد وُلدت من جديد على المسرح. صحيح أن صوتى كان يعانى، وأن «زورى» كان يشتكى من الغناء، لكن خلف ذلك كله كانت هناك شرارة.. شرارة قالت لى إن الغد يحمل لى شيئًا.
وإن لم أكن نجمة فى تلك اللحظة.. فإن كل ما حولى كان يلمّح، بخجل، أن النجمة قادمة.
فصل من رواية «داليدا تحكى»