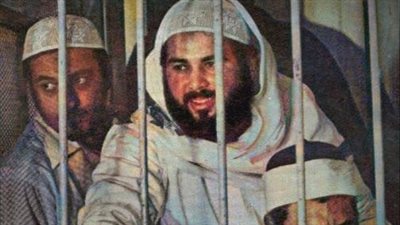أنا يتيم يا مصطفى.. الذين قتلوا صديقى بحرمانه من جائزة الدولة!

عُدت إلى الإسكندرية عام 1977 خائب الرجاء بعد أول عامين عشتهما فى القاهرة أمتلئ بالأحلام، والطموح اللا نهائى، لقد تم تعيينى وأنا فى الجيش فى الشعبة القومية ليونسكو بالدقى.
لقد عشت فى القاهرة عامين بعد أن عملت فى هذا المكان المغرى وحلمت أن أكون كاتبًا متحققًا فى العاصمة، ولكن أمى التى ماتت فى أكتوبر 1976، وأختى التى صارت تعيش وحدها فى الإسكندرية والشقة التى أعارها لى أحد أقاربى، كل هذا دفعنى إلى العودة الخائبة إلى الإسكندرية، وهناك شعرت بالخواء الشديد، رغم أننى لم أحقق أى نشاط فى القاهرة، وبدأت أبحث أين يتردد الأدباء، إنهم غالبًا فى نادى السينما بمتحف البلدية، وأيضًا قصور الثقافة المتناثرة فى المدينة.
وفى قصر الحرية أثرت زوبعة مع الأستاذ الدكتور يوسف عزالدين عيسى عندما حاول الدفاع عن فتحى الإبيارى فى ندوة، وذكر أغلب الحاضرين أن الإبيارى يستخدم كثيرًا الفعل الناقص «كان» فى كتاباته، وحاول الدكتور عيسى أن يبلغ الحاضرين وكلهم من تلاميذه أن «كان» عند الإبيارى موقرة للغاية، بدليل أن وليام فوكنر له رواية بهذا الاسم، فما كان منى سوى أن أعترض على هذه المعلومة وأقول إنه ليست هناك رواية لفوكنر باسم «كان»، وثارت الزوبعة لفترة فى ثقافة الإسكندرية، وأثرت العودة إلى عزلتى أقرأ أكثر، وأقتنى من المجلات والكتب ما يتسع به مسكنى.
فى تلك الفترة تعرفت على أدباء الإسكندرية خاصة الجيل الذى أمثله، تحت ريادة الناقد عبدالله هاشم، وتعرفت على أدباء من جيلى منهم مصطفى نصر وسعيد بكر وأحمد محمد حميدة.
كان «مصطفى نصر» يسكن على مقربة جدًا من منى، فصرنا رفيقين، نذهب إلى الأنشطة الخاصة عن الأدباء، وفى بعض الأحيان قد نجلس للعب الطاولة فى المنشية، كان مصطفى هو أقرب الناس إلىّ منذ أن عرفته حتى وفاته فى أكتوبر عام ٢٠٢٥، لم ينقطع عن الاتصال، وقرأت أغلب أعماله، ومنها «الصعود فوق جدار أملس»، و«جبل ناعسة»، وأعمال أخرى كثيرة.
وعندما عملت بدار الهلال واجهت بعض المشاكل لنشر روايته «المساليب»، لكن علاقة مصطفى بجمال الغيطانى سهّلت له أمور نشر الرواية فى دار الهلال.

كنت الصندوق السرى لصديقى مصطفى يحكى لى عن كل شىء فى حياته الخاصة، فترددت على بيته وصار أبناؤه الصغار مدللين من طرفى، هؤلاء الأبناء صاروا كبارًا فيما بعد وأرباب أسر، لكنى لا أنسى دفء مصطفى نصر وهو يضع يده اليمنى فى يدى اليسرى على طريقة الأصدقاء المقربين، ونتجول فى شوارع المدينة يحكى لى ما يعِن له.
كان هذا الرجل حكّاء فى المقام الأول، يهتم بالمهمشين والشخصيات الثانوية الذين يمرون حوله مثل بعض الموظفين الذين أصبحوا مقاعد أمام مكاتبهم، وأعتقد أنه ليس من حقى أن أتكلم عن أسرار أحتفظ بها لمصطفى، ولا يعلم عنها أحد شيئًا، لكنه كان يحكى لى دومًا على مر السنوات علاقته بأبيه، الرجل «قوى الذكورة» الذى يغير على زوجته من ابنه فيطالبه بالبيات فى أى منزل من منازل الأسر.. إنها حكايات أشد غرابة بكثير من القصص الحقيقية التى رواها الكاتب فى رواياته ومجموعته القصصية.
لقد عبر مصطفى عن حبه للسينما فى كتاب يحمل اسم «سينما إلدورادو»، وهناك رواية حققت له المجد الأدبى بنشرها فى القاهرة بعنوان «يهود الإسكندرية»، وهى رواية وقع عقد تحويلها إلى فيلم مع الفنان محمود حميدة كمنتج قبل عامين من رحيله، وكم أبلغنى أن هناك كاتب سيناريو شابًا كان يزوره فى الإسكندرية لمراجعة ما أنجز من الكتابة، ولا أعرف ما هو مصير السيناريو أو الفيلم خاصة فى الفترة المقبلة.
مصطفى نصر كان لا ينقطع عن زياراتى عندما عدت إلى القاهرة مجددًا، كان دائما بصحبة أدباء آخرين ويقوم فى كل زيارة بالتجوال فى المؤسسات الصحفية ولدى بعض التنظيمات الثقافية مثل اتحاد الكتاب ونادى القصة، كل هؤلاء كانوا مرتبطين بالإسكندرية، وفخورين للغاية بمفهوم أدباء الأقاليم، فيذهب معهم من مؤتمر إلى آخر، وكان فى بعض هذه المؤتمرات يلقى بكلمة، أو يتم تكريمه، بما يحقق له الكثير من طموحه الأدبى.
كما كان فى السنوات الأخيرة من حياته يقوم بترشيح نفسه لنيل جوائز الدولة التقديرية وهو الذى لم يحصل على جوائز أقل من قبل، رغم استحقاقه لها، وكان ينتخبه لهذه المهمة أعضاء فى مجلس إدارة «الأتيليه» بالإسكندرية، وعندما رحل هذا الشخص فإن مصطفى لم يجد أحدًا يختاره، كل ما أعرفه أنه فى عام ٢٠٢٥ أعيد طرح اسمه مرة أخرى لنيل الجائزة، إلا أن من حصلوا عليها فى ذلك العام لم يكن أحد منهم قد حقق نفس المكانة الأدبية لمصطفى، وأعتقد أن هذا الأمر ترك حذًا شديد البتر فى داخل الكاتب الذى مات على إثر إعلان الجوائز بعدة أسابيع.
وكم لاحظت ذلك فى مكالماتنا الهاتفية، رغم أنه مر فى العام الأسبق بأزمة صحية طاحنة كانت كفيلة بالقضاء عليه، لكنه تجاوزها.
أهم شىء بمصطفى نصر هى علاقته بزوجته، فهى ابنة عمه التى اختارها له أبوه، كانت سيدة ريفية طيبة عاشت فى المدينة دون أن تعرفها، وتفانت فى حب زوجها، وكم قدّرت ظروفه فى السراء والضراء، وقد رحلت قبل وفاته بست سنوات عاشها دون أى عزلة باعتبار أن أبناءه كانوا دائمًا حوله لا يتركونه وحيدًا، لكنه الموت زاره فى آخر حياته، أى وهو فى الثامنة والسبعين.
بدت مكانة مصطفى نصر عندما قامت هيئة الكتاب بطباعة أعماله الكاملة، مثلما حدث مع كبار الكتاب فى مصر، وكم كان يشعر بالرضا لهذا الأمر، إذ كان طموحه بلا حدود، ولا أنسى له أبدًا أنه كتب على الفيسبوك مناشدًا وزيرة الثقافة أننى قد أُصبت بفقدان البصر بعد أن حدث ذلك عام ٢٠٢١، ورغم مشاغلها فإن الوزيرة اهتمت، لكن مدير مكتبها أصر على أن يتم علاجى فى مستشفيات التأمين الصحى، فرفضت بشدة ما يعنى أن الكتاب لدى وزارة الثقافة هم أيضًا فئات، وكم حزنت أننى الذى قمت بكتابة نعى لصديقى وأنا تحت تأثير الكثير من الظروف الماضية، لكن كل ما حدث أن مصطفى قد رحل فى سكون وبلا أى ضجة، مثلما عاش حياته الخاصة والأدبية.
كان خجولًا، مليئًا بالحياة، وكان نشطًا حتى وإن داهمه المرض، وكم آلمنى أنه لم يعد يأتى إلى القاهرة التى تحولت بالنسبة لى إلى بقعة من الظلام الأسود، لا أستطيع أن أرى ما وراءه، وكل ما أستطيع أن أفعله هو أن أقول: هذا صديق لا يتكرر فى الحياة ولا مرة واحدة، رغم وجود أصدقاء آخرين أحمل لهم الكثير من الإعزاز.