الأسطوات.. الأسرار المخفية عن شعراء العامية المصرية

- التجربة الصحفية لمأمون الشناوى أسهمت فى إثراء رؤيته الإبداعية وصقل لغته
- حسن أبوعثمان من أهم «شعراء الظل» فى تاريخ الأغنية المصرية
- عبدالفتاح مصطفى تحول للأغنية الدينية بسبب تجربة شعورية عميقة
- الأغانى الحديثة أصبحت تعتمد على صيحات لحظية وإيقاعات متكررة
فى كتابه الأحدث «الأسطوات»، يغزل الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين سيرة ومسيرة شعراء الأغنية فى العصر الحديث، فى إطار أعم وأشمل عن تاريخ الأغنية المصرية بصفة عامة، مع الحرص على أن يكون ذلك بالعمق المطلوب.
فالكتاب لم يكتفِ باستعراض سير وأعمال أبرز شعراء الأغنية فى العصر الحديث، مثل بديع خيرى وحسين السيد ومأمون الشناوى وفتحى قورة ومرسى جميل عزيز وعبدالفتاح مصطفى وحسن أبوعتمان وعصام عبدالله وعبدالرحيم منصور وسامى العجمى، وغيرهم الكثير، بل حرص أيضًا على إبراز السياق الاجتماعى والثقافى الذى نشأ فيه هؤلاء الشعراء، إلى جانب التكوين النفسى والفكرى الذى صنع تجربتهم الفنية الفريدة.
حول الكتاب، والجديد الذى يكشفه فى مسيرة أبرز شعراء الأغنية المصرية، ولماذا لم تعد الأغنيات ترسخ فى الوجدان كما كانت فى حقب سابقة، وغيرها من التفاصيل الأخرى، يدور حوار «حرف» التالى مع ميسرة صلاح الدين.
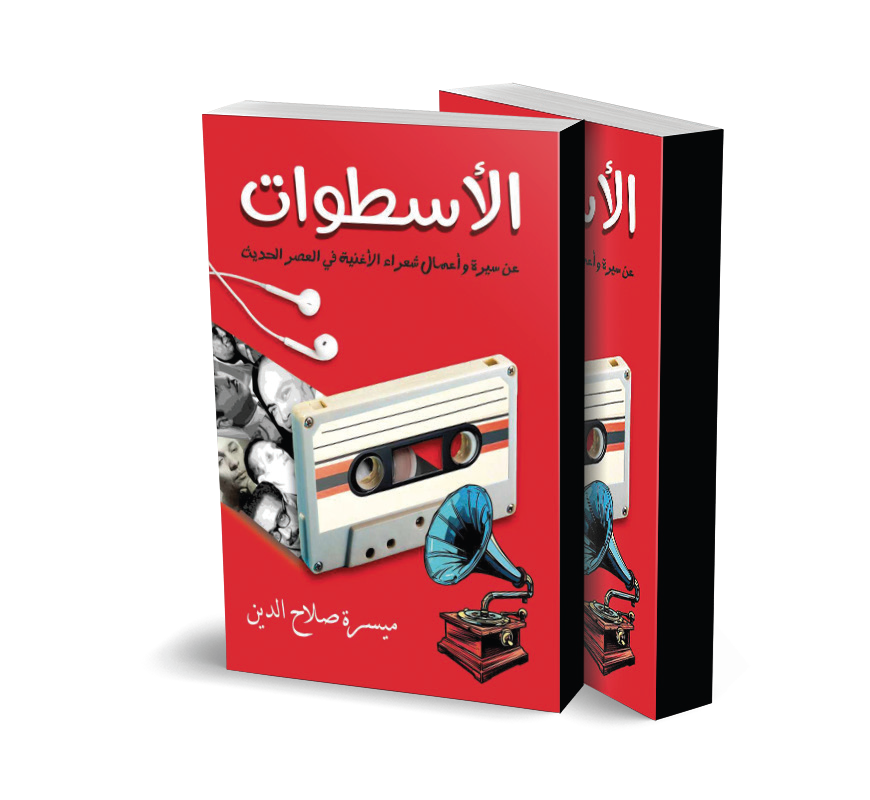
■ لماذا اخترت وصف «الأسطوات» دونًا عن غيره عنوانًا للكتاب؟
- لم يكن اختيار عنوان الكتاب أمرًا سهلًا، فقد استغرقت وقتًا طويلًا فى البحث عن العنوان الأنسب. «الأسطوات» كلمة ذات أصول تركية، ويمكن تتبع جذورها حتى اللغة الفارسية، وتعنى فى سياق هذا الكتاب أولئك الصُنّاع المهرة من شعراء الأغنية، الذين أخذوا على عاتقهم تأسيس عصر نهضة الفن المصرى فى أزهى مراحله.
اخترت هذا العنوان تحديدًا لأنه يحمل بُعدًا فنيًا وحِرفيًا فى آنٍ واحد، فهو لا يشير فقط إلى الموهبة، بل إلى تراكم الخبرة والاجتهاد فى تشكيل هوية فنية واضحة. هؤلاء الشعراء لم يكونوا مجرد صُناع أغانٍ، بل كانوا مؤثرين فى تشكيل الذوق العام والثقافة المصرية، وأسّسوا مدرسة متكاملة جمعت بين الإبداع والتجديد، وكان لهم تأثير واسع على الأجيال اللاحقة.
أعتقد أن كلمة «أُسطى» لا تُطلق فقط على الشخص الموهوب، بل تشير إلى من يجمع بين الموهبة والحِرفية، إلى جانب وعيه العميق بالمرحلة التاريخية والاجتماعية التى يعيش فيها، ما يجعله صاحب تأثير ممتد يتجاوز زمنه. ولطالما كنت مفتونًا بهؤلاء الشعراء الذين لم يُسلط عليهم الضوء بالقدر الكافى، فرأيت أن «الأسطوات» العنوان الأمثل لتكريمهم والاعتراف بإسهاماتهم.

■ ما الجديد الذى يكشفه الكتاب عن حياة هؤلاء «الأسطوات»؟
- فى ظل انتشار الكتب التى تتناول سير الشعراء والفنانين، كان التحدى بالنسبة لى أن أقدم طرحًا مختلفًا، لا يقتصر على السيرة الذاتية، بل يغوص فى أعماق التجربة الإبداعية لهؤلاء الشعراء. لذا لم أكتفِ بجمع المعلومات المُتاحة، بل سعيت إلى تقديم رؤى جديدة، من خلال تحليل نصوصهم الشعرية بعمق، وتتبع تأثيرات المدارس النقدية والفلسفية عليهم، ما يتيح للقارئ فهمًا أعمق لتطور أعمالهم.
حرصت أيضًا على إبراز السياق الاجتماعى والثقافى الذى نشأ فيه هؤلاء الشعراء، إلى جانب التكوين النفسى والفكرى الذى صنع تجربتهم الفنية الفريدة. لم يكن التناول مجرد عرض للسير الذاتية، بل محاولة لكشف العوامل التى قادت كل «أُسطى» إلى التدفق الإبداعى، واللحظات المفصلية التى شكّلت مسيرته.
كل شخصية فى الكتاب كانت بمثابة لغز حاولت فكّ شفراته، ليس فقط عبر سيرته، بل من خلال كلماته وأسلوبه والتأثيرات التى صاغته. أردت أن أخلق تفاعلًا حقيقيًا بين القارئ وهؤلاء «الأسطوات»، بحيث لا يكتفى بمعرفة سيرهم، بل يشعر بوجودهم وتأثيرهم، وأرجو أن أكون قد وفّقت فى تقديم رؤية جديدة تضىء جوانب ربما لم تُطرح من قبل.
■ هل هناك محطات معينة توقفت عندها فى سِيَر «أسطوات» الشعر الغنائى؟
- وراء كل أغنية خالدة، يقف شاعر صنع كلماتها بروحه وعقله. سير هؤلاء «الأسطوات» ليست مجرد محطات زمنية، بل رحلات ملهمة مليئة بالتحديات والتحولات التى تستحق التأمل، فقد كانت حياتهم زاخرة بالأحداث المهمة، والتغيرات الفكرية والفنية التى لم تؤثر فقط على مسيرتهم، بل أعادت تشكيل ملامح الأغنية المصرية.
يمكننا أن نرى كيف أثرت التحولات النفسية فى مسار الشاعر عبدالفتاح مصطفى، الذى ترك الأغنية العاطفية بعد تجربة شعورية عميقة، وبدأ رحلته مع الأغنية الدينية، ليصبح أحد روّادها ومؤسسيها فى العصر الحديث.
أما الشاعر مرسى جميل عزيز، فقد شهدت كتاباته تحولًا جذريًا، إذ تخلى عن التراكيب المعقدة والزخرفة اللفظية التى طبعت أعماله فى بداياته، واختار لغة أكثر بساطة وسلاسة، لتناسب الذوق الجديد وتتناغم مع أصوات مطربين شباب مثل عبدالحليم حافظ، ما عزز تأثيره فى الأغنية المصرية الحديثة.
هذه التحولات لم تكن مجرد تغييرات أسلوبية، بل تعبير عن تفاعل الشعراء مع الزمن والمجتمع والفن، ما جعلهم جزءًا لا يتجزأ من الوجدان الموسيقى المصرى.
■ لماذا تغيب أسماء شعراء الأغنية عن ذاكرة مُحبى الطرب على عكس المُلحِنين والمُطربين؟
- عندما نستمع إلى أغنية، فإن أول ما يرسخ فى أذهاننا هو الصوت والصورة، لا الكلمات التى صاغتها أنامل الشاعر. لذا، يحظى المطرب، بصفته الواجهة المرئية والصوتية للأغنية، بالنصيب الأكبر من الأضواء والشهرة. وفى بعض الحالات، ينجح الملحن فى اقتسام جزء من هذا التأثير، خاصة إذا كان حاضرًا بجانب المطرب فى المناسبات الفنية أو يشارك فى الأداء الموسيقى.
لكن رغم ذلك، لم يبقَ جميع شعراء الأغنية فى الظل، فقد تمكن بعضهم من أن يكونوا وجوهًا معروفة بفضل أعمالهم وأنشطتهم الأخرى. فحسين السيد لم يكن مجرد شاعر، بل كان أيضًا مذيعًا بارزًا من خلال برنامجه «البيانو الأبيض». أما بديع خيرى، فقد تجاوز كونه شاعرًا ليصبح ممثلًا سينمائيًا ومسرحيًا، فقد ظهر فى أفلام مثل «ياقوت»، وشارك نجيب الريحانى نجاحاته.
فى النهاية، تظل الكلمة هى البذرة التى تنطلق منها الأغنية، لكنها تحتاج إلى وسيط قوى: صوت المطرب وألحان الموسيقى، ليصل تأثيرها إلى الجمهور، ما يجعل الأضواء تتجه غالبًا إلى من يراهم الناس ويسمعونهم، أكثر ممن يبدعون فى الخفاء.
■ أشرت فى الكتاب إلى أن تاريخ الشعر المصرى يشكل لغزًا كبيرًا.. ما حيثيات هذا الحكم وظواهره؟
- يعد تاريخ الشعر المصرى لغزًا كبيرًا نظرًا لتعاقب الحقب الزمنية وتعدد الروافد الثقافية التى أثرت فيه وتأثر بها. انفتح الشعر المصرى على التأثيرات العربية القديمة، والتأثيرات الصوفية والدينية، إلى جانب التأثيرات الغربية التى برزت مع حركات التجديد. كما لعبت الفنون الأخرى، مثل الموسيقى والمسرح، دورًا فى تشكيل ملامحه، خاصة فى الشعر الغنائى.
فى المقابل، لم يكن الشعر مجرد متلقٍ لهذه التأثيرات، بل كان قوة فاعلة أثرت فى الثقافة الشعبية وتشكيل الوعى المجتمعى عبر الأجيال. ورغم هذا التفاعل الغنى، فإن التوثيق غير المنتظم، وتداخل الأدوار بين الشعراء والموسيقيين، فضلًا عن التأثيرات السياسية والاجتماعية، جعلت تاريخ الشعر المصرى مُتشعِبًا ومُعقَدًا، ما أضفى عليه طابع اللغز الذى يحتاج دائمًا إلى البحث والتحليل لفهم مساراته المختلفة.
■ أيهما كان له أثر أكبر على مأمون الشناوى: الصحافة أم الشعر؟
- يُعد مأمون الشناوى نموذجًا فريدًا جمع بين الصحافة والشعر، فقد نشأ فى بيئة أدبية ثرية، وتشكل وجدانه الأدبى مُبكرًا بتأثير أشعار جبران والشعراء الرومانسيين. كما أن قصة حبه الملتهبة فى شبابه كانت دافعًا له لممارسة الشعر، فعبّر عن مشاعره بأسلوب شاعرى مرهف، ما جعله واحدًا من أبرز شعراء الأغنية فى عصره.
لكن تجربته الصحفية لم تكن مجرد جانب جانبى فى حياته، بل كانت رافدًا أساسيًا أثرى رؤيته الإبداعية وصقل لغته، وأتاح له احتكاكًا مباشرًا بالمجتمع، ما انعكس على موضوعاته الشعرية وأضفى على كلماته بُعدًا إنسانيًا أعمق. فى بعض الأحيان، زادت الصحافة من تألقه الأدبى، بفضل إطلاعه المستمر وتفاعله مع القضايا المختلفة. لكن فى أحيان أخرى شكلت عبئًا، حين فرضت عليه التزامات مهنية قلّصت من تفرغه التام للإبداع الشعرى.
كما كان لإطلاعه الواسع على الفنون العالمية، خاصة الموسيقى الغربية، أثر كبير فى تطوير أسلوبه، وهو ما يتجلى فى رائعته «الربيع»، التى لحنها وغناها فريد الأطرش، مستلهمًا فيها روح شعراء الطبيعة مثل لامارتين، ومتأثرًا بمعزوفة «الفصول الأربعة» لـ«أنطونيو فيفالدى».
■ اسم الشاعر الغنائى حسن أبوعتمان غير معروف لدى كثيرين.. فماذا تقول عنه؟
- حسن أبوعتمان واحد من «شعراء الظل» الذين أسهموا فى كتابة مجموعة من أشهر الأغانى التى حفرت مكانها فى ذاكرة الأجيال. كان شابًا بسيطًا بدأ حياته فى صناعة الغزل والنسيج، ثم امتهن الحلاقة رغبةً فى التحرر من قيود الوظيفة، قبل أن يقرر النزوح إلى القاهرة بحثًا عن فرصة حقيقية فى عالم الغناء.
لعبت الصدفة دورًا كبيرًا فى دخوله الساحة الفنية، خاصة فى ظل الصراع القائم آنذاك بين عبدالحليم حافظ ومحمد رشدى. كان عبدالحليم يسعى للتواصل مع عبدالرحمن الأبنودى وبليغ حمدى، اللذين شكّلا مع «رشدى» فى بداياته ثلاثيًا ناجحًا. وبحسب رواية «رشدى» و«الأبنودى»، طلب «عبدالحليم» منهما التعاون معه، فكانت فرصة كبيرة دفعتهما للابتعاد عن «رشدى».
فى ظل هذه الظروف، بدأ محمد رشدى البحث عن شاعر وملحن جديدين ليكملا معه المسيرة التى بدأها مع «الأبنودى» و«بليغ»، فكان اللقاء مع حلمى بكر وحسن أبوعتمان، وكان أبرز ثمار هذا التعاون أغنية «عرباوى»، التى لاقت نجاحًا كبيرًا. ولاحقًا، ارتبط اسم «أبوعتمان» بالنجم أحمد عدوية، الذى قدّم معه مجموعة من الأغانى التى شكلت جزءًا من ملامح الثمانينيات، مثل «زحمة يا دنيا زحمة» و«يا ليل يا باشا» و«السح الدح امبو».
ما ميّز حسن أبوعتمان عن غيره هو بساطة كلماته وارتباطها القوى بالشارع، فقد استطاع أن يعبر عن مشاعر الناس بلغة سلسة لكنها عميقة التأثير. كما كان للملحن حلمى بكر دور كبير فى إبراز موهبته، واستطاع بألحانه أن يمنح كلماته طابعًا مميزًا جعلها تظل خالدة فى ذاكرة الجمهور. لم تكن أغانى «أبوعتمان» مجرد نجاحات لحظية، بل مثّلت تحولًا فى شكل الأغنية الشعبية، وأدخلت إيقاعات جديدة وكلمات أقرب إلى لغة الشارع، ما جعلها محبوبة بين مختلف فئات الجمهور.
■ أشرت أيضًا إلى دور لويس جريس فى اكتشاف عبدالرحيم منصور.. فما القصة؟
- بدأ اكتشاف عبدالرحيم منصور على يد الكاتب الكبير لويس جريس، الذى كان يؤمن بأن هناك كنوزًا فنية مُخبأة بعيدًا عن الأضواء، خاصة فى الصعيد، الذى يزخر بتراث شعرى وغنائى فريد، لكنه لم يحظَ بالفرصة الكافية للظهور. خلال جولاته لاكتشاف المواهب، أطلق «جريس» فى مجلة «صباح الخير» سلسلة مقالات بعنوان «المعذبون بالفن»، سلطت الضوء على المبدعين الذين لم يجدوا طريقهم بعد إلى الشهرة. أثناء تلك الجولات، التقى لويس جريس بالشاعر الشاب عبدالرحيم منصور، وأدرك سريعًا أنه أمام موهبة شعرية فريدة، فنشر عنه فى المجلة، ما فتح له أبوابًا جديدة فى عالم الفن.

■ أيهما صنع شهرة الآخر: فرقة «المصريين» أم عصام عبدالله؟
- كان عصام عبدالله حالة إبداعية متفردة، امتلك وعيًا ثقافيًا حادًا وموهبة شعرية متميزة جعلته مختلفًا عن غيره من شعراء الأغنية فى جيله. تميز بأسلوبه الذى مزج بين التعبير البسيط والفكرة العميقة، مع لمسات فلسفية وشاعرية حداثية، ما منح كلماته تأثيرًا يتجاوز الزمن. كتب «عبدالله» العديد من الأعمال التى لا تزال محفورة فى ذاكرة الغناء المصرى، مثل «لو بطلنا نحلم نموت» و«الصوت واللون والحرية» لـ«محمد منير»، و«فى قلب الليل» لـ«على الحجار»، و«وحدانية» لـ«أنغام»، و«يا بوى يا مصر» لـ«محمد الحلو».
جمعته الظروف والتوجه الفنى المشترك بفرقة «المصريين»، وكلاهما كان يغرد خارج السرب، فى فترة هيمن فيها «الكاسيت» التجارى على صناعة الموسيقى. لم يكن التعاون بينهما مجرد صدفة، بل نتيجة رؤية متقاربة بين شاعر يسعى لكسر القوالب التقليدية، وموسيقى عبقرى مثل هانى شنودة يبحث عن أصوات جديدة تعبر عن روح العصر.
لا يمكن القول إن أحدهما صنع شهرة الآخر منفردًا، بل كان كل منهما سببًا فى إثراء الآخر. موهبة عصام عبدالله أضافت للفرقة عمقًا فكريًا وشعريًا جعلها مميزة بين الفرق الموسيقية، فى حين أن «المصريين» وهانى شنودة وفّرا له منصة فنية تُبرز كلماته للجمهور. هذا التكامل هو ما جعل أعمالهم خالدة ومستمرة النجاح حتى اليوم.
■ ما المصادر التى استعنت بها فى توثيق سير أبطال الكتاب؟
- اعتمدت على منهج علمى يمزج بين تحليل البيانات الرقمية الكبرى والمنهج الوصفى التحليلى، لضمان دقة المعلومات وعمق الفهم. استندت إلى مصادر مباشرة، مثل المقابلات الشخصية والشهادات الحية من «الأسطوات» أنفسهم، أو من أفراد عاصروهم، سواء كانوا أصدقاء أو زملاء أو حتى منافسين، فضلًا عن اللجوء إلى مصادر غير مباشرة، شملت حوارات صحفية ولقاءات إذاعية وبرامج تليفزيونية ومذكرات وأرشيفات موسيقية وأدبية، علاوة على التحليل الزمنى، عبر ربط إبداعاتهم بسياقاتها السياسية والاجتماعية.
■ العشرات من الأغانى القديمة لا تزال حاضرة فى الأذهان.. ما تفسيرك لذلك؟
- أسهمت المنصات الرقمية وثقافة الاستهلاك السريع فى تحويل الأغانى إلى منتجات آنية قصيرة العمر، بعدما أصبح التركيز على الانتشار الفورى وعدد المشاهدات ومرات الاستماع أكثر من التركيز على جودة المحتوى وقيمته الفنية.
فى الماضى، كانت الأغانى تُنتج بعناية شديدة، ويمر العمل الفنى بمراحل دقيقة من الكتابة والتلحين والتوزيع والتسجيل، ما يضمن خروج منتج موسيقى متكامل يحمل بصمة فنية واضحة. أما اليوم، فإن سرعة الإنتاج وضغط السوق الرقمية يجعلان الأعمال الفنية تُطرح بوتيرة متسارعة، ما يقلل من فرص نضوجها. كما أن اعتماد الأغانى الحديثة على الصيحات اللحظية والإيقاعات المتكررة يجعلها تفقد تفردها بسرعة، لتظهر أغنية جديدة تحل محلها فى وقت قصير.
