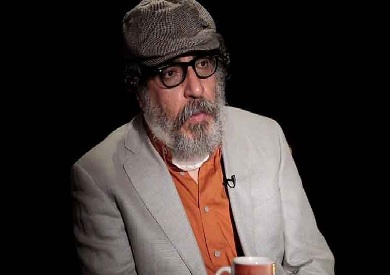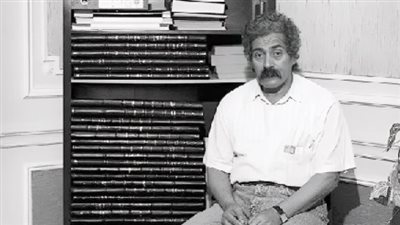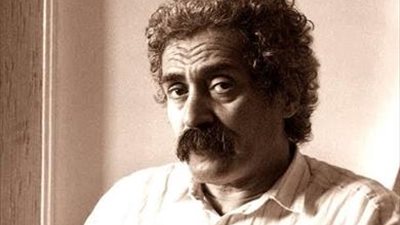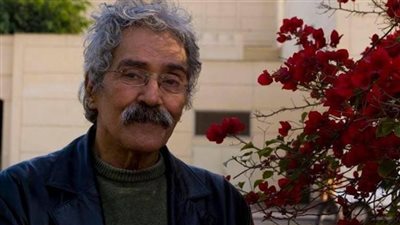مراجعة بالعقل.. نقد التنوير بسلاحه الحاسم
فولتير.. الأب الروحى لنجوم العلاقات العامة ومرتزقة السياسة والثقافة والدين

- نظرتنا لموضوع التنوير مجتزأة وضيقة ونشبه من ينظرون إلى الفن باعتباره سما المصرى
- فولتير لم يقرا أى مؤلفات مهمة تشرح له حقيقة الإسلام لكنه تجاسر وقدم عملًا أدبيًا وفنيًا كان يعتبره «درة إبداعه»
تحدثنا فى مقالين سابقين عن خلطة عجيبة من البرتقال والقشر، الطين والقمح، المدنس والمقدس، المستقيم والدائرة، المثقف والملك، الكنيسة والمقهى، الاستبداد والتنوير..
هل من غاية تمهد لها البداية؟
هل من محطة وصول لهذا الطريق الغامض المثير؟ الذى اتفقنا فى المقال السابق أن اسمه «الحياة»؟
بالمناسبة، أحفظ بيت شعر للمقاوم الفرنسى «رينيه شار» ترجمته العربية: «الهدف الحقيقى هو الطريق، وليس ما يؤدى إليه»، مثل ذلك قال باتريك ليفى فى «النساك»، وفى الطريق ذاته سأل محمود درويش حائرًا وقلقًا كعادته: «أين يُمتَحن الصواب؟ هل فى الطريق، أم الوصول إلى نهايات الطريق المفرحة؟
إذن، فلنمض «كما قال رامبو».
بدأت الرحلة بوصية كتبها إبراهيم أصلان فى بداية روايته «مالك الحزين» منسوبة للفرنسى «بول فاليرى»، المفاجأة أن فاليرى لم يقل تلك الوصية أبدًا، لكن كل المثقفين صدقوا ما لم يُقل، ورددوه مقتنعين أنه «الحقيقة»!
مثل هذه الحوادث الفاضحة لكذب الحقيقة، تفتح فى رأسى «هويس التداعى» لنماذج شبيهة، منها قول فولتير: «إننى أختلف مع ما تقول، لكننى على استعداد للتضحية بحياتى دفاعًا عن حقك فى أن تقول رأيك».
فولتير أيضًا لم يقل هذا أبدًا، خاصة فى هذه الواقعة التى سجلتها بإسهاب كاتبة إنجليزية باسم مستعار بعد وفاة فولتير بسنوات، وقد صاغت العبارة بأسلوبها، لكن معظم العالم ظل يردد القول منسوبًا لفولتير، وإذا سألت هؤلاء وبينهم مثقفون كبار يبدأون حديثهم عادة بتعبير «فى الحقيقة...» إذا سألتهم عن فكرة لفولتير، أو كتاب مؤثر فى تحقيق ثورة التنوير الأوروبى، ربما لا تسعفهم الذاكرة بتقديم إجابة شافية، ويظل الحديث يدور حول معنى عام عن «حرية الرأى» و«هجوم الشجاع ضد الكنيسة ورجال الدين»، ومعارك القدح والمدح للملوك والزملاء البارزين من علماء ومثقفى التنوير، وربما يذكر بعضهم رواية «كانديد» التى كتبها فولتير فى نهاية حياته، كانقلاب ساخر على أفكار سابقة تتصل بالتفاؤل كما قدمه الفيلسوف الألمانى المؤثر حينذاك «جوتفريد لايبنتس»، وإذا كان المثقف المسئول متعمقًا ومنتميًا بشوفينية للهوية العربية والإسلامية، فإنه سيذكر مسرحية «محمد» المثيرة للجدل فى تناولها سيرة نبى الإسلام، والطريف أن فولتير كتب الاسم خطأ فى النطق والتهجئة، حيث يُقرأ «ماهوميت» وليس «موهامد»، المؤكد أن ذلك بسبب ثقافة فولتير السمعية عن الإسلام، وكذلك تأثره بالنطق التركى للاسم، حيث تنقلب «الدال» إلى «تاء»!
المؤسف أن فولتير لم يقرا أى مؤلفات مهمة تشرح له حقيقة الإسلام»، لكنه تجاسر وقدم عملًا أدبيًا وفنيًا، كان يعتبره «درة إبداعه»، ويبذل كل الجهود والوساطات لعرض العمل فى المسارح والقصور، متأرجحًا بين تفسيرين متناقضين، مرة يقدم عمله كهجوم راديكالى على وحشية الدين الإسلامى، ومرة ينفى علاقة المسرحية بالإسلام، ويقول إن هدفها النيل من استبداد الكنيسة بشكل رمزى من خلال «دين آخر»!
أتذكر تعريفًا شائعًا للدبلوماسى يصفه بأنه «ذلك الشخص الذى يتكلم كثيرًا ولا يقول شيئًا»، وظنى أن التعريف ينطبق على فولتير أكثر، فقد حاولت أن أقرأ له كثيرًا للإمساك بقضية عميقة كفيلسوف مثل «ديكارت» أو كتربوى مثل «روسو» أو كرجل قانون مثل «مونتسكيو»، أو كروائى وشاعر ومسرحى مثل كثيرين من معاصريه، لكننى بالكاد توقفت عند «كانديد» بسبب دراسة متعمقة استغرقتنى عن فترة حكم سالازار للبرتغال ووقائع زلزال لشبونة الشهير الذى ورد فى الرواية، خلاف ذلك استهلكتنى نميمة فولتير، ولوثة العلاقات العامة التى كان يمارسها من خلال الرسائل الخاصة، ولها نصيب الأسد فيما تركه من كتابات منشورة!
المفارقة المضحكة فى كل ذلك قفزت إلى رأسى، وأنا أطالع نص محاضرة ألقاها فى جامعة إكسفورد «د. روبرت دارنتون» احتفالًا بصدور طبعة الأعمال الكاملة لفولتير بعد قرابة القرن من جهد التجميع والفهرسة والتصنيف، دارنتون أكاديمى أمريكى وأمين مكتبة «الكتاب التاريخى»، قد اختار عنوانًا يلخص ما أرغب فى توضيحه: «كتابات فولتير التى لا حصر لها.. نهايات وبدايات متجددة»، وقد أوضح فى متن محاضرته أن هناك أكثر من ٢٠٠ مجلد يتضمن ١٥ مليون كلمة (وهو ما يعادل ٢٠ كتابًا مقدسًا حسب رأى أحد النقاد اللاذعين).
ورغم كل هذا «الهبد العظيم»، لا يكاد يتذكر مثقفو التنوير الفطاحل من فولتير إلا عبارة مختلقة لم يقلها، وأتذكر أن صحيفة دولية كبرى اختارت العبارة منسوبة إلى فولتير على رأس صفحات الرأى، وفوق رأى كُتّاب المقالات من رتبة «أ.د»!
لا بأس من المفارقة، فهذا مما دربتنا عليه الحياة..
أمر طبيعى فى خصال الرحلة، أن تسافر وتغيب وتفعل الكثير وعندما يسـألك أحدهم: إيه اللى حصل فى سفرك؟
فترد ببساطة: ولا حاجة.
أو تستأذن من صديقك دقيقة تعبر فيها الرصيف إلى الكشك المقابل لتشترى سجائر، وعندما تعود وعلى وجهك ابتسامة، ويسألك: إيه اللى حصل؟، فتبدأ فى سرد حكاية طويلة كأنها «أوديسا الرصيف»!
«الحكاية» إذن لها قوانينها وشروطها، والخلاصة أن ما تبقى من فولتير يخضع فى مرة لمقولة «ولا حاجة» أو نكتة «عيل تايه وأهله لاقوه»، ومرة أخرى يحتاج المتلقى لابتلاع ١٥ مليون كلمة ليقتنع بما قالته «ايفيلين هال» نيابة عن فولتير أن حرية الرأى ضرورة ثقافية وسياسية، أو تقتنع بما نسب خطأ لمثقف آخر من أن «الدين أفيون الشعوب»، والعبارة اجتزاء لنص طويل كتبه ماركس فى مقدمة كتاب فلسفى عن نقد أفكار هيجل!
أكاد أرى فى واقعنا المصرى والعربى مستنسخات مزيفة وركيكة لفولتير، تدشن المقالات وتصدر الروايات وتتحدث فى الإذاعات وتكتب الأفلام لتقول نفس الكلام، مع ارتكاب نفس التناقضات التى ارتكبها فولتير: الدين أصل البلايا، والحرية أن تشنق آخر قس بأمعاء آخر مستبد، مع أن القائل يعيش مدجنًا فى بلاط المستبد ويحرص سعيدًا ومتلهفًا على تهنئة البابا فى حفل الكنيسة!
هل تستخدم فولتير كذريعة للهجوم على آخرين، كما فعل فولتير نفسه فى مسرحية «ماهوميت»؟
أم أنك ترتدى أقنعة تاريخية، بينما تناور لشن هجوم غير مباشر على التنوير؟
أحب الزملاء الذين يفكرون بالنوايا السيئة، أعتبرهم ديكارتيين أذكياء، لا يصدقون كل ما يسمعون حتى تأتيهم البينة، لهذا لن أخفى نيتى فى الهجوم، بل أوضح أننى لا أناور من أجل التمهيد لمعركة، أنا فى المعركة فعلًا، وأخوضها بوجهى قاصدًا إسقاط أقنعة التنوير عن العقول المعتمة، والمهزلة التى وجب أن نتعامل معها بجدية أن «فولتير» كان واحدًا من هؤلاء الذين ارتدوا قناع التنوير، وهو يمارس الفحشاء فى المجال العام، يهاجم الاستبداد ويغازل المستبدين، يدعو للحرية كأنها حريته الخاصة وليست حرية الجميع، وهو ما ظهر فى معاركه «النفسية» مع مثقفى عصره، وتهجمه على كثيرين منهم فى مقدمتهم جان جاك روسو «المخرب الكافر» وموبيرتوى «المخرف التافه»!

من هذه النقطة اكتسبت صفة «الطين» قيمتها التى تساءلت عنها فى المقال السابق: هل الطين مقدس أم مدنس؟
خلطة عجيبة تحتوى على كل شىء، لكنها ياللسحر تنبض بالحياة وقادرة على خلق الجديد المشتهى، مثقف شجاع يكذب ويغش ويزيف الحقائق، يواجه الاستبداد ويتربح منه، ينام مع ابنة أخته كما ينام فى بلاط الملوك، يسخر من العلماء لحسابات الوجاهة ومعادلات الاقتراب من العروش، يهاجم الكنيسة لصالح القصر، ثم يهاجم صاحب هذا القصر للتزلف إلى صاحب قصر آخر، ينادى بالحرية ويُسخّر الخدم والعبيد، يرتزق بكلمته فيبيع لقيصر روسيا ما رفضه ملك بروسيا، يهرب من فريدريك العظيم إلى بطرس الأكبر، والعبرة ليست بالثبات على المبدأ، لكن كما قال زميل ظريف «بالحفاظ على المبلغ».
الرحلة إذن، وكنت قد أسميتها «طينة التنوير»، تستحق أن تروى على مهل بكثير من التفصيل، لأن التفاصيل أقرب للحقيقة من الشعارات السطحية الرائجة، فتعالوا ندخل معًا عالم التفاصيل:
موسم بوتسدام
عندما تولى الأمير فريدريك عرش روسيا خلفًا لوالده بعد تعقيدات درامية، خاض معارك الدم على جبهات الحروب، وهو يعزف «الفلوت» ويحلم بتخليد اسمه كشاعر ومؤرخ وفنان، ومن أجل هذه الرغبة فكر فى «موسم بوتسدام» لاجتذاب الشعراء والعلماء والفنانين المشهورين من فرنسا وإيطاليا إلى بلاده، فقد تربى على الثقافة الفرنسية وانتمى إليها، وفى هذا الطريق تعرف على ماركيز فرنسى هارب من عائلته يدعى «جان بابتيست دى بوير» المشهور بلقب «ماركيز دارجينز»، وهو من أبناء الطبقة الأرستقراطية، عمل بالقانون والجيش لفترة قبل أن يهرب مع ممثلة إلى إسبانيا، وأعادته عائلته تحت حراسة عسكرية، ودخل بيت الطاعة العائلى حتى شارك فى محاكمة «كاترين كاديير» عام ١٧٣١، التى أثرت فى تفكيره بشدة، فهجر مهنة المحاماة، وأعلن عداءه للكنيسة، وكتب رواية اكتسبت شهرة واسعة بعنوان «الفيلسوفة تيريز»، من وحى قضية كاديير التى قيل إنها راهبة تتلبسها أرواح شريرة، وخضعت للعلاج بمعرفة القس جان جيرار، لكنه أغواها جنسيًا، وشغلت المحاكمة فرنسا كلها، وبعد الحكم بإعدامها نالت «كاديير» البراءة وسط احتفالات شعبية، وقد عالج ماركيز دارجينز القضية بأسلوب إباحى فى روايته وطبعها باسم مستعار فى هولندا، التى كانت حينذاك قبلة للكُتاب المتمردين، لأنها لا تخضع لقوانين الرقابة على المطبوعات التى تتشدد فيها فرنسا، وبسبب شهرته فى الكتابة دعاه الملك فريدريك لزيارة بروسيا وعرض عليه العمل فى البلاط كحاجب خاص، ثم ألحقه بأكاديمية برلين التى أسسها كمنارة جامعة للعلم والأدب.
كان دارجينز قد اكتسب شهرة فى الكتابة وارتبط بالوسط الصاخب من الأدباء والفنانين الفرنسيين الذين يتمتعون برعاية «سيدة بومبادور» عشيقة ملك فرنسا، كانت الملكة غير المتوجة تقيم صالونًا يضم معظم النخبة، وفى الصالون تعرف دارجينز على فولتير ونشأت بينهما صداقة امتدت العمر كله، كان العامل المشترك بين «زملاء صالون العشيقة» هو المجاهرة بازدراء العقائد والأعراف السائدة، والكتابة الإثارية والصدامية والفضائحية، تلك كانت «طبخة عصر التنوير»، وكانت الفكرة شائعة فلسفيًا عن ضرورة الهدم لكى يحدث البناء، وهى فكرة صحيحة بحسابات فكرية وعلمية دقيقة، كما أنها فكرة مدمرة فى حالة استخدامها لأغراض خبيثة ومزدوجة، وبعد أن اكتسب ثقة وإعجاب الملك بسبب مرحه، ونميمته المسلية وامتلاكه لمخزون هائل من العلاقات الشخصية والفضائح السرية، تحول «ماركيز دارجينز» إلى وكيل الملك المنوط به إغراء الفنانين والشعراء الفرنسيين، واجتذابهم إلى بروسيا، وكان فولتير هو «السمكة الكبيرة» التى أوصى بها فريدريك واصطادها الماركيز المرح.
كانت المرحلة التى سميت بعصر التنوير طويلة زمنيًا، ومتسعة جغرافيًا ومتنوعة من حيث الاهتمامات ومجالات الحياة، ولم يكن الأدب والشعر والمسرح والفنون هم الأساس، كانت الثورة العلمية تواصل تقدمها فى اضطراد ملحوظ وتأثير كبير فى تحديث شكل الحياة ومفاهيمها وأدواتها، وكانت الفنون والأفكار الفلسفية عالية الصوت وشائعة بين الناس، والنافع منها يفسح الطريق للمنجز العلمى الذى عرف طريقه إلى السياسة العامة مع «ثورة نيوتن» فى السنوات التى سبقت ميلاد فولتير، وكان «مشروع التحديث» و«التمرد على الكنيسة» ونقد الاستبداد الملكى، يتفاعل فى القصور وأوساط الطبقة الأرستقراطية، ولم يكن الغرض منه القضاء على الملكية، بل تخفيف انفرادها بالحكم، وتوسيع مساحة العمل واتخاذ القرار «دعه يعمل..»، «ماجنا كارتا»، «عقد اجتماعى»..
هذا يعنى أن نظرتنا لموضوع التنوير مجتزأة وضيقة، ونشبه من ينظرون إلى الفن باعتباره سما المصرى، أو الدين باعتباره عبدالله رشدى، أو الإعلام باعتباره توفيق عكاشة، أو التنوير باعتباره إسلام البحيرى وإبراهيم عيسى..
القصة مختلفة والبحر واسع والأسماك متنوعة بشدة، منها النافع ومنها السام والقاتل، والعبرة بالعقل وليس بالانبهار والتقليد الجاهل، وبالتالى فإن نقد حالة ثقافية مثل فولتير لا تعنى الانتقاص من التقدم الأوروبى على جبهات كثيرة، لكن الإنصاف يقتضى أن نسأل عن أسباب نشوب أكبر حربين عالميتين بعد إنجاز أوروبا لمهمة التنوير وإعمال العقل، ويبقى أن نحاكم فولتير وأمثاله على مصداقية دعوتهم للحرية الإنسانية وحقوق الإنسان، فى الوقت الذى ذهبت فيه أوروبا إلى أوسع حملات استعمار ونهب لشعوب العالم، مع ارتكاب جرائم إبادة يعترفون بها الآن فى ألمانيا وهولندا وانجلترا وفرنسا، وحتى بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، هذا إلى جانب ظهور تيارات العدمية والعبث والسريالية والفوضوية، بعدما تصورنا أن العقل انتصر والتفكير العلمى القانونى الإنسانى سيد القرار فى حياة الناس!
ولكى نقترب أكثر من الفهم الصحيح للتنوير كما حدث، وللتنوير كما وصلنا وفهمناها بالخطأ، نحكى فى المقال المقبل عن الجانب المؤسف من سيرة فولتير فى البلاط البروسى.. ذئب مال.. متآمر.. فضائحى.. مزور.. حقود.. انقلابى.. متنمر بجهل على العلم والعلماء، لكنه لا ينسى وهو يرتكب كل هذه الآثام، أن يمسك منديله بإصبعين ويضعه بتصنع على طرف أنفه ويقول: يا ولد هات العطر..
فى المقال المقبل، نكمل الخوض فى «طينة التنوير»