نـزار شقرون: منهج التحريم عطّل العقل العربى عن الإبداع

- رسّامونا عانوا طويلًا من «مصير جهنم» الذى لوّح به رجال الدين
- شعوبنا لا تنظر إلى الجسد باعتباره شكلًا بل تنظر إليه باعتباره «هوسًا جنسيًا»
- التاريخ المسيحى شهد حربًا طاحنة من أجل تجريم «الأيقونات»
- أخشى أن تتحول آلام الفلسطينيين لطقس نتابعه كحلقات مسلسل تليفزيونى
يمتلك الكاتب التونسى نزار شقرون ما يمكن وصفه بالرؤية البصرية الجمالية، فهو يقيّم الأشياء من منظور الصورة بكل ما تمتلكه من مفردات وعناصر فنية سواء كانت هذه الصورة فوتوغرافية أو تشكيلية أو سينمائية.
ويرى «شقرون» أن العقل العربى أصيب بما يمكن وصفه بـ«فوبيا التحريم» التى حرمته من أن يرى الصورة بشكل جمالى، أو أن يقيم الأشياء بطريقة فنية، معتبرًا أن الفقهاء على مدار التاريخ حاصروا ذلك العقل بالأحكام التى منعته من تذوق الفنون وإنتاج المعرفة المختلفة.
كما يرى الكاتب التونسى الذى أصدر كتاب «معاداة الصورة»، أن الجوائز الأدبية تسببت فى أزمات عديدة، وأنتجت ما وصفه بـ«الكتابة وفق كراسة الشروط»، لكنه لا ينفى أن هناك مسابقات انتصرت للتجارب الجادة.
عن أزمات العقل العربى ورؤيته لفكرة الصورة وإشكاليات الكتابة الأدبية، أجرت «حرف» مع نزار شقرون الحوار التالى.

■ فى كتابك «معاداة الصورة» تذهب إلى أن الصورة أصبحت تتحكم فى حياتنا بدلًا من إخضاعها لإرادتنا.. هلّا وضحت لنا الأمر.. وهل يقع فى نطاق هذا التصور هوس ما يعرف بـ«السيلفى»؟
- تغلغلت الصورة فى جميع جوانب حياتنا حتى أصبحت تتحكم فى صياغة جزء كبير من هويتنا، وحين نتحدث عن «الصورة» فلا يعنى ذلك أنّنا نقيمُ فى عصرها بالمعنى العميق للكلمة، نحن محاطون بها أو تحت هيمتنها دون أن نتمكن من السيطرة عليها أو التفاعل معها بشكل دقيق، أتحدث هنا عنّا «نحن» أبناء الحضارة العربيّة الذين حملوا فى ذواتهم الثقافية عبء «الكلمة» و«نكران» الصورة. إننّا اليوم نتواصل بالصور لا محالة، مجرد إرسال تهنئة بالعيد أو حتى تحية من صديق إلى صديق عبر «الماسنجر» غالبًا ما يتم بتحويل صورة وليسَ بالكتابة، حيث توافق هذا الفعل مع حالة «التكاسل» العربى. لاشكّ أنّ «الصورة» وسيط ولكنّنا سريعًا ما وثّناه وجعلناه محدّدًا لإدراكنا للعالم وللعلاقات فيما بيننا. والأخطر من ذلك أنّنا لسنا منتجين للصورة، وبالتالى نحن خارج دائرة إنتاج المعرفة التى تتم حاليًا عبرها. لقد انسقنا إلى استهلاك «الصور» تبعًا لانسياقنا لثقافة الغالب، وفى داخلنا عداء مبطن لـ«الصورة». قد تنهمك الأجيال العربية الجديدة فى الاحتفاء بالصور، إذ خلق استخدامها «الجوّال» حالة من إدراك جديد للعالم، قد يكون إدراكًا سطحيًا لغياب الوعى بثقافة الصورة ودورها وأخطارها ومدى قدرة صنّاعها على التحكم فى مصائر مجتمعات. إنّ العالم يتغيّر وإدراكنا له يتغيّر لا محالة، ولكنّه اليوم يُختصر فى شاشة صغيرة، وتحتكم فيه الذات فى تحديد سقف انتظارها ومدى تواصلها معه إلى نسبة تحكمها فى «إنتاج الصورة» عنها تخصيصًا. من هنا يأتى فعل «السيلفى» ليكون موازيًا لسؤال الوجود، هكذا أصبح يُقال «أنا أتسلفى إذن أنا موجود»! يعنى اختزال الوجود فى مدى القدرة على إظهار «الصورة الذاتية» أو «البورتريه الشخصى» فى العلاقة بالذات وبالآخر.
تنساق الأجيال العربية الآن مثل غيرها فى بلاد العالم الرحب إلى استهلاك رهيب للصورة، إلى درجة «الهوس» بل قد يكون ذلك مسلكًا نحو «عبادة» جديدة لها طقوسها وتعاليمها.
■ كيف ولماذا هيمنت الصورة على عصرنا الراهن؟
- كلُّ ما فى حياتنا أصبح يمرر بالصور، أبسط الأشياء أننا نستهلك المأكل والمشرب والملبس من خلال الصور، الاقتصاديّات فى العالم قائمة على «الصورة» حيثُ يكون التسويق بها وعبرها، ويكون التحكم فى أنماط العيش يسيرًا بفضل الصور الإشهاريّة مثلًا بتنوع محاملها، والتحكم فى أنماط التفكير أيضًا يستخدم الصور، الإعلام البصرى يوجّه وعى الرأى العام، يُقولب الحقيقة، طبعًا ذلك له شواهد عديدة عن التحكم فى العقل البشرى بواسطة تضخيم صورة لواقعة بسيطة أو لحدثٍ عابرٍ.
قد تقع الأحداث فعلًا ولكن تقديمها يكون مختلًفا للحقيقة، إنّه قائم على الخلفية الأيديولجية لمن يمتلك وسيلة الإعلام، ولمن يمتلك قدرة على صناعة الصورة.
إنّنا اليوم نتابع ما يجرى فى غزّة وكأنّه شريط درامى، نتفاعل مع القضيّة الفلسطينيّة وآلام الفلسطينيين، ولكن الخشية الكبرى أن يتحوّل هذا التفاعل إلى «طقس» لمتابعة حلقات لمسلسل تليفزيونى لا أكثر! إنّ طريقة مقاربة الحدث الواقعى من خلال «الصورة» قد تخلق مسارًا منحرفًا لوعى الأجيال بهذه القضيّة مثلما استطاعت الصور أن تحرّك الضمير العالمى للشباب والطلاب حول العالم كى يتحرّك لنصرة الفلسطينيين.
منذ زمن غير بعيد استطاعت «لوحة الجورنيكا» لبيكاسو أن تصنع «موقفًا» إنسانيًا لدى الرأى العام الغربى تجاه الظلم والاستبداد، نحن للأسف الشديد فى مجتمعنا العربى وعلى الرغم من وجود عشرات «المجازر» والأحداث القاسية، لم نستطع «ابتكار» صورة رمزيّة لكل هذا الدم والألم الذى سال.
من سنوات طبعًا سيطرة الصورة على الأجيال همّشت القراءة والكتابة، كثيرون يعتبرون «الصورة» أيسر فى الاستخدام والتواصل، لماذا نقرأ فى عالم تحكمه الصورة؟ ولماذا نكتب بينما تفيد لقطة ما أكثر مما يصنعه كتاب أحيانًا؟ هكذا يفكّر العرب «الجُدد»، وهم بين براثن شىء لا يعرفون مدى خطورته، ها هى الأجيال تستسلم لـ«الصورة» وتنقاد لها دون وعى بكيفية التعامل معها، نحن على حافة «التواكل الحضارى» فمجرّد حيازة جوّال من أى نوعٍ وامتلاك الحد الأدنى من معرفة استخدام التطبيقات يجعل الإنسان العربى فى غاية السعادة لأنّه تجاوز عجز القراءة والكتابة، بوهم امتلاك «الذات» دون عناء القراءة. هكذا نتمادى فى «الجهل» و«التخلف» بوهم امتلاك لغة العصر.

■ هل يجوز أن نقيم الصورة بمقوّمات النص المكتوب؟
- غالبًا ما تستعير قراءة الصّورة أدواتها من قراءة الخطاب المكتوب، دون أن ننفى وجود تمايز بين الخطابين. إنّنا نحتكم فى قراءتنا للصورة لما نمتلكه من رصيد أدبى، حتى أنّ النقد الفنى ولد فى رحم النقد الأدبى، ولم يكن النقاد فى أول الأمر غير شعراء وأدباء وجدوا فى أدوات نقد الأدب ما به يقرأون اللوحة ثم مختلف أشكال الصور. طبعًا حين تتم استعارة الأدوات الأدبيّة فإننا لا نقوم بإسقاطها تمامًا على الخطاب البصرى الذى له مقوماته ومصطلحاته أيضًا، ولكنّ قرابة متينة خُلقت بين الخطابين منذ القديم، لذلك كثيرًا ما نقول إنّ الشعر هو توأم التصوير.
■ ما الذى يجمع الصورة بالفن السردى والشعرى؟
- هناك حتمًا نقاط التقاء مثلما توجد نقاط افتراق أساسية بين السرد والشعر، إنّنا نتحدّث فى هذا الجانب عن وضعيّة «أجناسية» فى مرحلة تتداخل فيها الأجناس، فمع ثورة قصيدة النثر مثلًا، لم يعد التمييز الكلاسيكى بين «شعر» و«سرد» مطروحًا، هناك خلخلة للجنس الأدبى الواحد، فى الشّعر يسكن السّرد لا محالة، هذا منذ القصيدة الكلاسيكيّة وليس أمرًا طارئًا.
■ عبر مراحل تاريخنا العربى الإسلامى هناك معاداة واضحة للصورة.. ما أسباب هذا العداء وما هى تجلياته؟
- لنكن واعين بأنّ «التحريم» طال الصورة خشية تحوّلها إلى «عبادة»، وإن كانت ظروف عملية التحريم الفقهى مسايرة لفترة مبكّرة من ظهور الإسلام فإنّ تواصل نهج التحريم كانَ معطّلا لقدرات الإنسان العربى والمسلم على الإبداع. ما «حرّم» هو الصورة فى معناها وشكلها التشخيصى، وما أبيح هو كلّ شكل تجريدى، لذلك سُمح للخط العربى بأن ينتشر مثلما انتشرت الزخرفة وفنون العمارة. وكم أثيرت مسألة تحريم الصورة فى تاريخنا العربى بمثل ما أثيرت فى التاريخ المسيحى الذى شهد بدوره حربًا طاحنة حول «الأيقونات». لا محالة «التفكير الدينى» أرهق إبداعيّة التصوير، وفى تاريخنا الثقافى حاول بعض الرسامين ملاعبة «التصور الفقهى» بالابتعاد عن «التشبيه» وبجعل الصورة مجرد «حلية» و«تزويق» لا أكثر أى ليست عنصرًا مستقلًا يمكن أن يشكّل للمشاهد إدراكًا مخصوصًا، ولنا فى منمنمات الواسطى خير مثال على ذلك. لقد عانى الرسامون طويلًا، بسبب خوفهم من مصير «جهنم» الذى لوّح به الفقهاء. النص القرآنى لا يشير البتة إلى ذلك المصير. وصفوة القول إنّ الفقهاء اعتقلوا «العين» العربيّة حتى لا ترى ولا تدرك العالم من خلال حاسة البصر. وظلّت العين معطوبة لقرونٍ، وإلى الآن لا تزالُ فى حدود استخدام أدنى ممكناتها الإدراكيّة بسبب العطالة والإقصاء على مرّ القرون. ذلك العطب تسبّب فى تقليص مفهوم الجمال، إنّنا اليوم لا ننظر إلى الجسد مثلًا باعتباره شكلًا بقدر ما ننظر إليه باعتباره هوسًا للجنس، إدراكنا له لا يكون بالعين التى تتغذّى من الثقافة بل بالعين التى دُفنت فى وادى الغريزة. حين نريد أن نبنى فلسفة الجمال علينا أن نفكّر فى تحرير العين أولًا لأن فلسفة الجمال لدى العرب لا تزالُ تحت سيطرة العقل الفقهى.

■ بطلا روايتك «زول الله» ينتميان لجماعة سرية تمثل امتدادًا لجماعة «إخوان الصفا».. هل بحثهما عن المعنى الضائع يمثل بحثًا عن جوهر الفن فى عالمنا العربى؟
- هما فعلًا ينتميان إلى شبكة سرية، منذ القديم لا يُمكن للكائن المتسائل والمختلف إلاّ أن يكون منتميًا إلى «جماعة» مجرّدة، تنتمى إلى بعضها بروابط عميقة دون أن تحتاج إلى مسميات لذلك وقعت الحيرة إلى الآن فى تحديد أعضاء جماعة إخوان الصّفا، كان بإمكان أعضائها الإعلان عن أنفسهم فى مقدّمات الرسائل لكنهم لم يفعلوا ذلك ليس خوفًا من بطش السّلطة وإنّما لأنّ أصحاب المعارف لا يحتاجون إلى تسمية، إنّهم فى مدار «اللا مسمى» ما دامت أفكارهم هى الأهم من أسمائهم.
■ لماذا طالبت بإجراء مراجعات فكرية للتاريخ العربى الإسلامى؟
- هذا مطلب قديم متجدّد، فى كلّ عصر سيأتى كتّاب ليطالبوا بمراجعات للماضى، وينبغى زعزعة البداهات، وهى عملية يقوم بها الكاتب مع نفسه قبل أن يتوجّه بها إلى تاريخ ثقافته. نحن أسرى للمدونات السابقة، نتعامل معها بقدسيّة كبيرة، نخشى من التغيير ونعتقل الأفهام هناك فى ذلك الماضى. نسلّم مصيرنا الفكرى للنصوص السابقة ولا نرى فيها نتاج تجارب لأصحابها لهم مواضعاتهم التاريخيّة وإكراهاتهم. إذا أردنا أن نعود إلى الفعل الحضارى فعلينا أن نتعامل مع تلك النصوص باعتبارها التعبير المناسب لعصرها، وليست متعالية عنه.
نحن بدورنا نكتب فى سياق تجريبى لأنّنا نؤمن بأنّ الكتابة لا تتنصّل من التاريخ حتّى وإن تلبّست بمُثل عليا تخترق التاريخ نفسه.
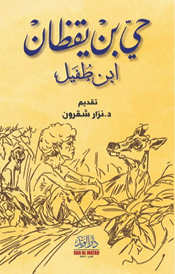
■ أشرت إلى أن البعض صار يكتب وفق شروط الجوائز.. هل أضرت هذه الجوائز بالمشهد الروائى؟
- نعم تجرأت على قول ذلك فى سياق شيوع «الكتابة وفق كرّاس الشروط»، قلّة من الكتاب الذين استطاعوا الاستجابة لمشاريعهم دون أن يخونوها، فما هو منتظر دائمًا أن يوجّه الكاتب ذائقة الرأى العام، وأن يظلّ طلائعيًا، و«رافضًا»، هذا يُذكرنى بدرس بسيط قام به الانطباعيون حين رفضت لجنة المعرض أعمالهم لأنّها لا تستجيب لذائقتها ومعاييرها، لم يتحقّق للفن أى منعطف دونَ هذا الخروج عن الذائقة التى قد تشكّلها الجوائز أيضًا، وكم مرّة قلت إنّ هناك روايات استشراقيّة يكتبها العرب لإشباع المتقبّل الغربى الذى لا يزال يرى الشرق غرائبيًا. وهذا لا ينفى أنّ بعض الجوائز ساهمت فى نصرة مشاريع بعض الكتاب الطلائعيين، ولكنّ ذلك نادر.
■ لمن قرأت من الكتّاب المصريين؟
- هناك كتّاب من الصعب أن يعبروا فى حياة الكاتب بشكل طارئ، بعضهم لا شك لا تزال آثاره فى موضع الحوار المتجدّد. هناك «عشرة» مع تجارب بعض الكتاب لا تُمحى، تتواصل عبر الزمن، لأنّنى أعيد فحص ما كتبوا، لا يمكننى أن أنكر حوارى مع تجارب عديدة مثل جمال الغيطانى وإدوار الخرّاط، ومحمد البساطى وغيرهم فى الأدب، أو أمل دنقل وعبدالمعطى حجازى فى الشّعر، ونصر حامد أبوزيد وحسن حنفى فى مقارباتهما للفكر الدينى، وقد أفاجئك بالقول إنّنى ما زلت أعود لقراءة طه حسين، كثيرًا ما أشعر بأنّه «مجهول» إلى الآن! لذلك عدت إلى مساءلة تصوّراته بشأن الغزل العربى فى مقدمتى لكتابى «اليوم الأخير».





