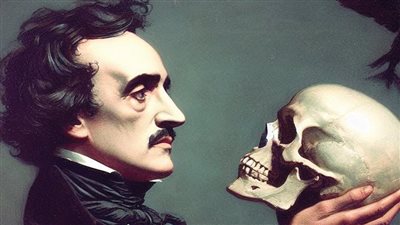القيمة الأعلى.. أزمنة الشعر وإن كره النقاد والناشرون والدكتور جابر عصفور

- اللوحة يميزها الشعر وإيقاعات الألوان.. والقصة تتخذ فرادتها من شاعرية المعالجة.. حتى المسرحية تعلو حين تكون «شعرية»
- الدكتور جابر عصفور أقام مقترحه النقدى على معطيات تخص الشعر.. وتحدث عن ارتفاع معدلات إنتاج الرواية واستهلاكها
قبل أسابيع قليلة أعلنت لجنة جائزة نوبل للأدب عن فوز الكورية الجنوبية هان كانج بالجائزة الأشهر حول العالم، وقالت إن الاختيار وقع عليها «لنثرها الشعرى المكثف الذى يواجه الصدمات التاريخية، ويكشف هشاشة الحياة البشرية.. وبأسلوبها الشعرى والتجريبى أصبحت مبتدعة فى النثر المعاصر»، وقبلها بمائة عام إلا سنة، أعلنت نفس اللجنة عن فوز الساخر الأيرلندى الشهير جورج برنارد شو بها عام 1925 لأن «هجاءه المحفّز غالبًا ما يملؤه جمال شعرى فريد»، ثم قالت فى حيثيات فوز الروائى الدانماركى يوهانس فلهالم ينسن عام 1944 أنه فاز بها «للقوة النادرة، والخصوبة فى خياله الشعرى»، تكرر الأمر مع الروائى الفرنسى المولود فى مدغشقر كلود سيمون عام 1985 «الذى يجمع فى رواياته بين إبداع الشاعر والرسام».. هؤلاء وغيرهم كثيرون كان الشعر بوابة فوزهم بنوبل، ما بالك لو عددت لك ما جاء فى حيثيات الفوز بجوائز «بوكر مان» البريطانية، أو العربية، أو غيرها من جوائز حول الكرة الأرضية.. عشرات الكتاب والمبدعين حول العالم يحملهم الشعر والحس الشعرى عاليًا وسط مجايليهم، وتضعهم الشاعرية فى مرتبة سامية خاصة، ومكانة لا يصلها إلا أعداد محدودة من البشر، ليأتى بعد ذلك من يظن أنه «زمن الرواية»، وأن الشعر قد انتهى عصره، أو أن مصيره الانقراض أو التلاشى والانحسار فى مساحة ضيقة من الترفيه.. بينما الحقيقة أنه هو الشعر الذى حافظ على علو مكانته على مر التاريخ، ولعلها المرة الأولى التى ألجأ فيها إلى الكتابة اليقينية المتأكدة.. فاللوحة يميزها الشعر وموسيقى الألوان، والقصة تسمو بشاعرية معالجتها، والرواية تستمد حضورها وتميزها من شعرية الكتابة، حتى المسرحية تعلو وتسمو مكانتها حين تكون «شعرية»، والشريط السينمائى كلما حضرت الشاعرية فى زواياه ولقطاته، ارتفعت حظوظه فى صالات العرض وسط الجماهير، وعلى منصات التتويج بالجوائز فى تفضيلات النقاد.

دربان متعارضان
هكذا يظل الشعر هو ما يميز الجيد ويرفعه دون غيره، أو هكذا لا يجد النقاد وأعضاء لجان التحكيم فى الجوائز المحلية والعالمية غير الشعر «مطية» يمررون بها ما لا يجدون له امتياز عن غيره، استنادًا إلى براح التأويلات الممكنة للنص الشعرى، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى افتراض ما ليس فى النص والبناء عليه، وكأن مقولة «المعنى فى بطن الشاعر»، لم تكن غير حيلة لجأ إليها شاعر لإخفاء حقيقة رأيه إن كان مدحًا أم هجاء.
دربان متعارضان، واستخدامان على طرفى نقيض.. أحدهما اعتراف بتفرد وقيمة استثنائية ومكانة عليا، والآخر محض تدليس وهراء لا قيمة له ولا وزن.. بينما يقف الشعر وحده، باعتباره هو ما يجمع بينهما، هو الفن الإنسانى الوحيد القادر على إثارة الدهشة، وفتح الجراح القديمة، ومطاردة فراشات الفرح إلى ما فوق السماوات العلا.
هكذا.. يظل الشعر والموسيقى فى أعلى درجات الإبداع الإنسانى، وإن راجت مقولات تحاول الزعم بغير ذلك، أو النزول بهما والترويج لفنون أخرى بحسابات الرواج والمبيعات، المكسب والخسارة، الإنتاج والاستهلاك، يظل الشعر والموسيقى هما الأرقى والأكثر حضورًا وتأثيرًا، وإن جهل كثيرون مسالكهما وتصريفاتهما التى يفتحان بها مساراتهما الخاصة فى أعماق النفس البشرية، والتعبير عنها فى جميع انفعالاتها، المسببة وغير المسببة وغير المفهومة أحيانًا.. وأغلب ظنى أنه على مدار التاريخ الإنسانى المعروف، تطورت الآداب وفنون المعرفة والعلوم الإنسانية تبعًا لحركة الشعر، بداية من كونه وسيلة لحفظ الأنساب والوقائع والأحداث الكبرى فى غياب الكتابة التى جاءت تالية لمحاولات التواصل الإنسانى الأولى عن طريق الأصوات المجردة.. مرورًا بكونه وسيلة لحفظ قصص الفخر والهجاء والإخبار والحكى وتداولها اعتمادًا على الإيقاع والقافية اللذين يسهلان الحفظ والاسترجاع، ووصولًا إلى قصائد الغزل والهيام ومحاولات استكشاف العواطف الإنسانية البسيطة، وما يمور بداخل النفس من مشاعر وانفعالات وهزائم وانتصارات، ومحاولة فهمها وفهم تعقيداتها وآليات تدفقها، ومسببات كبتها، وما تؤول إليه.
والحادث أنه قبل سنوات غير بعيدة، انطلقت مقولة «زمن الرواية» التى لا أعرف كيف تصدر لها نقاد ومفكرون ثقال وطليعون حول العالم، فبعيدًا عن تهافت المقولة، وارتكانها إلى حسابات الرواج الرأسمالى وآليات السوق، أو معطيات العرض والطلب التى لا ينبغى أن يبنى عليها متخصصون ومفكرون آراءهم، ولا يستقيم بها منهج علمى، خصوصًا فيما يتعلق بالإبداع والفن، خصوصًا أن الواقع لم يكن يشير إلا إلى غير ذلك.. وأغلب الظن أنه هو ما يحدث الآن.. فالرواية، حتى لحظتنا الراهنة، تستمد فرادتها من «لغتها الشعرية»، واللوحة أو الصورة الفوتوجرافية تستحوذ على متلقيها من «شعرية مفرداتها وألوانها»، ومن «شاعرية العلاقة بين الظل والنور، وإيقاعات امتزاج ألوانها وتجاورها».. حتى المسرحية تتخذ وضعية مختلفة إن جاءت «شعرية»، ومثلها المسلسل والفيلم السينمائى.. كلها لا تجد رواجًا إن لم تلق صدى فى نفس المتلقى وروحه التى لا يفك طلاسمها سوى الشعر والموسيقى، ولا يقبل المتفرج عليها إن لم تعبر عن تطلعات وآلام الإنسان فى مواجهة ما يحيط به من متغيرات.. الفنون جميعها مازالت تتوسل الوصول إلى المتلقى عن طريق الشعر، حتى كتب السياسة والتنمية البشرية لا تنجو من السطحية والتفاهة بغير أساليب الشعر واستعاراته ومجازاته، تلك التى تجاوزها الشعر فى غفلة من الجميع، ولم يعد مدهشًا أن تقرأ فى حيثيات فوز كاتب بأى من جوائز الدنيا عن «لغته الشعرية».
ربما يجهل كثيرون ما الشعر، ما اتجاهاته ومدارسه وطرقه فى الوصول إلى الروح والنفس البشرية، وربما يجهل نقاد مراحل تطوره تبعًا لتغير أنماط الحياة وطرق التواصل بين البشر.. فقصيدة النثر على سبيل المثال لم تكن مجرد رغبة من كتابها فى الاختلاف، أو تعبيرًا عن عجزهم عن النظم الإيقاعى، سواء فى إطار القصيدة العمودية أو قصيدة التفعيلة، ولكنها كانت وسيلة للإنصات إلى إيقاعات الروح، إلى توترات النفس البشرية، وعبثية الوجود، وربما كان ذلك واحد من أسباب كتابة تلك الفقرة العبثية فى حيثيات الجوائز بطول وعرض الكرة الأرضية.. لم يعد الشعر مجرد مجاز لغوى، ولا استعارات أو تشبيهات أو حتى لعب باللغة ومعها.. هى كتابة إنسانية يتجلى امتيازها فى قدرتها على الوصول إلى أعماق النفس ومناطقها المظلمة، والعصية على الفهم والتفسير.. يفسرها الشعر، وتصفها الموسيقى.
أكل هذه الأسماء «لاأحد»؟!
ربما يحتج أحدهم بأنه لم يعد لدينا شاعر عظيم كالمتنبى أو أحمد شوقى أو حافظ إبراهيم، وأن السنوات الأخيرة لم تشهد بزوغ نجم شاعر بحجم صلاح عبدالصبور أو أحمد عبدالمعطى حجازى أو محمود درويش، وهو رأى لا أساس له، بل يشى بجهل القائل به بما ينبغى عليه التفرغ له ودراسته، واستسهاله الاستسلام لما تروج له وسائل الإعلام، ووسائط الترفيه فى أنحاء الكرة الأرضية، فأغلب ظنى أن غياب الشعر عن المشهد الثقافى المصرى والعربى، والعالمى ربما، هو نتيجة طبيعية لنظام التفاهة الذى صك مصطلحه التشيكى ميلان كونديرا دون تعميم للمصطلح الذى أظن أن أخطر تمثلاته تظهر فى وسائل الإعلام المختلفة، فى برامج الكلام والاستهلاك والترفيه.. تلك التى لا تعرف عن الشعر سوى فقرات الترفيه، فتملأ الهواء بالساعات للشاعر الفلاح، يلقى نظمًا من الهراء والحكم والمواعظ المقفاة والموقعة، فيروجون له، ويسمون ما يقوله من هراءٍ فارغٍ شعرًا، والشعر منه براء، تليها ساعات لهويس لا تستقيم له فكرة، ولا علاقة له بالشعر فى جميع مستوياته، فيملأ الهواء بما لا يزيد على «عرض ترفيهى» يتضمن بعض القوافى وبعض خلاصات الحكمة وحصص التنمية البشرية.. وإن جاءوا بشاعر حقيقى فلكى يقول كلامًا مسليًا، أو يفتح معركة مع كتابات التيارات المخالفة لتياره الأدبى، بما يضمن ساعة من الترفيه، والاستهلاك منزوع القيمة والدسم، بينما الشعر الحقيقى هنا.. ملء القرى والمدن والنجوع، ولك أن تعرف أنه هنا الآن، فى مصر وحدها، لدينا جمال القصاص ومحمد آدم ومحمد سليمان وعبدالمنعم رمضان، هنا إبراهيم داود، وإبراهيم عبدالفتاح، وكمال عبدالحميد، هنا عزمى عبدالوهاب وياسر الزيات وبهية طلب وأمل جمال، وأسامة الحداد، وأحمد الشهاوى وأحمد بخيت ومسعود شومان وصادق شرشر.. هنا عماد فؤاد وعماد أبوصالح وفتحى عبدالسميع، وحمدى عابدين وخالد حريب وماهر مهران.. هنا عشرات الأسماء الذين لا تسعفنى بهم الذاكرة، ولا يتوقفون عن اقتراف الشعر كأبهى ما يكون..
قبل كل هؤلاء، مازال يعيش بيننا شاعر لا حد لموهبته وحضوره وتفرده، واسمه أحمد عبدالمعطى حجازى.. فهل شاهدت على أى شاشة فضائية واحدًا منهم يقرأ قصائده؟! هل تابع التليفزيون أمسيةً لأى منهم فى معرض القاهرة الدولى للكتاب؟! ما حجم الفقرات المخصصة للشعر فى «قناة النيل الثقافية»، لا الفضائيات الخاصة؟!
لن أجيب على هذه الأسئلة، ولا غيرها، ولكنى سأقول لك إن هذا الغياب «المتعمد»، هو ما أدى لظهور أعداد ممن يظنون أن الشعر هو فن رص الكلام ووضع دروس التنمية البشرية فى شكل إيقاعى مقفى أو غير مقفى، فن استدرار مصمصة الشفاه وإشعال الحماسة، وتظنهم متعلمين وقراء، ويفتون فى كل شىء، فيما لا يزيد حظهم من الشعر عن أبسط أشكاله واتجاهاته.. لن أتورط فى اعتبارهم ليسوا شعراء، فالشعر كثير، وكثير جدًا، ولكنهم لا يجيدون منه سوى أقل القليل، وهو فى زمن مثل زمننا قيمة لا تستطيع التقليل منها.. مجرد إقدام شخص وسط هذه الحالة من الفقر والإفقار على قراءة الشعر أو كتابته بطولة، أن يحمل أحدهم كتابًا وسط قفزات الأسعار ونهم التجار.. بطولة، أن يمسك قلمًا ليقول ما فى نفسه، هى أيضًا بطولة، وإن شابها بعض التعجل والاستسهال.

منطلقات الدكتور جابر
فى العدد الرابع من المجلد الحادى عشر لمجلة «فصول» المتخصصة فى النقد الأدبى، والصادر فى شتاء ١٩٩٣، أطلق الدكتور جابر عصفور مقولته المدوية حول زمن الرواية، فجعلها عنوانًا للعدد الذى وصلت صفحاته إلى أكثر من ثلاثمائة صفحة كجزء أول من ذات المحور، وكتب فى افتتاحيته ما يعد البذرة الأولى للفكرة التى جمعها فيما بعد فى كتاب صدر عن دار «المدى»، ثم فى طبعات شعبية ضمن مطبوعات مهرجان القراءة للجميع عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وللمفارقة أنه فى افتتاحية ذلك العدد، الذى تضمن دراسات معمقة حول ذات الفكرة للمغربيين محمد برادة ومحمد مشبال وغيرهما من كبار النقاد العرب، بنى الدكتور جابر عصفور مقترحه النقدى ذلك على عدد من المعطيات التى تخص الشعر أكثر من فن الرواية الذى تحدث عن ارتفاع معدلات «إنتاجه واستهلاكه» كميًا، وارتفاع معدلات فوز مبدعيه بالجوائز، والتناول من قبل الدرس النقدى، ثم يقول: «يضاف إلى ذلك قدرة الرواية على التقاط الأنغام المتباعدة، المتنافرة، المركبة، متغايرة الخواص، لإيقاع عصرنا، وذلك بواسطة الطبيعة البوليفونية التى ينطوى عليها النسيج الروائى، الذى يؤلف بين العناصر المختلفة، والخاصية الحوارية التى تجمع بين الأضداد، وتصل بينها وصل الجدل فى نسيج معقد، يتضافر فيه السرد والوصف والأحداث والشخصيات وأفعال الكلام وتراكيب الزمان والمكان، داخل الإطار الدلالى لمنظور (التبئير)، فى علاقات تصنع الأطراف المتجاوبة والعناصر المتنافرة فى شبكة متوترة الأبعاد والمكونات».. وهو حديث أظن أنه ينطبق على فن الشعر أكثر من الرواية، فهكذا كان الشعر عند القدماء، وهكذا هو عند المحدثين، وربما ذهب إلى ما هو أبعد من كل ذلك فى وقتنا الحالى، واللافت فيما ذهب إليه الدكتور جابر أنه، مثلًا، لم يجد وصفًا لطبيعة «النسيج الروائى» سوى باستخدام مصطلح «البوليفونية»، وهو مصطلح موسيقى فى الأصل يعنى تعدد الأصوات، وتزامن خطين لحنيين، أو أكثر، على أنهما مستقلين رغم اتصالهما، وكلنا نعرف طبيعة الارتباط الوثيقة ما بين الشعر والموسيقى، حتى وإن كانت قصيدة نثر!!
وفى القلب من فكرته التى دعى رفاقه لتبنيها فى مقالات ودراسات عددين كاملين من المجلة الأشهر نقديًا فى العالم العربى، يذهب الدكتور جابر عصفور إلى أن الرواية هى «فن المدينة القادر على اقتناص تحولات الطبقة المتوسطة فى المدن التى تزداد تعقيدًا وازدحامًا وكوزموبوليتانية»، لكنه يعود لكى يقول إن البحث عن القسمات الدالة على عصر المعلومات داخل العلاقات المتنافرة بين البشر «هو الذى يفسر، مع غيره، تفجر عنصر الشعرية فى الرواية، حيث لا تكتفى الرواية بأن تستنزل الشعر من عليائه، فى قمة التراتب الاجتماعى، بوصفه فن العربية الأكبر، وفن الطبقات العليا.. بل تجعل منه أحد فنون العربية، فى علاقات متكافئة غير متراتبة، حوارية وليست مونولوجية، ومتفاعلة متعددة الأبعاد وليست أحادية البعد. وفى داخل هذه العلاقات الجديدة أفادت الرواية من الشعر شعريته، وجعلت منه عنصرًا من عناصرها التكوينية فى مستوى، وملمحًا من ملامح أنواعها الفرعية فى ملمح ثان»، وهو القول المستغرب فى الحقيقة من ناقد وقارئ كبير بحجم الدكتور جابر عصفور، إذ لم تكن الرواية أو القصة منذ ظهورها الأول ببعيدة عن التوسل بالشعر كأحد مكوناتها التى تميز قصة عن أخرى.. منذ «كليلة ودمنة» التى يؤرخ بها لفن القص عند العرب، وحتى «دون كيخوت دى لامانثا» التى يؤرخ بها الغرب لنشأة الرواية الحديثة.. طوال تاريخها استعانت الرواية بكل ما أتيح لها من فنون التعبير للوصول إلى القارئ، غير أن الشعر كان دائمًا هو «حامل القيمة» الذى تتوسل به لاكتساب رفعة ومكانة لم تكن لها، وهو ما يذكره الدكتور جابر فى مقاله الافتتاحى المذكور قائلًا ما نصه: يكفى أن نتذكر خشية محمد حسين هيكل عام ١٩١٤ من أن تلحق به معرة كتابة الروايات، فتنتقص من مكانته الاجتماعية، وأن نتذكر صديق إبراهيم عبدالقادر المازنى، فى العشرينيات، الذى بادره منزعجًا حين علم أنه يهم بوضع رواية، وما ذهب إليه العقاد حين أصدر كتابه «فى بيتى» وقال على لسان صاحبه فى وصف مكتبته «ما أصغر نصيب القصص من هذه الرفوف»، وبرر ذلك بأن الرواية تظل فى مرتبة دون مرتبة الشعر.. وإنها لا تشيع إلا بين الدهماء، ثم يستشهد الدكتور جابر بمقال للروائى الأكبر نجيب محفوظ للرد على العقاد والتبشير بزمن الرواية، وهو المقال الذى نشره بمجلة «الرسالة» بعنوان «القصة عند العقاد»، وقال فيه: لقد ساد الشعر فى عصور الفطرة والأساطير، أما هذا العصر، عصر العلم والصناعة والحقائق، فيحتاج حتمًا لفن جديد، يوفق على قدر الطاقة بين شغف الإنسان الحديث بالحقائق وحنانه القديم إلى الخيال، وقد وجد العصر بغيته فى القصة، فإذا تأخر عنها الشعر فى مجال الانتشار، فليس ذلك لأنه أرقى من الزمن، ولكن لأنه تنقصه بعض العناصر التى تجعله موائمًا للعصر، فالقصة على هذا الرأى هى شعر الدنيا الحديثة. وسبب آخر لا يقل عن هذا فى خطره، هى مرونة القصة واتساعها لجميع الأغراض، مما يجعلها أداة صالحة للتعبير عن الحياة الإنسانية فى أشمل معانيها..
بالفعل كان الشعر عام ١٩٤٥، الذى كتب فيه عمنا نجيب محفوظ مقاله، أسير النظم، وتدبيج القوافى، فلم يكن هناك سوى القصيدة العمودية، وبعض «الزجل»، والمزج الساخر بين العامية والفصحى الذى أطلق عليه بيرم التونسى اسم «الشعر الحلمنتيشى» نسبة إلى إحدى الفرق التى كانت تعرض هذا النوع من الفكاهة..
بالفعل كان العصر بحاجة إلى فن جديد يلبى حاجات إنسان عصر الصناعة.. فهل كانت هى القصة أو الرواية هى ذلك الفن؟!
للأسف لم يكن ما ذهب إليه أديبنا الكبير هى الإجابة الصحيحة، رغم أنه أشار فى مقاله إلى ذلك الفن، وإن لم يكن جديدًا، وخصوصًا فى عبارته التى يقول فيها مبررًا تأخر الشعر فى الانتشار «لأنه تنقصه بعض العناصر التى تجعله موائمًا للعصر».. هذا هو ما حدث بالفعل، وهو ما شهده عمنا نجيب محفوظ فى حياته، وكتب عنه ناقدنا الكبير الدكتور جابر عصفور ورفاقه فى عددى «فصول زمن الرواية»، فقد تحرك الشعر والشعراء لتعويض ما كان ينقص فنهم، تخلص الشعر من كل ما علق به من زخارف ونتوءات، وغاص فى عمق النفس البشرية، حلق معها عاليًا، وفى جميع الاتجاهات، وشهدت تحركاته أسماء لا حصر لها من كبار الشعراء، فى قصيدة التفعيلة، وقصيدة النثر، فى العامية والفصحى، فى مصر والعراق ودول المغرب والخليج العربى.. ليبقى الشعر هو فن العربية الأول، هو الفن القادر على التطوير من نفسه مع الزمن، وعلى تطويع أدواته بما يتناسب مع تطورات الحياة والإنسان، ويوسع من مجالات اتصاله وتناوله وإيقاعاته.. هكذا يظل الشعر هو فن الإنسانية الأول، وإن كره النقاد والناشرون والروائيون والدكتور جابر عصفور، رحمه الله وغفر له.