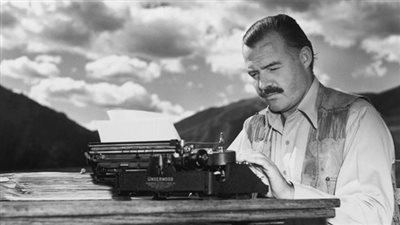آدم الشاعر الأول.. هكذا.. عن حقيقة «الكائن» وفتنة اللسان السليط

- درس الفلسفة بعد نصيحة من نجيب محفوظ.. ولا يجد متعته إلا فى المشى وسط الناس
- استوعب التراث الوجودى الغربى وغرق فى كتب المتصوفة وتسلح بفكر المعتزلة العقلانى وفلاسفة الإسلام فكانت النتيجة شعرية مفارقة وفارقة
هل التقيت بالشاعر الكبير محمد آدم صدفة أو بترتيب؟!
إذا كانت الإجابة بنعم، فلا بد أنك عانيت، مثلى وكثيرون غيرى، من مجموعة أسئلته المتلاحقة والمتكررة: هل قرأت لى؟! ماذا قرأت؟! ماذا يعجبك من قصائدى؟! أنا أم أدونيس؟! أنا أم حجازى؟! أنا أم حلمى سالم؟!.. على أن سؤال مقارنته لا يشتمل على غير كبار الشعراء فى العصر الحديث، فهو لا يسأل، ولا يضع نفسه فى مقارنة، ولو على سبيل المزاح، مع نصف موهوب، أو مجرد مشهور تستضيفه القنوات الفضائيات ومهرجانات الترفيه، يعرف جيدًا أن كثيرًا من مشاهير الشعراء أبرياء من الشعر، ذلك الذنب الجميل، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، لا علاقة لهم به غير بعض الكلمات الملفقة والكاذبة، وبعض القدرة على رصّ الكلمات فيما يبدو أنه شعر، وكثير من القدرة على تلوين الصوت ورسم الانفعال على الوجه والجسد.. هم فى أفضل الأحوال مقدمو فقرات شعرية خفيفة ولطيفة فى برامج الترفيه، والحفلات الخاصة التى يقيمها مدعو الثقافة والأدب من الأثرياء الجدد، ولا يذهبون إليها إلا باعتبارها «بابًا للرزق»، فلا هم يقدرون على التورط فى حقيقة الشعر المؤرقة، ولا هم بمستطيعين معها صبرًا.. لا يقربهم الشعر ولا يجرؤون على الاقتراب منه، لذا لا يراهم آدم، لا يعرفهم، ولا يسأل عن مقارنة بهم، ويشيح بوجهه لا مبالٍ إذا سألته أنت عن أحدهم.
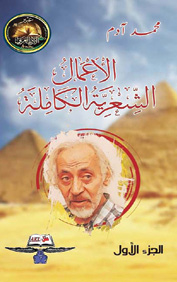
وهو لا يسأل عن مقارنة مع قدماء الشعراء، وإلا فلا مجال لديه لغير الأكابر منهم والأعيان، من يليقون بصحبته ويليق بهم.. ولا أظنه إذا فعلها سوف يسأل عن غير المتنبى، أو امرئ القيس، لا ثالث لهما إلا إذا فتحنا القوس على شعراء العالم الكبار.. وقديمًا قالوا إن لكلٍ من اسمه نصيبًا، فأى نصيب يمكن أن يحصل عليه إذا كان هو محمد، وهو آدم؟! فإذا كان نبينا «محمد» هو من قال فيه القرآن الكريم: «وما علمناه الشعر وما ينبغى له»، فآدم الأول هو من علمه الله الأسماء كلها، وقد حصل آدم على نصيبه من اسمه كاملًا غير منقوص، ولكن وفق طريقته هو، ووفق حياته التى اختارها لنفسه منذ لحظة الميلاد وحتى ساعتنا هذه.
أما إن لم يكن قد حدث ولم تلتقه صدفة أو وفق ترتيب مسبق، فقد فاتك الكثير من متعة الجلوس فى حضرة «شاعر» كما يقول الكتاب، وكما يظهر فى الأعمال الدرامية كافة، بجيدها ورديئها، بحلوها ومرها، فهو الاثنان معًا، وفى نفس الوقت.. فربما تراه كرجل حالم، حسن الملبس، غارق فى التفكير فى معضلات الكون والحياة اليومية البسيطة كما تجده فى كلاسيكيات السينما الأوروبية والأمريكية التى تعرف قيمة أن تكون شاعرًا فى عالم استهلاكى ومنحط مثل عالمنا الحديث.. وربما تراه مجرد شخص عبثى، مُشعث الشعر، يلهو بمشاعر المحيطين به ويتلاعب برءوسهم، كما يبدو فى غالبية الأعمال الدرامية والسينمائية العربية التى تتخذ من الشعر والشعراء مادة لاستجداء الضحكات السمجة والجاهلة.
هو حشد من المتناقضات فى شخص واحد، لا تملك إلا أن تحبه فتطيل الجلوس إليه، والإنصات لكل ما يقول.. فأنت فى حضرة رجلٍ نظيف الطوية، يزن كل كلمة قبل أن ينطق بها، وهو فى اللحظة ذاتها، شخص عفوى لا يهتم بشىء، لا بصورته ولا ملبسه، ولا يفرق معه كيف تراه، أو كيف تؤثر الكلمات التى يلقيها فى محيطه وفيمن حوله.. فظ عنيف ومزعج لا يتوقف عن ملاحقتك بأسئلته التى لا تعرف لها إجابة، ورقيق فى غاية الوداعة، لا يدخر جهدًا للتعبير عن مودته الصافية لأوقات لاحقة، وكأن شيئًا بداخله يهمس له «لا تؤجل مودة اليوم إلى الغد»، أو «وما تدرى نفس ماذا تكسب غدًا وما تدرى نفس بأى أرض تموت».
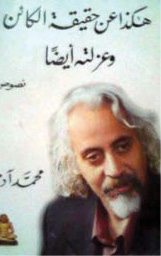
ذلك الصاخب النهم للحياة، هو ذاته الرومانسى والانفعالى، الواقعى، سليط اللسان الذى لا تفوته فرصة لمواقعة الحياة، ولا التعبير عن اشتهاء ملذاتها كافة، لاغتنام ما تطوله يداه، ودون أن يساوره أى ندم إن لم تطل يداه غير الخواء.. يكفيه الشعر والشعراء، وتكفيه محبة الأصدقاء، وهم كثيرون.. تكفيه «لقمة» سريعة، وفنجان من القهوة المُرة ما دامت الضحكة حاضرة، ومادام فى يده كتاب، وما دامت لديه القدرة على المشى فى شوارع القاهرة ومناكفة جميع خلق الله.
عندما التقيته للمرة الأولى، أدهشتنى حقيقة عمله فى أحد البنوك الحكومية الكبرى «بنك الإسكندرية»، فسرحت فى الأمر واستوقفتنى المفارقة.. كنا فى منتصف تسعينيات القرن الماضى، وكنت قد قرأت له ثلاثة دواوين فاتنة، هى «أنا بهاء الجسد واكتمالات الدائرة»، «هكذا.. عن حقيقة الكائن وعزلته أيضًا»، و«كتاب الوقت والعبارة»، وكنت أتابع ما ينشره من قصائد فى بعض الدوريات المهتمة بالشعر، وتحتفى بها وبه، وفى مقدمتها مجلة «إبداع» حين كان يرأس تحريرها الناقد الأدبى الكبير الدكتور عبدالقادر القط، ففتنتنى لغة الشاعر التى تناطح «مزامير داود» و«نشيد الإنشاد» وكتابات المتصوفة الكبار، تزاحمها فتجبّها، وتكاد تعلو عليها.. هى لغة صافية، رائقة، مسترسلة، لا تحدها سماء، ولا توقف تدفقها صخور المسكوت عنه، ولا المعلوم بالضرورة.. وكنت قد قرأت عنه فى دراسة الناقد الأدبى الكبير الدكتور محمد فكرى الجزار حول تجربة شعراء السبعينيات فى مصر، والتى نشرتها الثقافة الجماهيرية فى كتاب بعنوان «لسانيات الاختلاف»، وهى الدراسة التى كنت وما زلت أراها الدراسة الأهم حول تجربة ذلك الجيل الفارق والمهم فى مسيرة الشعر العربى.. ووجدتنى أتساءل هل من كتب هذه االقصائد الفاتنة هو موظف البنك الذى يحدثنى عن الفقر والفقراء والحداثة وما بعدها، ونهاية التاريخ؟!
كأنه آدم الأول، وهو كذلك فى كل ما خطت يداه من قصائد وأعمال شعرية، رجل وحيد فى محيط لا يعرف عنه شيئًا، ويعرف عنه كل شىء، يراه للمرة الأولى، ولا يلتزم بكتاب التعليمات، فيقطف من ثمر الأرض، ويأكل منها، لا ممنوعات ولا محرمات، ولمَ لا؟! فهو لا يختلف عن «آدم الأول» فى غير اختياره للأرض كمنفى اختيارى، يحبه، ويحب كل الكائنات التى تعيث فيها فرحًا، وشغبًا ومحبة.

حشد من المتناقضات التى يخاصم بعضها البعض، والمكونات التى لا تجتمع فى شخص واحد إلا لكى تشى بشكل من أشكال الجنون، والخروج على كل ما تعارف البشر عليه، فيسهل أن تظن به الظنون، ويسهل أن تقع فى محبته، وفتنة الجلوس إليه، والائتناس بصحبته والنفور منه فى وقت واحد.. معًا، تشى بإنسانية لا حدود لها، ولا تلقى بالًا لما يدور حولها، رغم انشغالها به، وغرقها فى تفاصيله حتى الأذنين.
وآدم الذى عرفته رجل به مس من الشعر، ومن فتنة الحياة بكل مباهجها، حتى وإن كان يشكو من تجاهل الإعلام والجوائز والنقاد، فهى شكوى غير حقيقية، ولا مردود لها فى نفسه كما قد تظن، لا تصيبه بأى شكل من أشكال الخيبة أو الإحباط، حتى إنه لا يلبث أن يؤكد أن كبار النقاد المصريين والعرب جميعهم كتبوا عن أعماله، عن ذائقته، جرأته فى اجتراح كل محظور وممنوع.. آدم هو الشعر فى صورة صعلوك يجوب المقاهى والحانات بحثًا عن سطر يبدأ به قصيدة طويلة جديدة، لا تراه بغير كتاب فى يمينه، وبغير وصية بقراءة عمل أدبى جديد، يحدثك عنه بالتفصيل الممل، ويحدثك عن الحياة الدنيا، ومدارس الفلسفة، ومحنة الوجود، وكأنها هى مسوغه الوحيد للوجود.
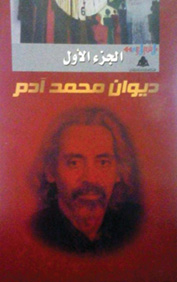
ومحمد آدم، الشاعر الذى يعرف بمنجزه العالم العربى كله، ويجهله كثير من أهل مصر، من مواليد إحدى القرى الفقيرة بمحافظة المنوفية عام ١٩٥٣، تخرج فى كلية التجارة، لكنه توجه إلى دراسة الفلسفة بناء على نصيحة من أديب مصر الأكبر نجيب محفوظ الذى احتفى به عندما سمع إحدى قصائده، فحصل على إجازة الدكتوراه من جامعة عين شمس بعنوان «فلسفة الجمال عند ميخائيل باختين»، بدأ كتابة الشعر مبكرًا، وتفرد صوته وسط مجايليه منذ اللحظة الأولى، فترجمت قصائده إلى عدد من اللغات الحية، كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية، وطبعت أعماله الكاملة فى سوريا والعراق ولبنان والمغرب ومصر.. صادر الأزهر الشريف ديوانه الأول «أنا بهاء الجسد واكتمالات الدائرة» الصادر عام ١٩٩٢، فتبعه بديوان «كتاب الوقت والعبارة» فى نفس العام، و«هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته أيضًا» ١٩٩٥، و«متاهة الجسد» ١٩٩٨، ثم «نشيد آدم» الذى طبع للمرة الأولى فى سوريا عام ٢٠١٠، وغيرها الكثير من الدواوين التى فتنت نقاد الأدب العربى الحديث، وأصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ٢٠٠٤ كتابًا باللغة الإنجليزية عن تجربته الشعرية للدكتور محمد عنانى، أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة، فيما كتب الدكتور محمد عبدالمطلب، أستاذ البلاغة والنقد الأدبى بجامعة عين شمس عن تجربته: «محمد آدم أحد رواد الحداثة السبعينية الذين أحدثوا هزة كبرى فى مسيرة الشعرية العربية، لكنه من بين جيله كانت له خصوصيته وتفرده، وخصوصيته فى أنه لم ينقطع عن موروثه الثقافى جملة، وموروثه العرفانى على وجه الخصوص.. لقد جاءت خصوصية محمد آدم من امتلاكه لأدواته اللغويّة بوصفها أحد مبتكراته، لا بوصفها ميراثًا فوقيًا مقدسًا، ومن ثم اتجهت شعريته إلى تخليص اللغة من وظيفتها التوصيلية بحيث أصبح عنده هدف فى ذاته، فالذى يتكلم فى شعريته، لغته وأبنيته الصياغية المتمردة على اللغة المستهلكة، أى أن الجماعة أصبحت، عند محمد آدم، فردية، والفوقى أصبح عنده حياتيًا، وقد بلغت شعريته أفقها الصحيح عندما هجر التجربة بمفهومها الرومانسى والواقعى، وحلّق فى مدارات الحال والموقف والمقام، وخاصة مقام الجسد، الذى أصبح هو العالم، ومن خلاله أبحر إلى المجهول والخبىء على نحو ما صنع الصوفيون عندما أدركوا أن وراء العالم الحاضر عالمًا غائبًا عليهم أن يقاربوه بالملاينة حينًا والاقتحام العنيف حينًا آخر»، وقال عنه الدكتور ماهر شفيق فريد، أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة: «محمد آدم واحد من أعظم شعراء السبعينيات فى مصر، صوره كونية كتلك التى نجدها فى أشعار وليم بليك، وويتمان، وسان جون بيرس، وهنرى ميللير، ونثرهم. تغرّب أحيانًا إلى حد الاقتراب من تخوم السوريالية، وتذكرنا قصائده بخيال كتاب «ألف ليلة وليلة» المشرقى.. نبرة الشاعر تتراوح ما بين التراث العظيم لمحيى الدين بن عربى، والقرآن الكريم، وكذلك نبوءات أنبياء العهد القديم والأسفار «الجامعة، ونشيد الأنشاد، والمزامير»، والحفاوة باللغة، والتصارع مع صعوباتها همّ مخامر لهذا الشاعر، فهو لا يفتأ يتأمَل دلالاتها الصوتية والدلالة النحوية والمعنوية وطابعها الاستعارى»، وكتب عنه الدكتور حسن حماد، أستاذ الفلسفة وعلم الجمال بجامعة الزقازيق: «إن فرادة أو خصوصية العالم الشعرى لمحمد آدم تنبع من ثراء الخلفية الثقافية التى انطلق منها، فقد استوعب آدم كلًا من التراث الغربى، خاصة التراث الوجودى، وقرأ مؤلفات العظيم دوستويفسكى، وغرق فى كتب المتصوفة، خاصة ابن عربى والحلاج والنفرى، وتسلح بالفكر العقلانى عند المعتزلة، وابن رشد وسائر فلاسفة الإسلام.. ولقد عرف محمد آدم المعاناة منذ طفولته، فقد ذاق مرارة الحرمان، وعرف معنى البؤس والمعاناة والعرى بمعناه الجسدى والنفسى.. إن كل هذه العوامل وغيرها هى التى شكلت ذلك الوجدان المتوهج لهذا الشاعر الذى أؤمن بأنه أهم شاعر عربى فى القرن العشرين»، فيما كتب الدكتور محمد فكرى الجزار، أستاذ النقد الأدبى الحديث بجامعة المنوفية ما نصه: «على كثرة ما بين أيدينا من نصوص، فالحقيقة التى لا يجب أن نغض عنها طرف ذائقتنا أننا إزاء شعرية مختلفة وفريدة، وهى بلا شك شعرية صادمة بكل ما تعنيه الكلمة، فنحن لا نقرأ حين نقرأ إلا بفضل خلفية معرفية عن النوع الذى نقرأ له وتجلياته، وتحكم هذه الخلفية قراءتنا وأحكامنا عما نقرؤه من حيث ندرى ولا ندرى.. أما هذه الشعرية فليس كمثلها شعرية، وإنها لتضطرك لقراءة نصها من نقطة الصفر، إذ لا تشبه سواها ولا تشتبه به أو يشتبه بها، وهكذا الشعر العظيم ينبغى أن يكون.. سلام لآدم، سلام لشعرية آدم الخضراء».