تحت جلد الثقافة والمثقفين.. أسرار وأخبار من مذكرات صلاح دياب الكاشفة

- ما زلت أحتفظ بصورة خاصة لمجدى مهنا فى مكتبى حتى تذكرنى به دائمًا
- صلاح حافظ كانت له مدرسة صحفية متفردة وأفادنى كثيرًا بأفكاره رغم اختلافنا السياسى
كغيره من رجال الأعمال يعانى صلاح دياب من فهم خاطئ ترسّخ لدى الكثيرين عن العلاقة بين الثقافة والثروة.
فى مذكراته التى صدرت مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية، فى طبعة أنيقة، يفسر صلاح هذا اللبس وسوء الفهم، فيذهب إلى أن الكثير من الأعمال الدرامية والأدبية خلقت صورًا ذهنية سلبية ومعلبة تظهر رجل الأعمال جاهلًا سطحيًا أو جاهلًا ومستغلًا، فى مقابل رسم صورة للمثقف على أنه فقير وزاهد فى الدنيا، وكأنه لا يمكن أن يكون رجل الأعمال على قدر من الثقافة، أو على درجة عالية من الذوق الفنى والأدبى.
على طول المذكرات وعرضها- تصل صفحاتها إلى 399 صفحة من القطع الكبير- بذل صلاح، الذى ولد فى 4 فبراير 1944، جهدًا خارقًا، ليثبت أن هذه الصورة المغلوطة فى الغالب لا أساس لها من الصحة.
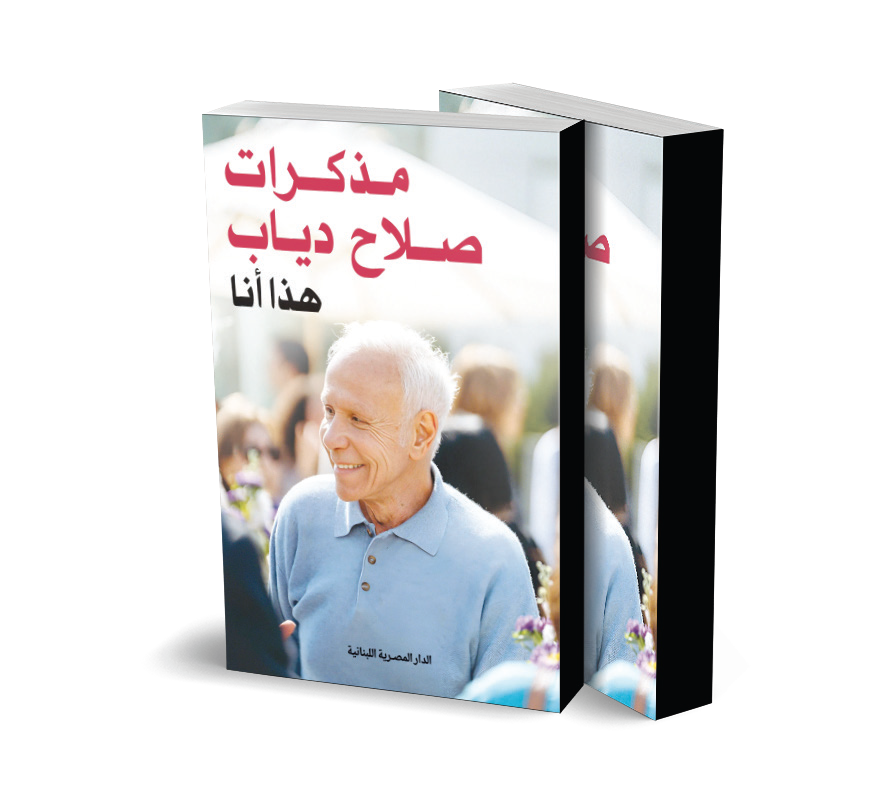
لجأ صلاح دياب إلى استعراض بعض جوانب حياته التى تماست بشكل واضح وصريح مع حياة كبار المثقفين والمفكرين والكتاب والأدباء والصحفيين، ويعترف بأن اقترابه منهم واقترابهم منه كان بسبب أنه حفيد الصحفى الكبير الرائد محمد توفيق دياب، فقد استجابوا إلى دعواته وأنسوا إليه لأنه من ريحة أستاذهم الذى علّمهم وكتب فى صحفهم.
كان صلاح دياب يحكى بعفويته المعروفة عنه، وهى عفوية فى النهاية انجرفت بقدمه إلى مواطن زلل كثيرة، كان يمكنه أن يتفاداها، لولا أنه يعتبر البوح بما لديه متعته الكبرى فى الحياة.
من بين سطور العفوية تسللنا إلى ما يتناسب معنا فى هذه المذكرات.
سنضع جانبًا حياته الخاصة، ومشروعاته الاقتصادية، وعلاقاته العابرة للقارات، وكذلك ما قاله عن ظروف حبسه مرتين، المرة الأولى 4 أيام والمرة الثانية 40 يومًا، فله أن يقول روايته، دون أن يكون له الحق بالطبع فى مصادرة رواية الآخرين.
اهتمامنا الأساسى أيضًا ليس فيما قاله عن علاقته بالمثقفين، ولكن فى بعض الأسرار التى نعتقد أنها ستكون مفاجأة لكثيرين.
لن نتدخل كثيرًا فيما يرويه صلاح، قد نظهر فقط للربط بين الوقائع، لكننا نتركه يحكى ويكشف من الأسرار والأخبار والأفكار ما يمكن أن يعيد ترتيب بعض ما نعرفه من تاريخنا الثقافى.
الآن صلاح دياب هو الذى يتحدث.

مايسة طلعت.. المترجمة التى كشفت حقيقة كتابة هيكل بالإنجليزية
اقتربت من المفكر اليسارى محمد سيد أحمد، تعرفت عليه عائليًا، وكانت زوجته السيدة الأنيقة مايسة طلعت زميلتى فى المدرسة الإنجليزية، كانت واحدة من جميلات المدرسة. ومحمد سيد أحمد هو ابن عباس باشا سيد أحمد الثرى الشهير، رغم توجهه اليسارى، فإنه كان يسكن فى عمارة فاخرة على نيل الزمالك، وزوجته المتمكنة من اللغة الإنجليزية هى أفضل من ترجم من العربية إلى الإنجليزية. وربما لا يعرف كثيرون أن الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل كان يدفع إليها ببعض كتبه بعد أن يكون قد صاغها باللغة العربية، فتقوم هى بترجمتها إلى الإنجليزية، ليصدر الكتاب أولًا فى دور النشر الأجنبية، وكأن هيكل قد كتبه بالإنجليزية، ثم بعدها يعلن عن أنه تولى بنفسه ترجمته إلى العربية، لكن المؤكد أن النسخة العربية كانت موجودة مسبقًا.

جلسات النميمة مصدر إحسان عبدالقدوس لكتابة رواياته
كان إحسان عبدالقدوس يلبى دعواتى مصطحبًا زوجته الفاضلة، يظل مستمعًا شبه صامت، وعندما يتكلم كان يفعل ذلك بصوت خفيض جدًا، كان يركز على تفاصيل كل ما يقال خلال الحوار، كأنه يجمع مادة لقصصه ومقالاته، وأعتقد أن الشخصيات النسائية والشبابية الجميلة التى تعلقنا بها فى قصصه الرومانسية استمدها من الاستماع فى مثل تلك الجلسات الثرية بالمعلومات والقصص عن العائلات، والتى لا تخلو من النميمة الاجتماعية والسياسية.
مصطفى أمين يفضح يوسف إدريس فى قصة «لا تكذبى»
بدأ مصطفى أمين أول عمله الصحفى مع جدى توفيق دياب، ولم يكن جدى يكتب مقالاته بالقلم، بل كان يمليها وهو يمشى فى مكتبه ذهابًا وإيابًا على أحد تلاميذه، وكان أحدهم مصطفى أمين، الذى احتفظ بحب توفيق دياب وعائلته من بعده، وكتب عنه أكثر من مرة، لذلك كان من الطبيعى أن يتعاطف معى باعتبارى حفيد من كان يعتبره أستاذًا له.
حكى لى مصطفى أمين مرة أن الشاعر الراحل كامل الشناوى اشترى تورتة للفنانة نجاة التى كان مغرمًا بها، ذهب بها إليها فى منزلها للاحتفال بعيد ميلادها، وخلال إطفاء الشموع وغناء أغنية عيد الميلاد، لمح فى عينيها إعجابًا بأحد الحضور، قيل ربما يكون يوسف إدريس، فانهار حينها لكونه كان عاطفيًا بطبعه، ولجأ على الفور لمنزل مصطفى أمين، وكان يسكن فى عمارات وديع سعد بالزمالك، وقص عليه باكيًا كل ما حدث.
هنا دفع إليه مصطفى بورقة وقلم ليكتب قصيدته الشهيرة «لا تكذبى»، أى أن تلك القصيدة الشهيرة نزل وحيها فى منزل مصطفى أمين، على أثر هذه الصدمة العاطفية، وبعدها غنتها نجاة كما غناها عبدالحليم وعبدالوهاب. الطريف فى تلك القصة أننى كنت مقربًا جدًا من يوسف إدريس وعائلته، لكننى لم أفكر ولو للحظة فى أن أسأله عن هذه الواقعة التى رواها لنا مصطفى أمين، كنت منبهرًا بإدريس وإبداعاته، أعرف قدره ويعرف قدرى بالطبع، وأعلم أيضًا أن رفع التكليف مع هؤلاء تجاوز لا يليق، خاصة فى وجود الزوجات.

صدمة أحمد بهاء الدين: الملكية هى النظام الأفضل لمصر
جمعنى فى باريس لقاء مع مجموعة من الأصدقاء فى بداية ثمانينيات القرن الماضى بدعوة من صديقى رجل الأعمال الكويتى محمد الشارخ، الحضور كانوا أنا وزوجتى نينى، والأستاذ أحمد بهاء الدين وزوجته السيدة دايزى، ويوسف إدريس وزوجته السيدة رجاء، وإبراهيم نافع وزوجته السيدة علا بركات، وسعيد سنبل وزوجته السيدة فادية مكرم عبيد، إضافة إلى الداعى محمد الشارخ وزوجته السيدة موضى.
أثناء الغداء انطلقت الألسنة إلى مساحات وأفكار جريئة، تحدثت عن إسبانيا التى أعادها الديكتاتور فرانكو، رئيس الدولة، إلى مملكة عام ١٩٧٦، وشرحت كيف استقرت الديمقراطية هناك بعد التحول إلى الملكية، وتساءلت: هل تصلح هذه التجربة فى مصر؟
هنا لا أنسى أن صديقى إبراهيم نافع لكزنى فى ساقى، وقال لى بصوت خفيض: مفيش داعى تفتح الموضوع ده قدام أحمد بهاء الدين ويوسف إدريس.
امتثلت لما قال نافع برهة، ثم عدت مجددًا لأطرح السؤال نفسه، ويومها فوجئت برد أحمد بهاء الدين، الذى لم يأخذ وقتًا طويلًا فى التفكير قبل أن يقول: الملكية هى النظام الأفضل لمصر.
وأضاف: نعم هى أفضل الأنظمة، لكن عليك أن تدرك أن الديكتاتور فرانكو كان يمهد الأرض لعودة الملكية قبل ذلك بسنوات، كان يجهز الملك خوان كارلوس ويدربه لهذا الدور، لذلك فالأمر فى مصر قد يختلف.
وعقّب يوسف إدريس على كلام بهاء قائلًا بحماس: أؤيدك تمامًا فيما قلت.
رأى الثنائى كان مفاجئًا للجميع، بمن فيهم إبراهيم نافع الذى كان بالطبع يشعر بالحرج الشديد من أى تطاول على النظام فى ذلك الوقت، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام، بينما الآخرون، وأنا أولهم، لا يقيدهم التزام مع الدولة.. أقصد الجمهورية.

صلاح حافظ كاتب إعلانات من أجلى
تعرفت على الكاتب الصحفى صلاح حافظ، أحد أهم رؤساء تحرير مجلة «روزاليوسف» على مدار تاريخها الطويل، كانت للرجل مدرسة صحفية متفردة، أفادنى كثيرًا بأفكاره رغم اختلافنا السياسى والفكرى، داومت على قراءة ما يكتب معجبًا بصياغته لمقالاته فى «روزاليوسف» التى شهدت ازدهارًا وتفوقًا فى عهده.
وأتذكر أننى طلبت من صلاح حافظ بعد ذلك خدمة عجيبة الشأن، كنت فى منتصف ثمانينيات القرن الماضى قد حصلت على توكيل كمبيوتر صغير اسمه صخر، كان بدائيًا بلغة الزمن الحالى، لكنه كان ملء السمع والبصر حينها، كان المورد لذلك الكمبيوتر أو صاحبه هو رجل الأعمال الكويتى محمد الشارخ، وهو رجل ذو خيال وثقافة عميقة، كان فى ذلك الكمبيوتر برنامج لتفسير القرآن الكريم، أعده العبقرى الفذ د. نبيل على- رحمه الله- إذا ما استعلمت عن معلومة حول آية معينة أو شرح لمعنى أو كلمة فإنه يتوصل لها ويقدمها لك على الفور.
أردت أن أدفع بهذا الجهاز من خلال حملة إعلانية تحريرية، فهى أنسب الوسائل للوصول إلى هذه النوعية من الجمهور المستهدف، ولم يكن هناك أفضل من الأهرام فى ذلك الوقت، وتشاء الظروف أن يتوقف لمدة شهر تقريبًا عمود الكاتب الصحفى الكبير أحمد بهاء الدين «يوميات» بالصفحة الأخيرة، أظنه كان خاضعًا للعلاج وقتها.
اتفقت مع صديقى صلاح حافظ أن يجهز لى مادة إعلانية تحريرية عن «صخر» تمتد على مدى الشهر، وزودته بالمعلومات الفنية بالطبع، بعدها أقنعت الصديق إبراهيم نافع بالفكرة، فحدد لى ثمنًا للإعلان، المعلومات صاغها صلاح حافظ بشكل رائع، واستمتعنا بقراءة ما كتبه حتى لو كان الهدف حملة إعلانية.

أنا صاحب اسم «أنور وجدى» الذى كان يكتب به إبراهيم سعدة
بدأت معرفتى بإبراهيم سعدة مطلع ثمانينيات القرن الماضى، حين ظهرت على السطح قضية «جمال تراست بنك» لصاحبه على الجمال، وهو لبنانى انتقل إلى مصر وتزوج بمصرية، وقد حقق بنكه نجاحات واسعة فى وقت قصير.
اتهم الرجل بالمتاجرة فى العملة الصعبة، وكانت قضية شهيرة جدًا، وكتب إبراهيم سعدة فى مقاله الذى كان بعنوان «آخر عمود» جزءًا شخصيًا من قصة الجمال، أشار فيها إلى معلومات جريئة ومباشرة عن زوجته المصرية وأمها، اتصلت بسعدة على تليفون مكتبه دون أى معرفة سابقة، وعبرت له عن اعتراضى على تناول أمور شخصية بهذا الشكل.
قلت له: اكتب ما شئت فى مخالفات الرجل وتجاوزاته للقانون وفساده المالى إن وجد، أما حياته الخاصة فشىء مختلف، علينا أن نتجنب فيه قذف المحصنات.
غامرت هنا باللوم، فسعدة قد يتحول من الهجوم على الجمال إلى الهجوم على شخصى، لكن الرجل اعترف بالخطأ وامتلك شجاعة الاعتذار، ومن هنا صارت بيننا صداقة ممتدة.
وذات يوم كنت فى زيارة له فى مكتبه بـ«أخبار اليوم»، سألنى: ما رأيك فى عمود الصفحة الأخيرة من أخبار اليوم، الذى يحمل توقيع عبدالستار حمودة؟
قلت له: لم ألتفت إليه، ولم أنبهر بالاسم، ولذلك لم أتعرض لمضمون المقال. كشف لى عن أنه اسم وهمى، وأنه هو الذى يكتب مادته، علقت أن الاسم الموقّع به العمود غير جذاب بالمرة.
فسألنى: كيف يكون الإسم إذن؟
قلت: لا أعلم.. لكن لماذا لا تبحث عن أى شخصية مشهورة، شخصية تاريخية، أو فكرية أو فنية، تركت أثرًا فى نفوس الناس.
سألنى: مثل من؟
صمتُ برهة، ثم قلت له: ماذا لو كان توقيع المقال باسم أنور وجدى مثلًا؟
فورًا استدعى إبراهيم سعدة سكرتيرته وأخذ منها المقالة وشطب الاسم، ووضع بدلًا منه اسم أنور وجدى.
وهكذا تحول اسم كاتب عمود إبراهيم سعدة الأسبوعى من عبدالستار حمودة إلى أنور وجدى، وقد استمر لسنوات طويلة، وحقق انتشارًا جبارًا.

محمد المخزنجى قال لى: كنت أضيق كلما سمعت اسمك
استضافت الإذاعية القديرة نادية صالح، فى برنامجها الشهير «زيارة إلى مكتبة فلان»، يوسف إدريس، سألته أسئلة متنوعة، منها: كيف كانت طفولتك؟
فأجاب: كلها شقاء.
سألته: وكيف كان شبابك؟
فقال: هايف.
سألته: من هو أقرب الناس إلى قلبك من خارج عائلتك؟
فمباشرة قال لها: صلاح دياب.
يومها فوجئت وفرحت وشعرت كأننى حصلت على جائزة كبرى.
وعندما اقتربت من الدكتور محمد المخزنجى، من خلال حضوره جلساتنا فى نادى الكتاب، قال لى: أريد أن أصارحك بشىء غريب، كلما كان يذكر اسمك كنت أشعر بشىء من الضيق.
فسألته: لماذا؟
قال: كنت من مريدى يوسف إدريس ومن تلاميذه المقربين، ومشيت على نهجه الأدبى والفكرى، ظننت نفسى أقرب الناس إليه، إلى أن سمعته فى برنامج نادية صالح عندما سألته عن الصديق الأقرب إليه، فأجاب بذكر اسمك، صدمت، فكنت أتوقع أن يقول صديقى وتلميذى الأقرب هو محمد المخزنجى، لهذا لم أحمل لك ودًا إلى أن التقيتك، أما الآن فأستطيع القول إن يوسف إدريس كان محقًا ولم يكن مجاملًا، أراك محرضًا على التأمل والتفكير، أحسست ساعتها أن الدكتور المخزنجى كان أكثر مجاملة ورقة من يوسف إدريس نفسه.

أصدرت المصرى اليوم فى لحظة تأنيب ضمير بسبب مجدى مهنا
كان أحد رجال الأعمال قد أنشأ محطة لتكرير البترول، وأدخل معه «هيئة البترول» شريكا بحصة ٤٠٪، ودفعت له مليارًا ونصف المليار دولار، ثم دفعت الدولة مبلغًا آخر لتزيد حصتها إلى ٦٠٪، كل ذلك دون مناقصات أو مزايدات، بل دون علم بحقيقة التكلفة، ومع الوقت دخل «البنك الأهلى» شريكًا، وخرج مؤسس الشركة بعد أن حصل على مليارات الدولارات، أضعاف تكلفة التأسيس، وذلك حتى قبل بدء المشروع. استفزتنى تلك القصة، التى لم تكن قد خرجت للعلن بعد. وجدت الدولة التى تلجأ للخصخصة هى نفسها التى تدفع مليارات لرجل أعمال لتحول شركته الخاصة إلى القطاع العام، ولم أفهم سبب التوجُّه «للعَمْعَمْة» بدلًا من «الخصخصة»!
طلبت من الدكتور نعمان جمعة أن يُثير تلك القضية الخطيرة على صفحات جريدة «الوفد»، فقال لى: «لو أثرنا تلك القضية فإن الأمر لن يمر على خير، بل أتوقع تصفية جسدية لمَن سيفتح الموضوع»!
كعادتى لم أستسلم، فاتصلت بالصديق مجدى مهنا، رئيس تحرير جريدة «الوفد» وقتذاك، كنت أثق فى نقائه وشجاعته. أعطيته المعلومات التى تُعضِّد وجهة نظرى فى تلك القضية المثيرة للاستفزاز. لقد رأيت عوارًا فى إجراءات انتقال الملكية للدولة بهذا الأسلوب، فكيف لشركة قطاع خاص أن تنقلب إلى قطاع عام بهذه البساطة، ويحقق مؤسسوها أرباحًا بهذه الضخامة؟
وبالفعل تناول «مهنا» الموضوع فى ستة مقالات نارية نُشرت فى جريدة «الوفد» اليومية، آخرها مقال أكد فيه أن الأمر نفسه يكاد يتكرر فى شركة أخرى مملوكة لرجل الأعمال نفسه!
بعدها حدث ما حذر منه الدكتور «نعمان»، فلم يمر شهر على النشر حتى أجبرت الجريدة على إقالة مجدى مهنا!
حزنت وأحسست بذنب وتأنيب ضمير؛ لأننى كنت وراء كل ما حدث للصديق «مجدى». عند تلك اللحظة بالضبط تحركت لإصدار جريدة خاصة، واتفقت مع مجدى مهنا على أن يرأس تحريرها. اشتريت ترخيص جريدة «الزمان» وبدأنا- أنا ومجدى مهنا- إجراءات الإصدار فعليًا فى سنة ٢٠٠٣م. اتخذنا مقرًا مؤقتًا للجريدة بالمهندسين إلى أن توافر مكان أفضل بجاردن سيتى، كان عبارة عن طابق أرضى مساحته ٤٠٠ متر تقريبًا.
بدأ «مهنا» بتكوين فريقه، وخرجت عشرة أعداد تجريبية، لكننى- فى الحقيقة- لم أُعجب بها على الإطلاق. كانت أشبه بمدرسة «روزاليوسف»، ولم أكن أريد للصحافة الجديدة أن تكون تقليدًا لشىء موجود بالفعل. لم يكن ذلك ما تمنيته، لا من حيث الفكرة، ولا المضمون، ولا الشكل. شعرت بأنها قد تكون جريدة جديدة، ولكن بثياب قديمة.
استشرت أصدقائى المقربين من ذوى الخبرة الصحفية، وعلى رأسهم الصحفى الكبير الراحل صلاح منتصر، واتفقوا معى على أن الأعداد «الزيرو»- أى التجريبية- ليست مُرضية، ولن تضيف جديدًا، ولا ترقى لميلاد صحيفة قوية ومتفردة قادرة على الحياة والمنافسة.
فى تلك الفترة، وقعت عيناى مصادفة على مجلة شهرية اسمها «كايرو تايمز» تصدر باللغة الإنجليزية. ذهبت إليه فى مكتبه فى «جاردن سيتى». عرضت على هشام قاسم أن ينضم لـ«المصرى اليوم» ناشرًا، فاشترط أن يجلس أولًا مع مجدى مهنا رئيس التحرير، وبعدها يقرر الرفض أو القبول.
بالفعل التقيا معًا عدة مرات، وللأسف لم يتفقا، وأخبرنى «قاسم» باعتذاره؛ لعدم استطاعته التعامل مع «مهنا»، وبرر ذلك بأن أفكار الأخير «تقليدية وقديمة»، وفقدت صلاحيتها برحيل جمال عبدالناصر!
كانت السياسة التحريرية فيما يخص الشئون الخارجية هى نقطة الخلاف الكبرى بين الرجلين. صار احتدام النقاش بينهما أمرًا معتادًا، وقد حاولت تقريب المسافات بينهما دون جدوى.
الحق أننى انحزت لرؤية هشام قاسم، رأيت أن أفكار «مهنا» - مع حبى وتقديرى له- لا تتناسب مع طبيعة المرحلة، فحسمت أمرى فى هذا الاتجاه، وسألت قاسم: «إذا كان عدم اتفاقك مع مجدى مهنا نهائيًا ولا رجعة فيه، فما الحل؟ هل ترغب فى أن يترك رئاسة التحرير وتتولى أنت مكانه» كانت إجابته مفاجئة لى: «لا.. طلباتى أصعب من هذا بكثير، فليرحل مجدى مهنا ومعه فريقه كاملًا، المكون من ٢٠٠ صحفى، فلكى أستطيع أن أباشر عملى بالجريدة، أشترط أن أبدأ من جديد وبفريق كامل جديد من اختيارى».
صدمنى ذلك الطلب. الحق أننى خشيت معاداة ٢٠٠ صحفى دفعة واحدة، فهم بالتأكيد ليسوا من عوام الناس، فبإمكانهم استهدافى بأقلامهم، لكن بعد تردد حسمت قرارى بالاستغناء عن فريق العمل بالكامل، بعد ثلاثة أشهر فقط، لذلك تم تعويضهم ماديًا ومعنويًا ليتقبلوا بمحبة وود اعتذارنا لهم عن عدم الاستمرار.
أما مجدى مهنا، فكما عهدته فارسًا فى مهنته وأخلاقه. لم ينعكس اختلافنا فى الجريدة على علاقتنا الإنسانية، واتفقنا على أن يكون له «عمود يومى» فى الصفحة الأخيرة للجريدة باسم «فى الممنوع». وصار ذلك العمود أيقونة «المصرى اليوم» إلى أن رحل صاحبه، لكننى ما زلت أحتفظ بصورة خاصة له فى مكتبى لتذكرنى دائمًا به.







