فرض عين.. متى ينتهى التاريخ المُزور فى مدارسنا؟

- لسنوات طويلة ونحن ندرس التاريخ على طريقة التلقين لا مجال للتفكير أو النقاش
- قبل ثورة يوليو 1952 كان يتم حجب تاريخنا بفعل فاعل
دخل علينا أستاذ التاريخ فى محاضرته الأولى لنا فى الجامعة، وقبل أن يبدأ منهجه المقرر علينا سألنا سؤالًا واحدًا: ما هى أسباب فشل الحملة الفرنسية على مصر؟
اتجه إلى السبورة وبدأ يكتب وراءنا الأسباب التى كنا قد حفظناها من كتب التاريخ فى المرحلتين الابتدائية والثانوية.
قلنا: انتشار الطاعون بين جنود الحملة.. فكتبه على أنه السبب الأول.
وقلنا: تحطم الأسطول الفرنسى فى معركة أبوقير البحرية.. فكتبه على أنه السبب الثانى.
وقلنا: استبسال أحمد باشا الجزار والى عكا حتى فشل حصارها.. فكتبه على أنه السبب الثالث.
ظل الأستاذ ممسكًا بالطباشيرة قليلًا فى انتظار ما سنقوله بعد ذلك، لكننا صمتنا، فالتفت إلينا، وقال: وما هو السبب الرابع؟
وقف أحدنا وقال له: هى ثلاثة أسباب فقط؟
رد أستاذ التاريخ: من قال لكم إنها ثلاثة أسباب فقط؟
تطوع زميل آخر ورد عليه: هذا ما درسناه فى كتب التاريخ فى المدرسة.

دون سخرية، رغم أن الموقف كان يستحق السخرية، قال أستاذ التاريخ: لن ألوم عليكم.. فهذه هى المشكلة الفعلية، لقد درستم التاريخ فى المدارس بشكل خاطئ، أنتم تعيدون وتكررون ما حفظتم فى كتب التاريخ المدرسية.. والواقع أن التاريخ ليس كذلك.
تذكرت هذه الواقعة وأنا أتابع حالة الجدل المتهافتة حول تدريس التاريخ من عدمه فى المدارس، وهو جدل يؤكد أننا وصلنا بالفعل إلى حافة الانهيار، أوشكنا على السقوط الكامل، أصبحنا على مقربة من الخروج من التاريخ نفسه دون أن تكون لدينا أدنى فرصة للدخول إلى المستقبل.
لم يقل أحد أبدًا بعدم دراسة التاريخ فى مدارسنا.
حتى الصديق العزيز تامر أمين الذى وجد نفسه محاطًا بحالة هائلة من الهجوم بسبب دعوته لعدم دراسة التاريخ، لم يقل ذلك.
كان فقط يقدم رؤية لدراسة التاريخ فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، على أن تكون الدراسة فى الثانوية للمواد المؤهلة لسوق العمل.
قد تختلف مع هذه الرؤية أو تتفق، تقبلها أو ترفضها تمامًا، لكن لا يمكن أن تتهم أحدًا بأنه ينادى بعدم دراسة التاريخ، لأنه لا يفعلها عاقل أبدًا.
المشكلة الحقيقية ليست فى دراسة التاريخ من عدمه، فدراسة التاريخ بالنسبة لى فرض عين، لا بد أن يؤديها كل مواطن، المشكلة هى كيفية دراسة هذا التاريخ، طريقة التعامل معه والتعاطى مع ما يزخر به، واستقباله فى مراحل حياتنا المختلفة.
لسنوات طويلة ونحن ندرس التاريخ على طريقة التلقين، لا مجال للتفكير أو النقاش أو الاعتراض على ما جاءتنا به الكتب الدراسية أو حتى غير الدراسية، وهو ما أفقد التاريخ سحره وجاذبيته وقدرته على الحضور والتأثير فى حاضرنا ومستقبلنا.
لقد تركنا تاريخنا فى أيدى من يعبثون به حتى تحول إلى ضحية، لم ندافع عنه، ولم نتصد لكتابته وتدريسه بالطريقة التى تليق به، وتليق بدولة تاريخها يمثل جزءًا كبيرًا من ثقلها وحضورها وتأثيرها.
قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ كان يتم حجب تاريخنا بفعل فاعل.
عندما كتب العقاد كتابه المهم «ضرب الإسكندرية»، وهو الكتاب الذى يسجل فيه أدوار حكام مصر منذ سعيد وعباس وحتى إسماعيل وتوفيق فى تمهيد الأرض لاحتلال مصر، قام الملك فاروق بمصادرة الكتاب ومطاردته، وعندما قابل الرئيس جمال عبدالناصر العقاد لأول مرة فى العام ١٩٥٨ قال له إنه قرأ الكتاب عندما حصل على نسخة مهربة منه من وراء ظهر الرقابة.
لم يكن المصريون حتى ١٩٥٢ يعرفون أدوار أحمد عرابى ومصطفى كامل ومحمد فريد فى الحركة الوطنية المصرية، فقد تم حجب ما فعلوه، وعندما جاءت الثورة أزاحت التراب من على صفحاتهم وأعادت لهم الاعتبار مرة أخرى، وأصبح تاريحنا يبدأ من عندهم وحدهم.

وفى مقابل ذلك اجتهدت الثورة فى طمس كل ما يتعلق بالعقود التى سبقتها، وأهالت التراب من جديد على كل ما يتعلق بأسرة محمد على، فتزاحمت الحقائق إلى جوار الأكاذيب، فلم نعد قادرين على رسم صورة حقيقية لما حدث.
وبعد أن خرج الإخوان من السجون فى بدايات عصر الرئيس السادات بدأوا فى كتابة فترة الرئيس عبدالناصر على هواهم وطبقًا لمزاجهم، فشكلوا وعى أجيال متعاقبة من خلال الأكاذيب والمبالغات التى وثقوها فى كتبهم التى كانت تُباع بأسعار زهيدة حتى يضمنوا لها الانتشار والرواج والتأثير.
لقد غزت هذه الكتابات دراسات وكتبًا ومقالات حتى الذين يختلفون مع الإخوان، فاستسلموا لها، ولم يستطيعوا أن يخرجوا من أسرها، لأنه لم تكن هناك رواية أخرى تقابلها وتفندها وتعرض الحقائق على الناس.
لم يكن لدينا دليل على أن التاريخ الذى كتبه الإخوان مزور وزائف بشكل كامل، لكننا كنا نتشكك فيه، فالنقد الداخلى لروايات من كتبوا من الجماعة كان يشير إلى أنها تفتقد المنطق، لكننا لم نتصد لها بما يتناسب معها وبما تستحقه من تفنيد وتدقيق ومراجعة.
وحتى عندما تأكدنا من بعض ما جرى لم نحرك ساكنًا.
كان أبوالعلا ماضى أحد قيادات الإخوان السابقين فى سنوات خروجه على الجماعة وقبل أن يعود إليها مرة أخرى، قد كتب مقالًا فى جريدة «العربى» الصادرة عن الحزب الناصرى، يناقش فيه مقولة الإخوان المؤسسة «بيننا وبينهم الجنائز».
كانت الجماعة تعلم أعضاءها أنهم ليعرفوا الفارق بينهم وبين خصومهم فليس عليهم إلا أن يقارنوا جنائزهم وجنائز من ليسوا معهم.

تأمل أبوالعلا المقولة الإخوانية فوجد أن جنائز خصوم الإخوان ومن يناصبونهم العداء تفوق أعداد جنائز أعضاء الجماعة، وضرب مثلًا على ذلك بجنازة الرئيس جمال عبدالناصر تحديدًا التى كانت مثل يوم الحشر.
بعد نشر المقال التقى أبوالعلا ماضى بيوسف ندا، وهو واحد من قيادات الإخوان الكبار، كانوا يلقبونه بوزير ماليتها، عاتب ندا أبوالعلا، إذ كيف يفكك هذه المقولة الأساسية التى تعتمد عليها الجماعة فى تربية كوادرها؟
رد أبوالعلا بأنه فكر وتأمل فوجد أن هذه المقولة ليست صحيحة، وأن هناك كثيرًا من كتابات الإخوان تستحق المراجعة، وضرب مثلًا على ذلك بكتاب زينب الغزالى «أيام من حياتى»، وهو الكتاب الذى تحكى فيها تجربتها فى السجن الحربى أيام الرئيس جمال عبدالناصر.
ضحك يوسف ندا وقال لأبوالعلا: هل تعرف أننى من كتبت هذا الكتاب؟ فزينب الغزالى لم تكتب فيه شيئًا، وقد تعمدت أن أنسج فيه كثيرًا من قصص التعذيب فى محاولة لشحن المصريين وحشدهم ضد نظام عبدالناصر.

عرفنا ذلك.. لكن هناك من لا يزال يصدق زينب الغزالى ويردد ما قالته.
ومع بداية السبعينيات فتح السادات الباب أمام مَن يريدون انتقاد عهد عبدالناصر، وكانت ضربة البداية من مقال كتبه مصطفى محمود فى مجلة «صباح الخير»، كان عنوانه «شكرًا يا أنور السادات» وكتبه فى مايو ١٩٧١، لتتوالى بعد ذلك المقالات والكتب التى نسبت لعبدالناصر ما لم يقله مالك فى الخمر.
وعندما ضاق هيكل ذرعًا بعد سنوات بما كتب عن عبدالناصر أصدر كتابه «لمصر لا لعبدالناصر»، فند فيه ببراعة وعقل ومنطق ومستندات كل ما نسب لعبدالناصر.
ورغم أن كتاب هيكل موجود ولا يزال يصدر فى طبعات عن دور نشر مختلفة، ورغم أن أجيالًا متعددة قرأت الكتاب إلا أن الاتهامات لا تزال مسلطة على رقبة عبدالناصر، نعيد إنتاجها دون النظر فيها أو الاهتمام بأن هناك من تصدى لها.

ماذا يعنى ذلك؟
معناه أن الرواية الأولى يكون لها التأثير الأكبر والأبقى.
ومعناه أيضًا أننا تركنا تاريخنا طويلًا للأيادى العابثة تمرح فيه كما تشاء، وكانت النتيجة أن تاريخنا أصبح كائنًا مشوهًا لا نستطيع أن نعرف له ملامح ولا نستقر معه أو به على حال واحدة.
إننا نفتقد جزءًا مهمًا وكبيرًا من تاريخنا، لأن عددًا لا يستهان به من السياسيين ماتوا دون أن يتركوا وراءهم مذكراتهم التى هى مصدر مهم من مصادر التاريخ، وحجتهم فى ذلك أن ما قاموا به وما عاشوه فى مناصبهم الرسمية ليس ملكًا لهم، فهناك أمور تتعلق بأسرار الدولة العليا وليس من حقهم أن يفصحوا عنه، وهو كلام يحتاج إلى كلام، وحجة تستحق أن نأتى عليها كاملة، لأنها ليست منطقية وواقعية، فتاريخ هذا البلد ملك لمن يعيشون فيه.
على عكس السياسيين كتب المثقفون والمفكرون والصحفيون مذكراتهم، واضعين بين أيدينا زخمًا هائلًا عن تاريخنا الثقافى والفكرى، لكننا للأسف الشديد تركنا هذا التاريخ دون دراسة جديرة به، فأصبح ركامًا متراكمًا، لا نستفيد منه بشىء، رغم أن هذا التاريخ يستحق القراءة والتأمل والبحث والتحقق والتدقيق.
أعرف أن زحام الحياة أصبح حاكمًا، وأن التطورات التكنولوجية أصبحت تحيط بنا من كل جانب، وأن علوم ووظائف المستقبل صارت هى الهم الأكبر والأساسى للجميع، لكن ليس معنى هذا أن ننفى التاريخ، وأن نتركه وراء ظهورنا، لأن تاريخنا هو نحن، بدونه لن نستطيع أن نفهم أنفسنا أو نفهم الآخرين، وبدونه لن نستطيع أن ندافع عن أرضنا وأمننا وحاضرنا، ولن نستطيع كذلك أن ندخل إلى المستقبل.

لكن السؤال هو: عن أى تاريخ نتحدث؟
هل هو التاريخ الذى ندرسه لأولادنا فى المدارس؟
هل هو التاريخ الذى كُتب بأمزجة وأهواء وعواطف من كتبوه ليحققوا مصالحهم ويدافعوا عن أنفسهم ويتبرأوا مما فعلوه؟
هل هو التاريخ الذى يريده لنا خصومنا من كل اتجاه؟
هل هو التاريخ الصامت الأصم الذى لا يفيدنا بشىء؟
هل هو التاريخ المقرر فى المدارس ليمتحن فيه الطلبة وبعد أن ينتهوا من اختباراتهم يصبح وكأن شيئًا لم يكن؟
إننى هنا لا أتحدث عن دراسة التاريخ، وهى فرض عين على الجميع، ولكننى أتحدث عن ثقافة قراءة التاريخ، وهى ثقافة لا بد أن تلازمنا طوال حياتنا على اختلاف تخصصاتنا، فالتاريخ لا يجب أن يكون مقصورًا على من يدرسونه أو يتخصصون فيه، لا بد أن يكون التاريخ طعامًا على كل مائدة، دون أن نستهين بذلك أو نقلل من شأنه.
لقد طالبت- وما زلت- بتوثيق كل الأحداث التى مرت بها مصر منذ ٢٠١١ وحتى الآن، واقترحت أكثر من مرة أن تكون هناك لجان متخصصة لتوثيق هذه الأحداث، وتركها للأجيال القادمة ليعرفوا على وجه التحديد ما الذى حدث فى مصر، بدلًا من أن نترك ذلك لمن يصيغونه على هواهم.
هل تريدون مثالًا واضحًا على ذلك؟
منذ سنوات صدر عن المركز العربى للأبحاث والدراسات، الذى يرأسه عزمى بشارة، مجلدان بعنوان «ثورة مصر»، الجزء الأول «من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير»، والثانى «من الثورة إلى الانقلاب».
حرصت على اقتناء المجلدين، للوهلة الأولى اعتقدت أنهما ليسا متوافرين فى مصر، فطلبت من بعض الأصدقاء فى قطر أن يرسلوا لى بنسخة من المجلدين، وبعد أيام فوجئت أنهما متوافران هنا فى القاهرة ويُباعان بشكل عادى جدًا.
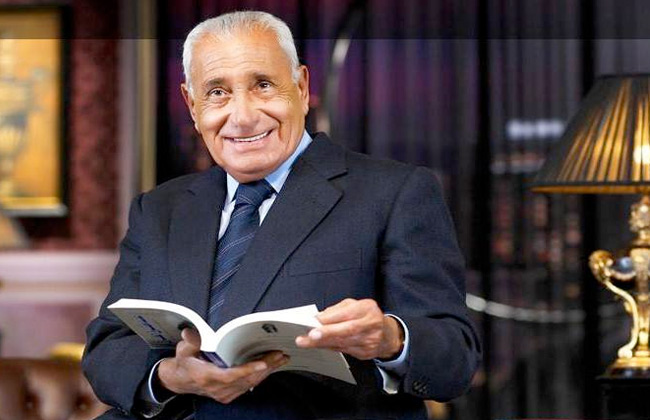
بدأت فى تصفح ما كتبه عزمى بشارة وفريق بحثه عن الأحداث التى شهدتها مصر فى ٢٠١١ و٢٠١٣، فوجدت أكبر عملية تزوير للتاريخ، ويكفى أنه يصدر فى عنوان الجزء الثانى أن ما حدث فى ٣٠ يوليو انقلاب.
الكتاب للأسف الشديد موجود ومنتشر ويستعين به الباحثون، وأعتقد أنه سيظل موجودًا، دون أن تكون هناك رؤية أخرى فى رواية الأحداث... وهذا ما أقصده، فلابد أن نكتب تاريخنا قبل أن يكتبه الآخرون ثم يقوموا بتصديره لنا.
قضية التاريخ أهم وأكبر وأعقد وأخطر من مناقشات هزلية وهزيلة عن جدوى تدريسه من عدمها، لا بد أن يكون اهتمامنا منصرفًا لكيف نكتب التاريخ؟ وكيف نقوم بتدريسه لأولادنا؟، وكيف نكون قادرين على قراءته طوال الوقت؟
وبغير ذلك لا تحلموا بمستقبل.. أى مستقبل.









