أنــور مغيث: البشر الآن لا يريدون الفلسفة من باب «لازمتها إيه»؟

- تراجع الاهتمام بالفلسفة خارج نطاق الجامعة منذ الثمانينيات
- الإنتاج الفلسفى أصبح محدودًا وغالبًا ما يقتصر على الكتب التعليمية للطلبة
- تعلمت من أساتذتى فى مصر وفرنسا عدم قول أى شىء دون مراجعة دقيقة
- استفدت من زكى نجيب محمود لكن انسجامى أكبر مع حسن حنفى وفؤاد زكريا
- الاهتمام بما بعد الموت لا يزال يشغل جزءًا كبيرًا من التفكير العربى اليوم
- من حق المواطن العادى قراءة دوستويفسكى ومشاهدة الأفلام الأجنبية
- لولا جهود العرب فى ترجمة أعمال الفلاسفة الإغريق لانهارت حضارة اليونان
- لا توجد جهة فى مصر تمنح الدعم الكافى لترجمة الكتب العربية وإيصالها للعالم
- كل إنتاج الجامعات اليوم لا يستحق أن يخرج إلى الشارع
- العرب يفتقرون للحس النقدى.. والأكثر قلقًا هو أن يصدّق خريجو الجامعة الأفكار الخرافية
فى زوايا الحياة المزدحمة بالضوضاء والمعلومات السطحية، هناك عقل يرفض الانصياع للعادة، ويسعى إلى استكشاف المعنى خلف الظواهر، هذا العقل هو عقل المفكر والفيلسوف الدكتور أنور مغيث، تجلس أمام كتاب مفتوح، ولا تعرف هل ستجد فيه إجابات عن أسئلتك، أم مزيدًا من التساؤلات التى تشوش ذهنك، وهذه هى اللحظة التى يعيشها كل من يختار أن يكون فيلسوفًا.
الفلسفة عند أنور مغيث ليست مجرد تخصص جامعى، ولا رفاهية ثقافية، بل أداة لفهم العالم، وتحويل القلق إلى وقود للبحث، والسطحية إلى تأمل، ومن ينظر فى منجزه العلمى يرى إنسانًا يبحث عن ذاته وسط عبث الواقع، ونلمس قدرة الترجمة على إعادة صياغة المعنى، وجعل الفكر العربى شريكًا فاعلًا فى الحوار العالمى، لا مجرد تابع له.
من دراسته فى فرنسا على يد كبار الفلاسفة، إلى تعليمه فى مصر بين أساتذة متميزين، يصل بنا «مغيث» إلى رؤية فلسفية متكاملة، الفلسفة وسيلة لفهم الحياة والوعى والعدالة والديمقراطية، أداة للتأمل وسط الإحباط، ومنهج للتفكير فى عصر يهيمن عليه الذكاء الاصطناعى وسرعة المعلومات.
فى حواره مع «حرف» يحكى أنور مغيث كيف يمكن للفكر أن يكون نبراسًا للوعى؟ وكيف تتحول الترجمة إلى شريك فى إنتاج المعنى، لا مجرد جسر لغوى؟ لتصبح الفلسفة ممارسة يومية تتجاوز حدود الجامعة إلى حياة الإنسان نفسها.
■ نشأت فى بيت يقدّس القراءة، وتربّيت وسط جيل يقدّر المعرفة كطريق للنهضة.. متى اكتشفت أن الفلسفة ستكون قدرك؟
- فى الواقع كان اكتشافى الفلسفة كقدرى أمرًا متأخرًا نسبيًا، وبالتحديد خلال فترة الجامعة، قبل ذلك، لم تكن الفلسفة جزءًا من اهتماماتى، رغم شغفى بالقراءة والثقافة، لم يخطر ببالى أبدًا أن أصبح متخصصًا فيها أو أن أدخل قسم الفلسفة.
عندما التحقت بكلية الآداب كانت الفلسفة آخر خيار فى استمارة الرغبات، وبدأت فى قسم اللغات الشرقية، بعد شهر فقط تم افتتاح قسم اللغة اليابانية لأول مرة فى الشرق الأوسط، وانتقلت إليه، نظرًا لأن دراسة اليابانية تتطلب التفرغ والانضباط الكامل، إذ لم يكن من الممكن قراءة الكتب خارج الجامعة بسهولة، وكانت اللغة نفسها جديدة تمامًا على مصر.
فى تلك الفترة كان الوقت الأكبر داخل الجامعة يذهب لممارسة النشاط السياسى، وليس حضور المحاضرات، لذلك فى نهاية العام تحولت إلى دراسة الفلسفة، لم يكن هذا قرارًا مدروسًا أو خطة وضعتها مسبقًا، بل جاء كنتيجة للظروف التى فرضها الواقع، لذلك يمكن القول إن الفلسفة كانت بالفعل قدرى.

■ درست فى فرنسا على يد فلاسفة كبار مثل جان لوك نانسى وجورج لابيكا، وتعلمت فى مصر على يد أساتذة مثل فؤاد زكريا وزكى نجيب محمود. كيف أثّرت هذه المدرسة المزدوجة- المصرية والفرنسية- فى تكوينك الفكرى؟
- تأثير هذه المدارس لم يكن مباشرًا على أفكارى، بل جاء أولًا عبر خلفيتى الفكرية السابقة، خصوصًا انحيازى لفكرة العدالة الاجتماعية والنضال من أجل الطبقات الشعبية، أى التوجه اليسارى، هذا الانحياز ساعدنى على اختيار ما يميل إليه عقلى من أفكار الفلاسفة، حتى وإن اختلفت المدارس أو السياقات التى جاءوا منها.
من الجانب التربوى، تعلمت من أساتذتى فى مصر وفرنسا أهمية البحث الدقيق عن المعلومة، وعدم قول أى شىء دون مراجعة دقيقة، والانتباه إلى دقة المصطلح والفكر، هذه المهارات الأكاديمية كانت بلا أى خلفية أيديولوجية مسبقة، لكنها ساعدتنى على صقل تفكيرى النقدى.
بين الأساتذة المصريين، استفدت كثيرًا من الدكتور توفيق الطويل وزكى نجيب محمود، لكنى شعرت بانسجام أكبر مع الأساتذة المتمردين، مثل الدكتور حسن حنفى وفؤاد زكريا، اللذين كانت لديهما قدرة على الجمع بين العقلانية والتمرد والاهتمام بالعدالة الاجتماعية، وهو ما أصبح جزءًا من رؤيتى الفلسفية الخاصة.
■ تتردد فى كتاباتك فكرة «الندّية الفكرية» عند حوارك مع فلاسفة الغرب.. برأيك، كيف يمكن للمفكر العربى أن يتحاور مع الغرب دون أن يشعر بالدونية؟
- الحوار مع أى مفكر، سواء كان غربيًا أو يابانيًا أو صينيًا، يقوم على أساس التخصص والموضوعية فى الفلسفة، وليس على مسألة كرامة أو شعور بالدونية، الندية الفكرية ليست شعورًا بالغرور، بل لها علامات موضوعية واضحة، مثل إتقان اللغات وإلمام واسع بالتراث الفلسفى والمدارس الفلسفية المختلفة.
فى نفس الوقت يظل لكل مفكر سياقه المجتمعى واهتماماته المختلفة؛ فالمشكلات والآمال التى يعيشها المفكر العربى تختلف عن تلك التى تواجه أستاذًا غربيًا، ولكن المهم أن تكون أفكاره مستندة إلى معرفة حقيقية، وليست مجرد انحياز لهوية أو تكرار أفكار لا يمكن إثباتها.
الغاية أن يكون للمفكر العربى حجج واضحة، بحيث يمكن أن يقنع حتى مفكرًا غربيًا، سواء يابانيًا أو فرنسيًا، بأن موقفه مدروس ومعقول. الندية هنا تعنى القدرة على تقديم الفكر العربى بشكل أصيل وجدّى، وليس مجرد طرح أفكار عشوائية أمام الآخر الغربى، ومن ثم يصبح التعليم الفلسفى الجاد، الذى يؤهل المفكر العربى للمنافسة على نفس المستوى، ضرورة أساسية.
■ ما معنى أن تكون فيلسوفًا عربيًا فى زمن يبدو فيه العالم العربى منشغلًا بالنجاة لا بالتفكير؟
- هذه بالفعل مشكلة كبيرة وطبيعية إلى حد ما، فالبشر دائمًا لديهم هواجس وهموم حول مصيرهم بعد الموت، مثل التساؤل عن النجاة فى الآخرة وما يجب فعله فى الدنيا لضمانها، هذه أسئلة مشروعة، لكنها تصبح إشكالية حينما تشغل الإنسان لدرجة إهماله ضرورات حياته اليومية، وتغيب عنها سبل العيش المشترك مع الآخرين، وحتى حقوقه التى قد تمنحه شعورًا أكبر بالحرية.
التعلق المفرط بمسألة النجاة فى الآخرة قد يصادر كل الجهود المبذولة لتحسين الحياة الدنيوية، فالمعرفة عند أرسطو كانت هدفها الحكمة والارتقاء بالسعادة، أما فى العصور الوسطى فقد صارت المعرفة وسيلة لضمان النجاة الآخرة، بينما مع الحداثة أصبحت المعرفة وسيلة لتحسين وضع الإنسان، وزيادة رفاهيته، وتمكينه من التحكم فى الطبيعة، كما يقول ديكارت، فلا يكتفى الإنسان بمعرفة الظواهر، بل يسعى لتطبيقها عمليًا فى اختراعات وتطوير حياة البشر.
حين ننظر إلى العالم العربى حتى اليوم، بعد عدة قرون من الحداثة، نلاحظ أن الاهتمام بما بعد الموت ما زال يشغل جزءًا كبيرًا من التفكير، وهذا ينعكس بلا شك على تخلف الحياة العملية والاجتماعية، لذا أن تكون فيلسوفًا عربيًا اليوم يعنى مواجهة هذا التحدى: محاولة نقل الاهتمام من النجاة وحدها إلى تحسين الواقع الحياتى والمعيشى للإنسان.

■ كنت من أبرز الأصوات التى رأت فى الترجمة «ممارسة فلسفية» وليست مجرد نقل للنصوص.. كيف تفهم الترجمة اليوم وأهميتها للفلسفة؟
- الترجمة، بمعناها الواسع، حق لكل مواطن، لا يمكن لأى لجنة أو جهة أن تحدد ما يجب أن يُترجم لمصلحة المجتمع وحده، فالمواطن العادى له الحق فى قراءة دوستويفسكى، والاستماع إلى الموسيقى العالمية، ومشاهدة الأفلام الأجنبية. الترجمة هنا تمنح الإنسان فرصة العيش فى عصره وفهم ملامحه واتجاهات العالم، ومعرفة ما يختاره لنفسه من أفكار، دون أن يكون أسير انغلاق أو جمود فكرى.
أما بالنسبة للفلسفة، فالموضوع أعمق، الفلسفة بدأت عند اليونان، حيث شهدت حضارة متكاملة من مسرح وشعر وعلم، لكنها تطورت فى شكلها الفلسفى الخاص، وعندما انهارت الحضارة اليونانية كان من الممكن أن يختفى هذا الإرث، لولا جهود العرب فى ترجمة أعمال الفلاسفة اليونانيين، مثل أفلاطون وأرسطو، إلى اللغة العربية، ومناقشتها وتحليلها، ثم إعادة ترجمتها لاحقًا إلى اللاتينية، ما مهّد الطريق لنشوء الفلسفة الأوروبية.
التجربة تعلمنا أن الترجمة لا تقتصر على نقل الكلمات، بل على تحويل الفكر إلى خطاب عالمى، يُفهم فى أى سياق، مع الاحتفاظ بصبغته الثقافية الأصلية. الفيلسوف نفسه، حتى حين يقرأ دون ترجمة عربية، يترجم هذه الأفكار فى ذهنه ليعيها ويفكر فيها، لأن الفلسفة لا يمكن أن تتطور بمعزل عن الحوار مع فكر الآخرين.
وبالرغم من الدعوات المتكررة لإنتاج فلسفة عربية صرفة بمعزل عن التراث الفلسفى العالمى، فإن أى فلسفة حقيقية هى خطاب كونى، موجّه للإنسان عامة، لكنه يبقى متأثرًا بثقافة المؤلف ولغته. فالكتابة بالعربية، مثلًا، تتأثر بالشعر والنحو والبلاغة العربية، لكنها فى نفس الوقت يجب أن تكون مفهومة لأى قارئ عالمى، سواء صينيًا أو يابانيًا أو أمريكيًا، وكما قال ديكارت باللاتينى: «أكتب حتى للمسلمين»، أى أن الخطاب الفلسفى يجب أن يكون إنسانيًا فى غايته، ولكنه متجذر فى الثقافة التى صيغ فيها.
■ إلى أى مدى يمكن للمترجم أن يكون شريكًا فى إنتاج المعنى، لا مجرد وسيط بين لغتين؟
- المترجم يجب أن يكون شريكًا فى إنتاج المعنى، لكن على شرط أن يتحرر من شيئين أساسيين: الأول، الترجمة الحرفية، لأنها سهلة لكنها سطحية؛ بمجرد أن أجد مرادفًا للكلمة أضعه وأكتفى، دون التأكد من عمق المعنى فى السياق الجديد. الثانى، الحرص على جعل النص مفهومًا للقارئ، بحيث لا أحذف ما لم أفهمه لتسهيل المهمة، لأن هذا يقلل من وفائى للمؤلف الأصلى.
لذلك يجب على المترجم أن يبذل جهدًا، يقرأ ويستفسر ويسأل الممارسين الأحدث خبرة، حتى يقترب من المعنى الأصلى قدر الإمكان. الشراكة تظهر بوضوح من خلال مصير الكتب المترجمة: فالكتاب فى لغته الأصلية قد يُقرأ ويُنتقد ويُشاد به، لكن عند نقله إلى لغة أخرى يُعاد وضعه فى سياق جديد. هنا، المترجم يمنح النص حياة ثانية، حيث يبدأ القارئ اليابانى أو الفرنسى أو العربى فى التفاعل مع الكتاب من منظوره الثقافى وسياقه الواقعى.
كما يشير دريدا، الترجمة ليست مجرد نسخة أو صورة فوتوغرافية للنص الأصلى، بل هى خلق عمر جديد للكتاب، يسمح له بأن يُفهم ويُناقش فى ثقافة مختلفة، فيصبح المترجم فعليًا شريكًا فى إنتاج المعنى وإعادة صياغته، دون أن يفقد نصه أصالته.
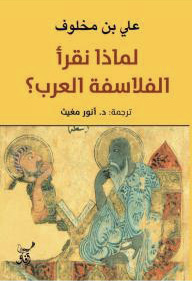
■ برأيك، ما الذى ينقص مشروع الترجمة العربى ليصبح مشروعًا حضاريًا متكاملًا، وليس مجرد جهد فردى؟
- المشروع الحضارى للترجمة لا يمكن أن يُترك بالكامل للمبادرات الفردية، لأن الإنتاج الفكرى والأدبى والإبداعى يعتمد غالبًا على جهود الأفراد، والفنان أو المترجم المتميز يلقى قبولًا جماهيريًا ويصبح مؤثرًا. الدولة ليست مُنتجًا للفكر، لكنها يمكن أن توفر الرعاية والدعم اللذين يحولان هذه المبادرات الفردية إلى مشروع شامل.
التاريخ يوضح ذلك بجلاء: فقد دعم «المأمون» الترجمة بدفع الذهب للمترجمين، وفى عهد محمد على تم تكليف المبعوثين بالدراسة والترجمة قبل مغادرتهم البلاد، وتمويل المدارس المتخصصة للترجمة. هذه أمثلة على دور الدولة فى تمكين الترجمة من أن تصبح جزءًا من مشروع حضارى.
أما إذا تُركت للجهود الفردية أو دور النشر الخاصة فقط، فسينحصر الإنتاج فى الكتب الأكثر مبيعًا، غالبًا الروايات الخفيفة، كما حدث فى نهاية القرن التاسع عشر حين كانت الترجمات تتضمن أغلبها روايات عاطفية أو بوليسية أو مغامرات، بينما تظل الدراسات الأساسية فى الاقتصاد والقانون والفكر والفلسفة شبه غائبة.
الدولة هنا ليست مجرد داعم مالى، بل هى التى تخلق إطارًا يسمح للترجمة بأن تكون أداة للإشعاع الثقافى والقوة الناعمة، كما يحدث فى فرنسا وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا والنرويج، حيث تُقدم منح لترجمة الكتب ودعم نشرها عالميًا. بالمقابل، فى مصر والعالم العربى لا توجد جهة تمنح الدعم الكافى لترجمة الكتب العربية وإيصالها للعالم، ما يجعل المشروع العربى للترجمة محدودًا، وغير قادر على أن يكون مشروعًا حضاريًا متكاملًا يواكب التقدم العالمى.

■ فى مصر، ما زالت الفلسفة تعامل كترفٍ ثقافى لا كضرورة فكرية. برأيك، كيف يمكن إعادة الاعتبار للفكر الفلسفى فى التعليم والإعلام؟
- الفلسفة مادة تعليمية تحتاج إلى جهد وموارد: مدرسين، مرتبات، وقت للطلاب، امتحانات وتصحيح. إذا لم تُعتبر ضرورية، يختصر البعض الطريق ويلغونها. لكن معيار الإلغاء غالبًا يكون خاطئًا، مثل التركيز على سوق العمل فقط. على سبيل المثال، هل سيحتاج الشخص المتخصص فى الهندسة أو الطب إلى معرفة المتنبى أو الجغرافيا؟ بالطبع لا. ولكن هذا ليس معيارًا حقيقيًا لتحديد قيمة مادة تعليمية.
المنظور الأفضل هو مقارنة التعليم العربى بالدول المتقدمة: أغلب الدول الناجحة تدرّس الفلسفة، على الأقل فى السنة النهائية للثانوية العامة، لأنها تعلم مهارات التفكير، المنهجية، وقدرة الطالب على تكوين رأيه والدفاع عنه بحجج عقلية. الفلسفة لا تمنح فقط المعرفة، بل تعلم كيفية الوصول إلى المعرفة.
الفلسفة تُعلم الطالب منهج التفكير: كيف يصل من الجهل إلى المعرفة بطريقة منظمة، وكيف يستخدم المنطق، ويقيّم الحجج، ويحدّد المصطلحات بدقة، ويقدّر قيمة الأدلة. هذه المهارات أساسية ليس فقط للتعليم الجامعى أو المهنى، بل للحياة اليومية أيضًا.
فى التعليم الجامعى، حيث يبدأ التعليم المهنى، يحتاج الطالب إلى مهارات التفكير النقدى والمنطقى التى تمنحها الفلسفة، ليس فقط ليصبح متخصصًا فى مجال معين، بل ليكون قادرًا على التعامل مع المعلومات، تحليل المشكلات، واقتراح حلول منطقية ومؤثرة. الفلسفة إذًا ليست ترفًا، بل ضرورة فكرية تُعد الإنسان للمجتمع والعالم.
■ هل ترى أن غياب الفلسفة من الوعى العام له دور مباشر فى انتشار الخرافة والتطرف؟
- بالتأكيد، انتشار الخرافة والتطرف له أكثر من سبب، وأحدهما الجهل الأساسى، مثل الأشخاص الذين لم يدخلوا مدارس أصلًا، فهذا أمر متوقع وطبيعى. لكن الأمر الأكثر قلقًا هو عندما يكون الشخص متعلمًا، حاصلًا على ليسانس أو خريج جامعة، ومع ذلك يصدق أفكارًا غير منطقية أو خرافية.
فى أوروبا، على سبيل المثال، لو حاولت إقناع شخص متعلم بشىء غير واقعى، سيكتشف بسهولة أن هذا الكلام غير منطقى. بينما فى بعض المجتمعات العربية، قد يُقبل على هذا الكلام، لأنه يفتقر إلى الحس النقدى، وهو عنصر أساسى يجب أن تمنحه الفلسفة.
إحدى الغايات الرئيسة لتدريس الفلسفة، تطوير الحس النقدى لدى الإنسان: أن يسمع، يفكر، يقارن، ولا يقبل كل ما يُقال دون تدقيق. فالشخص صاحب الحس النقدى لا يصدق أى خرافة، بل يحلل المعلومات ويقرر بناءً على دليل ومنطق. وهذا يعزز وعيه ويقيه من الانجرار وراء التطرف أو المعتقدات غير المستندة إلى فكر عقلانى.

■ هل تعتقد أن الفلسفة تمنح صاحبها الطمأنينة أم تزيده قلقًا وتساؤلات مستمرة؟
- أنا أرى أن الفلسفة تزيد الإنسان قلقًا وتساؤلاته، بل تزيد القلق حوله أيضًا. ولهذا السبب كثيرون يريدون إسكات صوت الفيلسوف، متسائلين: «الفلسفة هتفيد بإيه؟ لزمتها إيه؟» لأن الفيلسوف، حتى عندما يتحدث، لا يريح الآخرين، بل ينقل لهم قلقه وأسئلته.
ولكن هذا القلق له قيمة: أولًا، يمنح الإنسان شعورًا بأنه قد انتقل إلى مرحلة أعلى فى تكوينه الذاتى. كما قال هيوم عن نفسه: كان نائمًا ومستريحًا على عقائده، لكنه استيقظ بقلق الفلسفة، والشعور باليقظة أفضل من الراحة السطحية السابقة.
ثانيًا، كما كان سقراط يقول: لو خُير بين الحقيقة وبين البحث عنها، لاختار البحث عنها. فالميزة ليست فى الحصول على الحقيقة جاهزة، بل فى الشغف بالبحث عنها. وهناك مثال من محاورات أفلاطون يوضح هذا: «جاء شاب يريد التعلم عند بروتاغوراس»، فسأله سقراط: «إذا ذهب هذا الشاب إلى مختلف المعلمين، ماذا سيصبح؟»، فأجاب بروتاغوراس: «سيعود إلى بيته وهو أفضل»، إذًا الفلسفة ليست وسيلة لمهنة أو لقب، بل رحلة تحسين الذات وتنمية العقل والوعى.
■ فى كتاباتك ومواقفك دافعت عن الديمقراطية والعلمانية بوصفهما شرطين أساسيين للعقل الحر. كيف ترى موقع هاتين الفكرتين اليوم فى الواقعين المصرى والعربى؟
- الهدف من الدفاع عن الديمقراطية والعلمانية ليس مجرد تقليد للغرب أو استيراد الحداثة كما هى، فالفكرة ليست أن ننسخ النموذج الغربى. الحداثة فى جوهرها عملية منظمة تعتمد على مؤسسات واضحة: انتخابات نزيهة، برلمان، صحافة حرة، مؤسسات قانونية. أى دولة تريد التقدم يجب أن تتبع هذه الأسس، من اليابان إلى البرازيل، ولا توجد حداثة خاصة بمعزل عن هذه المعايير.
الديمقراطية، رغم تحدياتها، أساسية لأنها حق الإنسان فى المشاركة واتخاذ القرار، حتى لو كانت نتائجها غير مرضية أحيانًا. المشكلة تكمن عندما يُتوقع أن يختار الشعب بعقلانية بينما الواقع يظهر أن كثيرين يصرون على مواقف متطرفة أو خرافية. فمثلًا، فى بعض استطلاعات الرأى بمصر، طالب ٦٥٪ من المستجيبين بعقوبات صارمة على المرأة الزانية، وهو مثال على أن ممارسة الديمقراطية تحتاج إلى وعى ونزاهة، وإلا قد تُستخدم القرارات لتقييد الحريات بدلًا من تمكينها.
أما العلمانية، فهى ضرورية لسببين رئيسيين: أولًا، لأنها تضمن حرية الضمير لكل فرد، فلا يُكره أحد على اعتقاد معين، وهذا ما أكده جون لوك منذ قرون. ثانيًا، العلمانية تمنع تحول الدين إلى ثقافة سائدة تفرض معايير على العلم والفن والفكر، وهو ما يؤدى إلى خنق الإبداع والحرية الفكرية. فى الواقع العربى، كثيرون يخلطون بين حرية الاعتقاد وحرية التعبير، ما يخلق ذريعة لمنع النقاش والتفكير الحر. فالأمر يتعلق بحق الإنسان فى اختيار معتقده وممارسة فكره بحرية دون خوف من العقاب أو الرقابة، وهو شرط أساسى لعقل حر ومجتمع متقدم.
باختصار، الديمقراطية والعلمانية ليستا مجرد شعارات، بل أطر ضرورية لحرية الفكر، وتمكين الإنسان من المشاركة، وضمان مناخ فكرى يسمح بالنقد والإبداع، حتى لو كان الواقع اليوم بعيدًا عن هذه المثالية.

■ فى كتاباتك يظهر الإنسان دائمًا ككائن يبحث عن المعنى وسط العبث.. ما الذى يجعل الإنسان يستمر فى هذا البحث رغم كل الإحباطات؟
- بالتأكيد، هناك الكثير من الإحباطات ومظاهر العبث فى الحياة، لكن إذا نظرنا إلى تطور تاريخ البشرية، نكتشف أن هناك دائمًا فرصًا للتحسن، ولو على مستوى الفكر أو الوعى، حتى لو لم يكن الواقع أفضل دائمًا. على سبيل المثال، فى اليونان القديمة كانت العبودية أمرًا شائعًا، وكان الإنسان يُباع ويُشترى. لكن مع مرور الزمن وبفضل جهود البشر، وحتى استغلال بعض القوى للاستعمار وإنهاء تجارة العبيد، تم القضاء على سوق النخاسة. هذا يمثل خطوة حقيقية فى مسيرة الإنسانية، رغم أن البعض قد يقول إن الرأسماليين استبدلوا عبودية العمال بأساليب قاسية أخرى، إلا أن الوعى البشرى تقدم على المدى الطويل.
كما أن الإنسان يواصل النضال من أجل حقوق العمال، ويطالب بنقابات، وتأمين صحى، وسكن ملائم، وهذه الإنجازات تمثل تقدمًا ملموسًا رغم كل الصعوبات. إذا استسلم الإنسان لفكرة أن كل شىء عديم الجدوى، وأن الحياة عبثية، فإنه يسقط فى اليأس والعدمية. لكن الاعتقاد بأن الإنسان قادر على بذل الجهد لتحسين الواقع وتعديله، هو ما يمنحه الأمل ويجعله يستمر فى البحث عن المعنى، رغم المظاهر الكثيرة التى قد تدعو إلى الإحباط.
■ كيف ترى مستقبل الفلسفة فى العالم العربى خلال العقود المقبلة؟ هل ستظل حبيسة الجامعة أم يمكن أن تخرج إلى الشارع؟
- الفلسفة فى الأصل بدأت من الشارع؛ فالأسماء الكبيرة مثل فولتير وروسو وماركس وتولستوى، كانت حاضرة فى النقاش العام والصحف منذ القرن التاسع عشر. حتى أول من كتب عن نيتشه فى مصر كان سلامة موسى. وفى بدايات القرن العشرين، كان أحمد لطفى السيد مدركًا أهمية الفلسفة فى إدخال الحداثة إلى الوطن العربى، فأصر على إنشاء قسم فلسفة فى الجامعة الأهلية عام ١٩٠٨، رغم معارضة الأزهر والسلطات الأجنبية. وهكذا دخلت الفلسفة الجامعة، واستقطبت أساتذة كبارًا مثل لالاند وكواريه، ما أتاح لمصر إنتاج أسماء بارزة مثل عبدالرحمن بدوى وزكى نجيب محمود وفؤاد زكريا وإبراهيم بيومى مدكور ويوسف كرم. هؤلاء الأساتذة كانوا متقنين اللغات الأجنبية واللغة العربية، وكتبهم امتازت بالدقة والتنظيم، حتى إن بعض أعمالهم مثل خرافة الميتافيزيقا لزكى نجيب محمود كانت تثير جدلًا واسعًا فى الصحف العامة، وتناقش فى الإعلام.
لكن للأسف، منذ الثمانينيات، تراجع الاهتمام بالفلسفة خارج نطاق الجامعة. الإنتاج الفلسفى أصبح محدودًا، وغالبًا ما يقتصر على الكتب التعليمية للطلبة، دون أن يثير نقاشًا أو اهتمامًا فى المجال العام. أما خارج الجامعة، فغياب الإنتاج الفلسفى الجاد جعل الفلسفة تختفى تقريبًا من الشارع.
السبب فى ذلك، حسب رأيى، هو أن ما يُنتج اليوم فى الجامعة لا يستحق أن يخرج للشارع. حين كان زكى نجيب محمود أو محمد كامل يكتبان فى الأربعينيات والخمسينيات، كانت كتاباتهما تصل إلى العامة وتهم القراء خارج الوسط الأكاديمى. اليوم، الإهمال فى التعليم الفلسفى وانعكاسه على المجال الثقافى العام أدى إلى ابتعاد الفلسفة عن المجتمع.
مع ذلك، هناك أمل. الفلسفة ستظل تجد مكانها، لأن تطورات العالم تقتضى وجودها، وهناك حاجة ملحة لإعادة الاعتبار لها، سواء فى التعليم أو فى الإعلام والثقافة العامة. لكن هذا يتطلب وجود فاعلين اجتماعيين ووعى لدى صناع القرار بأهمية الفلسفة ودورها فى صياغة وعى الإنسان والمجتمع.

■ فى زمن الذكاء الاصطناعى وسرعة المعلومة، هل يمكن للفكر الفلسفى أن يصمد أمام سطحية العصر؟
- السؤال يفترض أن عصرنا الحالى ملىء بالسطحية ويحتاج مواجهة، لكن حتى الآن لا يمكن التأكد مما إذا كان الذكاء الاصطناعى فعلًا يزيد السطحية أم يساعد الإنسان فى تجاوزها. الفلسفة يجب أن تبقى موجودة ولها مكان، بل على العكس، الناس بدأوا يشعرون بأن العلم وحده لن يجيب عن مخاوفهم من الذكاء الاصطناعى، لأن العلم هو من أنتجه.
إذا عدنا إلى الدين، وتركناه هو الذى يحدد موقفنا من هذه التكنولوجيا، نجد أنفسنا نبتعد عن مسيرة التقدم التى حققتها البشرية على مر العصور. هنا تظهر الفلسفة كالتخصص القادر على إعطاء نظرة شاملة وعامة، تحدد غايات وجود الإنسان وتفسر ما وراء الظواهر. العلم يحل المشكلات العملية، مثل بناء أسانسير لتسهيل صعود عشرة طوابق، لكنه لا يجيب عن سؤال معنى الوجود وغاياته، وهذا ما تعنيه الفلسفة.
الذكاء الاصطناعى يمكن أن يُنظر إليه كأداة تقلل من فاعليتنا وتلغى قدرتنا على التفكير والتحليل والتأويل، فيجعل وجودنا يبدو بلا أهمية. هذا هو مصدر القلق من هذه التقنية. لكن من جهة أخرى، يمكن للذكاء الاصطناعى أن يحررنا من أعباء العمل والروتين اليومى، ويتيح لنا وقتًا أكبر للتفكير والتأمل، تمامًا كما كان حلم الماركسية القديمة فى التقدم التكنولوجى: تحرير البشر من الضغوط الاجتماعية والعمل الشاق.
إذًا، الفلسفة هى التى تحدد ما إذا كان الذكاء الاصطناعى يمثل تهديدًا أم فرصة، فهى قادرة على التفكير فى تداعياته على الإنسان والوعى الإنسانى، وعلى فهم مكانه ضمن مسيرة التقدم البشرى.
■ فى تجربتك الأكاديمية دائمًا ما تربط الفلسفة بالواقع.. هل ترى أن الفيلسوف لا يزال قادرًا على التأثير فى الوعى العام وسط صخب الإعلام والسياسة؟
- بالتأكيد، وجود الإعلام والسياسة يجعل مهمة الفيلسوف أكثر إلحاحًا وضرورة، كلما ازدادت الضوضاء والضجيج المسيطر، زادت الحاجة لوجود صوت للفيلسوف، حتى لو كان محدودًا، وحتى لو استمع له أقلية أو لم يفهمه الكثيرون، يظل دوره ضروريًا، لأنه يقدم رؤية مختلفة عما يفرضه الرأى العام أو الموضة الفكرية أو الأيديولوجيات المتكررة. صوت الفيلسوف هو الذى ينبه إلى ما لا يُتداول، ويقدّم رؤى جديدة للمشكلات، على سبيل المثال قد يُعتقد أن الفقر يؤدى بالضرورة إلى التطرف الدينى، لكن بحوثًا دقيقة تُظهر أن بعض الدول الأكثر فقرًا أقل تطرفًا دينيًا، وهنا يظهر دور الفيلسوف فى البحث عن الدوافع الحقيقية للأحداث، وتقديم تحليلات نقدية لا تعتمد على المألوف، بل على التدقيق والمراجعة المستمرة.صوت الفيلسوف إذن يظل ضروريًا لأنه يقدّم فهمًا مختلفًا ويبحث دائمًا عن الجديد.
■ ما الفكرة أو السؤال الذى لم تتوقف عن التفكير فيه حتى اليوم؟
- السؤال الذى لا أفارق التفكير فيه هو: ما الذى سيجعل لكلامى تأثيرًا حقيقيًا؟، أكتب وأتمنى أن يقرأ الناس ما أكتب ويستفيدوا منه، لكننى فى الوقت نفسه لا أعلم: هل سيقرأه أحد أساسًا؟ وإذا قرأه، هل سيستفيد حقًا، وهل سيُحدث فرقًا فى حياتهم؟
هذا القلق يجعلنى أحيانًا أشعر بأن الكتابة نوع من الصلف، أو حتى اقتحام حياة الآخرين بلا مبرر. فمن أنا لأفرض على الناس ما أكتبه وأن ينتبهوا له؟ ومع ذلك، إذا لم أكتب، أشعر بأننى لم أؤد واجبى تجاه ما أستطيع تقديمه. وهنا يظهر الصراع الدائم: بين جدوى ما أفعله، وبين شعور الواجب الأخلاقى الذى يفرض علىّ الاستمرار. هذا التوتر هو الذى أعيشه باستمرار.





