دينا مندور.. «قصبجى» المترجمين عن الفرنسية

- فى السوربون اعتبروا رسالتى أكبر نقلة فى «الاستشراق» بعد إدوارد سعيد
- قال لى جابر عصفور: لو ترجمتى هذا الكتاب الصعب سيغير حياتك.. وفعلًا حصل
- أحدث مصرية تحصل على الدكتوراه من السوربون «تعزف» سيرتها
فى ديسمبر 2023 حصلت المترجمة والباحثة دينا فتحى مندور على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عن رسالتها «الترجمة العربية للرواية الفرنسية ما بعد الاستشراقية»، ومع هذه الدرجة العلمية الرفيعة من أشهر جامعات الأرض حصلت دينا مندور معها على شهادتين إضافيتين لا تقلان قيمة (فى حساباتها هى على الأقل)، أولاهما اعتراف أكاديمى بأنها نحتت مصطلحًا علميًا جديدًا هو «ما بعد الاستشراق» وأسست برسالتها- الأولى من نوعها عنه- لمرحلة جديدة فى تاريخ الاستشراق بعد أيقونته إدوارد سعيد، سوف يحسب لها وينسب لاسمها وهو شىء لو تعلمون عظيم.
وثانى الشهادات الإضافية كان من أستاذها المشرف على رسالتها للدكتوراه البروفيسير الفرنسى المرموق فريدريك لاجرانج، رئيس قسم الدراسات العربية بجامعة السوربون، والذى راح يشجعها على مواصلة مشروعها كمترجمة بعد أن قرأ إنتاجها وأدرك موهبتها وأصالتها، بل كان يرجع إليها فى ترجماته هو نفسه من العربية للفرنسية، ولأنه من العارفين بالثقافة العربية سألها يومًا: إنتى عارفة الموسيقار القصبجى؟.. إنتى قصبجى الترجمة!.. واختياره للقصبجى بالذات كان عن معرفة واسعة بالموسيقى العربية وأسطواتها، وبتاريخ القصبجى وموهبته، وهو ما اتضح عندما أضاف: إنتى أسطى كبير فى الترجمة!
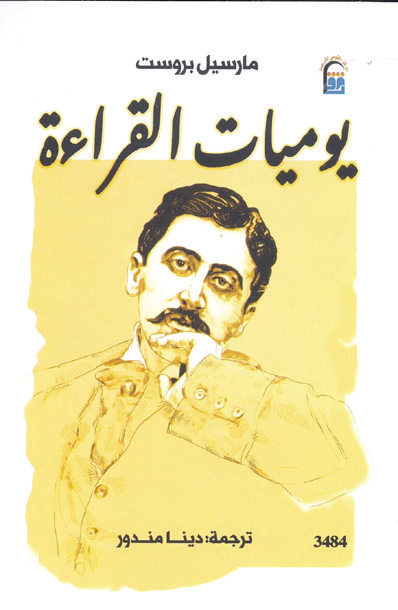
نحن إذن أمام تجربة مهمة وملهمة لمترجمة مصرية، وصفها أستاذها الفرنسى بأنها «قصبجى» المترجمين من الفرنسية إلى العربية، ولا بد أن تشعر بحجم المفارقة عندما تعترف لك دينا مندور بأنها التحقت بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب فى جامعة طنطا «بلدها ومسقط رأسها» بالصدفة، ولم تكن الفرنسية قبلها لغة دراسة رئيسية، فعانت فى دراستها الجامعية ونجحت بصعوبة فى سنتها الأولى بالكلية، وكانت تفهم الفرنسية بمشقة.. فكيف حدث هذا التحول الكبير والنقلة الهائلة التى قادتها للحصول على درجة الدكتوراه من السوربون، أعرق الجامعات الفرنسية، ولانتزاع اعتراف أساتذتها الفرنسيين أنهم تعلموا منها.. وأنها أسست لمرحلة جديدة فى دراسات الاستشراق بعد إدوارد سعيد، أو مرحلة ما بعد الاستشراق.. المصطلح الذى نحتت اسمه وسجلوه باسمها؟!
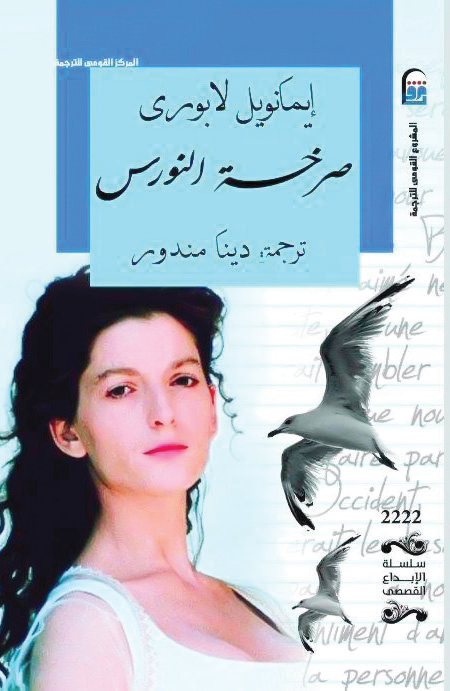
الإجابة تستحق أن ننصت إلى د. دينا مندور وهى تحكى عن رحلتها من طنطا إلى السوربون، بكل ما فيها من نجاحات ومطبات، مصادفات ومفارقات، أحلام وكوابيس، وصولًا إلى تجربتها فى تأسيس وحدة اللغات بجامعة الجلالة وبالمنهج الذى اختارته لتدريس الفرنسية جامعًا بين اللغة والأدب والترجمة.. لنسمعها وهى «تعزف» سيرتها:
لم أدرس فى مدارس فرنسية، ولذلك وجدت صعوبة كبيرة فى التعامل مع اللغة الفرنسية عندما التحقت بكلية آداب طنطا، ورغم أننى كنت مهتمة جدًا بالدراسة والمحاضرات، لكنى كنت أفهم بصعوبة ونجحت فى سنة أولى بالعافية، وهو أمر أزعجنى كثيرًا لأنى كنت متفوقة دراسيًا طول عمرى، وقررت فى الإجازة الصيفية أن أوطد علاقتى باللغة الفرنسية من خلال المركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، وكنت أسافر بالقطار يوميًا من طنطا إلى الإسكندرية، وشاركتنى الحماس أربع من زميلاتى، لكنه كان حماسًا مؤقتًا ووجدتنى بعد فترة قصيرة بمفردى فى رحلة السفر اليومية إلى «السنُتر» كما كنا نسميه حينها..
فرقت معى تلك الكورسات جدًا وبدأت أحس بأثرها فيما تلى من سنوات الدراسة، وبعد أن كنت أنجح بـ«الزق» تخرجت وترتيبى الرابع على الدفعة، وبعد التخرج دخلت فى تجارب مختلفة، من التدريب فى قناة النيل الثقافية إلى العمل بشركة سياحية لفترة قصيرة، ومن العمل بالمجلس الأعلى للثقافة «إدارة تنظيم المؤتمرات الدولية» إلى كتابة المقالات فى القسم الثقافى بجريدة «الأهرام إبدو» (وقت أن كان يرأس تحريرها الأستاذ محمد سلماوى)، وحينها ظهر المشروع القومى للترجمة، الذى قام فى البداية على أكتاف د. جابر عصفور والمترجم الأستاذ طلعت الشايب والأستاذة ماجدة أباظة، وعُرض علىّ وقتها، العام ٢٠٠٠، العمل بهذا المشروع الطموح، قالوا لى: جربى تترجمى، لكن لم تتح لى الظروف للمشاركة فى التجربة، حيث انشغلت بعدها لسنوات فى تجربة أخرى مختلفة هى الزواج والإنجاب، ولما رجعت فى العام ٢٠٠٥ اخترت العمل فى قسم الموارد البشرية بالشركة المصرية للاتصالات ضمانًا لدخل ثابت يعيننى على تكاليف معيشة أسرة أصبحت مسئولة عنها، لكن بعد عام واحد شعرت بنفور داخلى من هذا العمل الوظيفى الممل..
وحدث وقتها أن جمعنى لقاء بأستاذى د. جابر عصفور، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وعاد ليكرر دعوته لى بأن أجرب نفسى فى الترجمة، وكان د. جابر عائدًا لتوه من رحلة علاج فى فرنسا وأحضر معه أحدث ما صدر فى باريس وبينها ٥ كتب تخاطب القراء تحت العشرين، وقال لى بطريقته التلقائية الأبوية الودودة: تعالى شوفى الكتب دى هتلاقيها أسهل فى الترجمة من الكتب الكبيرة الصعبة.. ابدأى بواحد منها.. جربى وهنشوف لك مُراجع للترجمة!

ووجدتنى أستجيب له وأسحب منها كتابًا وأفتحه بطريقة عشوائية، وقرأت منه صفحة ولمسنى الحوار الإنسانى وقررت أن أبدأ فى ترجمته، وكانت رواية عنوانها «فتاتى الصغيرة» عن معاناة فتاة مراهقة فى قرية صغيرة مع مجتمعها المحافظ.. وبعد أن ترجمت ٦٠ صفحة من الرواية ذهبت للأستاذ طلعت الشايب، المترجم المرموق، لأتأكد من سلامة ترجمتى ولغتى العربية، ولما قرأ سألنى بدهشة: إنتى متأكدة إن دى أول ترجمة لكى؟.. ولما أجبت بالإيجاب قال بحماس: كملى يا بنتى كملى، وفعلًا منحتنى شهادته الثقة فى نفسى، وأنجزت ترجمتى لأول كتاب عن الفرنسية.
وتصادف أن جمعنى لقاء بعدها بالدكتور جابر، وكان حماسى للترجمة قد خفت أمام بريق وامتيازات الترقية التى حصلت عليها فى عملى الوظيفى، لكنه عاد بطريقته المقنعة ليجذبنى من جديد إلى الترجمة: «شوفى.. فيه كتاب جديد صعب.. بس لو ترجمتيه هيغير لك حياتك».. وأعطانى كتاب «المرأة الثالثة.. ديمومة الأنثوى وثورته» للفيلسوف الفرنسى «جيل ليبوفتسكى»، وصارحنى بأن مترجمة محترفة أعادته واعتذرت عن عدم ترجمته لصعوبته، ولما بدأت فى قراءته وجدته عبارة عن طلاسم، ومع ذلك استفزنى هذا التحدى وعكفت على ترجمته، وبعد المائة صفحة الأولى وجدتنى أحمل الكتاب وأعيده للدكتور جابر وأقدم له اعتذارى عن عدم استطاعتى استكماله، لكنه رفض استسلامى وطالبنى بالصبر وإتمام الترجمة..
وتطوع أصدقاء مشتركون مع المترجم القدير الأستاذ بشير السباعى بأن يتواصلوا معه ويطلبوا منه مساعدة صديقتهم المترجمة المجتهدة التى تلاقى بعض الصعوبات فى ترجمة كتاب فرنسى، ورحب الرجل بكل شهامة، وقبل أن نحدد موعدًا للقاء قابلته بالصدفة فى ندوة بمركز اللغات والترجمة بالجامعة الأمريكية كان ضيفها المستعرب الفرنسى ريشارد جاكمون «مشرفى على رسالة الماجستير فيما بعد»..
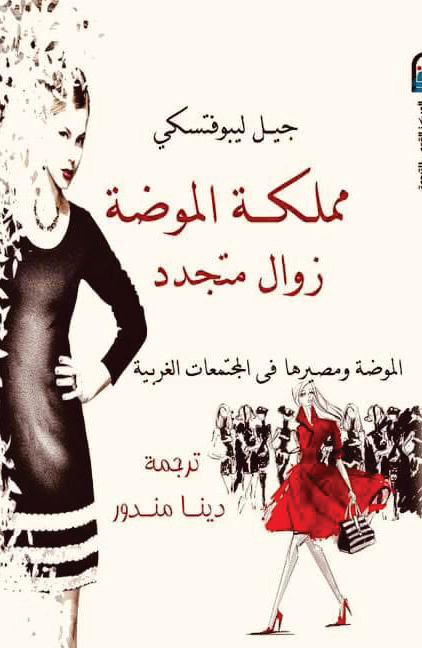
الطريف أننى لم أستطع الكلام أو السلام مع الأستاذ بشير بسبب الزحام، لكنى تلقيت منه اتصالًا بعدها بأيام يسألنى: إنتى عندك كام سنة؟، كتمت استغرابى من السؤال ولكنى أجبته: ٣٣، ثم أدركت مغزاه عندما شرح لى: أنا هبعتلك إيميل.. تفاعلى معه إيجابيًا» (فاكرة تعبيره كويس).. وكان الإيميل عبارة عن مسابقة تطلقها وزارة الثقافة الفرنسية لشباب المترجمين العرب لاختيار ثلاثة منهم فقط، بشرط أن يكون المتقدم للمسابقة لديه مشروع جاد تحت الترجمة، ويحصل الفائز على منحة لمدة ١٠ أسابيع فى فرنسا يشارك خلالها فى ورشة مع كبار المترجمين هناك..
ترددت كثيرًا فى المشاركة، واتصلت بالأستاذ بشير لأشكره على ترشيحه لى، وصارحته بأن فرصة فوزى بالمسابقة تكاد تكون معدومة وسط المتسابقين من دول المغرب العربى، المعروف عنهم براعتهم وإجادتهم للفرنسية، ثم تحججت بسبب شخصى وهو أن ظروفى العائلية لن تسمح بأن أترك أولادى الصغار وأسافر كل هذه المدة، ووجدته يعنفنى على هذه الروح الانهزامية ويتهمنى بالخوف والجبن وعدم الثقة بنفسى، واستفزتنى كلماته وأشعلت فى نفسى روح التحدى، وتصادف وقتها أن كنت فى حصتى الأخيرة فى «ليفل» تنشيطى بالمركز الثقافى الفرنسى، وحكيت لأستاذتى فيه د. رانيا فتحى عن المسابقة وكان لتشجيعها عامل السحر، وشاركتنى فى تجهيز استمارة مشاركتى بالمسابقة، ويشاء السميع القدير أن أكون من المقبولين، وكنت ثالث ثلاثة من الفائزين بالمنحة الفرنسية..

سافرت إلى باريس فى العام ٢٠١١، وكانت هذه المنحة نقطة فارقة فى حياتى ودشنت مشروعى للترجمة، بفضل ما اكتسبته من خبرات ومهارات، وفى نهايتها عرضنا شغلنا أمام وزير الثقافة الفرنسى فى مقر الوزارة التاريخى الذى يعد جزءًا من متحف اللوفر، ووزير الثقافة يومها كان فريدرك ميتران، ابن عم الرئيس ميتران، وكان فى الأصل مذيعًا تليفزيونيًا ومن عشاق الحضارة والثقافة المصرية وله حلقات شهيرة عن تحية كاريوكا وسامية جمال.. وكنت فى منتهى السعادة أننى المصرية الوحيدة فى هذا اللقاء.. وربما بسبب هذه السعادة قررت أن أضحى بعملى الوظيفى، فقدمت استقالتى لكى أخوض المغامرة مع الترجمة حتى نهايتها..
وفى أثناء المنحة أتيح لى أن ألتقى جيل ليبوفتسكى، الفيلسوف الفرنسى الذى عذبنى فى ترجمة كتابه «المرأة الثالثة»، والمدهش أننا بعدها أصبحنا أصدقاء، وعلاقتنا موصولة حتى الآن، وترجمت له كتابًا آخر فيما بعد، وأجريت معه لقاء صحفيا نُشر فى باب «وجهًا لوجه» بمجلة العربى الكويتية.. وبعد نشر ترجمتى لكتابه «المرأة الثالثة» استضافه المركز القومى للترجمة بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى وزار القاهرة فى مايو ٢٠١٢
ترجمت بعدها رواية فرنسية بديعة اسمها «صرخة النورس» عن سيرة وتجربة ممثلة فرنسية صماء، تحكى فيها عما عانته من مصاعب وتحديات فى سنوات مراهقتها فى أواخر السبعينيات، حيث كان المجتمع الفرنسى وقتها يمنع لغة الإشارة للصم والبكم ويعتبر لغة الأصابع بمثابة لغة قبيحة لا يجوز استخدامها فى مكان عام.. وقادت هذه الصبية الصغيرة «إيمانويل لابورى» حركة تمرد للصم فى فرنسا وتصدرت مظاهراتهم فى قلب باريس حتى تم إقرار قوانين تبيح لغة الإشارة، وأسست إيمانويل ما يعرف بالمسرح المرئى، أول مسرح يدمج الناطقين والصم فى عرض مسرحى واحد.. تجربة إنسانية مذهلة حظيت باهتمام عالمى وهناك دراسات مقارنة بينها وبين تجربة عميد الأدب العربى طه حسين.. ومن دواعى سعادتى أن قررت د. منى طلبة تدريس ترجمتى للرواية فى مادة الأدب المقارن لطلابها بآداب عين شمس.
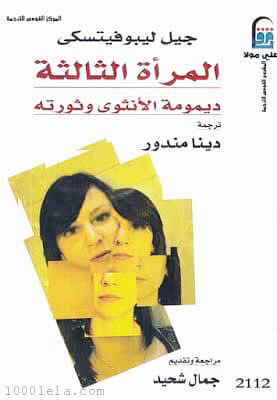
ولجيل ليبوفتسكى ترجمت كتاب «مملكة الموضة زوال متجدد.. الموضة ومصيرها فى المجتمعات الغربية»، وهو كتاب شديد العمق والدلالة ويروى قصة الموضة من منظور فلسفى وكيف كانت ساحة لصراع الطبقات فى المجتمع الغربى..
فتحت لى الترجمة أبواب فرنسا من جديد وفزت بمسابقة أعتبرها أهم من الأولى، وكنت العربية الوحيدة الفائزة فى هذه المسابقة العالمية التى نظمها مركز دعم الترجمة ونشر الكتب بمدينة «بوردو»، وتقدم لها ٦٨ مترجمًا من كل أنحاء العالم، وفاز فيها اثنان فقط، مترجمة من أرمينيا وأنا..
ورجعت من هذه التجربة المهمة وترجمت كتابى «الفلاسفة والحب.. من سقراط إلى سيمون دى بفوار» لمارى لومونييه وأود لانسولان، وهو كتاب فريد من نوعه يتناول الحياة العاطفية لعشرة من أشهر الفلاسفة فى التاريخ..

فى تلك الفترة ٢٠١٣- شعرت بحاجتى إلى تعميق علاقتى بالترجمة واللغة الفرنسية، ووجدت فرصة لدراسة الماجستير بجامعة «أكس أون بروفانس» الفرنسية، وعملت رسالة كان موضوعها يشغلنى كثيرً ا منذ المنحة الأولى لى بباريس، وهو الفروق بين الترجمات العربية، بمعنى أنك يمكن أن تجد ثلاث أو أربع ترجمات عربية مختلفة لنص فرنسى واحد باختلاف جنسية وثقافة المترجم العربى، يعنى تلاقى ترجمة النص فى المغرب العربى مختلفة عن الترجمة المصرية وعن الترجمة الشامية..
وبعد البحث والحصر وجدت أن أفضل نص يمكن أن أطبق عليه دراستى هو رواية «الغريب» للكاتب الفرنسى الشهير ألبير كامى، واخترت لها ٤ ترجمات عربية، ترجمتان مصريتان وواحدة لبنانية وترجمة مغربية، ووصلت إلى نتائج مهمة فيما يمكن أن نسميه علم اجتماع الترجمة، وكيف أن الظروف السياسية والاجتماعية التى يعيش فيها المترجم تؤثر بشكل ملموس وقوى على ترجمته واختياره للمفردات ومعانيها.. وحصلت فى هذا الموضوع على درجة الماجستير.. التى منحتنى ثقة فى نفسى وإمكاناتى..
وبدأت بعدها فورًا الاستعداد للدكتوراه، واخترت لها موضوعًا كان يشغلنى هو الآخر منذ سفرى لفرنسا وهو العلاقة الجدلية بين الشرق والغرب، وكنت أبحث لها عن تناول مختلف ورؤية جادة غير مستهلكة، وأتاحت لى الظروف حينها لقاء البروفيسور فريدريك لاجرانج، رئيس قسم الدراسات العربية بجامعة السوربون، وهو متخصص بشكل كبير فى التاريخ العربى، وعملت معه ما يشبه العصف الذهنى كانت نتيجته هو الاتفاق على أن يكون موضوع رسالتى على الاستشراق الحديث..
طبعا الاستشراق موضوع قُتل بحثًا، لكنى وجدت فيه زاوية جديدة ومختلفة، فقد اكتسب الاستشراق سمعة سيئة من ارتباطه بمرحلة الاستعمار الغربى، وفكرت فى التركيز على الشق الأدبى من الاستشراق ومحاولة تفكيك سمعته السيئة وليس محوها، والتركيز على الكتابات الحديثة فى هذا الموضوع خلال الأربعين سنة الماضية، لنتجاوز المرحلة الكلاسيكية من الاستشراق التى كان من علاماتها الفارقة كتاب إدوارد سعيد الشهير، الذى فضح فيه استغلال الاستعمار للمستشرقين، وقال بشكل واضح وصريح إن الاستعمار الأوربى- والفرنسى منه خاصة- استخدم المستشرقين فى نواح غير أخلاقية ليدل الجنرالات على أسرار النسيج الاجتماعى والفنى للمجتمعات العربية ليتمكنوا من فرض سيطرتهم واستمرار احتلالهم.. وكان لكتابات إدوارد سعيد أصداؤها المدوية، ودخلت بعدها دراسات الاستشراق فى صمت مطبق بعدما أحس المستشرقون بالخزى من ماضيهم المشين فى علاقتهم بالاستعمار وسمعته الرديئة..
وبدأت فى تتبع كتابات المستشرقين الجدد، ولمست نعومتها فى الحديث عن الشرق وتقديم مشاكله على أنها جزء من النسيج الإنسانى الكونى، وبشكل أكثر إنسانية ورحابة، وهو ما يتجلى فى كتابات أمين معلوف وغيره من أصحاب الجذور العربية.. وكانت مشكلتى عدم توافر مراجع كافية عن الموضوع، وبان أن المشكلة أصبحت ميزة فى حد ذاتها، لأن الرسالة كانت أصيلة وتؤسس لفرع جديد فى دراسات الاستشراق، أو ما سميته ما بعد الاستشراق، وهو ما اعترف به الأساتذة الذين أشرفوا على الرسالة وناقشوها..
كنت بتوجيه البروفيسور لاجرانج قد قدمت الرسالة إلى جامعة السوربون وتم قبولها، وأشرف لاجرانج عليها، وكانت لجنة المناقشة مهيبة: البروفيسور برنار فرانكو رئيس قسم الأدب الحديث والمقارن بجامعة السوربون، البروفيسور لورانس دونوز أستاذ الأدب العربى والمقارن بجامعة لورين، البروفيسور ريما سليمان «من أصل لبنانى» نائب رئيس المعهد الوطنى للغات والحضارات الشرقية «إينالكو»، البروفيسور نجلا نخلة سيروتى «من أصل لبنانى» مديرة أبحاث بالمركز الوطنى للأبحاث العلمية بباريس والأستاذة بجامعة أكس أون بروفانس.. ومنحتنى اللجنة درجة الدكتوراه من السوربون فى ديسمبر ٢٠٢٣، وتم نشر الرسالة على كل المواقع الأكاديمية الأوروبية وأرشيف المكتبة الأكاديمية للسوربون..
وكان من دواعى سعادتى وشعورى بالفخر أن الرسالة تمت مناقشتها فى مبنى السوربون القديم، المبنى نفسه الذى درس فيه عميد الأدب العربى طه حسين، وتوسعت الجامعة بعدها وأصبح لها العديد من الفروع السوربونية.. لكن للمبنى الأصلى مذاقه الخاص.. ففيه درس طه حسين وحصل على الدكتوراه.. وكأننى مشيت على خطاه..
مع تجربتى الممتعة فى التدريس بجامعة الجلالة أعكف على تقديم دراستى عن الاستشراق باللغة العربية لتكون متاحة للقارئ العربى.. وأعكف كذلك على مشروع خاص بعلم اجتماع الترجمة أنوى فيه تفكيك كثير من المفاهيم الملتبسة فى معانيها وفهمنا لها، ولتبسيطها أنوى طرحها فى شكل مقالات صحفية..
وبالطبع عندى مشروعات مؤجلة للترجمة.. وتطاردنى دائمًا كلمة أستاذى البروفيسور فريدريك لاجرانج وتشجيعه لى وإشادته بموهبتى كمترجمة.. أو قصبجى المترجمين، كما وصفنى..








