المتمردة.. وداد نبى: الغرب يعتبر شعراء المنفى «فئرانًا يكتبون القصيدة»

- الشاعرة السورية المقيمة فى ألمانيا: أهل السويداء يُقتلون على الهوية
- كيف يمكن أن نحب بلادًا حتى العظم ثم تقسو علينا لهذه الدرجة المرعبة؟
- أعرف الكثير من الشاعرات اللواتى محاهن عالم الأمومة بممحاةٍ قاسية
- بعد أسابيع من سقوط «الأسد» تبيّن أن البديل أسوأ من الديكتاتور القديم
أحبها تلك البلاد حتى فى خرابها الأخير!
هكذا كتبت الشاعرة السورية وداد نبى، فاختزلت فى بيتٍ واحد وجع المنفى، وحنين المدن التى تسكن القلب رغم الخراب.
هى ابنة الشام وجبالها الخضراء، التى منحت القصيدة نبرة خاصة، تمزج بين الحب والحسرة، الأنوثة والتمرد، والوطن كذاكرة والجسد كقارة، فتوجها الشعر مؤخرًا بجائزة «كامايورى» الدولية لعام 2025 عن كتابها «قارة اسمها الجسد»، الصادر باللغة الإيطالية، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرتها التى تنبض بالحياة رغم ويلات الحرب والغربة.
فى حوارها مع «حرف»، تفتح وداد نبى قلبها وتتحدث عن لحظة الفوز، عن الأمومة، عن المنفى، وعن الكتابة كفعل مقاومة، وعن كيف يمكن للشعر أن يكون بيتًا حين تغلق الأوطان أبوابها.
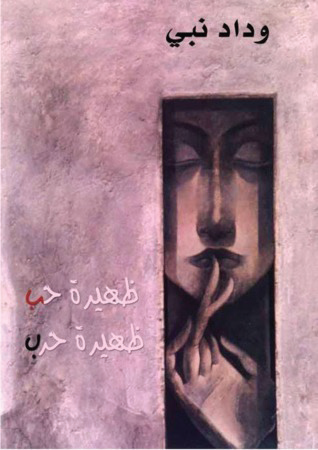
■ بماذا شعرت حين حصلت على الجائزة الدولية للشعر «كامايورى»؟
- كنت سعيدة بالطبع، فالجائزة تُعد من أعرق الجوائز الشعرية فى إيطاليا، وتأسست عام ١٩٨١، ولم يحصل عليها من قبل أىّ كاتب يكتب بالعربية، ومن بين الأسماء العالمية البارزة التى نالتها، الشاعرة الإيطالية ألدا ميرينى، والحائز على جائزة نوبل شيموس هينى.
لذلك كان فوز كتابى «قارة اسمها جسد» (منشورات دى فيليتشه، ٢٠٢٥، ترجمة وتقديم سيمونى سيبيليو)، بهذه الجائزة، بمثابة اعتراف بالأدب المكتوب باللغة العربية والمترجم للإيطالية.
لكن مشاعر البهجة سرعان ما تلاشت بسبب المجازر الوحشية التى وقعت فى بلدى، فى مدينة السويداء، حيث شعرت بالذنب لأننى كنت سعيدة فى لحظة كانت فيها حياة فيها أصدقاء وصديقات تحت الخطر، عالقين فى خوفٍ هائل من أن يتم قتلهم على الهوية.
إحدى الصديقات «نبال النبوانى» كتبت على صفحتها فيما المدينة تتعرض للاقتحام والقتل: إنها مثل وداد نبى: تحبها تلك البلاد حتى خرابها الأخير. حين قرأت بوستها على «فيسبوك»، بكيت، كنت أشعر بالعجز والعار، كيف يمكن لنا أن نحب بلادًا حتى العظم وكيف يمكنها أن تقسو علينا لهذه الدرجة المرعبة.

■ فى ديوانك «قارة اسمها الجسد».. هل كنت توثقين تجربتك فى الأمومة؟ وكيف يمكن لولادة طفل أن تشكل هوية جديدة لك؟ ومتى يصبح الجسد المحدود فى حجم قارة؟
- فى الواقع، هناك نصان فقط فى الكتاب يتناولان موضوع الأمومة، يتحدث أحدهما عن صعوبة كتابة الشعر بعد أن تصبح المرأة الشاعرة أُمًّا.
إذ سرعان ما تحتل الأمومة ذات المرأة- وأقصد هنا فعل «تحتل»- لأن المرأة، فى السنوات الأولى من ولادة الطفل، تفقد الكثير من هويتها الفردية لصالح هوية الأم الجديدة؛ هذه الهوية التى تُبعدها، بقسوة، عن اللغة والكتابة لفترة من الزمن، لتغرسها فى عالم الأمومة والطفل، ذاك العالم الذى يتطلب محوًا كبيرًا للفردية لصالح إفساح المجال للكائن الصغير الذى وُلد.
ويظل هذا الصراع قائمًا بين ذات الأم وذات الشاعرة، أحيانًا، يتوافق الشعوران ويعيشان جنبًا إلى جنب، لكن كثيرًا ما تطغى إحدى الهويتين على الأخرى، أعرف الكثير من الشاعرات والكاتبات اللواتى محاهنَّ عالمُ الأمومة بممحاةٍ قاسية.
لذا، ربما كنت واعية منذ البداية كى أقاوم تلك الممحاة الكبيرة.
وغالبًا، وفى مرحلة متقدمة من عمر الطفل، تندمج ذات الأم تدريجيًا داخل ذات الشاعرة، أو العكس. فتجد المرأة هوية أكبر وأعمق تدمج فى داخلها كلتا الهويتين. لكن، أحيانًا، تبتلع ذات الأم ذات الشاعرة، حتى يصعب على المرأة أن ترى فى المرآة ذاتها القديمة.
لهذا، كانت علاقتى مع الأمومة علاقةً إشكالية نوعًا ما، لأننى قاومت كى لا تبتلعنى «ذات الأم»، أو تحتلنى بالكامل.
حاولت، وما زلت، أن أخلق تلك الهوية الجامعة، التى تتسع لكلتا الهويتين معًا، دون أن تسعى إحداهما إلى محو الأخرى. أو احتلال مكانها، ولا أعرف إلى أىّ درجة نجحت فى ذلك.
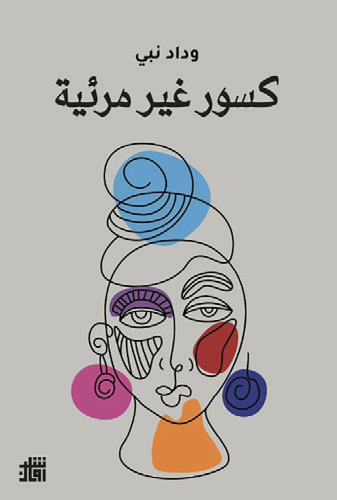
■ فى كتابك «كسور غير مرئية» صنعت للوباء بيتًا.. هل هذه طريقتك فى مواجهة الصعاب فى الواقع؟
- فكرة البيت لدىّ أليفة للغاية. أى شىء، أى شخص، أى حدث، حين أرغب فى جعله حميمًا وقريبًا منى، أقوم بتشبيهه بالبيت، وبذلك أستطيع أن أشعر بالأمان، خاصة فى واقعٍ تغلّفه القسوة والعنف. فى واقع سريع الجرح والهشاشة والانكسار، أحتاج إلى فكرة البيت كى أنجو.
أحيانًا يكون البيت مكانًا، وأحيانًا شخصًا، وأحيانًا أخرى فكرة. فى بيتى البرلينى، حيث أعيش، وحيث يُطلَق على هذا المكان اسم المنفى، أشعر- حين أكون داخله- أننى فى مكانى الحميمى الأليف. أسّستُ هذا البيت بالحب، وملأته بالكتب التى أحبها، وبالنباتات المنزلية، وباللوحات الفنية، وبالصور العائلية. هنا أشعر بأننى فى وطنى. بيتى هو وطنى، بطريقةٍ ما. حيث يكون بيتى، لا يكون منفاى. وحيث يكون شخصًا أحبه يكون بيتى أيضًا.

■ ما بين فرح سوريا بسقوط نظام الأسد وحزنها بسبب القتل على أساس الهوية.. ما قراءتك لهذا المشهد المُعقد؟ وهل هناك دليل للنجاة؟
- إنها مشاعر مركّبة جدًا.
بعد سقوط النظام، بقيتُ ثلاثة أيام أبكى من شدة الفرح. لم يكن سقوط الديكتاتور أمرًا واردًا أو ممكنًا.
لكن، وبعد أسابيع قليلة، تبيّن أن البديل كان أسوأ من الديكتاتور القديم: نظام إسلامى جهادى إرهابى، أول ماقام به هو الترويح لفكرة إبادة الأقليات وسوريا ذات اللون الواحد.
لذا سرعان ما تحولت دموع الفرح إلى دموع قهر وأسى، ونحن نراقب، كل يوم، المجازر الجديدة فى البلاد،
وكأننا بعد كل سنوات الحرب، لم نفعل شيئًا سوى استبدال مجازر بمجازر أخرى.
يبدو لى أحيانًا أن المشهد فى سوريا واضحٌ للغاية لمن يريد أن يقف مع الضحايا: كما كنّا ضد الديكتاتور القديم، فنحن أيضًا ضد السلطة الحالية، إذ إن كليهما دمّر سوريا، دمّر عوالمنا القديمة، وأحلامنا ببلادٍ آمنة، مستقرة، ديمقراطية.
لذا أجد أن خيارى هو فى رفض كليهما. والعمل على إيجاد عقد اجتماعى جديد بين السوريين والسوريات جميعًا يقوم على المواطنة والعدالة الديمقراطية والحقوق المتساوية للجميع.

■ صراع الهوية هنا وهناك.. كيف ينظر الفنان الألمانى أو الناشر الغربى للشاعر المهاجر؟
- كنتُ محظوظة، إذ إن ناشرىّ الألمانيّين الأول والثانى كانا مثقفين، وبعيدَين عن الانغلاق والتصورات المسبقة عن الآخر، خاصة أن ناشرى الألمانى الثانى من أصول مهاجرة.
مشكلتى، ومشكلة كثيرين غيرى على ما أعتقد، كانت فى أن النظرة إلينا فى ألمانيا غالبًا ما كانت باعتبارنا «لاجئين يكتبون الأدب»، وليس كتّابًا لديهم أيضًا تجارب فى الهجرة واللجوء.
فى الأوساط الأدبية الألمانية، كان هناك إصرار دائم على حشرنا فى تلك الزاوية الضيّقة: زاوية اللجوء والهجرة.
لأنها تجلب التمويل، ولأنها أقرب إلى النزعة الغربية المركزية حول الذات ورؤية الآخر، خصوصًا عندما يكون هذا الآخر قادمًا من منطقتنا، حيث يستمرّ الربط بين الإرهاب وبلداننا، ولغتنا، وثقافتنا.
لذا وجدت نفسى فى موقع المدافع دومًا عن إثبات هويتى الفردية أولًا، والفك بين الأدب الذى أكتبه وثيمة اللجوء التى كنت أحاصر بها. ولا أعرف إلى أى درجة نجحت بفك هذا الربط.

■ رحلتك من سوريا إلى برلين مليئة بالأمل والحلم والندوب.. إذا نظرتى للخلف قليلًا.. ماذا تقولين لنفسك اليوم؟
- أقول لنفسى: كلّ ما وصلتُ إليه، دفعتُ ثمنه مسبقًا بالدموع، وبالمعارك مع أفكارى المسبقة والنمطية، وبصدق جارح فى نقد أخطائى وقناعاتى القديمة، ومحاولاتى العديدة أن أكون نسخة أكثر صدقًا ولطفًا من ذاتى بعد كل تجربة.
بمعاركى ككاتبة وامرأة مع المجتمع، ومقاومة رغبته فى زجى فى دور نمطى معين، يناسب المجتمعات الذكورية التسلطية، فى معاركى مع الثقافة السائدة، والبيئة، والسلطة الذكورية والسياسية.
لم يكن الطريق سهلًا، بل كان مليئًا بالزجاج المكسور، مع ذلك، مشيتُ عليه ووصلت. أو أعتقد أننى وصلت.
لذا، أقول لنفسى: لا تتوقفى عن المضىّ قدمًا، لا تتخلّى عن حلمك بالعدالة، وبعالمٍ أقل قسوة، وبشرٍ أكثر لطفًا وإنسانية. لا تتوقفى عن الكتابة لانها نجاتكِ الوحيدة من كل ما يحدث.

■ فى إحدى قصائدك تقولين «بعد سنوات تعلمت التحكم بتدفق الدموع.. تعلمت إبعاد ذكرى القنابل.. فأصبحت الألمانية لغتى المفضلة».. كيف تأثرتِ بالثقافة الألمانية؟ وبرأيك.. ما الفرق بين الشعر الغربى والعربى؟ وما يميز كليهما؟
- لم تكن الثقافة والأدب الألمانيين بعيدَين عنى، حتى حين كنتُ فى سوريا. كنّا نقرأ الأدب الألمانى من خلال الترجمة، وكان لدىّ اطّلاع جيد على التاريخ والثقافة الألمانية، خاصة الفلسفة.
لكننى، عند وصولى ألمانيا، أصبتُ بما يشبه الصدمة، حين انتبهت أن الألمان، مثلًا، ليس لديهم معرفة تُذكر بثقافة الآخر. والآخر هنا هم شعوب منطقتنا.
معرفتهم وتصوراتهم عن العالم العربى والمشرق لا تزال، إلى حدّ كبير، تنطلق من ثقافة كولونيالية استشراقية، ذات نزعة مركزية غربية، ترى فيما يقدمه هذا الآخر مجرد نسخة باهتة مما تنتجه الذات الأوروبية.
عملتُ ضمن مشروع أدبى مع الكاتبة الألمانية المهمة أنييت غروشنر، كنا نختار موضوعًا للعمل عليه معًا- مثل موضوع حقوق النساء، أو المكتبات، أو المدن- ونُجرى نوعًا من الإسقاط المتوازى بين مدينتينا: برلين وحلب ع سبيل المثال.
ساعدنى هذا العمل مع «أنييت» على الاهتمام أكثر بالجانب التاريخى والأرشيفى للمدن والحكايات. فلكلّ مكان أرشيف، ولفهم أيّ مكان، لا بد من البدء من أرشيفه، لا فقط من جانبه العاطفى.
أما تجربتى مما قرأته من الشعر الألمانى الحديث، فوجدته إلى حدّ ما بعيدًا عن طبيعة الشعر المكتوب بالعربية. الشعر العربى غالبًا ما يكون غنائيًا، حميميًا، مهتمًا بالزخرفة اللغوية، فى حين أن الشعر الألمانى الذى قرأته يبدو أكثر جمودًا، تحليليًا، تفسيريًا.

■ توقفت كثيرًا عند قصيدة «لا تشرح لأحد».. أرادت الشاعرة ألا تفصح عما بداخلها.. أظن أن وراءها حكاية لا بد أن تروى.. ما ظروف كتابة هذه القصيدة؟ وهل يمكننا القول إن الصمت أبلغ رد فى بعض الأحيان؟
- هذه القصيدة كتبتُها فى ألمانيا، حين كان يُوجّه لى، كما لغيرى من الكتّاب والكاتبات السوريين، دعواتٌ للمشاركة فى فعاليات أدبية.
وكان الجمهور، فى الغالب، متعطشًا للحديث عن السياسة والهجرة، أكثر بكثير من اهتمامه بالأدب الذى نقدّمه. كنتُ أجد نفسى دائمًا واقعة فى هذا الفخ: فخّ الشرح والتفسير، عن مأساةٍ شارك فيها الجميع- بمن فيها الدول الأوروبية، سواء من خلال صمتهم تجاه الديكتاتورية، أو من خلال إغلاق أبواب الهجرة، وترك الهاربين يموتون فى البحر، أو على الحدود، أو فى الغابات.
ربما كانت هذه القصيدة بمثابة ردٍّ على الجمهور الألمانى، الذى كان ينظر إلينا أحيانًا كما لو أننا «فئران تكتب الشعر»- وهو تعبير للشاعر الأمريكى الصربى تشارلز سيميك- لكنه، فى هذا السياق، يعبّر بدقّة عمّا أردت قوله.
■ كيف يمكن أن يساعدنا الشعر فى أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا؟
- أحيانًا، كلّ ما يفعله الشعر هو أن يجعلنا نفهم أنفسنا بشكلٍ أفضل، دون أن يحاول دفعنا إلى التغيير. إنه يضىء تلك الأماكن المعتمة داخلنا، تلك التى لا نجرؤ عادةً على لمسها أو وضعها تحت الضوء.
لكن الشعر يشبه طفلًا صغيرًا، يحبو رويدًا رويدًا نحو الزوايا المهملة، المنسيّة، المؤلمة، ويقودنا، من خلال اللغة، إلى الكشف عنها، ورؤيتها، الاعتراف بها وقبولها دون خوف أو محاكمة.
وأعتقد أن هذا هو أجمل ما يمكن للشعر أن يفعله لنا: أن يساعدنا فى قبول كلّ الأجزاء التى تنتمى إلينا، سواء كانت مضيئة وجميلة، أو معتمة مشوهة وقاسية ومجروحة.

■ ماذا عن خططك المستقبلية؟ وهل هناك مشروعات أدبية جديدة فى الطريق؟
- سيصدر لى كتاب شعر جديد، تحت عنوان: «متحف الرغبات»، عن دار «خان الجنوب» فى برلين، قريبا، وتدور جميع القصائد فيه حول موضوع واحد: الرغبة والجسد.
وهى تجربة جديدة بالنسبة لى، إذ إنها المرة الأولى التى أبتعد فيها عن كتابة الشعر المتعلّق بالأمكنة المفقودة بسبب الحرب، أو عن الذاكرة التى لم تعد موجودة.
كما أننى أنهيتُ المسوّدة النهائية لكتابى عن الأمومة، حيث أتناول الجوانب المعتمة التى غالبًا لا يتم تسليط الضوء عليها بما يكفى، وكيفية انحلال أو تلاشى «ذات المرأة» لصالح «ذات الأم»، نتيجة الضغوط المجتمعية، والأدوار المرسومة مسبقًا.





