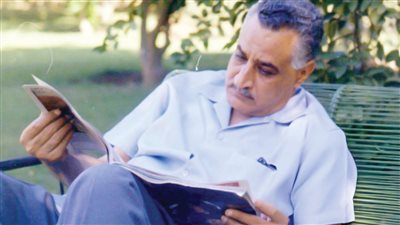مواجهات بلا مجاملة.. محمد عبدالنبى: ليس لدى مَثل أعلى وأغلب كتاباتنا النقدية مديح

- تأثرت فى فترة من حياتى بـ«إدوار الخرَّاط ونجيب محفوظ»
- المدح يعطِّل الكاتب أكثر من الهجاء ولو كان صادقًا
- راضٍ عن مسيرتى لأننى أحاول.. ولا أفكر فى الحصاد ما دامت الرحلة مستمرة
كاتب ومترجم ومدرب كتابة مصرى، تخرج فى كلية «اللغات والترجمة» قسم «اللغة الإنجليزى» بجامعة الأزهر، ومتفرغ للكتابة والترجمة، وله العديد من الترجمات الأدبية وغير الأدبية.
إجمالًا، حصل على جائزة «ساويرس» 4 مرات، عن أعمال مختلفة بين القصة والرواية والترجمات، ووصلت روايتاه «رجوع الشيخ» و«كل يوم تقريبًا» للقائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية «البوكر»، إلى جانب «فى غرفة العنكبوت» التى وصلت إلى القائمة القصيرة.
إنه الروائى والقاص والمترجم محمد عبدالنبى، الذى تحاوره «حرف» فى السطور التالية عن جدوى الزمن، ومفهومه للخلاص الذاتى والوجودى، ومفهوم الكتابة بصفة عامة لديه، إلى جانب قضايا أدبية وفكرية أخرى.

■ بداية.. هل يصلح الواقع كمادة للسرد القصصى أو الروائى؟
- لا أظن أنَّ هناك كاتب قصة أو رواية لا يستمد مادة نصوصه من الواقع ومنغصاته. الواقع هو المادة الخام للعمل الخيالى، تمامًا كما تستمد الأحلام مادتها وعناصرها الأولية ممَّا يحدث لنا فى الصحو خلال يومنا، قبل أن تعيد ترتيب وتركيب هذه العناصر عبرَ آلية معقَّدة، قد تبدو نتيجتها كأنها فوضى كاملة، لكن مع شىء من التأمُّل والتحليل تتبدَّى عن نظامٍ عميق للرموز والعلامات، يلم به المتخصصون فى تفسير الأحلام وفقًا للمناهج المختلفة. وعلى مستوى الأدب يلمُّ به المتخصصون فى النقد الأدبى وتحليل النصوص. الواقع أولًا ثم تأتى اللغة التى تتجسَّد فيها علامات ورموز وعناصر الواقع وتجربة الكاتب الشخصية، لتتحوَّل إلى نص أدبى يمكن أن نعتبره منتجًا جماليًا وفنيًا.
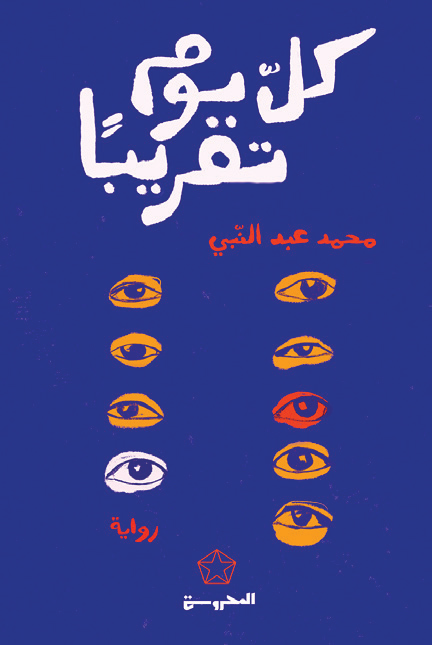
■ لماذا دائمًا ما يلجأ الكاتب لاستحضار الماضى كعتبة للسرد الإبداعى؟
- انتبهت مع كتابة القصص المختلفة فى مجموعة «سهرة درامية»، واختيار بعضها واستبعاد بعضها، إلى أكثر من خيط يجمعها معًا، أوضح هذه الخيوط هى علاقة الشخصيات المختلفة بالماضى، أو الانطلاق من شىء حدث فى الماضى أو ذكرى قديمة تفرض نفسها على الحاضر. هذا شىء حدث تلقائيًا بلا قصد أو انتباه، لكنه اتضح تدريجيًا مع تطوير القصص فى مرحلة بعد أخرى.
لا أرتاح كثيرًا لفكرة «النوستالجيا» أو الحنين العاطفى إلى زمن مضى، كأنه لا بدَّ أن يكون أمس أفضل من اليوم بلا شك، وهذا ليس صحيحًا على الدوام. فى المقابل، أحب أن أضع لحظتين مختلفتين لشخصية واحدة بجانب إحداهما الأخرى، وأتأمَّل العلاقات بينهما، وما جرى فى خلال الفترة الفاصلة بينهما. هذه مجرد لعبة قصصية أو حيلة سردية، تبدو ممتعة بالنسبة لىّ ومثيرة للفضول وشهية اللعب السردى.

■ فى نصوص «سهرة درامية» هناك الكثير من الأسى والشجن واستنزاف التاريخ الإنسانى.. هل تعتبر الكتابة ملاذًا أم سلوى.. أم هى الخلاص الوجودى بعينه؟
- الكتابة قد تكون ملاذًا وسلوى وتطهرًا وأشياء أخرى كثيرة، وقد تكون أشياءً مختلفة لكتَّاب مختلفين، فهى مثل فنون وألعاب وتسليات أخرى لا غرضية، لا هدف لها خارج ممارستها. قد تؤدى إلى نتائج عديدة ومتنوعة، لكنَّ العبرة فيها ليست بالنتيجة، بل بحالة ممارستها، الاندماج فيها، والتوحُّد معها.
أمَّا الخلاص الوجودى فهو شىء آخَر، لا يخص الكتابة بقدر ما يخص رحلة الكاتب كإنسان يدرك أزمته ويتساءل عن سبيل للخلاص. كل كاتب هو إنسان قبل الكتابة وبعدها، وهو بذلك أشمل وأوسع من حيث التجربة والحياة من علاقته بالكتابة، التى هى شريحة واحدة فقط فى حياته، ولا ينبغى أن تتضخم حتَّى تبتلعه بداخلها، فينتفخ الكاتب ويضمر الإنسان، وهذه بالنسبة إلىّ حالة مَرَضية.
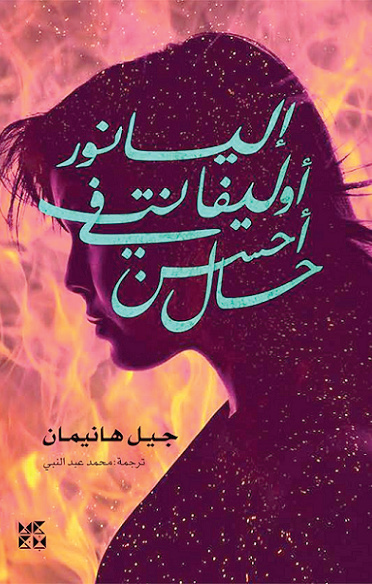
لا أظن أنَّ لدىّ مفهومًا للخلاص، أعتقد أنَّ كل إنسان عبر رحلته وتجربته يكتشف أمورًا عن نفسه وعن العالَم، ويتعلَّم دروسًا ويرتكب أخطاء، ويحاول أن يختار الأنسب له، وهكذا ربما يكون البحث عن الخلاص عملية متواصلة ومتجددة، وفى كل مرحلة لها تُطرَح أسئلة جديدة واكتشافات مختلفة.
لا يرتبط هذا بالكتابة ارتباطًا شرطيًا، الكتابة، وربما من قبلها القراءة، أدوات مساعدة فى الرحلة، لكنها ليست الرحلة بكل تأكيد. قد تتواصل رحلتى أنا على الأقل، بدون هذه الأدوات المساعدة، إذا توقفت عن كونها مفيدة لى فى السعى والاكتشاف، ولكن ما دامت مفيدة فستكون بجانبى. أظن أنَّ الكاتب لا يكتب سعيًا للخلاص الفردى أو الجماعى، لكن الكتابة نفسها جزء من رحلة الكاتب لاكتشاف ماذا يعنيه الخلاص بالنسبة إليه.

■ فى المجموعة القصصية ثمة «موتيفات» ذكية وملحوظة عن الإسكندرية والسويس والقاهرة تحيل القارئ للتوقف عند الزمن.. ما علاقتك بالزمن الفعلى فى نصوصك؟
- الزمن أحد ألغاز وجودنا الإنسانى الكُبرى. لا أستطيع أن أتخيَّل كاتبًا لا يطرح أسئلة تخص الزَمن، حتَّى ولو من خلال فِعله وتأثيره على الشخصيات، أو التغيير الذى يطرأ على الأماكن والموجودات. حركة الزمن أساسية لدىّ، وجوهرية فى السرد عمومًا. هنا فى مجموعة «سهرة درامية» كان الزمن بطلًا أساسيًا، ربما لأن معظمها قصص طويلة نسبيًا تتبع مصائر شخصيات عبر عدة عقود، وربما لأن كل شخصياتها تقريبًا تقيم علاقة ما مع ماضٍ محدَّد، ماضٍ منسى أو مستعاد، ماضٍ مخز أو غير مشرِّف كثيرًا أو كان فيه مجد زائف. عبر علاقتنا بالماضى تتبلور اللحظة الراهنة.
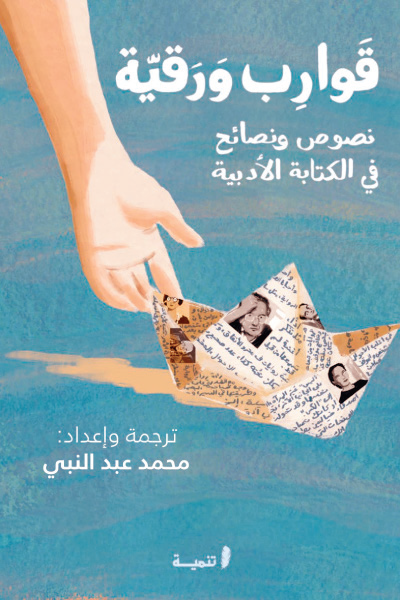
■ المجموعة أيضًا مليئة بتيمات الاغتراب والعزلة الاختيارية.. لماذا؟
- لست متأكدًا مِن قدرتى على التحدث عن تيمة بعينها فى قصص «سهرة درامية»، وربما من الأفضل أن أترك هذا للقراء المدربين والنقاد المتخصصين. بالطبع العزلة ضرورية للكاتب، لكنها ليست عزلة البرج العاجى المنفصل عن الواقع، بقدر ما هى اتخاذ مسافة صحية آمنة من المحافل والاجتماعيات الصاخبة، على الأقل لتوفير فضاء زمنى ومكانى مواتٍ للإنتاج.
قيل كثيرٌ فى العزلة كشرط للإنتاج الأدبى والفنى، ولا أودّ أن أزيد فى هذا أكثر. فى كتابه «كائنات العزلة- أنطولوجيا شعرية شخصية»، جمع الشاعر والمترجم عبدالقادرالجنابى كثيرًا من تلك المقتطفات والأقوال، فى مقدمته للمختارات الشعرية التى تدور حول العزلة من قريب أو بعيد.

■ فى غالبية نصوصك، بل وعناوينك القصصية، هناك ولع بـ«السرد الدائرى» الذى يمزج القصصى بالروائى.. هل هى تقنية الكتابة أم تأثر بفنياتك وجمالياتك فى كتابة الرواية؟
- لا أعرف ما هو «السرد الدائرى»، وكيف يمزج القصصى بالروائى، لكنى من حيث التقنيات الأساسية لا أرى فروقًا ضخمة بين كتابة القصة وكتابة الرواية، الفرق الأساسى بينهما، فى ظنى، هو كثافة المادة السردية، ومدى تمركزها فى مساحة محدودة، أو انبساطها على نطاق أوسع من عدد الكلمات وبالتالى الصفحات ثم الفصول.
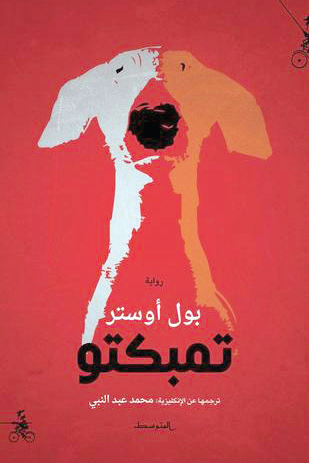
بعض الأفكار القصصية من السهل للغاية كتابتها كقصة قصيرة، ثم إعادة كتابتها كقصة طويلة، ثم تحويلها إلى رواية قصيرة، وهكذا، ما دام العالَم الخاص بالفكرة قابلًا للتوسُّع والتمدُّد. لكن بعض أفكار القصص القصيرة للغاية، من فقرة إلى بضع صفحات، من الصعب للغاية أن تُكتب بشكل آخَر غير صورة القصة القصيرة. فالفرق ليس فى تقنيات الكتابة بقدر ما هو فى إمكانيات كل فكرة وحدودها.
أستمتع بقدر أكبر مع القصة القصيرة، سواء بكتابتها أو بقراءتها، الرواية فيها نوع من الالتزام والعمل المتواصل لفترة طويلة، تشبه سباقات الماراثون (الركض لمسافات طويلة). لذلك لا أكتب الرواية إلَّا مضطرًا، عندما تفرض فكرة ما نفسها بشكل روائى وليس قصة.

■ فى عصر الحروب على أساس الهوية والعرق والديانة واللون والجنس.. كيف ترى مستقبل الآداب والفنون؟
- هذا سؤال كبير للغاية علىَّ، ولا أملك إجابة عنه، وأحسد مَن يملكون إجابة يقينية عنه. أنا لا أرى المستقبل، وبالكاد أعيش فى الحاضر، بالكاد أحاول أن أفهم الماضى، لكن المستقبل غيب فى علم الله، لا أحد مطلع عليه، يمكننا أن نلقى الافتراضات والتخمينات فقط، ثم يفاجئنا الواقع كما يفعل دائمًا.
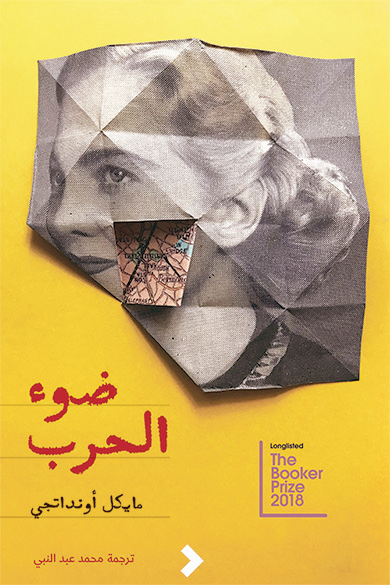
■ مع كثرة الجوائز الأدبية فى العقد الأخير مصريًا وعربيًا.. هل هناك عتبات تتكئ عليها لجان التحكيم فى مسألة منح وحجب الجوائز؟
- لا أعرف فى الحقيقة، الجوائز مختلفة، وطبيعتها مختلفة، وكل جائزة محترمة تتغير لجنة تحكيمها كل عام، ويتم الاتفاق ضمنًا على معايير أساسية، مثل سلامة اللغة أو الابتكار أو تماسك البنية. عندما شاركت كمحكم فى بعض الجوائز، مثل جائزة خيرى شلبى للرواية الأولى أو جائزة يحيى الطاهر عبدالله للمجموعة القصصية الأولى، لم تكن هناك أى عتبات أو اتفاقات مسبقة، بقدر ما كان هناك اعتماد لمعايير فنية وجودة فى الاختيار. لا أعرف أكثر من هذا، لأننى لم أطلع على آليات عمل لجان تحكيم أخرى، وبالتالى لا يبقى لدينا غير تكهنات وتخرصات.

■ ترجمت الكثير من الأعمال لكُتَّاب من عوالم شتَّى.. ما أبرز الأسماء التى توقفت عندها؟
- مع كل تجربة ترجمة أتعلَّم أشياء جديدة، وأستفيد من الكاتب الذى أترجم عمله حتَّى ولو لم يكن موافقًا لذوقى الأدبى كثيرًا. إذا اخترت عملًا واحدًا ممَّا ترجمته سابقًا سأختار بلا شك الكاتب جيرالد مرنين، الذى ترجمت له رواية «مليون نافذة»، فهو كاتب لا شبيه له، يفكِّر فى السرد وبالسرد، وبمثابة درس فى الكتابة النثرية الجمالية البحتة، البعيدة عن كل عناصر الوصفة السردية التقليدية من شخصية وحبكة وصراع إلخ. أمَّا فى الوقت الراهن فأنا أقرأ قصص وكتابات الأمريكية ليديا ديفيس، التى ترجمت لها سابقًا مقالات، وأترجم لها حاليًا قصصًا متفرقة، وأتمنى أن أترجم لها أحدث أعمالها «غرباؤنا» إذا تم الاتفاق عليه مع إحدى دور النشر.
■ مَن الكاتب الذى تأثرت به أكثر من غيره.. وهل أنت مؤمن بالرَمز أو المثال فى الكتابة؟
- لم يعد لدى رمز أو مَثل أعلى فى الكتابة، ربما يكون هذا شيئًا مؤسفًا، وربما يكون شيئًا مُحررًا مِن أسر الرموز. هناك بالأحرى دروس أو إشارات نستطيع أن ننتفع بها من حياة وتجارب كثير من الكتّاب والمبدعين، دون تخصيص واحدٍ منهم.
يتأثر كل كاتب، وربما كل قارئ فى الحقيقة، بكل مَن يقرأ لهم من الكُتّاب، سواء كانوا عظماء من وجهة نظره، أو ضعفاء وغير جديرين بوقته. طبيعة هذا التأثير ودرجته تتغير تبعًا لسن الكاتب الذى يقرأ، ولتجربته وسعة إطلاعه وعمق خبرته مع الكتابة، كما تتغيَّر تبعًا كذلك لنوعية كتابته ولنوع الكُتَّاب الذين يقرأ لهم فى هذا النوع.
وهكذا لا يمكن تعميم قواعد ثابتة فى مسألة التأثير والتأثر هذه. ومن الأفضل أن يُترَك الأمر بكامله للنقاد والمتخصصين. عن نفسى أحبُّ كُتابًا كثيرين، وتأثرت ب«إدوار الخرَّاط» فترة وبـ«نجيب محفوظ» فترة، وبغيرهما من كُتَّاب غير مصريين أو عرب فترات. لكنها تظل موجات تذهب وتجىء، ويظل التأثير العميق الدائم ألطف وأدق مِن أن يُرى بالعين المجردة.
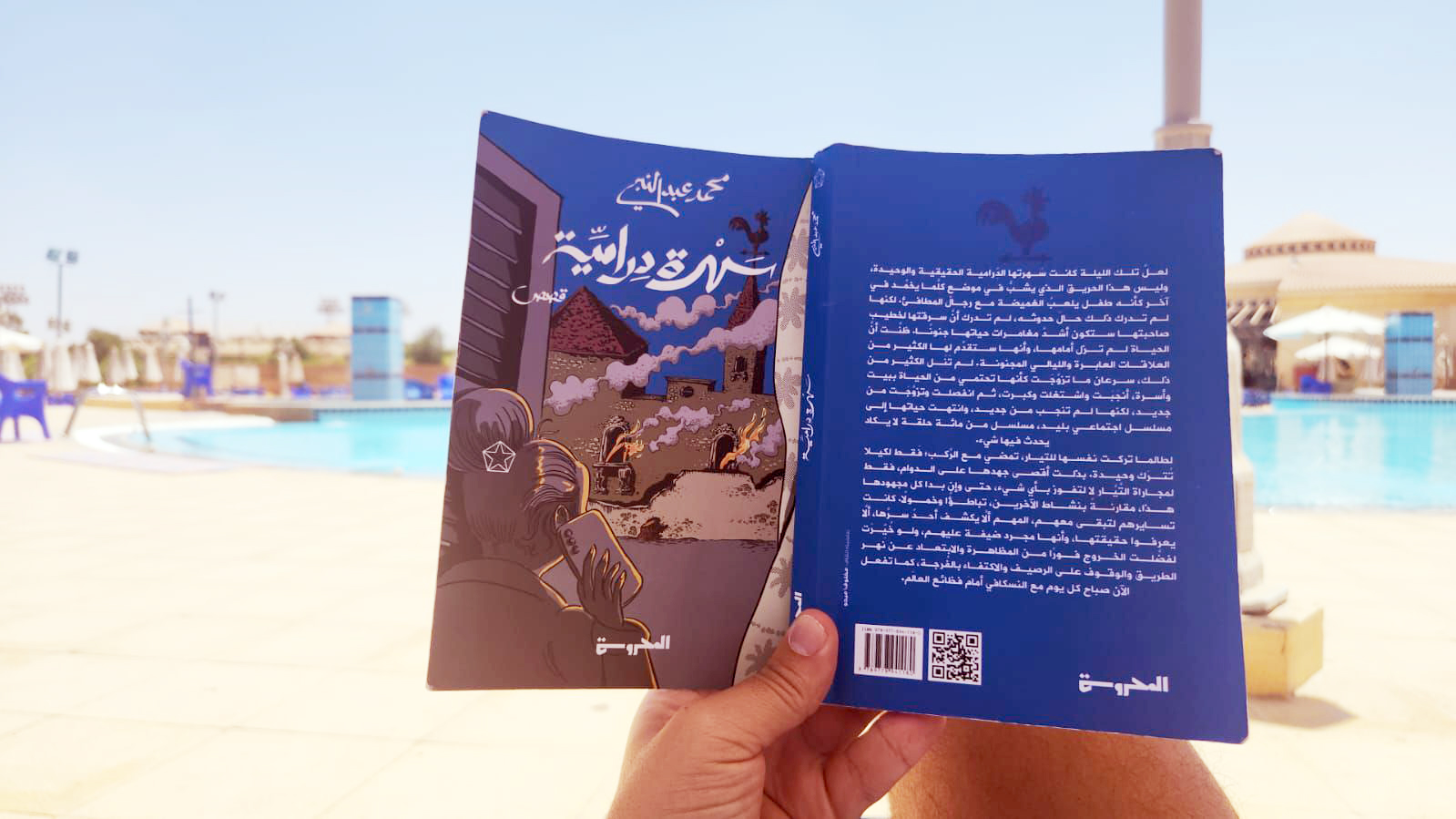
■ من خلال التعامل مع نصوصك فى القصة والرواية.. كيف ترى خارطة النقد فى مصر؟
- هذه مسألة عويصة، ولا أظن أنَّ لدى رؤية واضحة لها. يسعدنى الحظ بين الحين والآخر بقراءة نقدية لعمل من أعمالى، وتكون مثل مفاجأة سارة، غالبًا بقلم أحد المبدعين الزملاء من غير المتخصصين، أقرأ وأسعد، ولو هناك شىء جدير بالتأمُّل أضعه فى ذهنى، ثم أحاول أن أنسى الأمر كأن لم يكن، لأنَّ المديح يعطِّل أكثر من الهجاء، وأغلب كتابتنا النقدية مديح. ولو كان المديح صادقًا ومستحقًا، لا يدفع الكتابة نفسها إلى الأمام كثيرًا. ليس معنى هذا أننى أفضل الهجاء، بل أبحث دائمًا عمَّا وراء المدح والذم، عن التفكير فى النص، عن تحليله، عن أسباب ضعفه أو قوته، مثلًا.

■ بعد أكثر من 25 عامًا من الكتابة كيف يرى محمد عبدالنبى حصاد الرحلة؟
- لا أحب أن أفكِّر فى الحصاد ما دامت الرحلة مستمرة. هى مواسم، تتجدَّد كل فترة، وكل موسم له حصاده. التربة تُرهَق وتحتاج للراحة، الماء يتأخَّر أحيانًا، البذور قد تحتاج لفترة أطول لكى تنبت فى أحيان أخرى. لكنها عملية مستمرة ومتجددة، أقرب إلى دائرة، وليست خطًا مستقيمًا من هناك إلى هنا. أنا راضٍ عمومًا لأننى أحاول بقدر استطاعتى، وأبذل غاية جهدى، لكن طبعًا ليس هناك رضا تام عن المنتَج النهائى، دائمًا هناك شُبهة نقص أو أوجه قصور، أو شىء كان بحاجة لمزيد من العناية أو التأنى. وهذا كله طبيعى تمامًا ولا يزعجنى أو يعطّلنى.