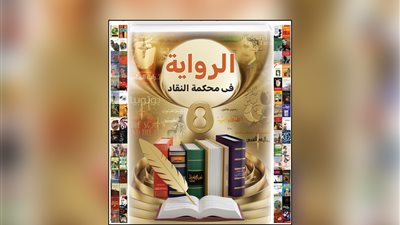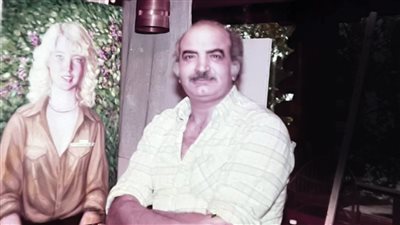حـوار المدهشات.. صبرى حافظ: «نوبل» لا تعاقب أدونيس والعرب ليس بينهم من يستحق الجائزة

- نجيب محفوظ قال لى «لم أعد أستطيع قراءة كتابات شباب الأدباء»
- جمال الغيطانى «نصف متعلم» وحوّل «أخبار الأدب» لمنصة مدح فى أعماله
- يحيى حقى كان يعتبر أى مقال عن جمال الغيطانى إهانة لكاتبه!
- وصفت محمد الشارخ بـ«اللص الكويتى» لأنه سرق الأرشيف الذى جمعته
- أنا ابن الحركة الثقافية المصرية وليس ابن الجامعة مثل جابر عصفور
- عبدالناصر حاول كتابة رواية.. وكان قارئًا جيدًا خاصة لتوفيق الحكيم
- المشهد النقدى المصرى والعربى تدهور كثيرًا.. وماضيه أفضل
- سهير القلماوى لعبت دورًا كبيرًا فى تدمير مجلة «المجلة» وإزاحة يحيى حقى عنها
- الأكاديمية السويدية قررت منح «نوبل» إلى إدوارد سعيد لولا وفاته
صبرى حافظ هو إحدى أبرز أيقونات النقد العربى المعاصر، ومن المعدودين على أصابع اليد الواحدة فى المشهد النقدى العربى الآن، وصاحب مسيرة تجعله امتدادًا لجيل الأساتذة من الكبار.
عمل طوال الوقت على تجاوز ما يمكن أن نصفه بالتقليدية، وأن يسهم بجُهديه النظرى والتطبيقى فى النظرية النقدية العالمية، عبر اشتباكه المباشر مع المركز الأوروبى، ومساهمته فى فتح الباب لدراسة الأدب العربى المعاصر فى الجامعات الأوروبية، بعدما كانت هذه الجامعات تنظر للإبداع العربى باعتباره «ماضى وَولّى».
ولا يخفى على أحد أن «حافظ» هو مِن أوائل مَن قدموا جيل التسعينيات من كُتاب الرواية والقصة القصيرة، مثل: مى التلمسانى ومنتصر القفاش وحمدى أبوجليل وسحر الموجى وميرال الطحاوى، وغيرهم الكثير.
ومازال الأستاذ المحاضر فى الأدب العربى بكلية الاستشراق جامعة لندن منذ 1987، ومؤلف العديد من الكتب فى المنهج واللغة والأدب المقارن، ومدلول السياقات الاجتماعية فى الرواية العربية- يشتبك مع واقعنا النقدى الراهن، الذى يقدم تشريحًا شاملًا له فى حواره التالى مع «حرف».
■ فى معرض شهادتك لمجلة «الطليعة» نهاية الستينيات.. أشرت إلى عدم وجود ناقد عربى أو مصرى يمكن أن ترى فيه نفسك، أو تحلم أن تكونه ما أثار جدلًا واسعًا حينها.. لماذا كنت ترى ذلك؟
- أتذكر أن هذه الشهادة، فى عام ١٩٦٨ أو ١٩٦٩، أزعجت الناقد الكبير لويس عوض، خاصة أنه كان ملء السمع والبصر وقتها، إلى جانب أسماء نقدية أخرى آنذاك، مثل أنور المعداوى، ولطيفة الزيات، علاوة على سهير القلماوى، التى لم أعتبرها ناقدة يومًا، وإنما أستاذة جامعية فقط.
ولكل واحد من هؤلاء النقاد صفة أحب أن تكون لدىّ. لويس عوض لديه القدرة على السفر إلى الخارج ومعرفة الثقافات الأخرى. أنور المعداوى كان شخصًا ممتلئًا بالكبرياء والكرامة، إلى جانب استقلال العقل النقدى. كما أحببت أن تكون لدىّ الحساسية النقدية التى تمتلكها لطيفة الزيات.
ومع ذلك، لم يكن هناك ناقد واحد يمكن القول إنه تتوافر فيه كل هذه الخصائص، خاصة أن النقد، فى تصورى الشخصى، ومنذ هذا الوقت المبكر، يعنى أنه عملية إبداعية.
■ هل هذه النظرة للمشهد النقدى المصرى والعربى ما زالت قائمة حتى الآن؟
- للأسف هذه النظرة أصبحت حاضرة بقوة، خاصة أن المشهد النقدى المصرى والعربى تدهور كثيرًا. فى الوقت الذى أدليت بشهادتى، كانت هناك هذه النماذج المهمة فى النقد العربى، فضلًا عن يحيى حقى، الناقد صاحب البصيرة الحادة. كان الوضع أفضل كثيرًا مما هو الآن.
الأمور بعد ذلك تدهورت كثيرًا، ويرجع ذلك إلى تدهور الجامعة، التى كانت تزود العقل الثقافى. فى الوقت السابق كانت الساحة العربية مفتوحة، وتتسم بقدر ما من الحراك النقدى والحرية فى التعبير، فإذا لم نكن نستطيع الكتابة فى مصر، كنا نكتب فى لبنان والعراق وسوريا.
كل هذه الأماكن كانت مفتوحة للكُتاب المصريين منذ الأربعينيات والخمسينيات، حتى أبناء جيلنا، الذين ظلوا فى تلك الفترة نجومًا للساحة الثقافية العربية، وجزءًا من مد الموجة الليبرالية النقدية العقلانية الحرة الظاهرة والمتبلورة فى هذا الوقت.

■ ما قصة حرمانك من السفر فى إحدى البعثات التعليمية فى وقت مبكر من حياتك المهنية؟
- كانت هناك مِنح للسفر والتعليم تأتى من روسيا، وتعود أهميتها فى ذلك الوقت أننى كنت فى مقتبل حياتى العلمية. ورغم أننى كنت الأول على دفعتى، حصل عليها زميل آخر ما زال فى سنته الأولى بالدراسات العليا، التى كانت لمدة عامين، وفقًا للنظام الجديد الذى قرره الدكتور مصطفى سويف عندما جاء مديرًا لأكاديمية الفنون آنذاك.
تضمن هذا النظام مجالين من مجالات التكوين الفنى والإبداع، هما: النقد الأدبى فى المسرح، وقسم السيناريو فى المعهد السينما، إلى جانب الدراسات العليا للطلبة الحاصلين على درجة جامعية. أنا كنت حاصلًا على درجة جامعية فى مجال الخدمة الاجتماعية، فتقدمت لخوض امتحان لاكتشاف القدرات الإبداعية، ونجحت فيه، ثم كنت الأول على الدفعة الأولى، وعندما جاءت المنحة لم أحصل عليها، وذهبت إلى زميل آخر.
قيل لى إن الأمن هو الذى طلب أن يسافر هذا الزميل، وليس أنا، فتأكدت أن هذا نموذج لتقديم أهل الثقة على أهل الخبرة فى نظام عبدالناصر، وهذا ما يجعلنى أذهب إلى النسق الذى أرساه طه حسين، وهو تقديم أهل الخبرة والمعرفة على أهل الثقة. بعدها قدمت شكوى لوزير الثقافة فى ذلك الوقت، بدرالدين أبوغازى، الذى كان يعرفنى بشكل شخصى، وقال لى: «لك حق».
■ ماذا حدث بعد ذلك؟
- نسق طه حسين «تقديم أهل الخبرة والمعرفة» كان المعجزة التى تسببت فى سفرى إلى إنجلترا، إذ جاء الأمر عبر أحد تلاميذه، الدكتور محمد مصطفى بدوى، الذى كان يعمل أستاذًا فى جامعة «أكسفورد»، وبدأ يقرأ مقالاتى التى تنشر فى مجلة «الآداب».
حينما زرته، عرفت أنه كان يقتبس بعض كلماتى، فى مقالاته التى ينشرها باللغة الإنجليزية. وعندما عرف أننى أريد السفر إلى إنجلترا، دبر لى تذكرة سفر على حساب الكلية، إلى جانب الإقامة، وجعل المركز الثقافى البريطانى يدفع لى ٢٥٠ جنيهًا مصريًا، وكانت الـ٥٠ جنيهًا وقتها تعادل ١٢٥ دولارًا. وحينما سافرت وفقت فى منحة للدكتوراه لمدة ٣ سنوات، لكنى عدت بعد ٦ سنوات كاملة، وللعلم كتبت كل ذلك فى كتاب «طه حسين ذكريات شخصية معه».
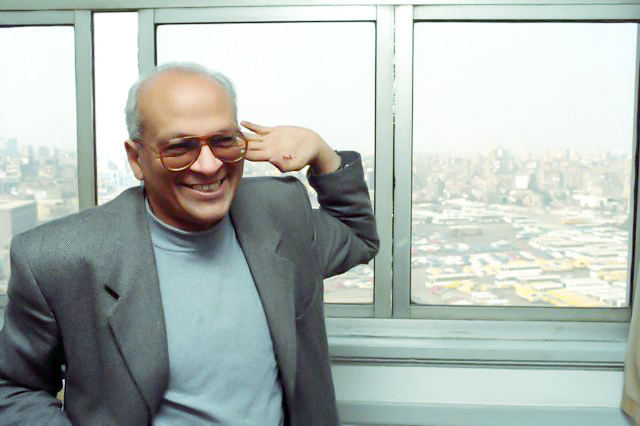
■ أيمكن القول إن أحلام جيلكم التقت مع أحلام عبدالناصر؟
- لم أسجن فى حياتى إلا فى فترة «عبدالناصر»، عام ١٩٦٦ على وجه التحديد.
اكتشفت ما يمكن تسميته بـ«خريطة وأجندة الوعى الاجتماعى والوطنى المصرى»، التى تشكلت فى أربعينيات القرن الفائت، وتبلورت فى مجلة «الفصول»، التى كان يرأس تحريرها زكى عبدالقادر، وكان من ضمن الذين عملوا فيها الكاتب الصحفى أحمد بهاء الدين، قبل دخوله «روز اليوسف» و«صباح الخير».
كانت هذه الأجندة متبلورة فى ذلك الوقت، بدءًا من الإصلاح الزراعى، وصولًا إلى مجانية التعليم، التى حققها طه حسين عبر «وزارة الوفد» من ١٩٥٠ إلى ١٩٥٢. ومجانية التعليم الثانوى هى التى فتحت لجيلى من الطبقة المتوسطة الدخول للجامعة فيما بعد. هؤلاء الذين دخلوا إلى المدارس الثانوية، ثم تخرجوا فيها فى ١٩٥٥ و١٩٥٦، وكان لا بد للجامعة أن تفتح أبوابها لهم.
هذه هى أجندة الوعى الوطنى التى ألهمت «عبدالناصر». هو أحد القلائل الذين كانوا على وعى بما يدور فى الحياة المصرية، ثقافية واجتماعية. هو ذاته كان يحاول أن يكتب رواية «فى سبيل الحرية». كان يقرأ بشكل يمكن وصفه بالجيد، كان يقرأ لتوفيق الحكيم. لذا يمكن القول إن كل هذا الجيل متفق مع الأجندة الوطنية التى اشتغل عليها «عبدالناصر»، لكن مختلف معه فى قضية الحرية.

■ فى رأيك.. هل نظام «عبدالناصر» كان مؤمنًا بفكرة تصدير مثقفيه إلى المشهد الثقافى العربى؟
- لا أظن ذلك، لأن المثقفين كانوا أبناء المسيرة التى تأسست منذ عودة طه حسين من جامعة «السوربون» فى فرنسا، وعمله فى الجامعة، ومعه جيل كامل ممن أسميتهم «جيل عبدالله النديم».
لم يكن هناك أبناء لزكى مبارك بهذا المعنى، فهو ليس من الشخصيات الفارقة، لأن هناك عشرات مثله يدرسون فى الجامعة المصرية، فضلًا عن الجيل الذى تلاه، مثل غالى شكرى وعلى الراعى وغيرهما. ومنهم من اختار أن يندرج تحت المؤسسة، وآخر اختار أن يكون مثقفًا مستقلًا وعقلانيًا مغايرًا.
■ أينتابك أى إحساس بالظلم تجاه السلطة الثقافية لعدم حصولك على جوائز؟
- أحسست بالغبن فى بداية حياتى، بعد عدم حصولى على بعثة الدراسة فى روسيا، كما سبق أن ذكرت. وعلى العكس من هذا الشعور، كنت محظوظًا فيما بعد بالسفر والدراسة فى لندن، وأن أكون جسرًا بين الخارج والداخل، بين الثقافتين العربية والأوروبية.
عدت بعد حصولى على الدكتوراه، ولم أجد فرصة للعمل فى الجامعة المصرية، فعدت للعمل فى الجامعات الغربية على مدى أكثر من ٢٠ عامًا، عملت خلالها فى العديد من الجامعات فى أوروبا، قبل أن استقر فى جامعة لندن.
هذا ساعدنى ليس فقط فى تطوير نظريتى النقدية، بل أطور تصوراتى النظرية لمسيرة الأدب العربى، وأطرحها عبر عدد من الكتب التى نُشرت باللغة الإنجليزية.
طورت تصورًا مغايرًا لأدبنا العربى. كنت فى هذا الوقت أشجع طلابى على تطبيق النظريات النقدية الحديثة على أعمال عربية. هذا المنحى سبقنى إليه محمد مصطفى بدوى، وجعل الأدب العربى الحديث مادة للدراسة فى الجامعات الأوروبية.
قبل هذا كان ينظر للأدب العربى على أنه جزء من تصور سائد بأن العرب لديهم حضارة قديمة وبادت. كان يُدرّس الأدب العربى مثل اليونانية القديمة، مع اعتبار أن الحضارة الحديثة ليس للعرب وجود فيها.
هذا ما غيرّه محمد مصطفى بدوى، رغم أنه كان من أبناء المنهج الوصفى التقليدى فى هذه الفترة، التى يمكن أن نسميها «فترة انفجارات النظرية النقدية»، فترة اكتشاف باختين، واكتشاف النظريات الجديدة، التى منها مدرسة براغ.
ما فعلته كان بمنزلة نقلة وإضافة لما ذهب إليه محمد مصطفى بدوى، وهو تطبيق المناهج الحديثة على دراسات الأدب العربية «دراسات الأدب المقارن»، ونقل الاهتمام من مركزية أوروبا إلى ندية التعامل معها، والعلاقة بين المناهج المختلفة، وكان هذا على مدار ٣٠ سنة كاملة.

■ ماذا عن نقاط التلاقى بينك وبين طه حسين؟
- أنا ابن الحركة الثقافية المصرية، وليس ابن الجامعة المصرية. ليس مثل جابر عصفور على سبيل المثال، الذى سلك مسلك الجامعة. خرجت لسبب تكوينى المختلف. ولحسن حظى بدأت دراسة الاجتماع فى مصر على يد أكبر الأساتذة فى ذلك الوقت، مصطفى سويف. هذا ما جعلنى ابن الحركة الثقافية بحراكها الواسع.
لذا حينما ذهبت متأخرًا لدراسة كتاب «فن الشعر» لأرسطو بشكل منهجى، وجدت كل المقولات الأساسية له كنت أطبقها فى كتاباتى على المسرح. لذا تحول طه حسين بكتاباته وتاريخه وسلوكه إلى مكون أساسى من مكونات الثقافة التى نعيش عليها فى هذه الفترة.
الإرث الثقافى الذى تركه طه حسين ونجيب محفوظ وأنور المعداوى ولطيفة الزيات بمنزلة الأساس الذى نبنى عليه ثقافتنا الحالية، فبفضل استقلالهم الفكرى وقدراتهم النقدية، استطاعوا أن يشكلوا الوجدان الثقافى بشكل عميق. ورغم مرور الزمن، فإن تأثير هذا الإرث لا يزال حاضرًا فى كل جوانب الحياة الثقافية. حتى لو لم ندرك ذلك بشكل صريح، فمواقفنا وتصورنا للثقافة اليوم امتداد طبيعى لهذا التراث الغنى.
كذلك يجب الإشارة إلى نجيب محفوظ، وندوته التى كانت تعقد فى الأوبرا، وتماثل «سينمارًا علميًا وثقافيًا»، يماثل أفضل «السينمارات» العلمية والأدبية التى تعقد فى جامعات أوروبا.
هذه هى القيم المعرفية التى انحدرت من طه حسين، دون أن نفكر بها كيف وصلت إلينا. لكن حينما تكتب تتحقق من أين جاءت كل هذه الرؤى والأفكار، وهذا ما حدث مع كتابى «طه حسين ذكريات شخصية معه».

■ هل كان هناك اشتباك حقيقى بين النقد العربى والأوروبى فى ذلك الوقت؟ وكيف ترى ما ذهب إليه الناقد والأكاديمى المغربى الدكتور عبدالرحيم جيران من أن «النقد العربى ظل مستهلكًا حتى وصل إلى مجرد ببغاوى لا يقدم أى منتج»؟
- إلى حد كبير كان هذا هو الموقف. الأجيال الأولى التى جاءت طبقت تقريبًا هذه النقلة بتطبيق المناهج الغربية، وعلى رأسهم طه حسين المنشغل بالمنهج «الديكارتى»، والذى ظهر بوضوح فى كتابه «فى الشعر الجاهلى». كذلك لويس عوض كان يدور حول المقولات التى تبلورت من عهد الإغريق، خاصة أنه بدأ حياته النقدية بكتاب «فن الشعر».
وحينما كان الناقد محمد مندور يدرس فى فرنسا، كان ديسسوار يكتب فى كتابه الذى تحول إلى نقلة فى المنهجية التى قامت عليها كل النظريات البنيوية بعد ذلك. كان مندور يعرف ذلك، لكن حتى بعد عودته كان يطبق المناهج الفرنسية التقليدية.
وهكذا، الحركة الثقافية لم تكن تبلورت. فيما بعد تبلورت القصة والرواية، ولذا كنا نلتف حول نجيب محفوظ، لأنه كان يكتب فيما نفكر فيه، وظل حتى آخر يوم فى حياته يعى أكثر ما يدور فى الواقع الثقافى المصرى والعربى.
قال لى مرة وهو فى الفترة الأخيرة من حياته إنه لم يعد يستطيع أن يقرأ كتابات الأدباء الشبان، وهذا يؤلمه جدًا، لأنه يعيد هضم كتاباتهم عبر منتجه الإبداعى. هو لم يتوقف أبدًا عن الإبداع، حتى فى وصوله لمراحل الذروة، فى أعمال مثل «الثلاثية» والمرحلة الواقعية. كتب «اللص والكلاب» وصولًا إلى «ميرامار»، وجاء بعد «الحرافيش» ليكتب «حديث الصباح والمساء»، التى فكك فيها بنية الرواية فى الوقت الذى تفككت فيه بنية الواقع المعيش.
كل هذا احتاج إلى أن يبدأ النقد العربى للتنظير لكل ما حدث. هذا ما فعلته على المستوى الشخصى، عبر كتاباتى فى عدد من الدوريات المصرية والعربية، منها «الناقد» و«فصول» و«الآداب»، وآمل أن أجمعها قريبًا.

■ كنت من أوائل النقاد الكبار الذين قرأوا لجيل التسعينات المهدور دمه وقدموه للمشهد الثقافى العربى.. لماذا؟
- قدمت فرزًا كاملًا لجيل التسعينات، الذى كان يشكل نقلة سردية، بدءًا من تصور البطل والمكان والخطاب، وصولًا إلى اللغة. هذه النقلة أدت إلى تغير قواعد الإيحاء، أى القواعد التى يحيل بها النص بما فى خارجه، وبداية الجدل الحوارى مع الواقع ومضاهاته بالشكل الذى يدور فيه.
هذا ما حدث مع نجيب محفوظ نفسه، فى أعمال مثل «الحرافيش» و«ليالى ألف ليلة». وهى طريقة مختلفة عن تلك الطريقة الساذجة التى تعامل بها جمال الغيطانى مع التراث بنفس لغته ونفس أدواته.
كانت هذه النقلة فى الكتابة تحتاج إلى تنظير نقدى حقيقى، وهذا ما فعلته مع جيل التسعينات. لكن حتى الآن لم أجمع ما كتبته فى كتاب، لأن كل هذه الكتابات النقدية ظلت إلى الآن متفرقة فى دوريات ثقافية، وأنا من البداية ابن لهذه الدوريات.
■ هاجمت جائزة «البوكر العربية» بمجرد تدشينها.. لماذا؟
- لأسباب أساسية، أولها أنه عندما تم تدشينها كانت محاولة لنسخ جائزة «البوكر» الإنجليزية بالعربى، وكانت تتم تحت غطاء مجموعة مستشرقين من الدرجة العاشرة، ومعهم واحد من أكثر نماذج الانتماء للصهيونية فى التاريخ البريطانى، لورد فايدن.
«فايدن» هو ناشر إنجليزى أغلب كتبه عن الشرق الأوسط، بدأ حياته كسكرتير لعزرا وايزمان، سابع رئيس فى تاريخ دولة الاستيطان، وهو صاحب مؤسسة هدفها تعزيز العلاقة بدولة الاستيطان الصهيونى.
كتبت هذه الكلام وفضحته، لكن هذا لا يمنع أن هذه الجائزة أدت إلى حراك ثقافى فى المنطقة العربية، وقدمت نماذج لأعمال روائية ممتازة، مثل «الطليانى» للتونسى شكرى المبخوت، و«فرانكشتاين فى بغداد» لأحمد السعداوى.
■ دعوات كتابة الرواية بالعامية.. كيف تراها؟
- هى مجرد دعوات، ولن تنجح لأسباب واضحة، وهى أن اللغة العربية هى المشترك بين دول العالم العربى، إلى جانب ذلك فاللغة العربية الفصحى هى لغة المقدس، وما زالت تحت الإطار العام، ولن تتفكك اللغة العربية لهذا السبب.
ستظل اللغة العربية هى لغة الثقافة من المغرب إلى العراق، وهى لغة المشترك الثقافى، الذى أثراه الإبداع الثقافى، بدءًا من «ألف ليلة وليلة» وصولًا إلى اللحظة الراهنة، بالتالى الإبداع فيها واحد.
أما عن وصول العامية المصرية إلى كل المنطقة العربية فيرجع إلى أسباب عديدة، أولها السينما، ومن بعدها الإذاعة والتليفزيون، فضلًا عن مشروع ثقافى كان قائمًا وسببًا فى رواج العامية المصرية.

■ هذا يأخذنا إلى سؤال آخر.. لماذا تعطل المد الثقافى والفنى المصرى خارج حدود الإقليم؟
- نعيش حالة من التدهور الثقافى مع المد الوهابى، الذى جاء منذ منتصف السبعينيات حتى الآن، وهذا ما ذكره «هيكل» فى كتاباته، من خلال الإشارة إلى لقاء «السادات» بعمر التلمسانى والملك فيصل، وإنفاقه ١٠ ملايين دولار لفتح الباب لـ«الإسلامجية»، ما فتح الباب للشيخ الشعراوى عبر دعمه بظهوره عبر التليفزيون والإذاعة، مع إطلاق دعوات لـ«تحجيب الفنانات»، حتى مع الوقت صار الحجاب حجابًا عقليًا للمرأة والرجل معًا.
هنا بدأت تتضرر مسيرة التنوير منذ النصف الثانى من السبعينيات حتى الآن، بعد أن كان دور المصرى مهمًا وأساسيًا ومركزيًا فى العالم العربى. وتدهور المشروع الثقافى المصرى لأن منابره ضُربت، خاصة فى مدن مثل بيروت وسوريا والعراق. كما أن السبعينيات كانت فترة تهجير للعقول المصرية، ودفع الثمن الداخل المصرى، مع فراغ الساحة من مواجهة المد الوهابى، الذى تغلغل تحت مظلة النظام آنذاك.
■ هناك أصوات نقدية عربية حازت احترام الشرق والغرب فى وقت واحد.. منها إيهاب حسن وإدوارد سعيد.. كيف تراهما؟ وهل كان الأول مع قطيعة مع مصر؟
- إيهاب حسن ينظر إلى نفسه طوال الوقت كناقد أمريكى لا مصرى، قابلته مرتين، وهو على عكس إدوارد سعيد، فقد اعتبر نفسه منذ وقت خروجه من مصر واحدًا من الأمريكان، لذا جاءت كل أعماله النقدية مرتبطة بالأدب الأمريكى.
لم يفكر مرة فى استعادة أو تحليل الأدب العربى، حتى من منظور كشف سوءاته، مقابل التبنى الكامل لقضايا الأدب الأمريكى. لكن لا يمكن إنكار دوره فى التنظير النقدى، خاصة فيما يتعلق بما بعد الحداثة.
إدوارد سعيد لم يتوقف فقط فى استعادة لغته العربية وموقفه من القضايا الكبرى، بل إنه غيّر الخريطة النقدية نتيجة موقفه، ونقده بلغ الخطاب الغربى، ونجح فى زعزعة مركزية هذا الغرب الاستعمارى، وتغيير رؤى الآخرين تجاه الشرق. هذا واضح عبر مشروعه فى كتبه عن الاستشراق. تأثير إدوارد سعيد دام واستمر، وتحول إلى مدارس مختلفة الآن فى نقد الاستشراق، أو النقد الثقافى أو المتعلق بالموسيقى.
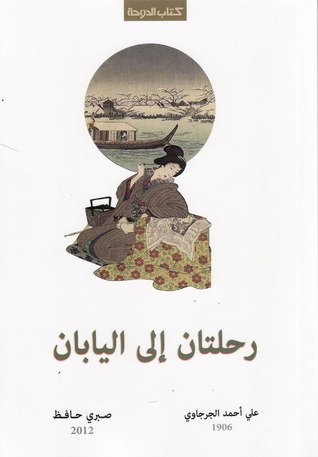
■ أشرت إلى أن إدوارد سعيد كان من ضمن أبرز الأسماء العربية المرشحة لـ«نوبل».. هل هناك أسماء عربية فى المشهد الثقافى العربى يمكن ترشيحها الآن للجائزة؟
- عندما عدت إلى مصر فترة السبعينيات، ولم أجد مكانًا لى فى الجامعة المصرية، رجعت إلى العديد من الجامعات الأوروبية حتى استقر الأمر بى فى جامعة لندن. فى تلك الفترة من التنقلات كانت تربطنى علاقة قوية بالعديد من أساتذة الجامعات، خاصة فى السويد، وأُتيح لى إلى حد كبير معرفة بعض الأعضاء من داخل الأكاديمية السويدية. وفى عام رحيل إدوارد سعيد، كانت هناك رغبة شديدة من جانب الأكاديمية فى إعطاء الجائزة له. لكنه رحل فى نفس العام. وهناك العديد من الأسماء العربية التى رُشحت لجائزة «نوبل» فى مجال الأدب، على رأسهم يوسف إدريس ومحمود درويش وأدونيس.
■ عدم منح أدونيس جائزة نوبل هل يعتبر عقابًا له؟
- لم تعاقب «نوبل» أدونيس، ولم تأتِ فرصة ليحصل العرب على جائزة أخرى، ولو حدث سيكون المجال مختلفًا عن الأدب. هناك من رُشح للجائزة ولم يحصل عليها، منهم الروائى الجزائرى محمد ديب.

■ أسماء مثل هشام مطر وجوخة الحارثى.. ما مستقبلها مع الجائزة؟
- إلى حد كبير لم يصل أحد بعد إلى مستوى ما أنجزه نجيب محفوظ. وبعد الفضيحة التى حدثت مؤخرًا داخل الأكاديمية، يبدو أن هناك مناوبة بين الذكور والإناث فى الفوز بها، ويبدو أن هذا يصعب الأمر كثيرًا علينا كعرب فى الحصول على الجائزة مرة أخرى.
■ كنت من أوائل الذين أدركوا أهمية الوسائط الرقمية ودشنت مجلة «الكلمة».. ما تفاصيل تلك التجربة؟
- أسستها منذ ١٨ سنة، واستمرت كمجلة شهرية لمدة ١٥ سنة، وجاءت كمشروع ثقافى متكامل، وبشراكة مع الكويتى محمد الشارخ، بدأنا نؤسس لها. كنت أعد رسالة الدكتوراه، وأمضيت ٣ سنوات فى التنقيب بالدوريات العربية للتأريخ لتطور الخطاب العربى السردى. سنوات طويلة قضيتها فى مراجعة الدوريات.
اكتشفت فى السنوات الأخيرة من عملى بالجامعة أن الطلاب غير راغبين بالعودة إلى الدوريات، هم يبحثون عنها عبر الإنترنت، فكان هذا أحد الدوافع الأساسية للمشروع، والتى ستؤدى إلى تمويله؛ أن نوفر الأرشيف الرقمى للدوريات العربية. بدأنا العمل لـ٣ سنين، وبعدها انفصل «الشارخ»، وسُرق الأرشيف الذى بدأته. وكتبت هذا عبر مجلة «الكلمة» تحت عنوان «اللص الكويتى».
كان هدفى أن يكون هذا أرشيفًا أكاديميًا تشارك فيه جميع الجامعات العربية، وبدأنا نذهب للعديد من المؤتمرات وأمناء المكتبات فى الأقسام العربية داخل أوروبا، وطلبنا منهم الاشتراك، وبهذا الاشتراك كنا سنمول المجلة والأرشيف فى نفس الوقت، ليكون جزءًا وأداة أساسية للبحث العلمى.
الحقيقة أن الأمر لم يكتمل، ولم يصبح للمجلة أى مورد للتمويل، وأصبحت قائمة على العمل التطوعى، وعملى بدأ يتناقص مع تقدمى فى العمر، لذا تحولت إلى مجلة فصلية. وللأسف لم أجد ما يشجع على التعاون عبر المؤسسات فى مصر أو خارجها من أجل استمرار المجلة.
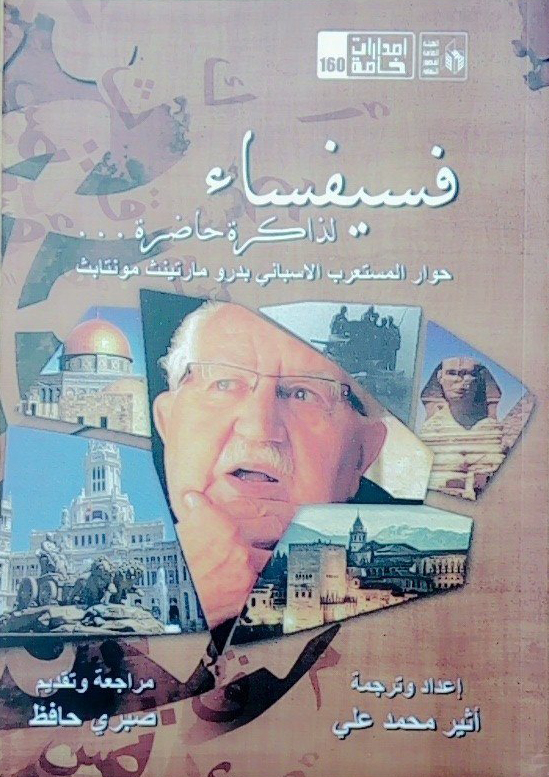
■ التطور الرقمى والكتابة الإبداعية عبر وسيط الذكاء الاصطناعى.. إلى أى مدى يهدد ويضيف لمشهد الإبداع والنقد فى العالم؟
- لا أتصور أن الرواية كعمل إبداعى أو حتى العمل النقدى يكتملان بهذا الشكل الرقمى. صحيح أن هناك محاولات، لكن منذ ٢٠٠٦ لا توجد رواية رقمية واحدة مهمة. والنقد جزء من التكوين الإبداعى ويحتاج إلى قدر كبير من التكوين الفكرى والثقافى والفلسفى، لأن الجانب الفلسفى مهم جدًا فى خلفيات النظريات الأدبية.
ولا بد أن تتوافر لدى الناقد الحساسية والشفافية والقدرة على استشراف المستقبل فى الأعمال الإبداعية التى يقرأها حتى يراهن على ما يقرأه. مثلًا هناك كتابات كتبت عنها قبل نشرها، وهذا فعلته مع أحمد زغلول الشيطى ومى التلمسانى ومنتصر القفاش، هؤلاء راهنت عليهم وما زالوا مستمرين.
بالنسبة للنقد فى المغرب مثلًا، الطالب يخرج من المدرسة الثانوية وهو يجيد اللغة الفرنسية تمامًا. أما الطالب المصرى فيخرج من الجامعة دون أن يجيد أى لغة أجنبية، ولديه مشاكل فى إجادته العربية.
هذا فرق فى التعليم، وهذا ما جعل معظم النقاد المغاربة قادرين على التعامل مع النص النقدى الفرنسى، خاصة أن فرنسا أجرت تحديثًا كبيرًا فى النظرية النقدية، بدءًا من رولان بارت حتى تودوروف.
وهذا ما جعل النقد المغربى يكون على اتصال مباشر بما يدور فى النقد الغربى وبشكل معاصر، وهناك عقل نقد أثرى مجاله، مثل محمد عابد الجابرى، وهذا لأنه تأسس على هذه المدرسة الفرنسية.
الأجيال الجديدة لم يُتح لها السفر، لكن نجد أسماء مثل ممدوح فرج النابى، الذى يدرس فى تركيا، والناقد الشاب محمود الغيطانى، وهى أسماء موهوبة نقديًا. والأخير قرأت له ولم أعرفه شخصيًا.
■ اتخذت موقفًا عدائيًا من جمال الغيطانى.. لماذا؟
- جمال الغيطانى هو ابن التحول الردىء الذى حدث فى القيم الثقافية العربية. فحينما كان يحيى يحقى رئيسًا لتحرير مجلة «المجلة»، وأنا اقتربت منه وعملت معه لعدة سنوات، كان يرفض أن يذكر اسمه فى المجلة، حتى بشكل تاريخى. كان يرى مجرد وجود اسمه فى مقالة يعد إهانة لكاتب المقال وله شخصيًا. على عكس «الغيطانى» الذى حول «أخبار الأدب» وفتح أبوابها للكتابة عن أعماله التى لا قيمة لها والمليئة بالأخطاء الإملائية واللغوية، حتى حديثه فى المؤتمرات التى حضرها خارج مصر كان مليئًا بالأخطاء، وكانت مسار سخرية المستشرقين.
«الغيطانى» لم يكمل تعليمه فهو «نصف متعلم»، وذلك يرجع إلى النظرة للتعليم، فهناك فرق واضح بين التعليم الجامعى المنظم والمنهجى وما يوفره من عقلية منظمة. هذه الخطوة الأولى التى تستطيع أن تبنى عليها، وهذا لم يحدث مع «الغيطانى»، على عكس مثلًا محمد شكرى صاحب «الخبز الحافى» الموهوب بالفطرة، وصاحب أعمال ابنة بيئته. فى وقت تجد فيه أعمال «الغيطانى» مملوءة بادعاءات معرفة بالتراث والتصوف، لدرجة تعيينه مديرًا لسلسلة «الذخائر» فى الهيئة العامة للكتاب.
■ سهير القلماوى لعبت دورًا كبيرًا فى إزاحة يحيى حقى.. لماذا؟
- جاءت سهير القلماوى مع المد الذى جاء مع أنور السادات، وكانت قريبة من جيهان السادات، ولعبت دورًا كبيرًا فى تدمير مجلة «المجلة»، وإزاحة يحيى حقى. هى دون شك تلميذة طه حسين، وعاصرت تفاصيل عملها الدءوب لـ«تطفيش» يحيى حقى من مجلة «المجلة»، التى كانت لها أكبر الأثر فى فتح الباب للجيل الجديد، مثل يحيى الطاهر عبدالله وعبدالحكيم قاسم وسعيد الكفراوى.