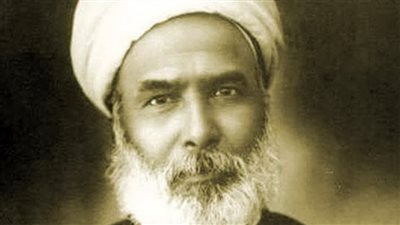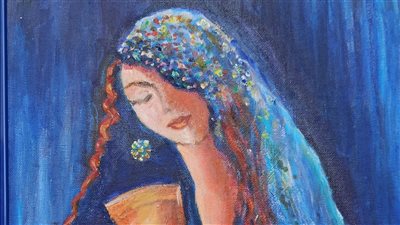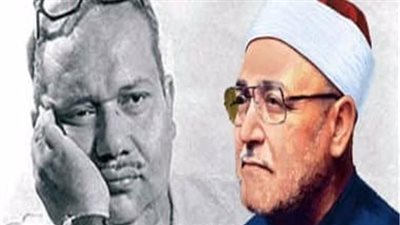راوتر شيخ البلد.. إعادة كتابة حكايات القرية المصرية

- تقوم حبكة راوتر شيخ البلد على أن شيخ البلد حينما وافته المنية قرر أولاده وضع راوتر يخدم أهل البلد
- هناك علاقات واضحة بين ما يكتبه عاطف وبين الكتاب الشهير الذى يحمل عنوانًا عجيبًا «هز القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف»
قرر عاطف عبيد، أخيرًا، الإفراج عن مجموعته التى سمعت قصصها غالبًا فى السنوات الخمس الأخيرة، وعلى الرغم من أنه يسعى دائمًا إلى البحث عن ابتسامة القارئ وضحكته وهو أسلوبه تقريبًا فى جميع أعماله، فإن تلك الضحكة أو الابتسامة تحمل من التهكم والمفارقة الكثير، إضافة إلى أننى أراها تعكس الروح المصرية الريفية، وتحمل ملامح الروح المصرية العامة، التى تسخر من كل شىء كعادتها حتى من نفسها إذا لزم الأمر، ولا يتوقف الحد عند السخرية بل يتعداها إلى نوع من الأنثروبولوجيا الثقافية التى تنتشر لدينا فى الريف المصرى، وهو يستكمل من جانب آخر روح القصة القصيرة التى خرج بها كثير من الكتاب المصريين فى العصر الحديث مثل عبدالحليم عبدالله ويوسف أبورية، وسعيد الكفراوى، وخيرى شلبى وكثير غيرهم، ولكن ربما يحتاج الأمر لرؤية تنتمى للنقد الثقافى أكثر من انتمائها للنقد الأدبى.
تمثل القصة القصيرة عند عاطف عبيد نوعًا من الاتكاء الأنثروبولوجى على ثقافة المكان والناس فى ريف مصر، وهو لا يتوقف عن حلب الحكايات ويسعى لتطويرها بحكم انتمائه لمجال تكنولوجيا المعلومات التى تمثل قاسمًا مشتركًا كبيرًا فى معظم قصصه الأخيرة، وهو لا يقبل بنهاية واحدة لنفس القصة، بل إنه يعيد تدوير الحكاية ليفوز بنهايات مغايرة للنهاية التى كتب بها القصة فى المرة الأولى، وغالبًا هو ما يتوسل المثل والحكمة والسخرية والتهكم من وراء الحكاية سواء أكانت جملة أو مشهدًا، ولكن أى كوميديا، وأى سخرية وتهكم؟!

إذا أردنا التحقق من جذور القصة القصيرة عند عاطف عبيد علينا أن نستكشف علاقة ما يكتبه بتاريخ القرية المصرية، فثمة علاقة ثقافية تاريخية بين ما يكتبه عبيد وبين التاريخ والتحولات التى جرت خلال النصف قرن الأخير على القرية المصرية، وهناك وشائج قربى بين حكايات الفلاح الفصيح «خون- أنوب» والذى عاش فى أهناسيا فى عهد الأسرة التاسعة أو العاشرة «نحو ٢٠٠٠ ق. م»، فى خطاباته لأحد النبلاء يشكو إليه ملماته وأحزان مظلمته التى وقعت على يدى مشرف «أو خولى» يدعى «نمتيناخت» حين ادعى الأخير أن حمارة «خون- أنوب» قد أكلت من زرع ذلك النبيل الذى يدعى «رينسى بن ميرو» بالقرب من ضفة النهر على تخوم إحدى القرى المصرية، حين استطاع «نمتيناخت» أن يستولى على حمار وبضاعة الفلاح التى كان يريد بيعها فى السوق بالمدينة بالتحايل والعدوان، وقد لاحظ النبيل أن شكاوى الفلاح تتجمل بالفصاحة والبلاغة رغم موضوعها الحزين، فعرض الأمر على فرعون فاعجب الملك بخطابات وشكايا الفلاح وتركه تسعة أيام يبث إليه كل يوم عدة شكاوى تمثل أبلغ ما قيل فى الظلم، ولما يئس الفلاح واستشعر التجاهل من قبل النبيل أرسل خطابًا إليه أهانه فيه، فعوقب بالضرب ولما يئس الفلاح من تحقيق العدالة غادر محبطًا، لكن النبيل أرسل إليه أن يعود ورد له حماره بل وعينه مشرفًا بدلًا من الخولى الذى ظلمه، لتنتهى شكاوى الفلاح الفصيح نهاية سعيدة مغايرة لكل واقع نعيشه.

كذلك هناك علاقات واضحة بين ما يكتبه عاطف وبين الكتاب الشهير الذى يحمل عنوانًا عجيبًا «هز القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف» وهو واحد من أهم كتب التراث المصرى الذى خطه الشيخ يوسف الشربينى فى القرن السابع عشر «بين ١٦٠٠- ١٦٩٩م» أيام الحكم العثمانى متحدثًا فيه عن الفلاح المصرى وإن كان أهال عليه كثيرًا من الصفات السيئة وسواء اتفقنا أو لم نتفق مع الشيخ يوسف فى الصفات التى أطلقها على الفلاحين فى مصر، إلا أنه يلقى أضواءً مهمة على الحياة الاجتماعية للفلاحين وأحوالهم فى الوادى منذ ما يزيد على ثلاثة قرون.
وكذلك هناك وشائج قوية بين القصة التى سميت المجموعة باسمها «راوتر شيخ البلد» وبين القصة الشهيرة لحسين مؤنس التى كتبها عام ١٩٧١ بعنوان «إدارة عموم الزير» التى تحكى عن ملك كان يسير ضمن حاشيته على أحد الأنهار ليجد الناس يشربون من مياه النهر، فأمر بوضع زير ضخم يوفر ماءً صالحًا للشرب، لكن البيروقراطية المصرية لم يعجبها الحال، فبعد عدة أيام تدخل أحد رجال الحاشية مطالبًا بتوفير كوز وغطاء للزير، ولأن هذه الأشياء من مال الحكومة فلا بد من تعيين حارس عليها، ووجد أن الأمر لا يحتاج لحارس واحد، بل لا بد من تعيين عدة حراس لمراقبة استخدام الكوز والغطاء، ومن ثم يجب تشكيل إدارة جديدة ليست موجودة فى دواوين الحكومة، وبعد مدة تم إنشاء مبنى جميل بجانب الزير اسمه «إدارة عموم الزير»، وأثناء مرور الملك بعد عام وجد المبنى الجميل وبه عدد هائل من الموظفين الذين شكلوا إدارات وأقسامًا، وبجانبها يقف الزير مكسورًا وقد تم نهب الكوز والغطاء، ومن المفهوم أن حسين مؤنس كان يلقى باللوم على الإدارات الحكومية واهتمامها بهيكلها وأوراقها أكثر من اهتمامها بخدمة المواطن.

تقوم حبكة راوتر شيخ البلد على أن شيخ البلد حينما وافته المنية قرر أولاده وضع راوتر يخدم أهل البلد، وهكذا كان المارة يتوقفون أمام هذا الراوتر المفتوح، والمتاح مجانًا استخدامه لكل عابر سبيل «وعلينا ألا ننسى أن هناك بُعدًا ثقافيًا لهذه المسألة فى الثقافة العربية والمصرية وهى عادة ما تتكلل إما بوضع زير أمام المنزل، أو مبرد مياه يشرب منه العابرون كنوع من الرحمة والتذكر لروح المرحوم»، وهكذا ولما عرف المكان من قبل أهل القرية، بدأ الزحام مما كان يتسبب فى انتهاء باقة الإنترنت سريعًا مما اضطر أولاد شيخ البلد إلى زيادة الباقة أو شحنها على فترات أسرع، ومن ثم بدأ الشارع الذى يمر أمام بيت شيخ البلد يتحول إلى سوق وزحام لرغبة الناس فى الاستفادة من الراوتر المجانى، وتتصاعد الحكاية إلى أن تصل بالناس لكسر باب بيت شيخ البلد الزجاجى من أجل المطالبة بتقوية الراوتر وحصول الجميع على إنترنت مجانى، وهنا أقسم عثمان ابن شيخ البلد إنه لن يجدد الإنترنت، وإنه سيخلع الراوتر من مكانه، زاد صفير الصبية، تقول زينب بنت شيخ البلد:
لم نعد نستطيع النوم من كل هذا الضجيج حول راوتر أبى، ولم يعد لنا طاقة بتكلفة الإنترنت كل شهر بهذا الحجم، هنا يتدخل ضابط ويقول لها:
نحن الذين ندفع تكلفة الإنترنت، بالاتفاق مع عثمان أخيك، والدك كتب لنا وصية أن يظل ينقل أخبار البلد إلينا حتى بعد موته، ففكرنا فى تركيب الراوتر فى الجرن الكبير!

بهذه الجملة الأخيرة، تأخذ القصة منحى آخر تمامًا بعيدًا عما يدور فى أذهاننا، وهى علاقة شيخ البلد بالأمن بتقصى أخبار الناس، مشكلة مؤنس فى السبعينيات كانت البيروقراطية، مشكلة عاطف هنا أن الإنترنت أصبح كاشفًا حتى لخفايا النفوس، وأن أكثر المستفيدين منه فى العالم كله رجال الأمن!
هناك قصص أخرى فى المجموعة تعكس نهاياتها حس التهكم، أو كوميديا الفارس، باللاتينية Farcire التى استخدمها ثربانتس فى دون كيخوته، وكل أعماله المسرحية التى استخدم فيها هذه النوعية من كوميديا الموقف التى تصل لحد التهكم الجارح، فقد كان ثربانتس مسرحيًا ورجل كوميديا الموقف أو الفارس فى القرن السابع عشر هو وموليير فرنسا خاصة مسرحيته الشهيرة طبيب رغم أنفه، ولعلنا لا ننسى للآن كيف استخدم ثربانتس هذا النوع من كوميديا الموقف فى عمله الأشهر دون كيخوته، وهنا أيضًا يتحول عاطف إلى كوميديا الفارس بنكهة ما بعد حداثية، بمعنى أن يؤهل مسرحة القصصى لإلقاء قنبلة غاز الضحك، كى يجعلك تضحك على أسوأ ما يمكن أن تشاهد، هنا لا يكون الهدف من الإضحاك هو الإضحاك ذاته، بل هذا المشهد الذى يجبرك على قبول تهكمه، والتهكم عبارة عن نوع من الازدراء لكل ما لا يقبله العقل لكنه يحدث، وحدوثه هو ما يفجر ذلك النوع من الكوميديا السوداء، فحياتنا مكتظة فى الأصل باللا معقول، ولأنه سيحدث شئنا أم أبينا فعلينا أن نضحك!

قصته «العجل هَد المصطبة» تذكرك على سبيل المثال بالقاص الصينى صاحب نوبل، مويان فى روايته عن الفلاح الصينى وأحواله مع الاشتراكية والشيوعية هناك، وهو بالطبع عضو فى الحزب الشيوعى الصينى، لكنه نقد الأوضاع هناك فى روايته الخالدة «الذرة الرفيعة الحمراء» مما يعنى أن الصين منفتحة على النقد الذاتى، وقد قالت لجنة نوبل عن أدب مويان «إنه يدمج الهلوسة الواقعية بالحكايات الشعبية والتاريخ والمعاصرة»، قدم مويان فى روايته هذا النموذج الذى يكاد يتشابه بين مصر والصين، لأنهما حضارتان قديمتان خاصة فى مسألة تعشير الجواميس من قبل عجل ذكر، وما يحدث أثناء عملية التعشير نقرأها نحن كمهازل بينما يمارسها الريفيون كأمر عادى، أما عاطف عبيد فإنه يعمل فى كتابته كناقد اجتماعى يحاول التعرف على حدود التطور الأنثروبولوجى فى السلوك الاجتماعى والثقافى فى القرية المصرية، حيث وصل الأمر وفق رؤيته بإحدى خريجات قسم اللغة الفرنسية من كلية الآداب أن تقوم بنفسها بمساعدة الثور على القيام بعملية التعشير، بل تنشئ جروبًا على الواتس وأيضًا تضع إنستا باى لتحصيل الأموال الخاصة بهذه العملية من كل أسرة تريد تعشير جاموستها، هنا لا مكان للأخلاقية لأن ذلك جزء من الحياة هناك، وأن هناك تطورًا يحدث لا يمكننا تخيله، ولا تملك إلا أن تضحك فى النهاية، فالأمر بأكمله عبثى تمامًا، كما ضحكت مع مويان وهو يصف نفس العملية فى الريف الصينى وبتفاصيل بالطبع مختلفة.

هناك كثير من القصص التى بالطبع لا تتطلع لما يحدث فى الريف لكنها تحمل هواء الريف مثل الحنين الواضح للأب والأم فى قصتى «النظارة» و«البغل»، ولكن فى المجموعة قصتان فريدتان فى نوعهما.. الأولى هى قصة الحذاء، حيث مات عبدالحميد المنادى فى القرية وأثناء غسله يكتشف مغسل الجثة أن قدمى المنادى متورمتان بشدة كأنهما كانتا محشورتين فى جوارب من الحديد، وهذا أيضًا كان يحدث فى اليابان من أجل تصغير أقدام النساء كنوع من التجميل للقدمين، لكن هنا كان السبب مختلفًا تمامًا، طلب المغسل من الابن أن يحضر له حذاء أبيه الميت، وبعد مقارنة الحذاء بالقدم قال المغسل:
• لماذا كان أبوك يلبس حذاء ٤١ رغم أن مقاس رجليه ٤٣؟
قال متولى «ابن المنادى» باكيًا:
إنه كان كتومًا طوال حياته، قليل الشكوى، جاء إلى الدنيا ورحل منها، ولم يعرف أن البراح كان على قرب نمرتين زيادة فى حذائه الضيق!
أما القصة الثانية كنموذج فهى قصة العصعص.. فهى قصة عن الكراهية والوحدة وماذا يمكن أن يفعلا بالإنسان، ومن المعروف أن جسد الإنسان يبلى تمامًا عند الموت ولا تتبقى منه سوى عظمة العصعص أو هكذا يقال، أتى شيخ البلد والراوى إلى الرجل الممتلئ بالكراهية ليطلبا منه فض ذلك والعودة لأهله ونبذ العزلة، فيجيبهما:
أنا جمعت ١٠٠ عظمة عصعص من قبر أبى تخص كل أهلى الراحلين،

ولم يترك لى فرصة للسؤال، قال مكملًا:
لقد طحنت عظام العصعص وأحرقتها حتى لا أرى من رحلوا يوم القيامة.
إن اهتمامى بحواديت عاطف عبيد المتعلقة بالريف المصرى الذى يكاد يجف نبع الأعمال منه نتيجة الهجرة الداخلية الواسعة أو التحولات العميقة هناك، والتى يرصدها عاطف فى قصصه القصيرة- هو اهتمام بمآل وأوضاع القصة القصيرة المصرية فى ثوبها الجديد وحمولاتها المتغيرة، فماذا يمكن أن يكتب عن الريف المصرى، ها هو عاطف يحاول تقديم نموذج مختلف عما كان يحدث فى الماضى بنماذج ابنة بيئتها المتغيرة وتطوراتها وأحوالها.
عادة ما يتصل بى عاطف فجرًا كل عدة شهور لكى يلقى على مسامعى قصته القصيرة عن أحوال «ماكوندو» المصرية، والتى عادة ما ينجح فى جعلى أضحك بلا نهاية متفكرًا فى هذه الحكاية العجيبة، وفى إسقاطاتها التى لا يمكنها أن تغيب عن عقل قارئ حصيف!