أحمد سراج يدافع عن خالد أبوالليل..
دعم نسيج التماسك الوطنى أم قبلة الحياة لأسراب الخراب!

- من هاجموا كتاب خالد أبوالليل اجتزءوا فقرات تعليقية وشارحة واستطرادية واتهموا صاحبه بالجهل وعدم الكفاءة
«وفى تلك اللحظة التى تعرض فيها عبدالناصر لمحاولة الاغتيال، كان الإخوان يهيئون الجماعة والأوساط الشعبية للهجوم عليه، واتهامه ببيع القضية الوطنية للإنجليز، وأنه فى طريقه إلى بيع القضية الفلسطينية. وكان الهدف من ذلك تعبئة الرأى العام ضد عبدالناصر، واستغلال حماس الشباب الإخوانى فى التخلص منه. ولكن فى الوقت الذى كان مخطط الإخوان يسير فى هذا الاتجاه فإذا بمحاولة اغتيال عبدالناصر تفسد هذا المخطط، وتربك حسابات القيادة وأعضائها» ترد هذه الفقرة فى الصفحة التاسعة والخمسين ومائتين من كتاب التاريخ الشعبى الصادر عن هيئة الكتاب المصرية. وعلى مدار عشر سنوات انتظرت أن يؤخذ الكتاب و«مجاله المعرفى الجديد» على محمل الجد، وأن ينتبه القائمون على الثقافة المصرية؛ أفرادًا ومؤسسات إلى أهمية «التاريخ من أسفل» لكن الأمر اقتصر على ندوة فى جامعة القاهرة، تحدث فيها محاضروها ومنهم رئيس قسم التاريخ فى الكلية العريقة، عن محاولة الكتاب لفتح أفق جديد فى باب نمتلك فيه أكثر مما يمتلك الآخرون.
لأسباب مختلفة ومقنعة تأخر الحديث عن الكتاب منها فما تضخه المطابع من آلاف الكتب، وما يجرى يوميًّا من أحداث متلاحقة، وبعد مجال الكتاب عن ذائقة الأكثر مبيعًا. ولأسباب محيرة تُحدِّث عنه؛ فكأننا جئنا بعلى يوسف لنحاكمه مع جوليان آسانج لتسريبه صورة تلغراف مرسل من سردار الجيش المصرى فى السودان إلى وزير الحربية فى مصر عن الحملة العسكرية فى دنقلة، دون أن ندرك أن على يوسف فعل هذا عام ١٨٩٦، وأن مصر كانت تحت الاحتلال البريطانى! لهذا أكتب الآن.

توقعت أن يكون النقاش حول سر تأخر الدعم المؤسسى لدعم التاريخ الشعبى، وقد سبقتنا إليه دول عربية بعشرات السنوات: «تأسس مركز التاريخ الشفوى بالدارة عام ١٩٩٧م (١٤١٦هـ)، وزود بالأجهزة التقنية اللازمة لإجراء المقابلات والتسجيل والحفظ والتدوين» أو من خلال الأحداث التى تناولها الكتاب: (١) حرب فلسطين. (٢) تشكيل حركة الضباط الأحرار. (٣) حريق القاهرة ٢٦ يناير ١٩٥٢. (٤) الأوضاع الاجتماعية والسياسية قبل الثورة. (٥) الفلاحون والفقراء قبل الثورة. (٦) الإنجليز والملك. (٧) قيام الثورة. (٨) الوزارة من على ماهر إلى محمد نجيب. (٩) محمد نجيب والقيادة قانون الإصلاح الزراعى. (١٠) أزمة مارس ١٩٥٤. (١١) حادث المنشية، ومحاولة الاغتيال. (١٢) عبدالناصر والإخوان. (١٣) اتفاقية الجلاء. (١٤) تأميم قناة السويس. (١٥) العدوان الثلاثى على مصر. (١٦) السد العالى. (١٧) الوحدة بين مصر وسوريا. (١٨) الجيش المصرى فى اليمن. (١٩) نكسة ٥ يونيو عام ١٩٦٧. (٢٠) حرب الاستنزاف. (٢١) وفاة عبدالناصر. لكن تُرِك كل هذا، وتم اجتزاء فقرات «تعليقية وشارحة واستطرادية» ثم بعد ذلك اندفع أشباه دون كيخوته؛ ليملأوا السهل والجبل، متهمين أستاذ الأدب الشعبى بالجهل، وعدم الكفاءة، ولست معنيًا بالرد على أى تهمة، ولا بالبحث عن النيات التى دفعت لهذا الهجوم الذى تأخر عقدًا، واشتعل عقب اختيار المؤلف نائبًا لرئيس هيئة الكتاب، ولم يكن خامل الذكر قبلها؛ فقد كان وكيلًا لأعرق كلية فى مصر. ما يعنينى هو أن نقرأ هذا الكتاب بما أظن أنه أُلِف لأجله؛ خدمة مصر.
يتوجب قبل حديثى عن الكتاب أن أعبر عن احترامى لكل من تناوله؛ علميًّا أو صحفيًّا، مادحًا أو ناقدًا أو ناقضًا؛ لأن هذا ما يطلبه الكاتب- أى كاتب- وما نعرفه معشر الكتاب: «من تعرَّضَ فقد استُهدِف» وحتى من دفعتهم حماستهم إلى التركيز على نقطة معينة؛ فهذا حقهم، مع لفت النظر إلى أن توجيه تهمة البحث عن أدلتها واستبعاد ما ينفيها ليس من عمل الكاتب.
انتهى جمع الكتاب فى ٢٠١٠، وموضوعاته أعلاه، وقام بالجمع- بإشراف أكاديمى- تسعة عشر باحثًا على النحو التالى: أكثر من ١٠٠ ساعة مسجلة صوتًا وصورة؛ فإحدى عشرة ساعة من محافظة أسوان، وتسع ساعات من محافظة قنا، وأربع ساعات من محافظة المنيا، وست ساعات من محافظة الفيوم، وسبع من العريش ومثلها من الشرقية، وست من سوهاج، واثنتا عشرة من أسيوط، وثلاث من المنصورة، ومثلها من الإسكندرية ومن بورسعيد، وسبع من القاهرة، وست من الجيزة، وإحدى عشرة من ٦ أكتوبر، وثمانى ساعات من محافظة المنوفية. جرى هذا بإشراف علمى وإدارى من كلية الآداب جامع القاهرة، وعلى يد أربعة مشرفين «بَينين»- لأن «التاريخ الشفاهى» يقع فى حقل الدراسات البينية؛ ففيه من التاريخ الموضوع، ومن الأدب الشعبى آليات الجمع والتدوين، ومن المكتبات الفهرسة والتوثيق- عبدالحميد حواس «أستاذ بالمعهد العالى للفنون الشعبية ومدير مركز دراسات الفنون الشعبية»، وحلمى شعراوى «رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية»، وأحمد زايد «أستاذ علم الاجتماع السياسى بكليّة الآداب جامعة القاهرة، عميد كلية الآداب السابق، ومدير مكتبة الإسكندرية»، وأحمد مرسى «حائز جائزة النيل، رئيس دار الكتب والوثائق القومية مطلع الألفية، رائد الأدب الشعبى». بقى أن المؤلف لم يتعامل مع مؤسسة منح أمريكية بل مع مشروع دعم البحث العلمى الاجتماعى بكلية الآداب، بجامعة القاهرة، ولو كان فى الأمر ما يشين ما ذكره فى الصفحة الأولى من كتابه التى وسمها بـ«شكر وتقدير».
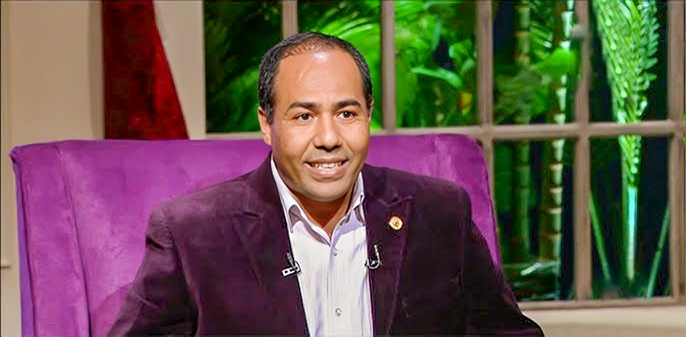
حين يُجرى بحثٌ يكون السؤال منصبًا على سبب اختيار الموضوع وسبب اختيار الأداة، وقد اختار المؤلف هذه الفترة لأسباب منها؛ بُعدها عن فترة الحكم «الجمع جرى فترة مبارك، ونطاقه من ١٩٤٨ حتى ١٩٧٠، ومركزه من حكم عبدالناصر حتى وفاته»، ورغم أن هذه الفترة تبعد عن لحظة الجمع قرابة أربعين عامًّا فقد توصل الباحثون إلى معاصرين لكثير من الأحداث، ومشاركين فيها بل منهم من جلس مع عبدالناصر: «قعدت مع عبدالناصر فى أيام السيل والسد العالى، وبعدين أنا كنت أمين الشباب فى منظمة الشباب فى السد العالى (ص٧٠٨). اللى فاكره كل حاجة حصلت طبعًا فى اليمن.. كنا موجودين لأن أنا باقول لك ما كناش نقعد فى مكان واحد. ما كناش من ضمن القوات اللى تروح فى مكان زى ده لغاية أخر المدة.. لاء دا إحنا جبناها من الأول للآخر. (ص ٥٩٤). اللى سمعته.. يقولك كانوا يقولوا طفوا النور وإعملوا البيبان والشبابيك بزهرة.. كانوا يزهروا الإزاز عشان اللى جوه ما ينبش وييقولوا طفوا النور دا غاره.. وكنا نسمع الضرب وكل حاجة بس منشفوش (ص٧٢٢). صورة محمد مهران مع عبدالناصر (ص ٧٦٧)». وهنا ملاحظة أن الفترة المبحوثة كبيرة نسبيًّا، وكان يمكن اختيار حدث واحد، وربما اختار الباحث هذا لأن الموضوع واحد، وهو «فترة حكم عبدالناصر».
لماذا اختار أبوالليل «التاريخ الشفاهى»؟ يذكر فى الفصل الأول من الجزء الأول الأصول النظرية والتجليات العربية، تطور «التاريخ الشعبى» والإرهاصات المصرية التى تشبه جداول الماء التى بحاجة إلى التجمع فى نهر واحد، وبعد عرضه للتجربة الغربية والعربية ومجالات اهتمام التاريخ الشعبى/ الشفاهى، يصل إلى: «الخلاصة، أن التاريخ الشفاهى طريقة بحث مرهقة، ولكنها مثمرة وقابلة للتغيير. وهى مفيدة- على وجه الخصوص- فى جمع البيانات المستمدة من وجهة نظر أولئك الذين ظلوا مهمشين فى العادة داخل هذه الثقافة، وأولئك الذين تم استبعادهم عن فرصة عرض أحوالهم وتقديمها. وبهذه الطريقة، يتيح التاريخ الشفاهى للرواة أن يرفعوا أصواتهم مطالبين بحقهم فى سياق يُمكنهم من هذا الحق ويعترف بخبراتهم الحياتية القيمة كمصدر مهم من مصادر المعرفة.. إن التاريخ الشفاهى عملية ذات طابع تعاونى مبنى على المشاركة يتوجب التفكير فيها بصورة كلية»، وفى هذا يكون قرار المؤلف كاشفًا لا منشئًا، فقد ضمن رأيه كلام شارلين بيير، باتريشيا ليفى: البحوث الكيفية فى العلوم الاجتماعية، ترجمة: هناء الجوهرى.

هكذا إذن اختار أبوالليل مجالًا معرفيًّا/ علمًا فرعيًّا، وأراد بموضوعه، أن يطرح لنا ضرورته:
• المادة التاريخية متوافرة ومتناثرة فى ثنايا النصوص الأدبية، الشعبية منها والرسمية، الشفاهية منها والمدونة. غير أن العلم الذى يستند إلى هذه المادة، ويعتبرها مصدرًا معرفيًا له- أعنى علم التاريخ- جاء فى وقت متأخر.
• المادة التاريخية الشفاهية تواترت فى ثنايا النصوص الأدبية الشفوية، ولكن وجود العلم الذى يعترف بقيمة هذه المواد الشفوية، واعتبارها مصدرًا تاريخيًّا، لم يتوفر إلا فى النصف الثانى من القرن العشرين. إن التاريخ الشفاهى هو مجال معرفى ينتمى إلى حقل العلوم الإنسانية، لا ينحصر اهتمامه فى التأريخ لطبقات النخبة أو الأفراد. فـ التاريخ الشفاهى قديم قدم التاريخ نفسه، بل كان التاريخ الشفاهى هو النوع الأول من التاريخ.
لا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد لنعرف أن المثال الموجود فى رأس المؤلف هو كتاب هوارد زن: «التاريخ الشعبى لأمريكا» فقد تحدث عنه المؤلف بكثير من الإعجاب، ولجأ لسد ثغرات الشهادات وللرد عليها- بطريقة زن- لمقالات وكتب ومؤلفات كـ«الصامتون يتكلمون» لسامى جوهر، وهو فى إيرادها يريد تأكيد فكرة بعد الإحاطة بجوانبها: «إن ما ذكره سامى جوهر يؤكد شهادة الإخوانى المنشق على عشماوى، الذى انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين منذ عام ١٩٥١، مؤكدًا أن مظاهرات مارس كانت تتم بتنظيم من الإخوان المسلمين، وكان سببها انقلاب عبدالناصر على اتفاقه مع الجماعة، ولكنهم لم يعلنوا ذلك صراحة، وإنما التحموا بالشعب، ووجهوا المظاهرات نحو تأييد نجيب فى أزمته مع مجلس قيادة الثورة. هذا إلى جانب إصباغ المظاهرات بطابع سياسى متمثل فى اعتراض شعبى على احتفاظ الإنجليز بقاعدة فى قناة السويس».
وحين عرض لشهادة فؤاد علام، رد عليها لا من باب الرفض، والدفاع عن الجماعة كما يعتقد البعض، ولكن ليفصل بين الشخصى والعلمى، ويصل إلى النتيجة العلمية المجردة؛ فقد ذكر: «غير أن هذا الرأى يحتاج إلى إعادة نظر بسبب اعتماد أصحابه على ما كتبته جريدة (مصر الفتاة) أثناء تلك الأحداث عن عدم مشاركة الإخوان فى تلك الحرب، ومعروف ما بين حزب مصر الفتاة وجماعة الإخوان المسلمين من عداء شديد إبان تلك الفترة». فقد ذكر صفحة (١١٦): «غير أن هذا التدخل لم يغير شيئًا فى نتيجة المعركة، سواء لأن تدخلهم جاء متأخرًا، أو- حسب ما يرى البعض- أن الحرب انتهت قبل أن تنتهى المفاوضات التى كان يجريها الإمام حسن البنا مع الحكومة المصرية، حول التأمين على أعضاء جماعة الإخوان المشتركين فى هذه الحرب، ضد الإصابة أو الموت لكل من سيشارك- من أعضاء جماعته- فى هذه الحرب. وهى مفاوضات أخذت شوطًا كبيرًا، أفاد فيها الإخوان مما حصلوا عليه من أسلحة، أو ما تلقوه من تدريب على استخدام السلاح، دون أن تتم مشاركتهم؛ إذ انتهت الحرب دون أن تنتهى المفاوضات. وهناك من يؤكد عدم مشاركة الإخوان فى المعركة بسبب ما تواتر من أنباء للإمام حسن البنا عن وجود مؤامرة دولية تهدف إلى التخلص من الجناح المسلح بالجماعة فى هذه الحرب».
لكن على كان مدخل زن أخلاقيًّا، كان مدخل أبوالليل علميًّا تجريبيًّا، فيقول زن: «إننى أفترض أو ربما آمل فقط، أننا ربما نجد مستقبلنا فى لحظات الماضى القصيرة التى سادتها الرحمة والشفقة، أكثر مما نجده فى قرونه المتعاقبة من الحرب والقتال. هذا هو مدخلى- دون مواربة- لرؤية وكتابة تاريخ الولايات المتحدة، وأفضل للقارئ أن يدرك ذلك قبل أن يستمر فى القراءة» ويقول أبوالليل: «غير أن الاهتمام بالتاريخ الشفاهى فى العالم العربى الحديث يبدو فقيرًا، فقد انحصر الاهتمام إما فى الترجمات القليلة للدراسات التى تنتمى إلى دائرة التاريخ الشفاهى، أو بالاكتفاء بالدعوة النظرية إلى أهمية الاعتماد على التاريخ الشفاهى، باعتباره مصدرًا من مصادر كتابة التاريخ. فـ نصيب العالم العربى من هذا التقدم العلمى فى مجال الدراسات التاريخية كان قليلًا» حسب قاسم عبده قاسم.
يبدو للقارئ للوهلة الأولى أن المؤلف يعبر عن أفكاره هو، وهذا يوقعه فى مشكلة كبرى، وعليه أن يدرك أن المؤلف يلجأ إلى تفصيح مجتزئ الشهادة، وتفسيره، وكان على المؤلف أن يضع الجملة الاعتراضية منذ بداية الكتاب، لا من الصفحة (٢١١): أما عن المجتمع المصرى فيما قبل الثورة- كما يحكى المبحوثون- فقد كان مجتمعًا مؤهلًا لاستقبال مثل هذا القانون وتأييده من قبل معظم أبنائه. فلقد كان المجتمع المصرى- فيما قبل الثورة- يسمى مجتمع النصف فى المائة، ما يدل على أن الثروة تسيطر عليها قلة من أفراد المجتمع. «لما جات الثورة قامت وضحت الحقيقة. إيه هيه بقى الحقيقة؟ إنه كانت الثروة فى إيد نص ف المية من الشعب المصرى. عشان كده عمل التأميم»، وسواء جرى هذا بإرادة المؤلف، أو أنه تركه لفطنة القارئ فقد أحدث بلبلة يسهل تجاوزها فى كثير من المواضع؛ ففى صفحة (١١٢) كان على المؤلف إيراد الشهادة مجتزأ أولًا، أو وضع الجملة الاعتراضية هكذا: «أدى بيع الفلسطينيين لأراضيهم مقابل مبالغ مالية عالية إلى تزايد نفوذ اليهود داخل الأراضى الفلسطينية، فتزايد عددهم، وتزايدت مساحاتهم الجغرافية التى سيطروا عليها، ودخلت فى حوزتهم؛ الأمر الذى أدى إلى تشكيل كيانات يهودية داخل فلسطين، ساعدهم على خوض حرب عام ١٩٤٨. حرب ٤٨ أصلًا هيَّه.. قبل ما تبدأ حرب ٤٨ كان فيه وجود يهودى فى منطقة فلسطين. وبعدين الوجود اليهودى ده بدأ يتسع ويكتر، وبعدين اتساعه الجغرافى، جزء كبير قوى تم عن طريق شراء أراضى الجماعة الفلسطينيين بمبالغ مغرية جدًا، واحد عنده حتة أرض اتعرض عليه مبلغ خرافى فيقبل علشان يروح مكان تانى أو يتباع ويستفيد ماديًا، وكانت دى عملية إيه احتلال تدريجى لفلسطين من اليهود. لحد ما اليهود وصلوا لمرحلة اللى همَّه حسوا فيها إن همه ممكن يكون لهم شكل من أشكال الكيان المستقل بيهم فمهدوا واحتكموا علشان يخشوا معركة مع الفلسطينيين ويبقى لهم وجود مستقل أو دولة كما يقال. من هنا بدأ التمهيد للمواجهة لأن الفلسطينيين لوحدهم ما كانش ممكن يقفوا ضد اليهود فنزلت الجيوش العربية ومصر اتحمست». يبدو ما بين الفقرة الأولى، وما بين مقدمة الباحث من علاقة تفسيرية.
لا ينكر أحد استدعاء الملك فاروق للجماعة لضرب الوفد وجماهيريته، ولا ينكر أن هذه الجماعة استدعيت عبر مسئول سياسى رفيع مقرب من الملك، وأن البنا بايع فاروق، ولمن أنكر فهذه إحدى رسائل البنا للملك: «يا صاحب الجلالة: إنَّ الإخوانَ المُسلمين باسْم شعب وادى النيل كلّه يلوذون بعرشكم، وهو خيرُ ملاذ، ويعوذون بعطفِكُم وهو أفضلُ معاذ، مُلتمِسينَ أن تتفضّلوا جلالتكم بتوجيه الحُكومة إلى نهج الصواب أو بإعفائها مِن أعباء الحُكم» أو ليبحث على الإنترنت عن: «جلالة الملك هو حاكم البلاد الشرعى، وهو- والحمد لله- ومن جميل توفيقه يؤدى الفرائض، ويعمل على ما فيه إعزاز الإسلام والمسلمين، فموقف الإخوان من السراى موقف الولاء والحب»، لهذا فمن الطبيعى أن يأتى ذكرهم فى حرب فلسطين، وأن يتتبع المؤلف الأمر، وكذلك أزمتهم مع ثورة يوليو.. وليس السؤال هنا: لماذا أورد المؤلف هذا؟ لكن كيف؟ وليست الإجابة باختيار مجتزأ والبناء عليه، وليست النتيجة التى يمكن أن نخلص إليها هى اتهام المؤلف.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، وليس إلى اثنين، عدا الشكر والتقديم، مائة صفحة للجزء النظرى، وأربعمائة للتطبيق، ومائتان ونيف لبعض الشهادات، يمكننا أن نرى الجزء الأول إجابة عن أسئلة: لماذا؟ وكيف؟ ونقرأ الجزء الثانى على أنه: ما؟ أما الجزء الثالث فهو نماذج وأدلة، وسيكون الاختلاف واجبًا وضروريًّا مع الأول والثانى، أما الثالث؛ فهو شهادات موثقة يجب أن تنقل كما هى؛ بحوشيها ومهذبها. والارتكان للعلم سيجعل الجزء الأول محل اعتبار وتقدير، ويبقى الجزء الثانى شاهدًا على جهد الإنسان؛ عجزًا وقدرةً، قصورًا وتقصيرًا، ولا يمكننا أن نطالب كاتبًا بأن يكتب ما نتفق عليه جميعًا، وإلا ما حاجتنا للكتابة إذن؟
احتوى الكتاب على مصادر متعددة، وليست شهادات المبحوثين فقط، فنجد «صفحات مضيئة من تاريخ مصر العسكرى، هيئة البحوث العسكرية بوزارة الدفاع، ونجد ترجمة قاسم عبده قاسم «نظرات جديدة عن الكتابة التاريخية» تحرير: بيتر بوركى، ونجد «التاريخ والسير» لحسين فوزى النجار. ومقال جمال عبدالناصر «شعب وجيش»، ومئات المصادر والمراجع العربية والأجنبية، وهذا يدل على احتشاد الكاتب وفريقه للعمل الذى تناول فترة مهمة ومليئة بالأحداث الجسام، خصوصًا وقد انحاز المؤلف إلى الرأى القائل بأن ثورة يوليو بدأت من نكبتنا فى فلسطين.
كيف يمكن أن نتجاوز هذا الجهد، والسقوط فى شرك الشجرة التى حَجبت الغابة، مع الاعتذار للشجرة لأننا نشبه هؤلاء بها؛ فكم لقينا منهم منذ ظهروا للوجود! إننا حين نتتبع «سرديتهم» هذا التتبع كمن «يقتل بعوضة بقنبلة نووية» حسب تعبير عبدالعزيز بركة فى رائعته «الجنقو» وأذكر هنا أن الدكتور جمال زهران كتب مقالًا يهاجمهم فيه ففوجئ بهم يتصلون به ليشكروه، وحين سألهم قالوا: «يكفى حضور اسمنا فى عنوان مقال» لهذا أصر على إضافة «الإرهابية» لعنوان كتابه عن فترة حكمهم الذى صدر فى المجلس الأعلى للثقافة.
ما لَم يمتزج الإخلاص لمصر ضد حركات الإرهاب والتطرف بالوعى وسعة الصدر والدراية، فستتحول صحفنا إلى محاكم تفتيش كارثية، وسيتجول فى أروقة ثقافتنا ذكرتية وهليبة «منهم من يظن نفسه النشو ومنهم من يظن نفسه الزينى بركات» وهذا النيران الصديقة لن تطال من نرميه برعونة فقط، بل ما يمثله المرمى، فهل معنى هذا أن نسكت عن الخطأ؛ لأن صاحبه موثوق به؟ كيف هذا ونحن أبناء مدرسة «الحق لا يُعرف بالرجال، بل الرجال يُعرفون بالحق».
دفاعًا عن خالد أبوالليل العالَم المجرِّب، والوطنى المخلص، والمسئول المُجرَّب، وعن حرية البحث العلمى أثارنى ما كيل له من اتهامات، وكتبت هذا لأن مصر حاضرة العالمين لا تستحق منا أن نسقطها دائمًا فى فلك أسراب الخراب المتطرفين، ولا أن نحمل غَدَّارات الاتهام؛ فتارة نطعن على منصور الذى دفعته حماسة الشعراء لمناقشة مصطلح، وتارةً مؤلَّف منذ عشر سنوات، فيما نترك مواقع ومنصات وكتب تهاجم مصر بضراوة وقسوة- ويمكن الرجوع لحوارات الدكتور عمرو موسى أمين جامعة الدول العربية السابق، وحديثه عن هذه القنوات- بل وتعيد تأريخ الأجهزة المصرية وفق رؤيتها، بل ونهمل الكتب التى حللت وكشفت هذه الجماعة وأخواتها إلى الحد الذى صار ذكرها يثير رعب هذه التيارات، وليعد من يهاجم «التاريخ الشعبى» لكتاب: «جذور العداء» ويرى كيف يؤرخ ويهاجم ويطعن، وكيف «يلعن» كتبًا مصرية طبعتها هيئة الكتاب، ويهاجمها بأنها ممولة؟
إن «تبنى سردية الجماعة» ليست مما يقوله الكاتب عن الكاتب؛ لأننا بحاجة إلى بناء سرديتنا نحن، وتطويرها ودعمها، وإلا كيف ندافع عن نصر حامد أبوزيد والإمام محمد عبده وطه حسين؟ إننى أدعو إلى مائدة مستديرة يحضرها متخصصون، لا لمحاكمة الكتاب، ولا لمديحه، بل لمناقشة منطلقاته وآلياته، لنعتبره تجربة أولى فى مجال معرفى نحتاج إلى أن تكون لنا بصمة فيه، وربما نصل بهذه الندوة التى سترحب بها جامعة القاهرة أو أى منتدى ثقافى إلى إنشاء مركز للتاريخ الشعبى، والأهم أن تكون سببًا من أسباب التماسك الوطنى.






