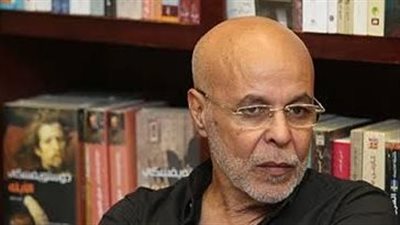حب وخيانة وموت على ضفاف النيل.. من رواية «الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار»

- لم يكن بإمكان الذين غرقوا أن يقصوا علينا مدة المعاناة فى الغرق
عايش
أربعون عامًا من اللاشىء، شخص عادى، من بين ملايين البشر العاديين، لست استثنائيًا أو مميزًا، لا أتذكر أننى حلمت يومًا بالتميز، لم أحلم بالمستحيل، فقط حياة عادية هى كل ما أردت، لا أعرف، ربما كانت هنا تكمن المشكلة؛ فقد يعاقب المرء على عاديته وتشابهه مع الكثيرين، أو رضاه بالقليل جدًا فى حياة جشعة، قرأت يومًا عن مليارات الروبوتات التى تشق طريقها إلى كوكب الأرض، أليس علينا أن نفسح لها المجال؟!

مؤكد سيزعجها وجودنا، كما ضقنا نحن البشر بوجود بعضنا البعض، وضجرت منا الحياة، من نحن وما الحياة؟! أليس غريبًا أن أتحدث عما لا أعرف، عما لم أعش، لو كانت هناك حياة حقًا، فهى فقيرة اللطف، ثرية بهؤلاء الذين يضيقون سبل النجاة فى أعين الناس، لا أعرف إن كان ثمة متسع لهم من الراحة، أو ضاقت بأعينهم الحياة أيضًا، لا شىء تقريبًا يجمع السيئ والجيد إلا هذه المسرحية الهزلية المسماة حياة.
لا أعرف شيئًا بدقة غير أننى غاضب جدًا..
طالما وقفت أمام هذا النهر أرسم أحلامى، فما، ومن الذين اجتمعوا واتحدوا ليرسموا لى تلك المقبرة؟!
السؤال لا يبحث عن إجابة، أحفظ الطرق التى قادتنى إلى هذه الطريق أكثر من كفى، هل حقًا أحفظ كفى؟!
خطر لى أن أتأمل خطوطها للمرة الأخيرة، وربما الأولى..
هذه يدك، هذه أصابع يدك، كم هى جافة، خمسة أصابع ليد حنون، أو ربما تظنها كذلك، بشرة قاسية، القشرة الخارجية ليست دليلًا على القسوة، قد تكون عكس الداخل تمامًا، ما جدوى الإحساس المرهف فى زمن مادى!
لكنها يدك وأصابعك وربما لا تستطيع الهروب من ملمسها شديد الخشونة لأسباب مادية، وأخرى متعلقة بسؤال ما الجدوى؟!
هل يموت الإنسان حين يتوقف عن الأسئلة؟!
هذا الحرق على يدك منذ الطفولة، يشبه كثيرًا روحك، ربما تشبه خريطة جسدك قدرك، ماذا أيضًا!
خطوط التجاعيد، ليست متعلقة بالزمن، أنت لم تعش، ومؤكد لن تعيش، هل تريد حقًا أن تعيش؟! أم أنك تموت ألف مرة ليمر يومك، ولا تعرف ما تنتظره من يوم آخر، تؤجل خططك اليومية فى الانتحار، ليس ثمة وسيلة للقتل لم تقرأ عنها، كم كنت مهتمًا بقراءة قصص المنتحرين وأدوات انتحارهم وكواليس اللحظات الأخيرة قبيل الانتحار النهائى، كم مرة ينتحر الإنسان، كم مرة يموت؟! محظوظون جدًا الذين ماتوا مرة واحدة، ماذا يؤخر لحظة مغادرتك للحياة! لعل السر فى هذا التأجيل هو عدم شعورك بوجودك الفعلى، هل أنت حى! ماذا تعرف عن الحياة لتعرف طريقًا واحدًا إلى أبواب الفرار منها، أليس الهروب من سمات الجبن؟ جبنًا؟!

هذه المسميات هى أكثر ما كرهته على هذه الأرض، تصبح المسميات كثيرًا مجرد لعب بالألفاظ، لتجاهل ما نشعر به، يقولون حياة ولا تجد غير معاناة؛ يقولون حبًا فلا تنخرط إلا فى ساحة قتال، أنت الخاسر فيها مسبقًا، البنت التى أحببتها، لم ترغب فى إضافة مفلس آخر إلى عيشتها البخيلة، وجدت من ينتشلها من الفرجة على العالم من بعيد، قصة لا تتوقف عن الحدوث، كالتناسل المفرط فى البلدان البائسة، هناك مشاعر حقيقية فى هذا العالم، لكن أحدًا لا يرى مجدًا فى الحب. كما لم تر أنت إلا ما تكرهه، قدمك تكره اللون الأحمر ورائحة الدم فى عالم ملطخ بالحروب، وضجيج الرصاص، الأسوأ من صوت الرصاص تلك الرصاصات الصامتة، كم هى يومية ومتكررة بلا عدد، يخيل لك أن الرصاص بكل أعيرته هو أكرم ما فى الحياة، إنه كريم إلى حد القضاء السريع على حياة بالاسم فقط.
يقولون ونس ولا تلمس غير الفراغ؛ جحيم فى صيغة شخوص. يقولون عزلة، فتراها أكثر ضجيجًا؛ تلتقى فيها مع بقايا كل من كنتهم فى يوم ما. يقولون مطر فلا تحلم بمظلة، كم اشتقت لعطر دمع السماء؛ بإحساسك أنها قريبة، تغيم وتبكى ككائن أرضى مازال قادرًا على تفريغ قهره بصيغة ما. لم تشتق أيضًا؟ لعل هذا الشوق هو ما يؤجل رحيلك النهائى مسافة زمن أخرى، طويلة كانت أم قصيرة، لا تهم المدة؛ إنها مجرد أرقام.. مسميات وتصنيفات تعلمت ألا تنشغل بها..
هذا هو النهر الذى عشقت لونه، ورائحته، ترى كم سأتألم فى تجربة الغرق؟!
لم يكن بإمكان الذين غرقوا أن يقصوا علينا مدة المعاناة فى الغرق، لكنها بالتأكيد أقصر من كل ألم عانيته..
ليت سبل الانتحار الأكثر ضمانًا وحسمًا كانت متاحة، لكن القاهرة اسمًا على مسمى، ضيقت علينا طرق الخلاص من حياة جافة، ممنوع عليك الانتحار من أعلى برج القاهرة. لماذا لا يا مدينتى الساحرة، ألا يحق لى وداعك بنظرة أخيرة.. ولو من بعيد؟!
ممنوع إلقاء جثتك تحت عجلات المترو.. المترو فقط للذين لم يقرروا بعد أن يتوقفوا عن «المعافرة»..
تجربة الصعود على أحد أسوار الكورنيش أيضًا، ستؤدى بعملية الانتحار إلى الفشل؛ إذ ربما يظن الناس أن عليهم إنقاذك، أن فى ردك عن الموت نجاتك، الكلام وظيفة سهلة، سيغرقونك بالنصائح والوعظ.. والتخويف من النار وكأنك لم تذقها من قبل..
أما لو طالتك يد الشرطة فهى قضية أشد قسوة، توجد غرامة مالية، أو حبس، عقوبة صارمة للإقدام على الانتحار. حتى الموت أصبح ترفًا؛ لذا اخترت أن أموت برفاهية، دخلت أحد أجمل المقاهى على النيل، إنه آخر مبلغ أمتلكه، فى هذا المقهى المطل على النهر مباشرة، إن وقفت جنب النهر، لن يظن أحد أننى مجنون يفكر فى قتل نفسه! لن يمنعنى أحد من القفز.. إذ لن ينتبه أحد، سيعتقد من يرانى أننى ألتصق بالنهر لأخذ سلفى.. فى هذا الوقت الذى تخدعه فيه الظنون أكون قد تخلصت من الناس، والظروف، والمعتقدات، من حياتى كلها..
رغم كابوسية الموقف كانت رائحة الهواء طيبة، قررت توديع السماء واستنشاق رائحة الجو الجميلة بشكل غريب، وأنا أدخن سيجارتى الأخيرة بتلذذ، مضى وقت طويل دون أن ألمس جمالًا فى أى شىء..
صوت الزفة نادانى من قرب..
أكان يجب أن تؤسس الحياة بتلك الصعوبة، لماذا يجب علينا أن نجمع المال، لم حين نمتلكه فقط يعتبروننا من خلق الله، ينظرون إلينا باحترام؟ ترى كم الفاتورة التى دفعها هؤلاء لامتلاك أو حتى استئجار باخرة مثل هذه، وتسخير كل هؤلاء الموظفين لخدمة أصحاب الفرح، لماذا هم أصحاب الفرح ونحن دائمًا الجالسين فى مقاعد الفرجة!
صوت الزفة والطبول يبدو ساخرًا من حالى..
كم أحببت صوت الطبول والزغاريد من قبل، وكنت ممن يصفقون لأفراح غيرى، الذين أعرفهم أو لا أعرفهم، الآن كم يزعجنى كل أولاد الكلب هؤلاء، أشعر بصداع يكاد يشق رأسى، لا أخشى الموت، ها أنا قادم إليه بنفسى، بروحى المثقلة، على قدمى المنهكتين، فقط سئمت الألم بقدر خوفى منه، لو أننى أمتلك سلاحًا لما ترددت فى إطلاق الرصاص على كل هؤلاء قبل أن أغادر عالمهم..
الآن ظهر العريس والعروس بوضوح، وجدت داخلى يهتف لا إراديًا: الله.
إنها ليست مجرد عروس يلطخ وجهها المكياج، ويضللك عن حقيقة جمالها أو زيفه، إنها أجمل فتاة رأيتها فى حياتى، فى السينما، المجلات، الإنترنت، الشوارع، وفى أحلامى القليلة، وخيالى غير الضيق، كم هى ملائكية، لو أن هناك ملائكة حقًا، فتلك الفتاة هى ملكتهم، أليست الحياة كريمة بعض الشىء كى تجعل هذا الجمال آخر ما أراه فى حياتى؟!
يتحدث أحد الموجودين فى الميكروفون، يا له من ابن قحاب مزعج، ألم يستطع أن يصمت قليلًا حتى أشبع عينى وكيانى كله من هذا الجمال.. حاولت عدم الاهتمام بما يقول والتركيز على وجه الفتاة، لكنه نطق اسمها، من المؤكد أن هذا هو اسمها:
لقد اجتمعنا اليوم من أجل زفاف ليلى وعادل، وكل الذين هنا يعرفون بل ويحفظون عن ظهر قلب قصة عادل وليلى، لكن دعونا نسمع القاصى والدانى وبأعلى صوت، عن قصتهما، يقول الكثيرون لا يوجد حب، فليتأكدوا من كذب كل مصادرهم، ها هى قصة ليلى وعادل تخبركم العكس، إنها أقرب لأسطورة، لمعجزة، لكنها حقيقة على أرض واقعنا، قصة حب استمرت منذ الطفولة، منذ كانا طفلين تعاهدا على الحب والإخلاص حتى النهاية، ورغم بعد المسافات ظلت القصة أقوى من الجغرافيا، وتاريخ قصص الحب الحزينة، فلم يحب عادل إلا ليلى، ولن تحب ليلى إلا عادل.
بين تصفيق الحضور الجنونى، والضحكات والدموع، لا أعرف كيف تسللت إلى الباخرة، كيف أصبحت فى مقابلة العريس والعروس، من أين جاء القرار والكلمات، لا أعرف، كأننى كنت أشاهدنى معهم وأنا أقول بكل ثقة وغضب:
أنا حبيب ليلى الحقيقى.