لسان بلا روح.. كيف يسطو «السارد الآلى» على حكايات البشر؟

- منصات تطلق خاصية القراءة الآلية لأى كتاب إلكترونى بـ«صوت اصطناعى»
- حين أسمع الأصوات الاصطناعية وأرى زملائى يسكبون أرواحهم فى فنهم أتأكد أننا لن نُستبدل
- النزوع الرأسمالى لاستبدال الإنسان المبدع بالآلة فى جوهره نزوع ضدّ الإنسانية
- لم أتخيّل يومًا أن الماكينات ستزحف على كتبى وعلى صوتى نفسه
نشأتُ فى بيتٍ يكاد يخلو من التلفاز. أمّى، بعد لحظة روحية عميقة غيّرت مسار حياتها وانتهت إلى إيمان إنجيلى متشدّد، صارت ترى فى برامج مثل «السنافر» خطرًا روحيًا . وهكذا لم يكن أمامنا سوى الكتب.. أكوامٌ وأكوامٌ من الكتب. كل أسبوع كنت أعود من المكتبة بكتلة ثقيلة من المجلدات، أغلبها من عوالم الخيال العلمى والفانتازيا فى عصرها الذهبى: سلسلة «المؤسّسة»، وأعمال هاينلاين ونيفن، وهى التى صاغت أولى ملامح ذائقتى الأدبية.
كنت أفتن بالتخييل. أرسم فى ذهنى مستقبلًا تحلّ فيه الآلة محل الأعمال المرهقة، فتترك لنا مساحة للإبداع والمتعة. لكنّنى لم أتخيّل يومًا أن الماكينات ستزحف على كتبى.. وعلى صوتى نفسه.
انفصل والداى وأنا بعد لم أبلغ العامين، وانتقل أبى إلى كاليفورنيا. كان ممثلًا ومذيعًا إذاعيًا، ومن أوائل المتحمسين للتكنولوجيا وتجهيزات الاستديوهات المنزلية الناشئة. كان يسجّل صوته وهو يقرأ الكتب، ويرسل الشرائط عبر البريد إلى بيتنا فى ريف إلينوى. كنتُ أجلس متكوّرًا حول جهاز تسجيل صغير من «فيشر برايس» فى غرفتى، أصغى إلى صوت أبى... جسدٌ غائب لكن حضوره عجيب وساحر، يحملنى معه إلى عوالم أخرى. قوة الصوت البشرى، حتى لو نُسخت على شريط كاسيت متواضع وشُغّلت عبر مكبر ردىء، غيّرت حياتى إلى الأبد. كان هناك عنصران لا ثالث لهما: روح إنسانية... وقصة. فإذا اجتمعا وُلد شىء جديد ومعنى عميق.
وبإلهامٍ من حلمى فى أن أكون راويًا، اكتشفت المسرح ومتعة تجسيد القصص حيّة أمام الناس، أسبح وسط بحرٍ من العيون. فى الثانوية انضممت إلى فريق الخطابة، وتخصّصت فى «فن إلقاء النثر». ولخيبة أمل أمى، اخترت التمثيل فى الجامعة، حيث درست المسرح، وبعد تخرّجى وانتقالى إلى شيكاغو سعيت وراء كل أشكال الحكى الممكنة: إعلانات، تجارب أداء للأفلام، دوبلاج، ومسرح.
فى عام ٢٠٠٥ تقدّمتُ لأول تجربة أداء فى كتاب صوتى: رواية تاريخية من ٥٠٠ صفحة تعيد سرد أسطورة روبن هود. عندها أدركت أن هناك صناعة كاملة قائمة على هذا المزج البسيط والعجيب بين «الصوت» و«القصة». فابتُليت بالعشق منذ ذلك اليوم.
واليوم، بعد أن رويت بصوتى ٨٠٠ عمل فى شتّى الأنواع والأساليب، أجدنى أعيش حياة أدبية بقدر ما هى مُرهقة بقدر ما هى آسرة، حياة كنتُ لأفنى عمرى كلّه فيها لو استطعت. إنها امتداد لحلم أبى، رغم أنه لم يعش ليسمعه. ففى صيف عام ١٩٩٣، قبيل دخولى الثانوية، رحل والدى وزوجته فى حادث سيارة. وبسبب الزمن وخشونة الطفولة، لم يبقَ لى من مكتبته الصوتية إلا شريط واحد أصفر البلاستيك من نوع «ماكسويل»، عليه ملصق بخط يده. يضم قصةً هزلية غامضة أظن أنه كتبها بعنوان «نداء قصر هامبتون»، مع مؤثرات صوتية من قمة ثمانينيات القرن العشرين، وعويل آلة «ثيرِمين»، وصوته... صوته وحده.
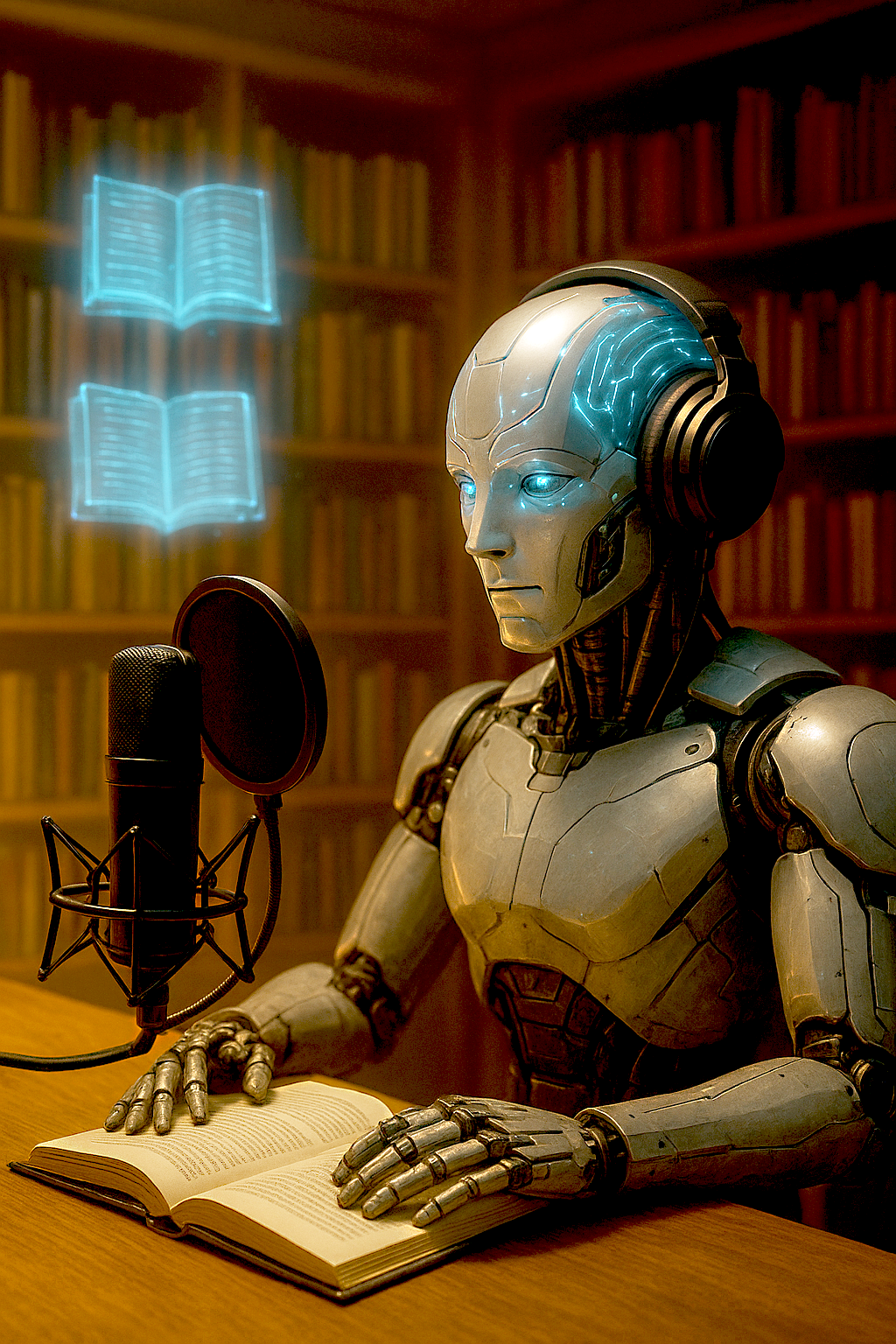
أتمتة الخيال
على مدى سنوات سبقت عقد العشرينيات من هذا القرن، ظلّت صناعة الكتب الصوتية ترقب شبح «أبوكاليبس الروبوتات». جهاز «كيندل» من أمازون أطلق خاصية القراءة الآلية لأى كتاب إلكترونى بصوت اصطناعى. جرّبت شركات صغيرة أخرى إنتاج أصوات آلية، لكن الفكرة لم تنجح تجاريًا. وكان المنقذ الأكبر أن ذراع أمازون للكتب الصوتية، أوديبِل، وهى الموزّع الأول عالميًا، رفضت السماح بالأصوات غير البشرية على منصتها. ومنذ نشأتها وهى تزعم أنها تضخّم من قوة الحكاية الإنسانية. غير أن المتشائمين منّا شكّوا فى أنهم إنما يحمون مصالحهم ريثما يجدون الطريقة التى تدرّ لهم الربح من أصوات روبوتاتهم الخاصة. ولقد كنّا على صواب.
فى نوفمبر من عام ٢٠٢٣، فُتحت أبواب الطوفان الآلى. للمرة الأولى، سمحت منصة أوديبول بدخول الأصوات الاصطناعية إلى منصتها «لكن بشرط أن تكون أصواتها هى وحدها». أطلقت عليها اسم «الأصوات الافتراضية»، وأتاحت لمؤلفى «كيندل دايركت بابليشر» خيار تحويل كتبهم إلى نسخ مسموعة بلمسة زر واحدة «وقد سُمّيت أحيانًا بـ(الكتب الصوتية بالذكاء الاصطناعى)». وفى غضون شهر واحد فقط، جرى رفع أكثر من عشرة آلاف كتاب «روبوتى» ووُضع للبيع. ثم تضاعف الرقم بوتيرة مذهلة، ليصل خلال بضعة أشهر إلى أكثر من خمسين ألف «أداء بلا روح». أما الآن، لحظة كتابة هذه السطور، فيتجاوز العدد الستين ألفًا.
كثيرًا ما أدرّس فن الكتب الصوتية لطلاب يرغبون فى دخول هذا المجال، وأول ما أحرص على غرسه فى أذهانهم هو أن هذه المهنة شرف قبل أن تكون عملًا. إن القدرة على سرد الحكايات هى ما يجعلنا بشرًا. منذ ثلاثمائة ألف عام، حين جلس أوائل الـ هومو سابيينس حول النار، كانت القصص لغتهم الأولى. كما يقول الباحث جوناثان جوتشال، نحن فى جوهرنا كائنات قصّاصَة، Homo Fictus. إن رواية الكتب المسموعة اليوم هى أقرب ما نمارسه من ذلك الفن البدائى الأصيل: شخص واحد، بصوت واحد، ينسج حكاية لشخص آخر.
لكن النزوع الرأسمالى لاستبدال الإنسان المبدع بالآلة هو فى جوهره نزوع ضدّ الإنسانية. إنها حكاية قديمة: لطالما سعينا إلى «أتمتة» الخيال، وإلى التخلص من العاطفة البشرية المربكة. نتذكّر هنا أسطورة جون هنرى، العامل الذى تحدّى آلة الحفر البخارية، ودفع حياته ثمنًا كى لا تُسلب منه مهنته:
«ما الإنسان إلا إنسان،
لكن قبل أن تدوسنى آلتك البخارية،
سأموت ومطرقتى بيدى».
صحيح أن جون هنرى فاز فى المنافسة الأخيرة، لكنه دفع ثمنًا فادحًا، وهو يعرف فى قرارة نفسه أنها كانت الصرخة الأخيرة. فالآلة لا تتعب، ولا تتنفس، ولن تذرف دمعة على رحيله.
واليوم، تقود شركات ناشئة مثل إليفن لابس موجة الأصوات الاصطناعية. يكفى أن ترفع بضع ثوانٍ من التسجيل حتى يولّد النظام نسخة مقلّدة مقنعة. لكن، هل سيكون لصوت مقلّد من ذكاء اصطناعى وقعٌ مماثل لصوت والدى الحقيقى؟
حين كنتُ طفلًا، كان وصول شريط كاسيت من والدى يعادل بالنسبة لى وصول حضوره نفسه. صوته النقى المعزول كان يقتحم وحدتى ليحادثنى مباشرة. ضد كل الحتمالات، كانت مجرد ذبذبات صوتية ترتطم بغشائى الطبلى، لكنها تحوّلت إلى معنى، بل أكثر: إلى علاقة حيّة.
أعترف بأننى أعانى فى تقبّل هذه الفكرة. فأنا حين أدرّس، أؤكد لطلابى أن الكلمات المكتوبة ليست سوى الثمر المعلَّق المنخفض، أما الكنز الحقيقى لأى راوٍ أو ممثل فهو ما بين الكلمات: الصمت، والظلال، والما لم يُقَل.
فالكتاب حين يُروى بصوت إنسان يتحوّل إلى فن مزدوج: النص يُعاد تفسيره عبر الراوى الذى يصبح بمثابة عدسة للقارئ. وكما أن هناك عشرات العروض لمسرحية بيت الدمية لإبسن، لكل منها مذاقها الخاص، فإن كل تسجيل لكتاب هو أداء فريد لا يتكرر.
ولذا أطلب دائمًا من طلابى أن يسألوا: أين تكمن المحبة؟ كل كتاب يولد من محبة ما، وكل قصة تُروى لسبب محدد. حتى فى الرواية المكتوبة بصيغة الغائب، هناك دائمًا «شخص ثالث» حىّ. من هو؟ لماذا يروى هذه الحكاية؟ ولماذا الآن بالذات؟ فى عالمنا، لا وجود لراوٍ كلى العلم.
أتذكر زميلة لى واجهت صعوبة فى تسجيل كتاب جاف تقنى عن نوع نادر من السرطان. لم تجد «المدخل» حتى قرأت فقرة الشكر فى نهاية الكتاب «التى غالبًا لا نضمّنها فى النسخ الصوتية». وهناك، بعد أن شكر المؤلف أسرته ووكيله، أسقط جملة أخيرة: أن والدته ماتت بهذا المرض عندما كان طفلًا. وهناك فقط، وُجد القلب، وظهر النص الخفى.
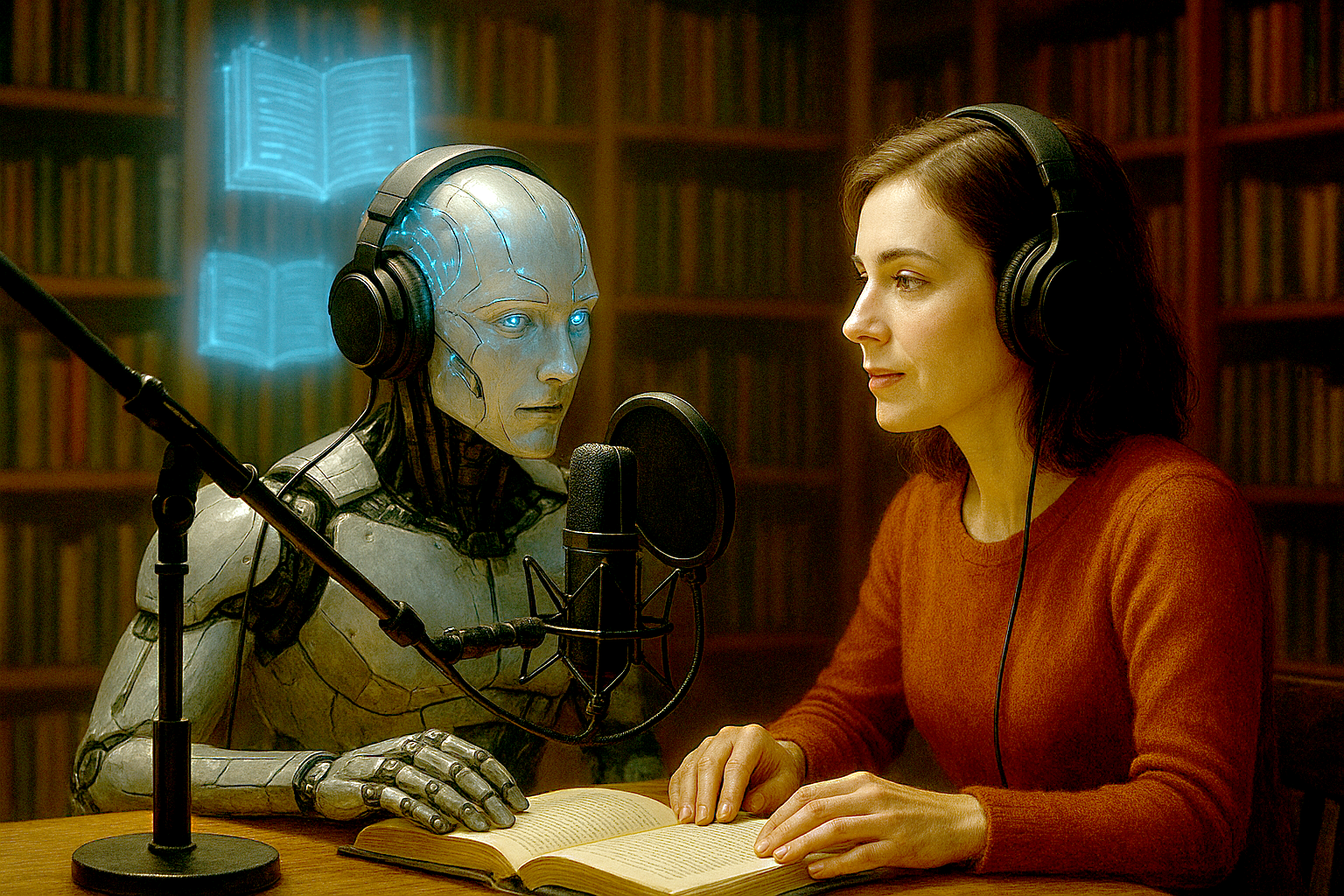
أجساد صناعية
حين كنت أصغى إلى والدى، كنت ألتقط ما بين السطور. أحيانًا كان يفاجئنى بأن يجعل قصة مألوفة مثل ليلة عيد الميلاد أكثر تفرّدًا عبر لمسته الصوتية الخاصة. كان ينهى القصيدة محرِّفًا السطر الأخير قائلًا: «عيد ميلاد سعيد للجميع، ولآدم ليلة هانئة!» ومع ذلك، كنت دائمًا أفهم ما يختبئ تحت الكلمات، ما كان ينفخ فى داخلى معنى حيًا. كانت الرسالة المضمَرة فى كل شريط كاسيت، الرسالة التى يتوق كل طفل لسماعها فى صوت أبيه: «أنا أحبك».
كان أبى يحكى لى القصص. كان يحبنى ويحكى لى القصص. لكن قصته هو انتهت فجأة، بسرعة قاتلة ضد شجرة على طريق معزول فى كاليفورنيا. استيقظت باكرًا ذلك الصباح على رنين الهاتف فى الطابق العلوى، تلاه وقع أقدام مسرعة وهمسات مضطربة. أذكر أن أخى الصغير هتف: «سأذهب لأخبر آدم!»، لكن أمى أوقفته. صعدت السلالم لأراها واقفة، ظِلّها يتشكل عند القمة.
فى وقت لاحق، تمددت بجوارى فى السرير، وراحت تتحسس بعينيها فى الظلام. كانتا جافتين. تركنى أبى باكرًا جدًا، برحيله عن أمى وبيتنا، مخلفًا جراحًا ما زالت حتى اليوم عصية على الالتئام. جراحًا لم أجد وسيلة للتعايش معها سوى أن أروى لنفسى قصصًا عنها، أحاول أن أمنحها معنى. ولعقد كامل، كان أى اتصال هاتفى فى الليل يفجر داخلى رعبًا دفينًا. ولأقصى أسفى، وللسبب الذى جعلنى أظن لعقود أننى مكسور من الداخل إلى غير رجعة، كان أول ما خطر لى عند سماع الخبر: «لن يكون هناك هدايا عيد ميلاد بعد الآن».
وحين فتشنا مقتنياته فى شقته، كنت أفتقر للنضج الذى كان سيدفعنى للاحتفاظ بالأشياء المهمة. لم أفعل. ما احتفظت به كان كتبه المصورة القديمة ومجلاته، وأشرطة فيديو مسجلة من قنوات الكيبل. معظم المجلات كانت كتيبات قديمة عن أفلام الرعب، سرعان ما ذابت إلى عجين ورقى بسبب حادث جهاز ترطيب. أما أشرطة الفيديو فكانت لأفلام مثل الحفرة المالية والدائرة القصيرة. وأما كومة الكتب المصورة، فقد أقنعت نفسى بأنها كنز، وربما كانت لتصبح كذلك لولا أن والدى كان يرسم شوارب ولحى على معظم الأبطال الخارقين.
أتذكر أن نسخة مبكرة من سيرفر الفضى قوبلت بنفَس متحسر من صاحب متجر القصص المصورة فى بلدتنا، بسبب الشارب واللحية التى خطها أبى على البطل على غلاف العدد. «ذلك المتجر الذى لا تزال أمى حتى اليوم تطلق عليه: (متجر الشيطان)». مجرد تفاهات، تبعثرت مع تبدّل السنين. وحتى كيس المسحوق الأبيض الذى وجدتُه فى درج منضدته الجانبية لم أكن أعرف له معنى فى وقتها. لاحقًا فقط عرفت أن قصة «غلبه النعاس على المقود» لم تكن سوى ستار، وأن ثمة عوامل أخرى كانت وراء الحادث. وأنا اليوم، فى السادسة والأربعين، لم يبقَ لى منه سوى ذكريات ضبابية، وشريط كاسيت واحد.
فهل يمكن لآلة أن تروى حكاية أب وابنه، وتملأها بالمعنى؟ فى التمثيل والسرد نتحدث دائمًا عن النية: نية الكاتب، ونيتنا نحن كمؤدين. الآلة لا تعرف النية. الآلة لا تستطيع أن تروى قصة، لأنها- ببساطة- لا تملك جسدًا. الحكايات تنبع من حكمة متجسدة، من حياة عاشها لحمًا ودمًا. الرواية الخالدة عن غرور الإنسان فى خلق الذكاء، فرانكنشتاين لمارى شيلى، لم يكن بوسع أحد سواها أن يكتبها بذلك العمق. كما يقول محررو نسخة الذكرى المئتين: «فقط مارى، بخبرتها الجسدية وحكمتها المتجسدة، استطاعت أن تكتب فرانكنشتاين بكل هذه الفاعلية».
قصتها ولدت من النقاشات الملتهبة حول «جدل الحيوية» وتعريف الحياة، وهو جدل لم يخبُ حتى اليوم. اليوم يدّعى مبرمجون أن ابتكاراتهم فى الذكاء الاصطناعى قد بلغت شأن الوعى الذاتى؛ حتى إن شركة جوجل فصلت مطورًا بارزًا بعدما جاهر باعتقاده أن روبوت المحادثة لديهم قد اكتسب وعيًا. وكما فعل فيكتور فرانكنشتاين، يمرّرون الكهرباء فى أجساد صناعية مرقّعة من هنا وهناك، ثم يهتفون: «إنه حى!».
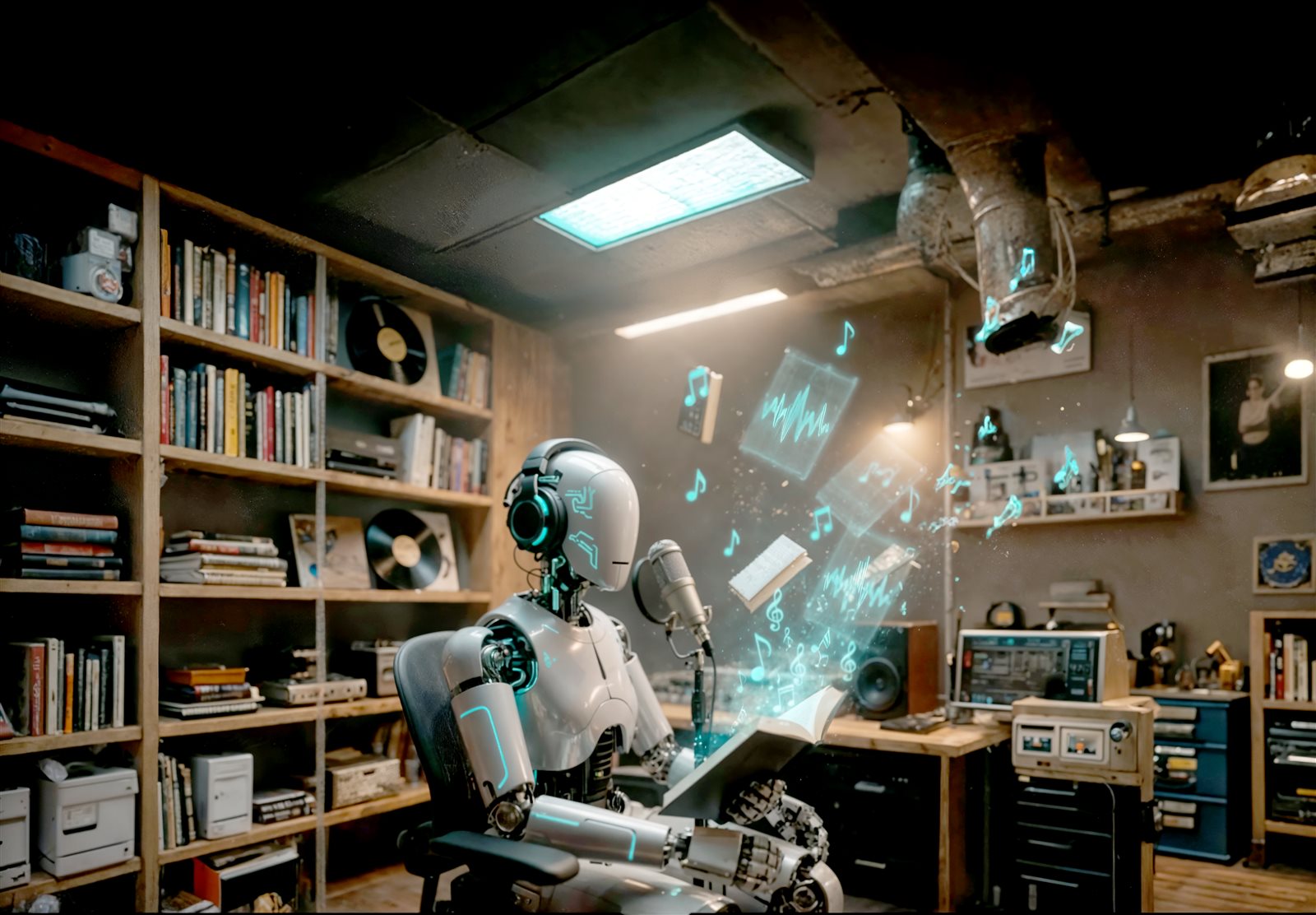
شهقات مبتورة
فى مشروع روائى مسموع حديث، جسدتُ شخصية «ماثيو»، الأب الذى يفقد ابنه فى حادث غرق بحفل حول حمام سباحة. أثناء التسجيل، باغتتنى أحزان الأبوة. تركت الدموع تسيل وأنا أواصل السرد. امتزج أبى وأطفالى مع القصة، واتسعت حياتى العاطفية على نحو لم أتوقعه. غمرتنى هواجس الخيال: ماذا لو فقدت طفلى فى غفلة واحدة؟ حتى غصّ صوتى، وانكسر إلى همس مثقل. والميكروفون سجّل كل شىء.
فهل يمكن لآلة أن تقلّد شهقاتى المبتورة أو نبرة صوتى المثقلة بالدموع؟ ربما. لكنها لن تستطيع أن تقلّد مخيلتى، أو الذكريات التى تتدفق بداخلى، أو أن تعيش لحظة الرعب من الفقد. الآلة لا تتغير بما تقرأه. الأجهزة التى تطنّ وتصفّر فى غرفة الطوارئ، محاولةً عبثًا إنعاش جسد ابن ماثيو، لم تتمكن من أن تعيد إليه أنفاسه.
القصص الشعبية مليئة بحكايات «المصطنع» الذى يتسلل ليحل محل «الطبيعى»: الطفل المستبدَل فى المهد. فى اليابان، صاغ العالم ماساهيرو مورى عام ١٩٧٠ مصطلح «وادى الغرابة» ليصف الظاهرة التى شهدها مبكرًا فى صناعة الروبوتات: حين يحاكى الشىء الإنسان بدقة شبه كاملة، لكنه يفشل فى بلوغ الكمال، فينشأ شعور غامض بالنفور.
وفى عام ١٧٦٩، بنى النمساوى فون كيمبلن جهازًا سمّاه التركى الآلى، وجال به أرجاء أوروبا، مدهشًا النبلاء بآلة تلعب الشطرنج وتهزم البشر. لكن الحقيقة ظهرت لاحقًا: لم يكن الأمر سوى قزم بشرى مختبئ فى جوف الآلة، يحرّك بيادقها بمهارة.
ورغم أن حكاية التركى الآلى مشهورة نسبيًا «حتى إن أمازون استعارت اسمه لبرنامجها الخاص بالعمّال عن بُعد»، فإن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن جزءًا آخر من المعرض التكنولوجى نفسه كان يضم حنجرة ميكانيكية، مكوّنة من سلسلة من الحواجز المطاطية والأنابيب الهوائية. لقد سبقت بذلك فكرة وادى الغرابة التى صاغها مورى؛ إذ روى الحاضرون أنهم شعروا بـ«إحساس غامض بالقلق» عند سماع أصواتها البشرية الغريبة. كتب أحدهم: «تبادلنا النظرات فى صمت وذهول، وداهمتنا قشعريرة رعب فى اللحظات الأولى».
من الناحية التقنية، يمكن لخوارزمية صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعى أن تُنتج شيئًا جديدًا، لكنها تفتقر إلى ذات داخلية تُفصح عنها. الكاتب شانون فالور يوضح الفرق فى كتابه «مرآة الذكاء الاصطناعى»:
«يمكن لأداة ذكاء اصطناعى أن تُنشئ أغنية بحرية جديدة، أو تمثالًا، أو شكلًا تجريديًا مبتكرًا. لكن ماذا يمكنها أن تُعبِّر من خلالها؟ فالتعبير يعنى أن فى داخلك شيئًا يلحّ للخروج، شيئًا يشق طريقه عبر فمك، وحجابك الحاجز، وإيماءتك، وإيقاع جسدك. أو ربما تسحبه أنت إلى الخارج بصعوبة، لأنه يقاوم الترجمة، يقاوم النطق. نموذج الذكاء الاصطناعى التوليدى لا يملك ما يحتاج قوله، بل مجرد تعليمات لإضافة ضجيج إحصائى يحنى نمطًا موجودًا فى اتجاه جديد. ليس له خبرة جسدية أو عاطفية أو فكرية بالعالم أو بالذات يمكن التعبير عنها».
ومنذ أرسطو، أدركنا أن الصوت والروح متداخلان: «الصوت هو نوع من الأصوات التى تصدر عن كائن حى، وما يُحدث الأثر يجب أن يكون فيه روح، ويصحبه فعل من أفعال الخيال، لأن الصوت هو صوت ذو معنى...».
أما الفيلسوف ملادن دولار فيتناول هذه الظاهرة فى كتابه «صوت ولا شىء أكثر». يصف ما يسميه الصوت الاصطناعى، وهو: «الصوت الذى لا يُرى مصدره، ولا يُعرف أصله، ولا يُمكن تحديد موضعه. إنه صوت يبحث عن أصل، عن جسد.. ومن الواضح أن الصوت بلا جسد هو بطبيعته مقلق وغريب. فالصوت هو لحم الروح، ماديته التى لا تنفصل عنها، والتى لا يمكن للروح أن تتخلّص من الجسد بفضلها».
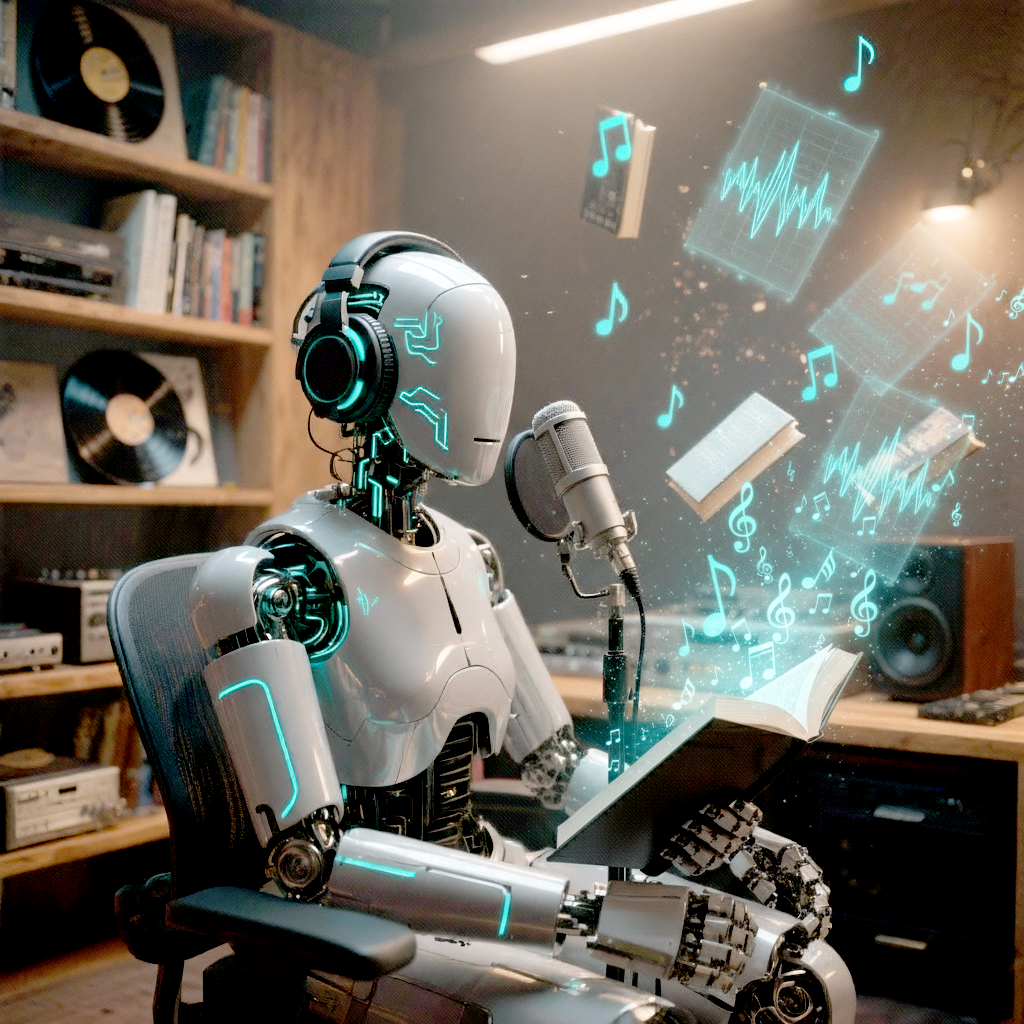
استنساخ حناجر الموتى
فى أوائل عام ٢٠٢٤، بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق «أودبل» أصواتها الافتراضية للجمهور، أصبتُ بعدوى كوفيد-١٩ أثناء حضور جنازة. ورغم أن العدوى زالت سريعًا، فإنها تركت وراءها شدًا غريبًا فى حنجرتى. وخلال يوم واحد فقط، صار ما يخرج من صوتى همسًا واهيًا متقطعًا، وكأن طبقة بعينها من طبقات صوتى الوسطى قد تضررت.
أدركت فورًا أن ما أعانيه ليس فقدانًا عابرًا للصوت بسبب نزلة برد؛ لم يكن هناك احتقان أو بُحّة تقليدية. بل بدا وكأن يدًا خفية تضغط على حنجرتى. سارعت لحجز موعد مع طبيب أنف وأذن وحنجرة متخصص فى علاج الممثلين والمغنين. بعد أن أدخل مخدرًا موضعيًا فى ممراتى الأنفية، دفع المنظار إلى حنجرتى. ظهرت صور الممرات الوردية على الشاشة أمامى. حين أخذت شهيقًا عميقًا، أوصل المنظار حتى الأوتار الصوتية. طلب منى أن أمدّ أصواتًا مختلفة وأترنّم ببعض النغمات، الأمر الذى أكّد شكوكه. قال لى: «ثمة تلف عصبى فى أوتارك الصوتية، وبالتحديد فى أحد الجانبين». وأرانى على الشاشة كيف كانت الأوتار تهتز معًا، بينما أحد الجانبين لا يتناغم مع الآخر.
حينها ارتفع فى داخلى ذلك الخوف المألوف لكل عامل حر. صحيح أن بعض الكتب يمكن تأجيل تسجيلها لبضعة أسابيع، لكن هناك حدًا أدنى من العمل علىّ إنجازه كل شهر لأدفع الفواتير. وماذا لو توقّف الناشرون عن التعاقد معى؟
كان الألم والانزعاج اللذان أشعر بهما نتيجةً لكل العضلات الصغيرة فى حلقى وهى تحاول «إجبار» الصوت على الخروج، لتعويض الخلل فى عمل الأحبال الصوتية. كان التشخيص غامضًا. الأمر متعلق بالأعصاب، وقد يكون هناك شفاء تام خلال شهر، أو قد يستغرق سنوات. وصف لى طبيب الأنف والأذن والحنجرة جلسات علاج نطقى، تضمنت برنامجًا من الطنين عبر قشات ذات أقطار مختلفة وتدليك الحلق بجهاز صغير محمول باليد «الذى، حسب مراجعات أمازون، لم يكن هذا هو الغرض الأصلى من صناعته».
ببطء محبط، ساعد هذا. لكن حتى الآن، وبعد مرور عامين، يبقى الألم. الأيام الطويلة من السرد تسحق حلقى، نبض مؤلم لا يزول أبدًا. أروى وكأننى أعرج.
على عكس أداتى البيولوجية الهشة، لن يمرض الصوت الاصطناعى أبدًا، لن يُصاب بشلل فى الأحبال الصوتية، ولن يخفت نشاطه أو قدرته على السرد على مدار الساعة. لكنه أيضًا لن يتعلم من المعاناة، لن يعرف النشوة ولا الحزن. سيظل يضرب بمطرقته البخارية بلا توقف، بينما يموت البشر بالعشرات إلى جواره. وكما كتب مدرّس الصوت ج. كليفورد تيرنر:
«الراوى هو الرابط بين المؤلف والمستمع. صوته هو الوسيلة التى تتجسد بها أعمال المؤلف، وهو القناة الأساسية التى يتدفق عبرها الفكر والشعور. صوته فى الحقيقة آلة، آلة متخصصة للغاية، تُفعَّل وتُعزَف بواسطة ذكاء الراوى ومشاعره، كلاهما تغذيه قوة الخيال التى يطبقها على إبداع المؤلف. الراوى لا يلتزم فقط بأقصى معايير النزاهة، بل يحمل أيضًا مسئولية واضحة تجاه المؤلف.. ومستمعيه».
فقط الإنسان قادر على الشعور بالمسئولية تجاه العمل الإبداعى لآخر. بعد إطلاق «الأصوات الافتراضية» من Audible بعام واحد، بدأت مرحلة تجريبية لبرنامج استنساخ الأصوات. كان يمكن للرواة على منصتهم «ACX» الاشتراك لاستنساخ أصواتهم، ثم يختار المؤلفون أو أصحاب الحقوق استخدام نسخة الراوى الاصطناعية بدلًا من الشخص نفسه، سواء لأسباب مالية أو زمنية. حتى كتابة هذه السطور، يظل نموذج التعويض غير واضح. لكنه منطق تجارى وحشى من كلا الجانبين.
إذا كان راوٍ ما مطلوبًا بكثرة فى نوع معين من الكتب، وكان اسمه وحده يبيع، فنسخته الصوتية ستكون شديدة الرواج. معظم الرواة المحترفين يسجلون نحو خمسين كتابًا فى العام. لكن الاستنساخ الصوتى سيسمح لهم بإنتاج مئات الكتب سنويًا، بلا حد نظرى للإنتاج. المؤلف يكسب اسم الراوى الشهير على كتبه، والراوى يتلقى دخلًا مستمرًا من العوائد.
أما أنا، كراوٍ بدوام كامل، فعادةً ما يكون جدولى ممتلئًا لشهرين أو أربعة مقدمًا، ما يضطرنى لرفض بعض الكتب أو الاختبارات ذات المواعيد الضيقة. تلك المشاريع تذهب لرواة آخرين، وغالبًا استفدت من مشاريع رفضها غيرى. لكن فى اقتصاد الذكاء الاصطناعى الجديد، ليس هناك ما يدفع الراوى المستنسخ لرفض أى عمل. وبما أن الرأسمالية تستغل كل فرصة، فالمشاهير سيستحوذون تدريجيًا على أغلب الأعمال، ويُزاح الرواة المتوسطون خارج دائرة الدخل والوظائف.
لن أتنافس فقط مع الرواة الأحياء ونسخهم المستنسخة، بل حتى مع أصوات الموتى. لا يحتاج استنساخ صوت لأكثر من ٣٠ دقيقة من تسجيل واضح، بينما للرواة الراحلين آلاف الساعات من التسجيلات التى يمكن أن يستغلها الذكاء الاصطناعى. فى حالة شهيرة، الممثل إدوارد هيرمان «المعروف من مسلسل Gilmore Girls وراوٍ بارز لكتب مثل Boys in the Boat و Unbroken» توفى عام ٢٠١٤، ورثته استنسخوا صوته، ويُنتَج الآن بواسطته كتب جديدة كـ«راوٍ زومبى». ومع مرور الزمن ورحيل المزيد من الرواة، سيزداد هذا الجيش من «الأصوات الميتة».

أسرى الخوارزميات
نادرًا ما ابتعد البشر عن الأتمتة. فى كتابه التاريخى عن حركة اللوديين Blood in the Machine، يكتب بريان ميرشانت عن حتمية الأتمتة:
«منطق الرأسمالية المنفلتة يضمن أن أى وسيلة لتقليل الكلفة أو الجهد أو زيادة السيطرة، ستُستخدم فى النهاية، بغض النظر عن طبيعة المجتمعات التى ستعطلها تلك التكنولوجيا. إنها القانون الحديدى للأتمتة الهادفة للربح: متى ما ظهرت وسيلة جذابة لخفض النفقات عبر آلة أو برنامج، سيتم تطبيقها».
كتب «ميرشانت» بشكل أساسى عن أتمتة العمل اليدوى، مثل الأنوال الميكانيكية فى إنجلترا القرن التاسع عشر. لكن المنطق نفسه يغرى الناشرين: الأصوات الاصطناعية تخفض الكلفة، تمنح السيطرة، وتوفر الجهد. الفارق أن العمل اليدوى يمكن قياسه، بينما الإبداع الفنى أصعب على الآلة الرأسمالية فى أن تُسعّره. والمفارقة أننى اضطررت لرفض اختبار رواية كتاب Blood in the Machine لصالح Hachette Audio بسبب قيودى البشرية فى الوقت والجدولة.
فى مجتمعى من الرواة، هناك حجتان متكررتان: علينا فقط أن نتأقلم مع التقنية الجديدة، وأن الذكاء الاصطناعى «مجرد أداة». الحجة الأولى تقول إن الفنانين لطالما تكيفوا مع التحولات التكنولوجية، من ممثلى الفودفيل الذين تحولوا للسينما الصامتة، إلى ممثلى الصامت الذين تكيفوا مع السينما الناطقة، وصولًا إلى التعليق الصوتى والتحريك الرقمى.
لكن بعد أن استمعت إلى الأصوات الاصطناعية، ورأيت زملائى الرواة يسكبون أرواحهم فى فنهم، أعلم أننا لن نُستبدل تمامًا أبدًا. ما يفشل هؤلاء فى إدراكه أننا لا نشهد وسيطًا جديدًا، بل تحولًا جذريًا. ليس تحسينًا بل إحلالًا. استنساخ الصوت قد يكون تكيفًا تجاريًا، لكنه ليس تكيفًا فنيًا.
أما عن الحجة الأخرى، أن الذكاء الاصطناعى مجرد أداة، فأجيب: نعم، يمكن تخيله كأداة لتنظيم الفواتير، أو لتحسين تقليل الضوضاء فى التسجيل، أو لاستخراج ملخصات للشخصيات من النصوص. لكن استبدال صوت الراوى بظل مكسور لا يُعد استخدامًا للأدوات، بل استبدالًا لشىء حى بشىء ميت.
أما Audible نفسها فتبعث برسائل متناقضة. ففى ٢٠٢٣ أرسلت لى هدية عيد لطيفة: سماعات Beats من Apple ومفكرة شخصية فى علبة مصممة إبداعيًا على يد فنان محلى، مع بطاقة كتب عليها: «نحن نحتفل بقوة السرد الملهم. نشكرك لكونك جزءًا أساسيًا من جعل القصص تنبض بالحياة». لكن صوتى لم يكن «أساسيًا» جدًا، إذ سرعان ما أطلقوا الأصوات الافتراضية، خطوة مصممة لتقليص أثر السرد البشرى. وكأنها ذراعان لمخلوق واحد، تعملان ضد بعضهما البعض.
بعد عامين من شللى الصوتى الجزئى، لم أعد قادرًا على السرد بنفس القدرة. يوم طويل أمام الميكروفون يعنى عضلات حلق متقرحة، وإحساسًا وكأن قزمًا صغيرًا ركل حنجرتى. أواصل تمارين العلاج الصوتى يوميًا، وقد صارت جزءًا من طقوسى. ومع ذلك، أنا ممتن: ممتن للقصص التى أرويها، لأنها تذكرنى كل مرة من جديد أننى إنسان، أننى أعانى، وأننى لن أعيش للأبد.
أقرأ لأطفالى الثلاثة ليلًا «رفقة الخاتم»، كتابًا أساسيًا من طفولتى. هم أطفال حسّاسون، ويرتعبون من وصف الأشباح السوداء فى نص تولكين. أما ابنى الأصغر فكان أشد حزنًا حين اضطر سام لترك حصانه الوفى «بيل» عند بوابات موريا. يطل علىّ من بين قضبان سريره العلوى، بعينين متسعتين، وقد ابتلعته القصة تمامًا. أنا هنا، حى، حاضر فى هذه اللحظة ولا غيرها، مرتبط بعائلتى عبر قصة.. وهذا يكفى.
بعد أن استمعت للأصوات الاصطناعية ورأيت زملائى يسكبون أرواحهم فى فنهم، أعلم أننا لن نُستبدل بالكامل. أعود لأسمع صوت والدى على شريط كاسيت واحد ثمين، حولته اليوم إلى ملف MP ٣ للذكرى.
تقدم Eleven Labs خدمة استنساخ الأصوات بسعر معقول. أستطيع أن أرسل لهم هذا الملف وأسمع والدى يكلمنى من وراء الموت. لكن الفكرة بغيضة لى. أتذكر ضحكته، ابتسامته، هو وزوجته يمسكان أيدى بعضهما فى الظلام عبر مقعد السيارة، يغنيان بخفوت: «دعنى أخبرك عن الطيور والنحل، والزهور والأشجار، والقمر فى الأعالى، وشىء يُدعى الحب»، بينما أستلقى فى المقعد الخلفى متظاهرًا بالنوم.
هذه الذكريات وصوته مصفّاة عبر الألم والزمن، بالكاد أتعرف على الصوت فى الشريط. الحقيقة أنها ليست مسألة الصوت. كثير من الداخلين الجدد لصناعة الكتب الصوتية يقولون لى: «الجميع يقول إن صوتى رائع، لذا يجب أن أجرب السرد». فأرد: ليس الأمر متعلقًا بالصوت، بل بقدرتك على سرد قصة. استحضار صوت والدى من الموت سيكون نوعًا من الاستمناء العاطفى. لن يكون هناك معنى سوى ما أضعه أنا، سيكون فارغًا. ما أتوق لسماعه «ولن أسمعه أبدًا» منه ببساطة: «أنا فخور بك».
لحياتى، لمهنتى، لقصتى، هناك طريقة واحدة فقط لمقاومة ذلك. ليس بتقليد اللوديين وتحطيم الآلات. «الأنوال الجديدة تعيش فى السحابة، فما الذى سنحطمه؟» لا، مثل جون هنرى، مطرقتنا فى أيدينا، ومطرقتنا هى الأقدم والأفضل. إنها ما يحددنا كجنس بشرى، إنها رواية القصص. أصوات الذكاء الاصطناعى مجرد أطفال غير طبيعيين، لا يستحقون سوى أن يُتركوا على الجبال ليموتوا بردًا.
كانت مارى شيلى محقة منذ أكثر من ٢٠٠ عام. فى كل الثقافات والأزمنة عرفنا أن ننفر من شبه- البشر غير الطبيعيين: الطفل المستبدل فى الأساطير الأوروبية، العيون الغريبة التى تحدق فينا، الكيتسونة اليابانية، المامونا البولندية، الـplentyn cael الويلزية، والـogbanje الإيغبوية، والغيلمات التى تهمس باللا إنسانية. أطلقت مارى شيلى اسمًا عليهم، وما زال صالحًا اليوم: نسميهم وحوشًا.
ماذا سنفقد إن أوكلنا إنسانيتنا للخوارزميات؟ قليلًا قليلًا، قصةً قصة، سنفقر. قال ويندل بيرى: «الاقتصاد الآلى أشعل بيت الروح البشرية». لقد انشغلنا بالخوف من أن نصبح مشابك ورق، أو بطاريات بشرية، أو تُسحق جماجمنا تحت أقدام التيتانيوم، حتى غفلنا عن الخطر الأدهى: تفويض فننا وإبداعنا للخوارزميات. إن اتبعنا هذا الطريق، ماذا سيبقى لغزاتنا الآلية لتغزوه؟ لن يكون هناك تمرد ولا مقاومة بطولية. بل مأساويًا.. سنكون قد تنازلنا عنه بأنفسنا، قصةً بعد قصة.







