فصول من كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية»
فى ذكرى مرور 102 عام على ميلاده.. هيكل يتذكر: أصدقائى الفنانون

- فى اليوم التالى لخروجى من الأهرام اتصلت بى أم كلثوم قاصدة إشعارى بالوقوف معى وبأنها تريد أن تعبر عن ذلك
- عبدالوهاب قال لى: إنت ورئيس الجمهورية بتتخانقوا أنا دخلى إيه بقى؟
- أعجبنى فى «ليالى الحلمية» العمدة صلاح السعدنى ويحيى الفخرانى اللذين كانا عملاقين وصفية العمرى فى الأجزاء الأخيرة
لم أكن أعتبر نفسى حكمًا على الحياة الفنية فى مصر فى أى وقت من الأوقات.
كان هناك غيرى من الصحفيين عندهم الحظ والفرصة أن يقتربوا من أبواب الفن، أنا اقتربت أكثر من عتبات السياسة، وكل من عرفتهم من الفنانين كانوا أصدقاء أكثر منهم فنانين فى واقع الأمر.
لكن رسخ فى يقينى مبكرًا جدًا أن الفن لا يعنى الفوضى، فالفن يعنى الالتزام بقواعد وقانون ونظام، وهذا لا يزيل البهجة من الحياة، ولا يجعل منك إنسانًا آليًا، الفوضى مع الهواية لا تنتج عملًا عظيمًا ولا تبقى على الإبداع متواصلًا.

أم كلثوم
أم كلثوم أحبها وكانت صديقة، وأنا واحد من الناس كنت أسمع أم كلثوم ربع ساعة فقط.
يوم زواجى أرادت أن تحيى فرحنا، والمشكلة أنه لم يكن هناك احتفال، لأننا نحن الاثنان لا نحب حكاية الأفراح، واقترحت هدايت أنه إذا أرادت أم كلثوم أن تهدينا حفلًا فليكن لصالح جمعية، وهى جمعية النور والأمل، التى كانت هدايت عضوة نشيطة فيها، وكانت تهتم بالفتيات الكفيفات. أقيمت الحفلة التى أحيتها أم كلثوم فى سينما راديو، جلسنا فى الصف الأول، كنا أصحاب الحفل طبعًا، أخذت هدايت وذهبنا إليها بعد الوصلة الأولى فى الاستراحة.
قالت لى: اسمع بقى انت قعدت الوصلة بحالها، أنا عارفاك بتتعذب يا ولد.
قلت لها: أنا مستمتع جدًا.
فقالت لى: معلشى علشان خاطرى روح بقى، كفاية عليك الوصلة الأولانية.
قلت لها: حاضر.
كنت قد سمعت بما فيه الكفاية فى هذه الوصلة، وكانت تعرف صعوبة الاستمرار بالنسبة لى، خاصة عندما تكون الأغنية الواحدة ساعة ونصف الساعة أو ربما ساعتين.
من بين ما أذكره عنها أننى زرتها بعد عودتها من زيارة إلى الأراضى المقدسة.
قلت لها: هيه... ماذا قلت وأنت واقفة أمام الروضة الشريفة، قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم؟ هل همست فى نجواك بإحدى أغنياتك العابدة الخاشعة، التى تغنيها له وأنت هنا فى القاهرة؟
قالت أم كلثوم: اسكت... لم أستطع أن أفتح فمى بكلمة واحدة.
قلت فى دهشة: أنت! أنت التى تغنى فى مدحه وفى سيرته أروع ما قيل فى مدحه وفى سيرته من قصائد كالهمزية النبوية ونهج البردة وإلى عرفات الله.
قالت أم كلثوم: نعم... نعم... أنا التى أجد نفسى فى مدحه وسيرته، هنا من على البعد، مثل اللبلب وجدت نفسى فى رحاب قبره وليس على لسانى كلمة واحدة.
واستطردت أم كلثوم: العجيب أنى عندما وجدت المدينة المنورة تبدو أمامى قابعة فى أحضان الرمال، ورأيت المآذن والقباب الخضراء، فوق الروضة الشريفة، أحسست بفيض جياش من المشاعر والأحاسيس، وأخذت أتحدث وأعبر عنها فى طلاقة، فلما وصلت إلى الروضة نفسها، ووقفت أمام القبر الطاهر، ران علىّ الصمت وتملكنى السكون.
وقلت لأم كلثوم ضاحكًا: لم تستطيعى أن تذكرى ولا قصيدة واحدة من أغانيك.
قالت أم كلثوم ضاحكة: تذكرت أغنية واحدة ولكن بعد أن خرجت؟
قلت لأم كلثوم: أيها؟
قالت: الأغنية التى أقول فيها «ولما أشوفك يروح منى الكلام وأنساه».
ومرة جلست بجوارها أسمع التجربة الأخيرة لنشيدها الجديد الذى كتبه بيرم التونسى ووضع لحنه السنباطى.
أحسست عندما وصلت أم كلثوم إلى الفقرة التى يقول فيها النشيد: ثلاث دول يا بورسعيد متقدمة/ بدبابات وطيارات تملا السما/ الأولة داخلة البلاد مستعمرة/ والتانية بعد الانكسار متجبرة/ والتالتة على العرب متأجرة- أحسست عندما وصلت أم كلثوم إلى هذه الفقرة أن روح مصر كلها تقمصت كيان هذه السيدة الجالسة بجانبى، أحسست أن مصر نفسها متجسدة فى كيان هذه الفلاحة العظيمة من السنبلاوين، واقفة على شاطئها المنتصر، ترقب موجة البغى تنحسر عن رماله الطاهرة، تشيع غزاتها المندحرين بضحكة ساخرة، أقسى على أسماعهم من صراخ المدافع.

محمد عبدالوهاب
فى يوم كنت فى بيت محمد عبدالوهاب، وفوجئت بوجود صلاح نصر وشمس بدران عنده، أبديت استغرابى من أن محمد عبدالوهاب يعزم الاثنين عنده بالذات، وأن يكونا معًا عنده فى بيته.
عبدالوهاب كان شديد الذكاء، لمح استغرابى ودهشتى، بعدها قمت من أجل الكلام فى التليفون، فجاء عبدالوهاب ورائى.
سألنى: هل استغربت من وجودهما؟
قلت له: لا.
فسألنى: قولى يا خويا مش الاتنين دول همه بالضبط الشديد والقوى؟
ثم استدرك شارحًا: أنت تعرف أنهم بالبلدى يقولون عن إنسان الشديد أو القوى، وأنا أقول عنهما الاثنين معًا: الشديد القوى.
ضحكت جدًا من كلامه، وفى اليوم التالى حكيت الحكاية لجمال عبدالناصر، فضحك منها وعليها.
وعندما اختلفت مع الرئيس أنور السادات، وعرف الكل ما جرى، فى اليوم التالى لخروجى من الأهرام اتصلت بى أم كلثوم قاصدة إشعارى بالوقوف معى، وبأنها تريد أن تعبر عن ذلك، وقد وصلتنى رسالتها غير المباشرة فعلًا، شعرت من الاتصال أنها تريد الوقوف معى، وأنها تريد أن تعبر عن ذلك.
عبدالوهاب مثلًا لم يفعل ما فعلته أم كلثوم، عبدالوهاب اختفى، لم أسمع صوته، وظل صمته مستمرًا إلى أن نشر فى الصحف أننى معروض علىّ منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام، وكان ذلك فى وزارة ممدوح سالم، التى اعتذرت عن دخولها.
كلمنى محمد عبدالوهاب فى ذلك الصباح.
قال فورًا، بعد السلام والتحيات والأشواق: أهلًا يا ألف مبروك... بقيت وزيرنا.
قلت له: أنا اعتذرت.
قال لى: إيه يا خويا؟
قلت له: أنا اعتذرت عن الوزارة.
قال لى: يعنى إيه اعتذرت عن الوزارة؟
قلت له: مش داخل الوزارة؟
سألنى: فعلًا ... فعلًا؟
قلت له: فعلًا.
قال لى: غريبة قوى إزاى كده؟
قلت له: اللى حصل.
قال لى: طيب.
ولم أسمع صوته بعد ذلك.
بعد سنوات التقينا فى عيادة طبيب أسنان مشهور، فوجدته يقول لى: إنت ورئيس الجمهورية بتتخانقوا أنا دخلى إيه بقى؟
ومن بين ما أذكره لعبدالوهاب، ولا أستطيع أن أنساه، أننى عندما كنت فى السجن كنت أتذكر أغنيته التى كتب كلماتها أحمد شوقى وفيها يقول: الفجر شقشق ولاح على سواد الخميلة.

منيرة المهدية
ذات يوم عام ١٩٤٦ جاءنى كامل الشناوى، وكنا أصدقاء، وقال: منيرة المهدية حتغنى تانى، فاندهشنا، وذهبنا لسينما أوبرا، والست ليس ذنبها، فالذوق العام تجاوزها، لأن الزمن لا يقف، الإيقاع العام تجاوزها، والكلمة تجاوزتها واللحن تجاوزها، يعنى أنت جئت بلحظة من الزمن مضت وتريد أن تلصقها بزمن جديد كأنه رقعة.
لما سألنى كامل الشناوى بعد الحفل، قلت له: يا راجل حرام عليك... حرام ترجع.
أنا واحد من الذين فهموا اعتزال محمد عبدالوهاب واعتبرته أذكى قرار اتخذه، فإذا كنت تحترم قيمة الزمن فجزء من احترامك له أن تكون مدركًا لحركته ومعدل هذه الحركة، وإذا تخيلت أنك قادر على وقف حركة الزمن وتتعلق به كأنه ترماى أو قطار وتقفز فيه، كل هذا ليس أكثر من لعب، فالماضى لا يستعاد.
من الممكن أن يكون هناك مشاعر حنين، هذه مشاعر إنسانية ولكن أنا أجدها مخالفة جدًا لتصوراتى ولفكرتى عن الزمن.

عبدالحليم حافظ
عندما كتب كامل الشناوى أغنية لأم كلثوم وقال فيها «عندى جمال»، اعترض عبدالناصر عليها، كان ذلك سنة ١٩٦٠، وبعد وضع حجر الأساس للسد العالى وحرب السويس والوحدة مع سوريا، تحولت الأغانى الوطنية إلى طوفان، وتحدث عبدالناصر بنفسه مع أم كلثوم وقال لها: أنا ضد ذكر اسمى، فجرى تغيير المقطع.
عبدالحليم حافظ كان شيئًا مختلفًا، منحناه كل الحب الذى فى صدورنا، وظللت طوال عمرى أشعر بحنين لصوته وللزمن الذى غنى فيه، كان عبدالناصر يعتبره نتاجًا لثورة يوليو، صوت الثورة ومطربها.
مرة عمل عبدالحليم حافظ حاجة غريبة، لم يعرف كيف يتصرف فيها، وقد واجهها بحيرة كاملة.
كان قد بدأ يسافر للخارج وأصبح نجمًا، وكان يسمع أن الرئيس يحب أربطة العنق، جاء حليم مرة لبيت عبدالناصر، وأنا كنت موجودًا، كان من عادته أن يصل إلى البيت ويجلس مع أولاد الرئيس الذين كانوا فى سن الصبا، ويثير حالة من الفرح الإنسانى النادر فى كل مكان فى البيت، كان يزيط ويهرج مع الأولاد، وكان الرئيس يحبه جدًا.
دخل حليم على الرئيس وفى يده شىء ما، دستة من الكرافتات، وعبدالناصر قال له: شوف يا حليم أنا حاخد واحدة فقط، بس ما تعملهاش تانى أبدًا.
قال له حليم: طيب سيادتك اختار.
رد عبدالناصر: أنا حاخد واحدة بالبخت دون اختيار.
ذات مساء، وبينما الكل فى انتظار الغزو، فى يونيو ١٩٥٦ بعد انتخاب عبدالناصر رئيسًا لمصر، كنت مع الرئيس فى مقر قيادة الثورة، فوجدت عبدالناصر يزرع الغرفة ذهابًا وإيابًا، بمزاج متعكر، بعد سماعه أغنية «إحنا الشعب»، كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، والتى يغنى عبدالحليم فى بدايتها: إحنا الشعب... اخترناك من قلب الشعب... يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير القلب... يا حلاوة الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه... مبروك ع الشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه... واحنا اخترناك وهنمشى وراك... يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير القلب.
ألهبت الأغنية خيال الجماهير، وغنوا والفرحة الغامرة وحرارة التفاؤل تملأ قلوبهم مع حليم، وأخذ كل إنسان يرددها وينشدها مؤمنًا بالمستقبل الواعد الذى سوف يتحقق على يدى عبدالناصر، وكان حليم قد أصبح أوسع المطربين شهرة.
توقف عبدالناصر أمام المقطع الذى يغنى فيه: ياللى بتسهر لجل ما تظهر شمش هنانا... إحنا جنودك سيبنا فى إيدك مصر أمانة.
قال لى: إن مصر فعلًا فى ظرف خطر، وهى فعلًا مرهونة على حسن تصرفنا وعلى شجاعتنا فى المواجهة، لهذا لا بد أن نبذل كل ما فى وسعنا لحمايتها وإنقاذها.

شادية
قالت لى شادية: اسمع هذه الأغنية، وقل لى ماذا فيها لكى تمنعها محطة الإذاعة؟
وبدأت شادية تغنى أغنية عن الحب تقول «أوله دردشة... وآخره وشوشة»، وانتهت شادية وتطلعت إلىّ تسألنى: هل فيها شىء يجب أن تمنع من أجله؟.
قلت على الفور: أجل فيها.
قالت: ماذا فيها؟
قلت: فيها خربشة.

عفاف راضى
جمال عبدالناصر كانت تلفت نظره أى موهبة تظهر فى أى مكان من العالم غير مصر، ولم تكن عنده شوفينية ولا أحاسيس أو مشاعر أو مواقف موجهة ضد الوطن العربى، فعروبة جمال عبدالناصر وقوميته لا يرقى إليهما الشك، ووقوفه ضد دعاوى الفرعونية فى مصر، أيضًا مسألة مؤكدة.
وموقفه من المواهب التى قد تظهر فى الوطن العربى لم يكن غيرة، تلك الغيرة الإنسانية التى قد نفهمها نحن، عبدالناصر كان عنده إعجاب حقيقى بفيروز، لم يكن يستطيع أن يخفى إعجابه بفيروز ووديع الصافى، كانت هناك أصوات يسمعها ويحبها بلا حدود.
كان من أمنياته أن يكون عندنا هنا فى مصر لون من الغناء الذى هو لون فيروز ووديع الصافى حيث صوت الجبل، كان يحلم بوجود هذا الصوت فى مصر.
وقد حدث أن سمع جمال عبدالناصر بالصدفة البحتة عفاف راضى وهى تغنى.
كان من عادته عندما يسافر إلى خارج مصر أن يفتح الراديو على القاهرة دائمًا وأبدًا، ويستمر هكذا طوال الوقت، مهما كان المكان الذى نكون فيه، وكان يستمع إلى أى مواد من راديو القاهرة، بصرف النظر عن كونها أعجبته أم لا.
حتى عندما يكون فى عمل أو يتناول الطعام أو فى فسحة، تكون إذاعة القاهرة فى الخلفية، سواء كان فيها غناء أو دراما، أو مواد سياسية، المهم أن يكون مع القاهرة والسلام.
يومها لفت جمال عبدالناصر نظرى إلى صوت عفاف راضى.
قال لى إنها موهبة، صوتها فيه حاجة وعينة فيروز، ولو أن أحدًا اهتم بها فى الإذاعة، ووفروا لها ملحنين كويسيين يمكن تصبح عفاف راضى فيروز أخرى، فأرجوك تهتموا بها، ثم عدنا وحدثت أمور أخرى وجدّت ظروف مغايرة.

صراع فى الميناء
بعد الثورة بشهور كان هناك فيلم يعرض اسمه «فيفا زاباطا» عن الثورة المكسيكية، أو عن محاولة إصلاح أحوالها، وفى النهاية فشلت هذه الثورة وانتهت إلى لا شىء، وكنت قد ذهبت إلى السينما، وشاهدت الفيلم وسعدت به وأعجبنى.
اقترحت على جمال عبدالناصر أن يذهب معى إلى السينما، فذهب ومعه عبدالحكيم عامر، وفى الأسبوع التالى طلب منى دعوته ومعه عبدالحكيم وعبداللطيف البغدادى، وكان معنا إما زكريا محيى الدين أو كمال الدين حسين وكانوا يشاهدون الفيلم للمرة الثانية.
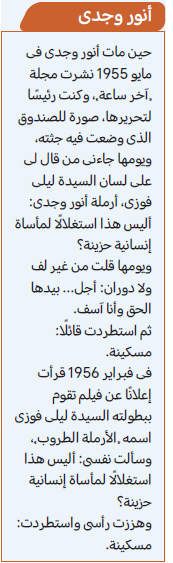
دفعت ثمن التذاكر كلها، وفى السينما كنا نجلس على شكل صف واحد، وعندما جلسنا، وأذكر هذا جيدًا، كانت الناس تنظر إلينا، وقبل أن يبدأ العرض سمعنا نشيد: على الإله القوى الاعتماد بالنظام والاتحاد والعمل، وقد كان النشيد الخاص بالثورة، ووقف الجميع لحظة سماع النشيد، والناس كلها كانت تردد هذا النشيد بحماس منقطع النظير.
وفى فبراير ١٩٥٦ شاهدت فيلم «صراع فى الميناء»، ورأيت فاتن حمامة بعد أن كبرت، آخر مرة رأيتها فيها على الشاشة كانت عندما ظهرت مع عبدالوهاب طفلة فى فيلمه القديم «يوم سعيد» فى عام ١٩٤١.
دخلت الفيلم مصادفة، وخرجت منه وفى عزمى ألا أنكر الشهادة، وأن أقول كلمة الحق، وأنا لم أرَ فاتن حمامة شخصيًا فى حياتى حتى هذا الوقت، وكذلك لم أرَ زوجها وبطل فيلمها عمر الشريف.
كان رأيى فى عمر الشريف من مجرد رؤية صورته فى الصحف لا يرضيه كثيرًا، ولو كان لى أمر عليه لأخذته من يده إلى أقرب حلاق وطلبت منه أن يحلق له «شوشته» التى ينكشها على مقدمة رأسه فتوة وشبابًا.
ورغم أننى لم أكن أعرف كاتب القصة أو واضع السيناريو أو مخرج الفيلم، لكننى وللحق خرجت معجبًا بكل هؤلاء.
بفاتن حمامة التى أدت دورها ممثلة رائعة.
وبعمر الشريف برغم «شوشته» المنكوشة على رأسه.
وبكاتب القصة وواضع السيناريو.
وقبل هؤلاء جميعًا بمخرج الفيلم.
لم يكن الفيلم، كما تعودنا أن نرى دائمًا، قصة بنت الباشا الهاربة مع سائق سيارته، ولم يكن فى الفيلم رقص بطن، ولم تكن فيه أغانٍ تحشر بين المشاهد والسلام.
كان الفيلم قطعة من صميم الحياة، قطعة فيها فكرة، ولها روح ووراءها هدف، ولقد خرجت من الفيلم وأنا مؤمن بأن الدولة يجب أن تغير سياستها تجاه السينما المصرية، ما دامت السينما المصرية قد بدأت تغير اتجاهها أيضًا.
لقد كنت حزينًا لمأساة السينما المصرية، وأنا أكره أن تضمحل السينما المصرية كفن وصناعة.
فى يناير ١٩٥٧، رأيت فيلم «بنات اليوم» الذى يمثله عبدالحليم حافظ وأمامه ماجدة، والذى أخرجه بركات، إذا لم أقل إنه جهد رائع من جميع نواحيه، لكنت بذلك أكتم شهادة حق لا بد أن أؤديها، لقد أثار الفيلم أمامى أزمة السينما المصرية، مع أن السينما المصرية موضوع بعيد عما أتعرض للكتابة فيه عادة.
ينبغى ألا تموت السينما فى مصر، وينبغى ألا تترك بين الموت والحياة تحت أعباء الأنقاض التى خلّفتها لها التجارب التى مرت بها، لست خبيرًا ولا أنا أحاول ادعاء الخبرة، إن الذى تحتاج إليه السينما المصرية هو: فهم من الدولة لرسالتها، إعطاء درس للرقباء يضع لمحات من النور فى رءوسهم، إبعاد العناصر الدخيلة التى تشبه فى هجومها على السينما المصرية غارات التتار فى نفس الوقت الذى تبعد فيه العناصر التى تريد انتهاز فرصة ربح سريع بأى شكل وأى ثمن.

روك أند رول
فى أبريل ١٩٥٧ وكنت جالسًا فى أحد نوادى القاهرة الكبرى، سألتنى إحدى السيدات دون مقدمات: ألا تعجبك رقصة «روك أند رول»؟ إن الدنيا كلها مجنونة بها، إنها آخر حركة فى فن الرقص.
قلت لها وأنا أتابع عن قرب راقصى «روك أند رول» بالقرب منى: الحقيقة أنها لا تعجبنى.
قالت: إذن أنت رجعى... لا تستطيع تقبل الأشياء الجديدة.
وقلت: هذه الرقصة ليست شيئًا جديدًا، كان أجدادنا فى الغابة يرقصونها عندما يجرى رجل منهم يطارد امرأة ثم يمسك بها، وتقاوم فيشدها، وتجرى فيخبطها فى الأرض، والفرق بين عهد الغابة وعهدنا أنهم لم يكونوا يسمونها «روك أند رول» وإنما كانوا أكثر صراحة، فسموا الأشياء بأسمائها.
تطلعت إلى فتى وفتاة يرقصان «روك أند رول» وكان يشدها ويدفعها، ثم يحملها فيضعها على صدره، وإحدى ساقيها فى ناحية من صدره والساق الأخرى فى الناحية الثانية، ثم قلت لسائلتى وأنا أهز رأسى متحسرًا: لو كانت ابنتى لكنت قطمت رقبتها.
قالت: يا ساتر... الحمد لله أنه ليس لك بنت.
قلت: أجل... الحمد لله مع أنى كنت أتمنى أن تكون لى بنت، لكنى غيرت رأيى بعد رقصة «روك أند رول»
كارايان

تشدنى موسيقى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وأنا مدين فى تعلقى بالموسيقى العالمية لعقلية الدكتور محمود عزمى، كنا نجتمع فى بيته كل يوم خميس نتحدث ونتحاور، ثم نصغى إلى قطعة موسيقية مما هيأ لى إمكانية تذوق تلك الموسيقى.
وظللت لسنوات زائرًا دائمًا تقريبًا لمهرجان موزارت، الذى يقام فى مسقط رأسه فى مدينة سالزبورج بالنمسا، وظنى بأن كارايان هو أفضل قائد أوركسترا لموسيقى موزارت، وبعد كارايان، الذى توفى فى العام ١٩٨٩، تلاشى جزء كبير من مذاقه.
فى عام ١٩٨٥ كان كارايان فى قمة توقده، وقد باغتنى اثنان- ابنى الأصغر حسن ورئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر- لم يتمكنان من كتم مشاعرهما عندما كان يقود الأوركسترا، فإذا الدموع تسيل من شدة التأثر وتتحول إلى بكاء مكبوت.
أما عن الموسيقى العربية، فكنت أعتبر طوال الوقت أنه لم يتبقَ من النغم الشرقى الأصيل سوى التواشيح الدينية والموشحات الأندلسية والمدائح الدينية والنبوية والصوفية والمواويل.
ظللت طوال حياتى مولعًا بالتواشيح «الشيخ سيد النقشبندى مثلًا».
ومفتونًا بالموشحات «المطربة الكبيرة فيروز مثلًا».
المدائح تحرك مشاعرى «أحمد التونى مثلًا»، وتأخذنى المواويل «كان وديع الصافى بظنى آخر نجوم فن الموال».
ينسى البعض أحيانًا أن فن تلاوة القرآن «تجويد ومقامات وغيرها من فنون التلاوة» كان جزءًا منه موسيقى، وأعتقد أن أنغام محمد عبدالوهاب وكمال الطويل ورياض السنباطى ومحمد القصبجى والأخوين رحبانى استطاعت أن تجدد الموسيقى العربية وتواكب العصر.
لقد حاولت أن أفهم موسيقى العصر..
من موسيقى الجاز وهى خفيفة راقصة بإيقاعات متنوعة تعبيرًا عن الحياة السلسة فى تناولها والرشيقة فى إيقاعها، إلى موسيقى الروك وهى تعبير عن سرعة القرن العشرين ووسائل مواصلاته من السيارة والطائرة حتى المكوك والصاروخ، مستوحية إيقاعاتها من صيحات الغرائز الأولى للإنسان وأنفاسها المتتابعة وعرقها المتدفق تعبيرًا عن عصر الريبة والهذيان والتخبط، وأبرز نجومه ألفيس بريسلى.
وقد وصلت إلى موسيقى الراى، وهى صيحة الفن فى المغرب العربى والمدوية فى العالم فى تسعينيات القرن العشرين، وأبرز نجومها مجموعة من الشباب كخالد ومامى.
لم أستوعب أيًا من الموسيقات الثلاث، لكنى أفضل أغانى فرانك سيناترا بصوته العميق، وخوليو إجليسياس، صوته سر تفوقه، وله طريقته الإبداعية عن غيره، لكننى بطبيعتى أنحاز للموسيقى على الغناء.
فى السنوات الأخيرة جرت أشياء لا أتصور نفسى مندمجًا فيها مثل الأغنية الشبابية، لقد رأيت فى برنامج تليفزيونى أغنية تسمى «بابا أوبح» لم أستطع الاندماج فيها.
هناك فرق بين أن تندمج أو تتابع ما يجرى، عندما تشعر بالاغتراب معناها أن المشكلة فيك وليس فى الآخرين.
وفى الحقيقة لم أكن أعرف أحدًا من نجوم الغناء الجدد فى عالمنا العربى، كان آخر عهدى بالغناء هو عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم وفيروز ومن واكب عصرهم من نجوم المغنى والطرب.
فى العهد الملكى هناك من كان يغنى لوديان المشرق «يا شراعًا وراء دجلة يجرى» و«سلامًا من صبا بردى أرق».
وفى عهد ناصر بكل ما يمثله من عنفوان ثورى وامتلاك الإردة غنى حليم «لا حسلم بالمكتوب ولا حارضى أبات مغلوب».
لكن فى السنوات الأخيرة كنت أجد طبلًا وزمرًا وهز خصور على إيقاعات بدائية وأنغام صحراوية بجلجلة صاخبة وحائرة ومترددة أخفقت فى ابتكار لحن وعجزت عن استيحاء نغم.
لانا تيرنر
ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء ثلاثة تحقيقات عن الرأسمالية الكبيرة التى تحكم أمريكا، وعن التمييز العنصرى ضد السود، والجريمة المنظمة ودور عصابات المافيا فى الحياة الأمريكية.

كانت الملكة نازلى تسكن فى مدينة لوس أنجلوس شارع «تاور رود»، والبيت كان مزودًا بحمام سباحة، وهناك تعرفت هى على كثيرين من نجوم هوليوود، وقد تحولوا ضيوفًا لبيتها ومتواجدين فى حفلاتها.
كانت قصة غرام الأميرة فتحية مع رياض غالى، موظف السلك الدبلوماسى فى قنصلية مصر فى سان فرانسيسكو، قد بدأت بالتصاعد، وهكذا كان موضوعى الرابع الذى أغطيه، وذهبت لمقابلة الملكة نازلى، وكان ضمن ما سألتنى فيه: عن مكان إقامتى؟
قلت لها: فى فندق هوليوود بلازا.
قالت: تعال الليلة وأسهر معنا، سيكون معنا على العشاء الفنانة «ماريون ديفيز».
قلت لها: ياه دى من زمن السينما الصامتة.
قالت الملكة: إذن من يعجبك من نجمات هوليوود وترغب بمقابلتها؟
فقلت لها: «لانا تيرنر».
قالت الملكة: إذن موعدنا فى السادسة مساء، انتظر فى ردهة الفندق، سأرسل لك سيارة كاديلاك تأتى بك.
فى الساعة السادسة تقريبًا كنت جالسًا فى الردهة، وأصداء جلبة وصخب فى الخارج، ثم ناس مجتمعون حول نجمة سينمائية شهيرة، والمفاجأة كانت «لانا تيرنر» بنفسها، وقد اتجهت لموظف الاستقبال تطلبنى بالاسم، وعلمت أن الملكة نازلى التمست منها أن تمر علىّ لتأخذنى معها، وهكذا رافقت نجمتى المفضلة، وأنا فى شدة الحياء وفى مأزق مؤلم.
لم أنظر إليها على طول الطريق، فقد أغاظنى منظر الناس وهم يروننى بجوارها، ونحن نهبط سلم الفندق، وروت «لانا تيرنر» للملكة نازلى كل ما حدث وقالت لها إننى لم ألتفت إليها على طول الطريق، فقالت لها الملكة نازلى: هو فلاح مصرى، والفلاحون لا يمكنهم رفع أعينهم فى النساء.
فى أكتوبر ١٩٥٦ كنت عائدًا مع مصطفى أمين على الطائرة العائدة من نيويورك فى طريقها إلى باريس بعد مهمة صحفية، جاءتنا مضيفة الطائرة الجميلة تقول: هش، وتطلعنا إليها فى فضول.
قالت: هل تعرفون من سيركب معنا الآن قبل أن تقوم الطائرة؟
قلنا: من؟
قالت: مارلين ديتريتش نجمة السينما الشهيرة، وصاحبة أجمل ساقين فى الدنيا.
تراجعت المضيفة الجميلة تفسح الطريق لمارلين، ودخلت نجمة السينما المشهورة، فألقت علينا جميعًا نظرة خاطفة، ثم اتجهت على الفور إلى السرير المحجوز لها على الطائرة.
بدأ مصطفى أمين يهمس فى أذنى كيف أن مارلين ديتريتش كانت بطلة أحلامه أيام المراهقة، وكانت بطلة أحلام شباب الدنيا كلها فى ذلك الوقت منذ ما يقرب من ثلاثين سنة.
أقبلت مضيفة الطائرة تقول لمصطفى أمين: ألا تريد أن تنام؟
وسألها مصطفى عن موضع سريره، فإذا هى تشير إلى السرير الذى يعلو سرير مارلين ديتريتش مباشرة.
سألته المضيفة: هل أضع لك السلم لتصعد عليه إلى فراشك؟
تلفت مصطفى حوله كمن وقع فى ورطة ثم قال للمضيفة: ألا تريننى رجلًا طويلًا عريضًا، ماذا لو صعدت إلى هذا السرير العلوى فلم يتحمل وزنى وسقط بى على مارلين ديتريتش؟
استدار مصطفى أمين يسألنى: ما رأيك لو أخذت سريرى فوق مارلين وأخذت أنا سريرك؟
قلت له بسرعة: أبدًا، وما ذنبى أنا ولم تكن هى فى يوم من الأيام حلمى؟... اذهب أنت لقد كانت فى يوم من الأيام حلمك على أى حال.
ضحك مصطفى وقال: لقد كبرت... إننى أفضل الآن أن أحلم وأنا جالس على مقعدى هنا.
عرفت كذلك النجمة «لويز رينر»، وقد تحولت إلى صديقة، فقد كانت مقترنة من روبرت كنتيل، مدير نشر فى ويليام كولينز، وهى أكبر دار نشر بريطانية والتى تملك حقوق نشر كتبى، وكان زوجها الثانى، وهو للمفارقة مولود فى مصر، وكانت أسرته تعمل فى تجارة القطن فى مدينة الإسكندرية.
لم أكن أرى مارلين مونرو رمزًا للإغراء الأنثوى، لا شك أنها كان تملك مسحة من سحر ولمسة من جاذبية، خاصة أنها ومضت بغتة كشعلة فى هوليوود، وكذلك خبت فجأة، وقد رحلت وهى فى حدود السادسة والثلاثين، بمعنى أن جمالها أدرك غايته، ورغم أن الإعلام أطلق عليها فى البداية «الشقراء الغبية» إلا أن زواجها من المسرحى آرثر ميلر، ثم دخولها بعلاقات مع الأخوين كيندى «جون وروبرت»، وعملها كعارضة أزياء ثم ممثلة فى هوليوود، أعطاها تجربة بطريقة أو بأخرى.
لم أنجذب إلى مارلين مونرو أبدًا، ولكنها كانت بلا شك تكوين أنثوى مثير.
فى السنوات الأخيرة لم أعرف أحدًا من نجمات هوليوود، أصبح ما يلفت نظرى هو دقة الأداء، أكثر من لمسة الجمال.

ليالى الحليمة
لم أكن من هواة المسلسلات الدرامية، لكننى كنت قد رأيت بعض حلقات مسلسل «ليالى الحلمية»، وعندما غبت لظروف عمل طلبت أن تسجل لى الحلقات التى لم أتابعها، وعندما عدت شاهدتها كاملة، وأعتقد أن «ليالى الحلمية» تخرج عن نطاق العمل الفنى لتصبح حدثًا ثقافيًا وسياسيًا.
وفى بداية عرضها وعندما عرض إلى جوارها مسلسل «رأفت الهجان» شعرت أن المسلسلين قد قاما بعمل يقظة فى الضمير المصرى الذى استيقظ للصراع العربى الإسرائيلى مرة واحدة، واستيقظت فيه خلجة التنبه، لقد نجحت «ليالى الحلمية» لقربها الإنسانى من الناس، إلى جوار فكرة ممتازة وحوار ممتاز وسيناريو رائع.
أعجبنى فى «ليالى الحلمية» العمدة صلاح السعدنى ويحيى الفخرانى اللذين كانا عملاقين، وصفية العمرى فى الأجزاء الأخيرة كانت فنانة حقيقية عندما أصبح الدور يعتمد على أدائها أكثر مما يعتمد على شكلها.

تحية حليم
فى أحد معارض الفنانة التشكيلية تحية حليم سألت نفسى: لماذا أنا هنا الآن داخل إطار يبدو بعيدًا عن موطنى الطبيعى باعتبارى كائنًا عاش عمره ومارس عمله وسط مواقع الصحافة وقرب مواقع السياسة.
ولاختصار الطريق إلى إجابة واضحة قلت إننى من البداية واحد من الذين يعتقدون أن الفن هو الأب الحقيقى للثقافة فى جميع مجالاتها، ثم إن الفنون التشكيلية هى الحلقة الرئيسية فى قصة الصعود المدهش على سلم الحضارة الإنسانية.
كثيرًا ما كانت تحية حليم تأتى إلى مكتبى، تحدثنى عن خواطرها وأحوالها.
وكثيرًا ما ذهبت إلى مرسمها أتابع ما تفعل، وأحثها على زيادته.
ومن سوء الحظ أنها فى السنوات الأخيرة من عمرها توقفت عن الرسم لأن أعصاب يديها لحقها التهاب جمّد أصابعها معظم الوقت، وسواء جاءت تحية إلى مكتبى أو ذهبت إلى مرسمها، فقد كانت فى كل الأحوال نفس المخلوقة المندهشة بكل شىء، والمطمئنة الخائفة فى نفس واحد، والمتوجسة بالمفاجآت حتى حين لا تكون هناك مفاجأة، وكنت أرحب بها حين ألقاها بوصفها الفنانة الحائرة بين القطط المقيمة والعصافير.








