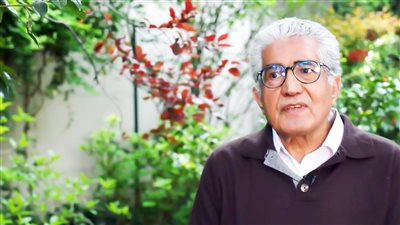التقاء العيب بالحرام.. قراءة فى تمثلات المرأة بين الدين والعرف

- تحوّل المكانة.. كيف هبطت المرأة من شمس مصر القديمة إلى ظل الثقافة الشعبية والفتاوى الذكورية؟
هناك دعابة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى منذ فترة طويلة، تقول: «لو لم تكن هناك امرأة، فعن مَن سيتحدث أهل الدين؟».. تبدو الجملة للوهلة الأولى ساخرة، لكنها فى العمق تحمل تأملًا مريرًا فى مركزية المرأة داخل الخطاب الدينى والاجتماعى معًا. المرأة هى الهاجس الدائم فى كثير من الأحاديث والفتاوى والنقاشات العامة، وكأن وجودها فى ذاته قضية تحتاج إلى ضبط أو تبرير أو مراقبة، من جسدها إلى صوتها، ومن ملابسها إلى دورها، يتحول كل ما يتصل بها إلى ساحة سجال لا تهدأ. لكن خلف هذا الانشغال المفرط تتخفى بنية فكرية وثقافية أعمق من مجرد اختلاف حول الستر أو الاختلاط أو العمل.
فى الجاهلية وُئدت البنات تحت الرمال، وفى الحاضر وُئدن وهن على قيد الحياة. لم تُلقَ عليهن الحجارة والتراب هذه المرة، بل أُحكمت حول أرواحهن قيود أشد قسوة وعنف، من فتاوى تُنطق باسم الله، وتقاليد تُبارَك باسم الحياء، وخطابات دينية تُحيل أنوثتهن إلى خطيئةٍ مؤبدة.
تلك البنية لم تتشكل صدفة، بل صنعها التاريخ حين اختلط الخطاب الدينى بالمعتقد الشعبى، حتى لم يعد من السهل التمييز بين ما هو وحى سماوى وما هو عرف أرضى، بين ما نُسب إلى الإله وما نطقت به ألسنة الرجال. والسؤال الأعمق يبقى: هل ما نعده «من الدين» هو فعلًا ما أراده الإله، أم أنه نتاج قراءات بشرية متحيزة صاغتها العصور لمصلحة الذكور؟
هنا تبرز إشكالية أخطر، تتعلق بما يمكن تسميته بـ«الدواخل على العقيدة»، أى تلك الأفكار التى تتسلل باسم الدين لتخدم أغراضًا اجتماعية أو سلطوية. فكل من أراد تمرير فكرة أو تثبيت سلطة، لم يجد وسيلة أنجح وأكثر تأثيرًا من أن يُسبغ عليها قداسة ويلصقها بالدين.

«هى» سبب لكل خطيئة
أصبحت المرأة فى مجتمعاتنا مرآةً تعكس الصراعات حول السلطة والهوية والدين، كل خطاب يحاول إثبات ذاته يبدأ منها أو ينتهى عندها، وكأنها الميدان الأسهل لتجريب الأفكار وتطبيق القواعد.
ومع مرور الزمن، لم تعد المشكلة فى النصوص وحدها، بل فى الطريقة التى ورثنا بها فهمها، وفى الأصوات التى منحت نفسها حق التفسير والوصاية. هكذا تراكمت حول المرأة طبقات من المعانى المتناقضة: فهى فى آنٍ واحد «عِرض يجب حفظه» و«كائن ناقص يحتاج إلى تقويم مستمر»، «باب للجنة» و«سبب للخطيئة». هى الغاوية، اللعوب، صاحبة الكيد العظيم كما يُقال، تُلاحقها الصفات ذاتها منذ مئات السنين، وكأنها وُلدت لتؤدى دور الخطيئة فى مسرح الرجال، وكأن هؤلاء لا يملكون عقلًا ولا إرادةً حرة. وكأن الأسطورة لم تُصنع عنها بقدر ما صُنعت لتُبرِّئهم منها، لتُخفى وراء دهائها المزعوم عجزهم عن مواجهة رغباتهم ومسئولياتهم، وتغلف عجزهم بورقٍ من القداسة والإنكار.
وفى خضم هذا التنازع، تضيع الحقيقة البسيطة: أن ما نسميه «طبيعة المرأة» ليس إلا صورة رسمها الخطاب، لا حقيقة لماهيتها. ومن هنا تكتسب قراءة كتاب «المرأة بين الخطاب الدينى والمعتقد الشعبى»، الصادر عن دار هن، للكاتب يسرى مصطفى، أهميتها الخاصة، إذ يفكك التداخل بين النص والعادة، أى ما نُسب إلى الدين وما التصق به من أثر التاريخ. ويحاول فهم هذا التداخل الذى شكّل نظرة المجتمع للمرأة عبر القرون.

الخضوع فضيلة أنثوية
يمضى الكاتب متتبعًا أثر تلك الأصوات التى صاغت صورة المرأة فى الوعى الجمعى، ويسائل الخطاب: كيف تتحول الفتوى إلى أداة للضبط الاجتماعى؟ وكيف ترتدى الأسطورة ثوب الورع لتبدو كحقيقة مقدسة؟
الكتاب يفتح بابًا لفهم العلاقة الملتبسة بين القداسة والموروث، ولا يتعامل مع القضية من منظور فقهى أو نسوى، بل يسعى إلى تحليل الخطابات تحليلًا منطقيًا وموضوعيًا، فيفصل بين الخطاب الدينى الذى يتم التعبير عنه من خلال الآراء الفقهية، والخطاب الثقافى الشعبى الذى يتم التعبير عنه من خلال الأمثال والمأثورات الشعبية وأثره على تشكيل الرؤى والتصورات بشأن مكانة المرأة وحقوقها الإنسانية.
يتناول المؤلف عددًا من المفاهيم الأساسية، مستعرضًا نماذج من الآراء الفقهية والمأثورات فى ثلاث قضايا جوهرية: القوامة، وتأديب الزوجة، وتعدد الزوجات.
لا يُقدم الكتاب إجابات جاهزة بقدر ما يفتح مساحة للتأمل فى كيفية تحول النصوص والتأويلات إلى أدواتٍ تحافظ على استمرار الهيمنة، وكيف تُدعم الثقافة الشعبية تلك الهيمنة بأمثال وحكايات تكرس الطاعة والصمت والخضوع بوصفها فضائل أنثوية.
عند هذه النقطة، يتوقف يسرى مصطفى أمام واحدة من أكثر المفاهيم إثارة للجدل: وهى القوامة، الكلمة التى حملت عبر الزمن ما يفوق معناها اللغوى، لتصبح مِعيارًا لترتيب البشر على سلم غير مرئى من السلطة والوصاية.

القوامة.. المرأة الأدنى مكانة
يقول الكاتب: «يعد مفهوم القوامة من المفاهيم المثيرة للجدل من منظور النوع الاجتماعى، لأنه يتصل مباشرة بالتراتبية الجندرية التى تعد محور إشكالية المساواة بين الرجال والنساء.. فى واقع الأمر إن وضع المرأة فى مكانة أدنى من الرجل هو أمر سائد فى الخطابات الدينية والشعبية».
فى قراءة يسرى مصطفى، لا تقتصر القوامة على معناها اللغوى أو الفقهى، بل تتجاوزهما لتصبح منظومة فكرية كاملة تنعكس فى بنية الخطاب الدينى والاجتماعى معًا. فعلى مستوى الخطابات الدينية الراهنة، تتعدد الأصوات والاتجاهات، بين خطاب تقليدى محافظ يرى فى ثبات المعانى ضمانًا للإيمان، وخطاب تجديدى يحاول المواءمة بين التحولات العصرية وما يُعرف بـ«الثوابت». غير أن منطق «علوّ الرجال على النساء» ظل ثابتًا فى الحالتين، وإن اختلفت اللغة أو تلطّفت المفردات. فحين يستند الخطاب الدينى إلى الطبيعة لتبرير الفارق - باعتبار المرأة أضعف جسمانيًا وربما عقليًا- ثم يضيف إلى ذلك بُعدًا اجتماعيًا يرى فى الرجل المُنفق وصاحب القرار، فإنه يعيد إنتاج الهرم نفسه لكن بوجوه مختلفة.
تمتد القوامة، كما يرى الكاتب، من الأسرة إلى المجال العام، وكأنها قاعدة خفية تحكم العلاقات الإنسانية جميعها، فحتى حين يُقال إن البيت هو «المكان الطبيعى للنساء»، تظل السلطة فيه للرجال. أما الفضاء العام، فكان ولا يزال يُعد امتيازًا ذكوريًا لا يقبل النقاش.
ومع تغير موازين القوى فى العصر الحديث، وتقدّم النساء فى كل مناحى الحياة خاصة فى مجالات التعليم والعمل والوعى بالحقوق، لم يتراجع الخطاب الدينى التقليدى عن موقفه، بل ازدادت نبرته الدفاعية والتوكيدية. وبدلًا من أن يُسائل مفهوم القوامة فى ضوء التحولات الاجتماعية، لجأ إلى تبريره، بل وتقديمه بوصفه رعاية لا سلطة، وتكليفًا لا تشريفًا، بينما الواقع يقول غير ذلك.
وفى هذا، يقول الكاتب: «حتى وإن تغيرت اللغة وطريقة عرض الأسانيد فإن الاتجاه واحد وهو مسئولية الرجل عن القيادة والإنفاق، واختلاف النساء طبيعيًا باعتبار أن الضعف متأصل فيهن... إلا أن مثل هذه الحجج لا تأخذ فى الاعتبار المسئوليات التى باتت تقع على عاتق كثير من النساء من أجل الإنفاق على الأسرة. فضلًا عن تجاهل قيمة ما يسمى بالعمل المنزلى غير المنظور الذى تباشره الغالبية العظمى من النساء».
ويضيف: «تجدر الإشارة إلى أن أحد المفاهيم الأساسية التى يستعين بها الخطاب لإضفاء مشروعية على التفاوت بين الذكور والإناث، هو مفهوم الفطرة، أى الطبيعة التى فطر الله عليها الذكر والأنثى، بالتالى فإن تغيير أدوار الرجال والنساء يعد انحرافًا عن الطبيعة التى أرادها الله للبشر. وفى الواقع أن مفهوم الفطرة يبدو شديد الالتباس وغير محدد، فهو يستخدم بشكل فضفاض بحيث يتضمن الطبيعة والثقافة معًا».

بين المعبد والمطبخ: رحلة انحدار من القداسة إلى التبعية
إذا كان الخطاب الدينى قد رسم ملامح المرأة محددًا ما يجوز وما لا يجوز، فإن الموروث الشعبى كان الوجه الآخر للعملة ذاتها. فحين تتراجع اللغة الفقهية إلى الظل، يتقدّم الحكى الشعبى والأمثال والأغانى لتكرر المعنى نفسه، ولكن بلُغة أقرب إلى القلب وأكثر رسوخًا فى الذاكرة.
وهنا يُشير يسرى مصطفى إلى أهمية كتابات أحمد رشدى صالح الذى كان من أوائل من قرأوا الأدب الشعبى بوصفه مرآةً للواقع الاجتماعى، لا مجرد تسلية أو إرث فنى. ففى كتاب صادر له مطلع السبعينيات، قدم قراءة صريحة لوضع النساء فى هذا الأدب، فرأى أنه يصور المرأة دائمًا فى مرتبة أدنى. كذلك رأى أن الثقافة الشعبية تنظر إلى المرأة بوصفها عورة، وأن من أشد الشتائم أن يُنادى رجل باسم أمه.
ويستطرد موضحًا أن هذه النظرة لم تكن أبدية، ففى بدايات التاريخ المصرى، وحسب النقوش الفرعونية، كانت المرأة شريكة للرجل فى المكانة والحق، بل قريبة من المساواة. بل كانت ملكة تحكم مصر مثل حتشبسوت وكليوباترا. غير أن التاريخ، كما يقول، لم يكن رحيمًا بها، إذ ما لبثت أن فقدت موقعها وأصبحت «عبدًا وتابعًا»، ولم تنجُ من تلك التراتبية حتى اليوم، رغم ما حملته الديانات من تعاليم منصفة.

العنف الحلال
إذا كانت القوامة قد رسّخت تراتبية العلاقة بين الرجل والمرأة، فإن نتائجها لم تقتصر على كونها أفكار فحسب، بل امتدت إلى الممارسة اليومية لتتحول فى كثير من الأحيان إلى أداة لتبرير العنف ضد النساء تحت مسمى «التأديب» أو «الوصاية الشرعية». فالموروث الثقافى، حين يضع الرجل فى موقع القائد أو الحاكم داخل الأسرة، يمنحه -ضمنًا- سلطة فرض الانضباط، ويمنح المرأة موقع التابع الذى يُحاسَب ويُؤدَّب. على سبيل المثال، يتردّد فى الذاكرة الشعبية مثل يقول: «اكسر للبنت (ضلع) يطلع لها ٢٤»، ليس كدعابة عابرة، بل كصيغة تُستخدم لتبرير التأديب البدنى داخل الأسرة، باعتبار العنف ضرورة للتربية وليس انتهاكًا.
وهكذا تتقاطع القوامة كفكرة مع العنف كممارسة، فيستمد كلاهما شرعيته من منظومة واحدة تمزج بين التقاليد والتأويلات الدينية والعرف الاجتماعى، لتجعل من العنف ضد النساء سلوكًا مقبولًا أو مبررًا وحلالًا فى نظر كثيرين، رغم ما يحمله من انتهاك للكرامة الإنسانية.

السكين فى يد تصلى
ولعل الأرقام تؤكد أن العنف ضد النساء لم يعد مجرد حالات فردية متفرقة، بل هو منهج متجذر فى البناء الاجتماعى والخطاب الثقافى الذى يوجه سلوك الأفراد والمجتمع. فالتقارير الرسمية تشير إلى أن نسبة كبيرة من النساء فى مصر تعرضن لشكل من أشكال العنف على يد شريك أو أحد أفراد الأسرة خلال حياتهن.
وتؤكد الإحصاءات أن نحو ثمانية ملايين امرأة وفتاة فى مصر يتعرضن سنويًا لأشكال مختلفة من العنف، يقع أغلبها داخل الأسرة. ويُعد العنف النفسى هو الأكثر شيوعًا بنسبة ٥١٪، يليه الإهمال بنسبة ٢٧٪، ثم العنف الجسدى بنسبة ١٢٪، فيما يشكل الأزواج الفاعل الرئيسى فى ٧٣٪ من هذه الحالات.
وحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام ٢٠٢١، فإن ٣١٪ من الزوجات المصريات تعرضن لشكل من أشكال العنف «الجسدى أو النفسى أو الجنسى» من أزواجهن، فيما تشير تقديرات وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن ٢٥٪ من النساء تعرضن لعنف جسدى، و٢٢٪ لعنف نفسى، و٦٪ لعنف جنسى فى العام نفسه.
ورغم الجهود التشريعية والمؤسسية التى تبذلها الدولة لحماية النساء، فإن العنف لا يزال مستمرًا بل يزداد شدة مع الوقت. فحسب تقرير مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات - النصف الأول من عام ٢٠٢٥ الصادر عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، تم توثيق ٤٩٥ جريمة عنف خلال ستة أشهر فقط، من بينها ١٥٦ جريمة قتل، غالبيتها على يد أزواج أو أفراد من الأسرة. كما رُصدت ١٢٢ واقعة تحرش جنسى، و١٩ حالة ابتزاز رقمى، إلى جانب ٢٢ حالة انتحار مرتبطة بالعنف الأسرى، و٨ محاولات انتحار أخرى.
وفى عام ٢٠٢٤ وحده، تم رصد ٢٦١ جريمة قتل نساء، مقارنة بـ١٤٠ جريمة فقط فى عام ٢٠٢٣، وهو ما يعكس تصاعدًا مقلقًا فى وتيرة العنف ضد النساء.
وربما تبدو هذه الأرقام، للوهلة الأولى، محدودة أو غير كارثية إذا ما قورنت بعدد السكان، لكنها فى الحقيقة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الواقع، إذ تمثل الحالات الموثّقة فقط. فالكثير من النساء لا يبلّغن عن العنف الذى يتعرضن له، إما خوفًا من الوصم الاجتماعى، أو حفاظًا على استقرار الأسرة الموهوم، أو لغياب الثقة فى آليات الحماية. لذلك فإن ما يُرصد رسميًا أو حقوقيًا لا يكشف سوى قمة جبل الجليد فى مشهد العنف الممنهج ضد النساء.
وهم تحرير المرأة
رغم كل خطابات التجديد التى تتناول فكرة تمكين النساء، يظل الواقع أكثر عنادًا وقسوة، حيث تُعاد صياغة السيطرة الذكورية فى صور أكثر نعومة وأقل صخبًا. ومن هنا، يصبح «تعدد الزوجات» أحد تجليات العنف الذى يختبئ وراء رداء «الحق الشرعى»، بينما يكرّس فكرة أن رغبات الرجل هى المعيار الأسمى الذى يُعاد ترتيب الحياة حوله.
وبينما يتم تقديم تاريخ «تحرير المرأة» بوصفه إنجازًا مكتملًا، تكشف القراءة المتأنية أنه لا يزال وعدًا مؤجّلًا، ما دامت الأفكار التى تُبرّر القهر والعنف قائمة. فالمشكلة الحقيقية تكمن فى الخطابات العميقة التى صاغت وعينا الجمعى من الفتاوى إلى الأغنية الشعبية.
وفى هذا المعنى، يقدم كتاب «المرأة بين الخطاب الدينى والمعتقد الشعبى» شهادة فكرية جريئة، تضع إصبعها على الجرح الأقدم فى تاريخنا: كيف تحوّل الإيمان إلى سلطة، والسلطة إلى موروث، والموروث إلى قيدٍ يُحكم حول عنق النساء باسم الفضيلة.