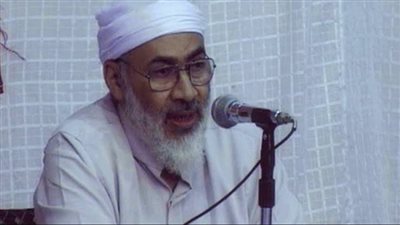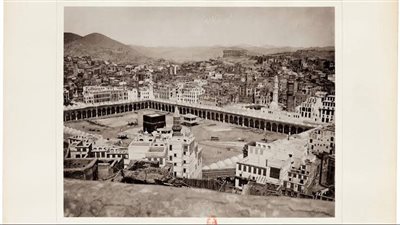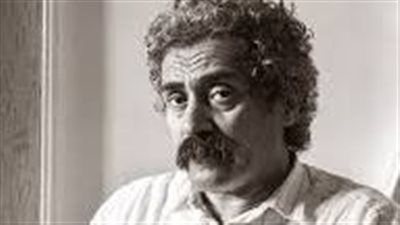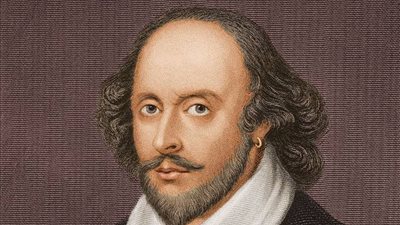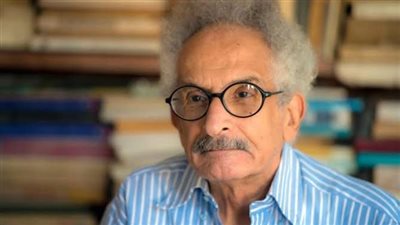هوس الاكتناز.. كيف تؤثر «الكراكيب» على حياتنا؟

- كتابا «اقتناء الفوضى» و«عبودية الكراكيب» يتصديان لـ«المشكلة المزمنة»
- الكراكيب تتحول إلى عبء نفسى وعائق للطاقة الإيجابية
فى كل بيت مصرى تقريبًا، هناك ركنٌ يمتلئ بأشياء لا نستخدمها. خزانة ملابس تضيق عن آخرها بقطعٍ لم نرتدها منذ سنوات، أدراج مطبخ مزدحمة بأدوات مكسورة نظن أننا سنعيد تدويرها يومًا ما، علب فارغة «يمكن تنفع»، أو كراتين تحت السرير محشوة بدفاتر قديمة وصور باهتة، والكثير من الأكياس البلاستيكية.
نسميها ببساطة «كراكيب»، لكنها فى الواقع أكثر من مجرد فوضى؛ الأجيال يتفاوتون فى نظرتهم إليها: الأهل الذين يصرون على أن «كل حاجة ليها وقتها» فيحتفظون بالأشياء كرصيد للمستقبل، بينما يسعى الجيل الأصغر إلى التخلص منها بحثًا عن الخفة والحرية.
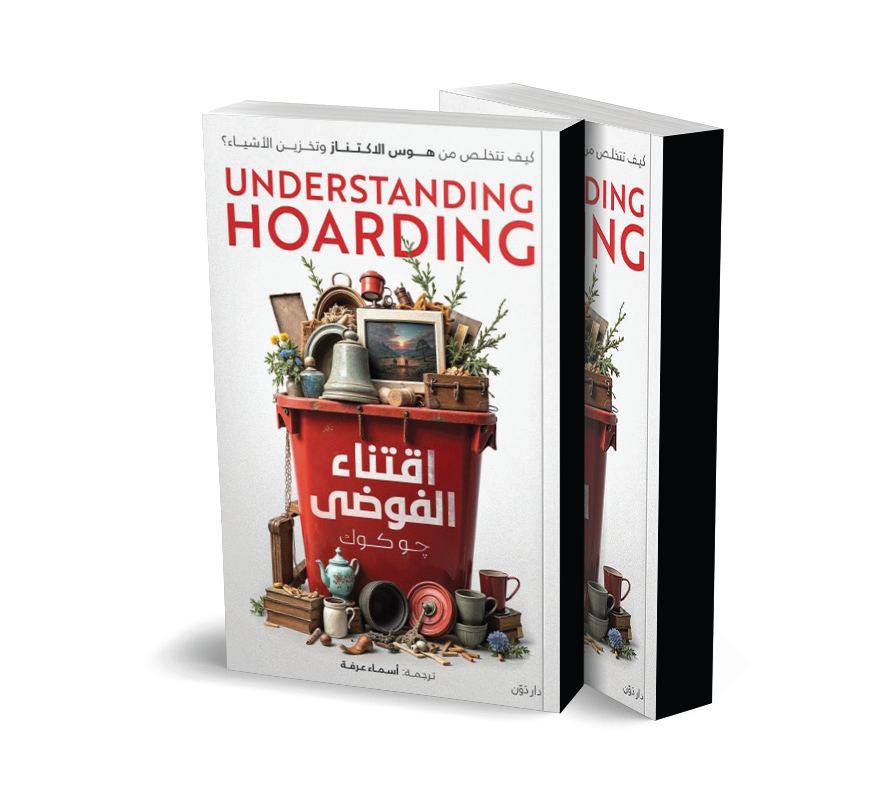
ذكرت لى طبيبتى النفسية قبلًا أن الكراكيب هى انعكاس لطريقتنا فى مواجهة الخسارة والخوف من النقصان، أو محاولة للتشبث بالذكريات، وربما تعويض لشعور خفى بعدم الأمان. حينها ظهر سؤال جوهرى: هل نحن نمتلك الأشياء، أم أن الأشياء هى التى تمتلكنا؟
هذا السؤال تحديدًا تتصدى له كاتبتان مختلفتان فى المنظور، متقاطعتان فى الجوهر: جو كوك فى كتابها «اقتناء الفوضى»، وكارين كينجستون فى كتابها «عبودية الكراكيب». الكتابان يكشفان ثقل التراكمات التى تعرقل حياتنا. من خلالهما، يمكن أن نعيد التفكير فى علاقتنا بما نكدسه من حولنا، وما ندفنه فى دواخلنا.
يذكر كتاب «اقتناء الفوضى.. كيف تتخلص من هوس الاكتناز وتخزين الأشياء؟»، فى نسخته العربية الصادرة حديثًا عن دار دون بترجمة أسماء عرفة، أنه فى عام ٢٠١٣ تم الاعتراف بالاكتناز باعتباره اضطرابًا مستقلًا فى التصنيف الدولى للأمراض الصادر عن منظمة الصحة العالمية. ويُشخَّص هذا الاضطراب بوجود خمسة معايير أساسية لدى الفرد، هى: الصعوبة المستمرة فى التخلص من الممتلكات أو الانفصال عنها بغضّ النظر عن قيمتها، التمسك بالعناصر والشعور بالضيق الشديد عند محاولة التخلص منها، تراكم الأشياء بشكل يعيق استخدام مساحات المعيشة، أن يؤدى الاكتناز إلى تراجع ملحوظ فى الأداء المهنى أو الاجتماعى أو النفسى، وأحيانًا يرتبط بسلوكيات أو اضطرابات أخرى مثل الوسواس القهرى.
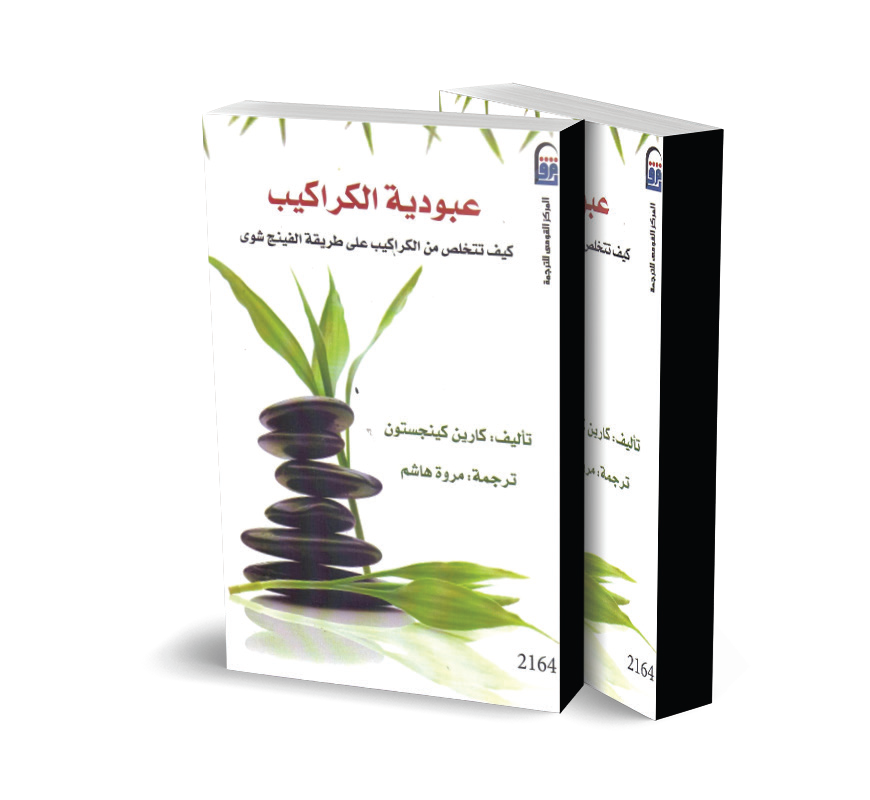
اكتناز رقمى
يشير الكتاب إلى شكل جديد من أشكال الاكتناز غير المألوف، وهو الاكتناز الرقمى. ويتمثل فى الاحتفاظ بكميات هائلة من الملفات الرقمية مثل المعلومات والصور ومستندات الـPDF. هذا السلوك يؤدى إلى تباطؤ الأجهزة المثقلة بالبيانات، وأحيانًا عجزها عن العمل بكفاءة. وللتغلب على ذلك، قد يلجأ البعض إلى شراء المزيد من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التخزين لاستيعاب أكبر قدر ممكن من البيانات. ولا يقتصر الأمر على أجهزة الكمبيوتر فقط، بل يشمل الهواتف المحمولة أيضًا مع تزايد التطبيقات الخاصة بالخرائط والمطاعم والخدمات المصرفية والأنظمة الغذائية والرياضية وغيرها. وهو ما يستهلك نفس القدر من الوقت والمال والموارد مثله مثل تخزين الأشياء المادية.
فى حياتنا اليومية، يظهر الاكتناز الرقمى فى صور أكثر بساطة: هواتف ممتلئة بآلاف صور الواتساب ولقطات الشاشة والميمز المكررة، أو رسائل بريد إلكترونى لم نفتحها منذ سنوات، أو مجلدات مزدحمة بملفات لا نحتاج إليها. ورغم معرفتنا أن معظمها بلا فائدة، نتردد فى الحذف وكأننا نخشى فقدان شىء مهم.
بهذا المعنى، يصبح الاكتناز الرقمى امتدادًا للكراكيب المادية: أعباء غير مرئية، لكنها تثقل عقولنا وأجهزتنا، وتستهلك المزيد من الوقت والمال والموارد.
الاكتناز القهرى
توضح جو كوك فى كتابها أن الأشخاص المصابين بالاكتناز يجدون صعوبة فى منع أنفسهم من الحصول على الأشياء. فهم يميلون إلى شراء وجمع أشياء تفوق احتياجاتهم الفعلية، ابتداءً من الصحف والعينات المجانية فى المتاجر وصولًا إلى أكياس المنتجات الفارغة. هذا السلوك يمنحهم شعورًا بالسيطرة والأمان، كدرع نفسى يحميهم، أو كعزلة تشبه الاحتماء داخل كهف. وقد أظهرت الدراسات أن الأفراد المصابين بالاكتناز القهرى يسجلون مستويات أعلى فى شعورهم بالوحدة والعزلة الاجتماعية مقارنة بغيرهم من الأصحاء.
خصصت الكاتبة فصلًا لتقديم بعض النصائح والتقنيات التى أثبتت فاعليتها مع الأشخاص الذين يعانون الاكتناز القهرى، وأفردت الفصل التالى للأقارب والأصدقاء تحت عنوان «كيف تساعد شخصًا يعانى الاكتناز؟».
فعلى سبيل المثال، طرحت قاعدة «التعامل مع الأمر لمرة واحدة»، وهى فعّالة فى التخلص من تكدس البريد الإلكترونى: اتخاذ القرار فى شأن الرسالة فورًا، بدلًا من تأجيله. هل ينبغى التخلص منها؟ هل أحتاج إلى الرد عليها؟ هكذا يصبح البريد أقل عبئًا.
ومن بين القواعد الأخرى لتخفيف الفوضى: تبسيط عملية الإزالة من خلال تقسيم المهمة، كفرز منطقة واحدة فقط من الغرفة، أو التركيز على فئة معينة من الأشياء مثل الملابس أو الأوراق أو الكتب. فالفوضى فى جوهرها هى تأجيل القرارات، لذا يساعد تبسيطها وتجزئتها على جعل عملية التخلص أقل صعوبة.
أما النقطة الأهم من وجهة نظرى فى هذا الكتاب فهى تخصيص مساحة لتقديم الدعم والنصح للشخص الذى يعانى من الاكتناز القهرى. إذ تنبه الكاتبة إلى ضرورة تجنب إصدار الأحكام عليه أو استخدام كلمات تقلل من قيمة ممتلكاته، حتى لو بدت بلا قيمة فعلية؛ فهى تحمل معنًى خاصًا بالنسبة له. كما توصى بالابتعاد عن المجادلة أو محاولات الإقناع المباشر بالتخلص من الأشياء، أو لمسها دون إذنه. وأخيرًا، إن كنت تريد مساعدة شخص يعانى الاكتناز، فعليك أن تتحلى بالصبر ولا تتصادم معه.
أمل مزمن
توضح الكاتبة ببساطة ما يدور فى ذهن الشخص الذى يكدّس الكراكيب، وتصف المشاعر المتناقضة التى يعيشها؛ فهو ممزق بين رغبتين متعارضتين: التغيير وعدم التغيير. فمثلًا، قد يتمنى الحصول على مساحة أوسع فى غرفته، لكنه فى الوقت نفسه يتشبث بكومة من المجلات القديمة، ربما لأن بها صورًا لمكان يحلم بزيارته. هذا التردد المستمر تصفه الكاتبة بـ«الأمل المزمن»، وهو فى الحقيقة عائق أساسى أمام التخلص من الفوضى.
يمكن اعتبار الأمل المزمن حالة تتجاوز مجرد التعلّق بالأشياء، فهو يشبه خيطًا واهيًا يربط الشخص بين ما مضى وما قد يأتى، لكنه فى الحقيقة يقيّده فى مكانه. يتشبث بالمجلات القديمة أو الأكياس المتناثرة وكأنها جواز سفر مؤجل إلى مستقبل أفضل أو ذكرى لا يريد أن يدفنها. الأمل هنا لا يعمل كقوة دافعة للتغيير، بل كعذر جميل للاستمرار فى الفوضى، وكأن الكراكيب تتحول إلى وعد صامت بأن الغد قد يمنحها معنى جديدًا، بينما الحقيقة أن هذا الغد لا يأتى أبدًا.
طاقة عالقة بين الجدران
بعد أن أضاءت جو كوك فى كتابها «اقتناء الفوضى» على البُعد النفسى والوجدانى للاكتناز القهرى، وكشفت كيف يعيش المكتنز فى دائرة من الصراع بين الرغبة فى التحرر والخوف من فقدان ما يمنحه شعورًا زائفًا بالأمان، يأتى كتاب «عبودية الكراكيب.. كيف تتخلص من الكراكيب على طريقة الفينج شوى» ليخطو بنا خطوة أعمق من المستوى الفردى إلى البعد الرمزى والوجودى للفوضى.
الكتاب الأول يضعنا وجهًا لوجه أمام التجربة الفردية بكل تناقضاتها، أما الثانى، الصادر عن المركز القومى للترجمة عام ٢٠١٤ من ترجمة وتقديم مروة هاشم، فيوسّع الإطار ليُرينا أن الكراكيب ليست مجرد أشياء تتكدس فى زوايا البيوت أو على رفوف الغرف، بل هى منظومة كاملة من العلاقات التى نصنعها مع ممتلكاتنا. تتحول هنا إلى استعارة عن قيود خفية تحاصرنا: قيود الماضى الذى نرفض أن نغادره، وقيود المستقبل الذى نخشى أن نواجهه، وحتى قيود الاستهلاك الذى يفرض علينا وهم الحاجة إلى المزيد.
وهكذا يبدو وكأن الكتابين يتكاملان؛ الأول يشرح كيف يتشكل جدار الكراكيب داخل الذات، والثانى يحاول أن يفكك سلطة هذا الجدار على وعينا، ليعيد تعريف علاقتنا بما نملك، وما نترك، وما نخاف أن نخسره. ومن هنا لا يكتفى كتاب «عبودية الكراكيب» بتحليل علاقتنا بالأشياء، بل يقترح أيضًا كيف يمكن أن يصبح التخلص من الفوضى مدخلًا لتجديد طاقة المكان والحياة معًا، على طريقة الفينج شوى «وهى فلسفة صينية قديمة تفيد بأن ترتيب البيت وتنظيمه يحرران الطاقة العالقة ويعيدان الانسجام للذات والمكان».
منزل مزدحم
تطرح كارين كينجستون فكرة أساسية من خلال كتابها وهى علاقتنا الوثيقة بالمبانى التى نعيش فيها، وبتأثير طاقتنا عليها وتأثيرها علينا. وترى أن العلاقة بين الكراكيب والطاقة علاقة متبادلة؛ فحين تتكدس الكراكيب تتوقف حركة الطاقة فى المكان، وحينما تركد الطاقة تبدأ الفوضى فى التضاعف، فيدخل البيت فى دائرة مغلقة يصعب كسرها. موضحة أن التكدس يبدأ عادة كعَرَض جانبى لحياتنا، لكنه سرعان ما يتحول إلى مشكلة بحد ذاتها، لأن كل ركن مزدحم يضيف المزيد من الثقل والجمود.
وكسر هذه الدائرة لا يتحقق إلا عبر إزالة الحواجز التى تعطل تدفق الطاقة بانسجام داخل محيطنا، وهو ما ينعكس تلقائيًا على حياتنا، إذ يمنحنا شعورًا بالتوازن، ويخلق مساحة لفرص وتجارب جديدة. وتشير كينجستون إلى أن معظم الناس يستخفون بتأثير الكراكيب عليهم، فيظنون أنها مجرد أغراض سيحتاجونها فيما بعد أو حتى غير مؤثرة، بينما فى الحقيقة هى تستنزف طاقتهم من دون أن يشعروا.
وأفردت كارين كينجستون فصلًا كاملًا لشرح تأثير الكراكيب على حياة الأفراد، مبينة أنها لا تقتصر على تشويه شكل المكان فحسب، بل تمتد إلى حياتنا النفسية والجسدية. فالاكتناز قد يسبب شعورًا دائمًا بالتعب والكسل، ويُبقينا عالقين فى الماضى، ويعطل قدرتنا على المضى قدمًا. كما قد يثير الخجل والإحباط، ويقلل من متعتنا بالحياة، فضلًا عن ما يسببه من أمراض تنفسية أو جلدية، وتكاليف مادية إضافية، إلى جانب مضاعفة أعباء التنظيف، وجعل الشخص أكثر فوضوية.
إطلاق سراح الأشياء
ولفتت «كارين» إلى أن التخلص من الكراكيب ليس مجرد التخلى عن المقتنيات، بل فعل أعمق أشبه بإطلاق سراح الأشياء. فالكراكيب لن تغادرنا إلا حين نتحرر من الخوف الذى جعلنا نتمسك بها من الأساس؛ عندها يصبح الفقد مساحة للانفتاح، لا للنقصان.
وتضيف: إن تخلصنا من الكراكيب يرتبط بألا نتعلق بالأشياء، فنصبح أكثر حرية، ونستمتع بما يأتى إلينا فى الحياة وما نقتنيه، مستخدمين إياه الاستخدام الأمثل. وعندما يحين الوقت، نتخلى عنه دون تردد. فنحن لسنا سوى حُرّاس مؤقتين للأشياء أثناء مرورها فى حياتنا. فكل المقتنيات المادية ليست سوى طاقة فى حالة انتقال؛ فقد نعتقد أننا نملك منزلًا أو سيارة، لكن فى الحقيقة لا نملك سوى أجسادنا، أما ما عداها فهى أشياء تقرضنا إياها الطبيعة، وما إن ينتهى وقتها لدينا حتى نعيدها إليها، لتعيد تدويرها وتجعلها تظهر من جديد فى أشكال مختلفة من دوننا.
وتؤكد كارين أن الآثار الإيجابية الناتجة عن التخلص من الكراكيب تستحق عناء السعى إليها؛ فلا يمكن أن يجتمع الحب والخوف فى مكان واحد. فكل ما نحتفظ به بدافع الخوف يحجب عنا فرصة دخول المزيد من الحب إلى حياتنا. وعندما نتخلص من ذلك الخوف ينفتح الطريق ليتدفق المزيد من الحب.
كراكيب الوقت
يشير الكتاب أيضًا إلى ما يمكن تسميته بـ«كراكيب الوقت»؛ تلك الأنشطة والتفاصيل الصغيرة التى تبدو عابرة لكنها تلتهم ساعاتنا دون أن نشعر. مثل الانشغال المفرط بوسائل التواصل، أو الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية الطويلة، المماطلة، أو الانغماس فى مهام لا تضيف لقيمتنا ولا تحقق لنا هدفًا حقيقيًا.
هذه الكراكيب قد لا تشغل حيّزًا ماديًا فى منازلنا، لكنها تعوقنا عن عيش لحظاتنا بصفاء وتوازن، وتخلق تضاربًا فى الطاقة يؤدى إلى شعور دائم بالإرهاق. والتخلص منها لا يقتصر على تنظيم جدولنا اليومى، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة توجيه وعينا نحو ما يستحق وقتنا فعلًا، لنستثمر طاقتنا فيما يمنحنا نموًا ومعنى.
وتقترح كارين كينجستون للتخلص من «كراكيب الوقت» أن نحدد أولوياتنا بوضوح، كى نعرف متى نقول «نعم» ومتى نقول «لا»، فالحياة فى جوهرها سلسلة من الاختيارات التى نصنعها كل يوم، والتى تحدد إن كنا سنستفيد من وقتنا أو نهدره.
حرية وخفة
فى النهاية، يمكننا القول إن الفوضى ليست مجرد أكوام من الأغراض التى تملأ منازلنا، بل هى انعكاس مباشر لحياتنا الداخلية، لعلاقاتنا، ولطريقتنا فى التعامل مع الزمن والطاقة والحياة ككل. فكل غرض غير مستخدم، وكل فكرة معلّقة، وكل وقت مهدور، إنما يشكّل عبئًا يقيّد حريتنا ويستهلك طاقتنا دون أن ندرك.
والتخلّص من الكراكيب- المادية والذهنية والعاطفية والروحية- هو دعوة للتحرّر من الخوف الذى يجعلنا نتشبّث بما لا يخدمنا، وفتح المجال أمام الفرص الجديدة. فالفقد هنا لا يعنى نقصانًا، بل مساحة للامتلاء بما هو أنفع وأجمل.
مواجهة الكراكيب ليست مهمة عابرة، بل رحلة وعى نحو حياة أكثر خفة ووضوحًا، حيث نصبح أحرارًا بما يكفى لنعطى الأشياء معناها، ثم نتركها ترحل حين يحين وقتها، ونمضى إلى الأمام بتوازن. ومن هنا تتقاطع هذه الفكرة مع قوانين الفينج شوى، التى تعزز من تدفق الطاقة الإيجابية فى المنزل من خلال التخلص من الفوضى، تحسين حركة الهواء والضوء الطبيعى، موازنة العناصر الخمسة «الماء، الخشب، النار، المعدن، الأرض»، واختيار الألوان وترتيب الأثاث بشكل استراتيجى. فتنظيم المكان بهذه الطريقة لا يعيد الصفاء للمكان فحسب، بل ينعكس مباشرة على حياتنا الداخلية، فيحرر طاقتنا ويخلق بيئة تسمح بقدوم الحب والفرص الجديدة.