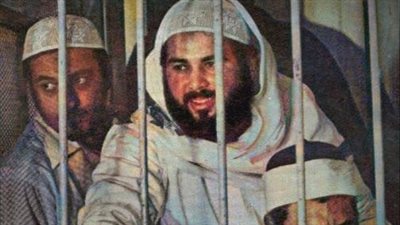صمت الرب الطويل.. الفصل الأول من رواية مصطفى أبوحسين الأولى والأخيرة
- لم يعُد الاضطهاد باسم الآلهة بل باسم الرب
- لم أستطع أن أدفن الصليب مع ابنى كما يفعل الناس.. بل رغبت فى أن أرفعه إلى السماء
- لم أطلب عدلًا يا رب طلبت فقط أن تتركنى أحبك على طريقتى
- لسنا نتمرد.. نحن فقط نفتح نافذة لنعيش.. بعيدًا عن الذل الذى صار طقسًا
من أنطينوس إلى أبوقسطور
فى حضن الصعيد الجنوبى لمصر على الضفة الشرقية لنهر النيل من بين تعرجاته، حيث يختلط عبق الطمى بوجع الأزمنة الغابرة، وُلدت أنصنا لا كمدينة فحسب، بل كصرخة فى وجه النسيان، كمأساةٍ تجلّت فى حجرٍ وعمودٍ وقبر.

فى عام ١٣٠ بعد الميلاد، لم يكن الإمبراطور الرومانى هادريان مجرد قيصر، بل كان رجلًا مكسورًا على عتبة الفَقْد، رأى العالم يتداعى حين ابتلعت مياه النيل وجه أنطينوس، الفتى الذى كانت عينه مرآةً لهشاشة الإنسان وسر افتتانه بالجمال الهَاشّ.
فماذا يفعل القيصر حين يعجز عن قهر الموت؟ يحاول أن يصنع من الخراب خلودًا، ومن الغياب حضورًا. أسّس أنطينوبوليس، لا حبًّا فى البناء، بل كتحدٍ للعدم. أراد أن يقول للكون: «خذلتنى الآلهة، لكننى سأمنح هذا الجسد الغارق حياةً لا تذوب».
لكن المفارقة أن المدينة التى نُسجت من وجع الحبيب شهدت لاحقًا مذابح الشهداء، وتحولت من محراب عشق وثنى إلى محرقة إيمان مسيحى، وكأنها أرض تكتب فيها الأرواح حكاياتها الأخيرة.
هنا برز اسم القديس أبوقسطور، القائد العسكرى الذى تمرّد على أمر اضطهاد المسيحيين. لم يُطِق روحه أن تطيع، فاعتنق دين الضعفاء- أولئك الذين يُقتلون ولا يَقتلون. فكان مصيره ومصير جنوده المؤمنين أن يُساقوا إلى الاستشهاد فى أنصنا، ليُضاف إلى ترابها معنى جديد: أن الشجاعة لا تنبت فقط فى الحرب، بل أحيانًا فى قرارٍ يُتخذ أمام الموت.
أنصنا، فى جوهرها، ليست رومانية ولا قبطية، بل سؤال وجودى: ما جدوى الخلود إن بُنى على قبر؟ وما معنى الحب حين يصير مدماكًا فى حضارةٍ ستفنَى؟ وهل يتفوق الحب على الإيمان؟ أم أن كليهما فى النهاية يُهزمان أمام صمت القبر وعبثية التاريخ؟
حيث يغفو التاريخ على هيئةٍ طينٍ مشققٍ بالشمس، تتكئ قرية أنصنا كأنها تنهيدة منسية من صدرٍ أنهكه الأنين. لا سور لها ولا أبواب، لكنها محاطة بما هو أضيق من الجدران: إحساسٌ خفى بالحصار، بالحزن الموروث، وبأنك خارج الزمن، ولست خارجه وحدك.
الطرق لا تُرسم هنا، بل تنبت كما تنبت الندوب على جسدٍ جلدته السياط. ضيقة، متعرجة، كأنها تعكس تاريخًا لا يعرف الاستقامة، تمرّ بين بيوتٍ من طينٍ لَبِن، تئنّ تحت صيف لا يرحم. على أبوابها تُنقش أسماء القديسين كما تُنقش الحكايات على ذاكرة المنسيّين: حروف صامتة، لكن كل نقشٍ يبكى.
حقولها بلا نهاية، وخُضرتها لا تبشّر بالفرح بل بالصبر. الفلاحون يسجدون للأرض، ليس حبًّا فى التراب، بل لأنها أقرب لهم من سماءٍ لا تجيب. فى كل نبتةٍ شكوى، وفى كل حصادٍ تسليم. لم يُخيَّروا بين الشقاء والكرامة، فزرعوا الشقاء علّهم يحصدون الكرامة.
أما الكنيسة.. فكانت الجرح الجميل فى جسد القرية. لم تكن فى وسطها، لكنها فى قلبها. بُنيت منذ عقود من حجارةٍ قديمة انتُزعت من أنقاض معبدٍ فرعونى لآمون رع إله رمسيس الثانى. حجارة عبدت الشمس يومًا، ثم نُقلت لتُبنى بها كنيسته تضىء فى ليل الروح. وكان الناس هنا يؤمنون بأن الحجر وإن عُبِدَ يظل وثنًا لكنه حين يسمع الصلاة، ينسى الشمس ويعرف المسيح.
قال ليشع كبير البنَّائين فى القرية، الرجل النحيل كما نخيل القرية، لشمعون حين رآه فى الشارع يعبر من أمامه، وبصوتٍ يخرج كأنه تنهيدة مدفونة فى قبو صدره:
«الحجر لا يُعبد هنا، لكنه يختار.. ونحن أحيينا هذه الحجارة بالصليب، لا بالسوط».
قالها بصوت ضعيف، وهو يغمس «كوز» ذرة فى «راكية»: مشتعلة من خشب التوت، ودون أن ينتظر إجابة من أحد. كان ليشع متشككًا فى جدوى مقاومة الظلم الذى يفرضه الجنود الروم الشرقيون، لكنه رأى شمعون وهو يحمل على كتفه ما تبقى سليمًا من حجارة المذبح المهدوم، والدموع تنهمر على خديه، تلك الدموع التى أيقظت فى قلب ليشع إيمانًا عميقًا بعدالة موقفهم، وألهبت روحه بإحساس جديد بالكرامة.
منذ أن تبنّت الدولة الرومانية «بشقّيها: الغربى والشرقى لاحقًا» المسيحية عام ٣٨٠ ميلادية، وأعلن الإمبراطور مارقيان بعد مجمَع خلقيدونية عام ٤٥١ ميلادية إيمانه بطبيعتين منفصلتين للمسيح- بشرية وإلهية- بدأ الظلم يتكلم بلغةٍ جديدة.
لم يعُد الاضطهاد باسم الآلهة، بل باسم الرب. فالأقباط فى مصر رفضوا قرارات هذا المجمع، تمسكوا بإيمانهم بطبيعة واحدة متجسدة للسيد المسيح، رفضوا الفصل بين لاهوته وناسوتِه؛ لأنهم رأوه يُصلب بكامله، لا بنصفه.
ومنذها، اشتد قهر الولاة الروم الشرقيين للمصريين. لم يكتفوا بالضرائب، بل حاولوا بالقوة، فرضوا لغةً لا يفهمها الفلاح؛ «اللاتينية»، وعقيدةً لا يراها فى دموع أمه.
كنيسة القرية الصغيرة، التى كانت تبكى مع يسوع، صارت محاصَرة. وفى ليلةٍ بلا قمر، كُسر مذبحها، وسُحبت صلبانها كما تُنتزع الأجنة من رحم أمّها.
رأى الناس فى حجارتها المهدّمة انعكاسًا لأنفسهم: لا فرق بين حجرٍ كان فرعونيًّا، ثم قبطيًّا، ثم كُسر لأنه لم يرضخ.. أن يكون رومانيًّا، وحين لم يرضخ أهل أنصنا. صارت القرية كلّها كنيسة مصلوبة. وبدا النيل، وإن بدا ساكنًا، كأنه يحمل جثمانَ شعبٍ لا يُدفن لأنه لا يموت.
انكسار المذبح
وفى مساءٍ بلا نجوم، كأن السماء طوت نورها حياءً من القادم، جاءت الخطى من الشمال. بلا طبول، بلا سيوف. لكن الهواء تغيّر، والنور ارتبك، والطين ارتعش. دخل الجنود كما يدخل الموت: صامتًا، محتومًا.
وقفوا عند الكنيسة، وهى تصدح يحيط بها أهلها يمسك الواحد منهم فى يده أغلى ما يملك؛ للدفاع عن بيته وكنيسته، أدوات الزراعة، «فئوس» و«شُعَب» كانت الكنيسة تظهر كأرملةٍ فقدت زوجها، ولم تُنزل السواد. جدرانها من حجارةٍ فرعونية.
ما زالت تحمل أخاديد رع وحورس، لكنها الآن تتنفس من مذبح قبطى، من صليبٍ نحته نجار عجوز من القرية بيديه المرتعشتين بعد دفن ابنه الوحيد حين قال:
«لم أستطع أن أدفن الصليب مع ابنى كما يفعل الناس.. بل رغبت فى أن أرفعه إلى السماء، فصنعت له سُلّمًا من خشب الزيتون بيدى».
لم تكن الكنيسة كنزًا يُسرق، بل ذاكرة تُذبح. لا ذهب فيها، ولا أيقونات تُغرى، بل صلاة تتكرر حتى يملّها الزمن.. لكنها لم تملّ أبناء أنصنا. كانوا يحفظون شكل الشمعة الوحيدة، ورائحة البخور، وشقوق الجدران التى تشبه وجوه أمهاتهم.
دخل الجنود، وجوههم جامدة، لا تنتمى حتى للحياة التى جاءوا من أوروبا الباردة ليطفئوها فى قيظ الصعيد. قال قائدهم، بلغةٍ لا تُشبه لغة الناس، ولا لغة الصلاة وهو يفض رسالة:
«بأمر القسطنطينية.. يُغلق هذا المكان».
همس أحد القرويين:
«أليس ما أخذوه منا كافيًا؟ الكنيسة أيضًا؟»
آخر يرد:
«لم يعُد هذا ظلمًا، بل هو انتقام!».
لكن جند المُقوقِس لم يغلقوا الباب. بل أمروا بفتح الجراح.
ضربوا المذبح أولًا. تحطمت زاويته اليمنى، وتطاير غبار أبيض، لا يشبه التراب، بل كأنه رماد دعاء قديم، لا يزال يرفض أن يُنسى. ثم سقط الصليب. صدر صوت خافت، كأن الخشب تأوّه، لا لأن الخشب يتألم، بل لأن داخله كانت تسكن قصة أب، وصلاة أمّ، وخطيئة بشرية تبحث عن غفران.
اقترب جندى صغير من الزاوية الشرقية، حيث ما زالت الشمعة الوحيدة تحترق منذ آخر قدَّاس. لم يكن يكره، لم يكن يفكر. فقط داسها. كما يُداس قلب برىء تحت وقع قوانين لا يفهمها. انطفأت. لكنها، قبل أن تموت، ومضت. ومضة واحدة، خاطفة، كأنها تقول: «أنا هنا.. حتى فى العتمة».
سقط الجدار الأخير. وتناثر الحجر كما تتناثر السنون الأخيرة من عمرٍ لم يُعش. وسكت الناقوس، لا لأن الزمن انتهى، بل لأن أحدًا لم يعد يجرؤ على قياسه.
كان شمعون ومعه أهل أنصنا، راكعًا كمن يصلى، بل كمن ضُرب فى صميمه. عيناه تحدّقان فى الفراغ الذى كان مذبحًا. يده اليمنى ترتعش، واليسرى تضغط على صدره، كأن قلبه يحاول الفرار.
همس لمن بجواره من أهله:
«كل شىء.. كل شىء انتهى..»
ثم ارتعش وجهه عن ومضة عجز قصير، مكتوم دون صوت، كمن حاول أن يسخر من الهاوية، فوجدها تسخر منه. انحنى، كما لو أن الركام دعاه إلى اعترافٍ غير معلَن. للحظة، بدا كمن فقدَ إيمانه، كمن أدرك أن الرب لم يكن فى الهيكل، ولا فى الجدران، ولا فى أى وعد. بل فى الصمت.. هذا الصمت الوحشى.

لكن يده لامست شيئًا. قطعة خشب. صليب صغير، منسى، ربما لطفل، أو سيدة عجوز. سقط دون أن يلاحظه أحد. رفعه ببطء، أزال عنه الغبار بأنامل مرتجفة، وتأمله كما يتأمل العميان وجوه أحبتهم: بلمس القلب، لا البصر.
ثم وقف لا بسرعة المنتصر، بل ببطء من أدرك أنه لا يُخلق ليُهزم. نظر إلى الجنود، إلى السماء الرمادية، إلى الركام، وقال بصوتٍ لم يخرج من فمه وحده، بل من شىء أقدم:
«هذا.. لم يُهدم بعد».
لم يكن الصليب يظهر فى يده كرمز، بل كيقينٍ عارٍ من كل زينة، عارٍ كما يكون الإيمان حين يُجلد.
الصلاة التى لاتقال
فى بيته ظل شمعون يحدّق فى السقف كمن يسمع ما لا يُسمع. المذبح كان لا يصرخ فى أذنه بالصوت، بل بصدى ما لا يُقال.
فى تلك الليلة، لم يَنمْ. ولم يعد يدرى: أكان يبكى لأنهم حطّموا الحجارة، أم لأنهم أيقظوا فيه حجرًا أعمق.. ذاك الذى كنا نظنه قلبًا.
فى صباح اليوم التالى ذهب شمعون إلى الكنيسة التى لم تعد كنيسة، وقف. لا يحمل سيفًا ولا حجرًا، بل عينيه فقط. وكانتا أثقل من كل سلاح، أعمق من كل لعنات الأرض.
من لم يعرفه، ظنه شيخًا بسيطًا مستسلِمًا. لكنه كان كبركان هادئ، لا يعلن عن نفسه إلا لحظة الانفجار. فى عينيه نار لا تشتعل، بل تنتظر الشرارة. شرارة الإهانة، شرارة سقوط القداسة تحت أقدام السلطة.
همس لرفيق دربه إلياس، لا كمن يفكر، بل كمن يتلو آخر مزاميره:
«لقد فعلوها.. داسوا على حجرٍ سبق المسيح بألف عام.. ونسوا أن الحجر لا يموت. بل يشهد».
وفى تلك اللحظة، لم يكن صوت الفئوس هو الأعلى. كان هناك صوت آخر.. أخف، أنقى، أشد قسوة. صوت الجدران تبكى. صوت الروح تُسحب من الجسد، لا بالموت، بل بالإهانة. صوتُ سؤالٍ خرج من جوف الطين، لا من شفتين:
«هل يولد الإيمان من الهدم؟ أم من الركام؟ هل يحتاج الله إلى مذبح؟ أم يكفيه قلبٌ منكسر لا يزال يحبّه؟».
تلك الليلة، لم تَنَم القرية. حتى من لم يؤمن، شعر بشىء يُنتزع من داخله. وكأنهم جميعًا أدركوا أن الكنيسة قد هُدّمت.. لكن المذبح، بقى فى مكان لا تبلغه الفئوس: فى قلوبهم.
فى الصباح، عاد شمعون. على كتفه شوال صغير، يحوى حجارة لم تمسسها المعاول. حملها كما يُحمل رُفات شهيد بلا قبر.
وقف عند عتبة بيته. لم يدخل. رفع عينيه إلى السماء، لا لأجل صلاة، بل مساءلة:
«لم أطلب عدلًا يا رب.. ولا نصرًا على الأعداء. طلبت فقط أن تتركنى أحبك على طريقتى. فلماذا لم تكترث؟».
دخل بيته لا بخُطَى رجل، بل بثقل نبى عجوز رأى الرب يُخذل.
ماريا كانت تطعم الدجاج بصمت، لا كمن يُطعم، بل كمن يُخدّر وجعًا. وسيرين تفصل القمح، كما لو أنها تفصل الحنين عن الألم.
الصمت لم يكن هدوءًا. بل صمت ما قبل الانهيار.
وضع الشوال أمام ماريا، لا يعرف لماذا ماريا بالتحديد، ربما لأنها الكبرى، كمن يضع قلبه دون خجل، وقال:
«هذه الحجارة من المذبح.. لم أقدر أن أتركها هناك».
رَفعتْ رأسها تبكى:
«كفى يا أبى.. ليس كلُّ ألمٍ ينبغى أن يُروى».
لكن كان فى عينيها شكر، وذهول، وذنب خفى: كيف لم ينهَر؟ كيف لم يصرخ؟ كيف صار أصلب من الحجر؟
جلس شمعون، وضع يده على الأرض كمن يستأنس التراب، وقال:
«كنتُ صغيرًا، وقلتُ إن الرب فى السماء. ثم كبرتُ، فظننت أنه فى القلب. أما الآن.. فأراه يسكن فى هذا الغضب الذى لا يصرخ. الغضب النبيل.. الذى ينتظر».
سيرين اقتربت، جلست عند قدميه، كمن يعود إلى رحمٍ لم يعرفه «أمها التى ماتت بعد ولادتها مباشرة» إلا حين جُرح. وسألته، بصوت لا يشبه الطفولة ولا الكهولة:
«أتعنى أن الكنيسة لن تعود؟ إذن، أين سنصلّى؟»
أجاب، دون تردد، دون أمل:
«الكنيسة؟ لا أعلم. لكن إن لم تُبنَ بالحجارة، فستُبنى بقلوبكنّ. وأنا.. سأظلّ أنحت الصليب، حتى لو كنتُ آخر قبطى على هذه الأرض».
ثم صمت. ولم يعُد هناك ما يُقال.
لكن الجو كله صار صلاة. لا تُقال، لا تُتلى، بل تُشمّ فى الهواء، وتُبصر فى عيون البنات، وتُلمَس فى الحجارة. كان المشهد مأساويًّا، لا لأنه مملوء بالألم، بل لأنه مملوء بالصبر. وما الصبر إلا أعمق أنواع البكاء.
لقاء منظم
فى مساءٍ غارقٍ بكآبةٍ، كأن الليل ذاته كان ينوح، اجتمع وجهاء أنصنا فى بيت شمعون. بيت طينى، لا يقول إنه بيت أحد الوجهاء، متواضع، لا يُغرى أحدًا. لكنَّ فيه شيئًا لا يُشترى، ولا يُرمّم: ذاك الوقار الذى لا يصدر عن كبرياء، بل عن جراح لا تندمل، لكنها لا تئِنَ.
البيت بدا كقلب صاحبه: قديم، مشقوق، لكنه لا يسقط.
ماريا تُحضّر المشروب ببطء لا لتسقيهم، بل كمن تصنع تعويذةً ضد الانكسار. وسيرين، خلف الباب، تراقب بصمت حذر، لا ترى رجالًا، بل ملامحَ قدَرٍ يتشكّل. كأنها تحفظ الوجوه، لا لتؤرخ، بل لتحاسب.
جلس شمعون فى صدر الغرفة، كتمثال من حجر قديم. لم ينظر فى وجوههم، كأنما يرى ما لا يُرى، يرى الكنيسة المهدومة كما تُرى الجثث فى الحلم: واقفة، لكنها ميتة.
كان رجلًا لا يشتكى، لا لأن الشكوى ضعف، بل لأن الشكوى تُفسد الألم، كما يُفسد الضجيج صلاة خافتة. لكنه اليوم.. لم يتكلم كقائد، ولا كمضيف.. بل كمن ضاق بصمته حتى كاد يخنقه. قال، وصوته يأتى من مكانٍ سحيق، من مغارة داخل الروح:
«لستُ نبيًّا، بل رجلٌ أنهكه التعب. أرغب فى أن أصرخ، لا أن أُصلّى. احتملنا الجزية.. ثم احتملنا الخراج.. ثم احتملنا بصقة الجند حين يمرّون على ديرنا كأنهم يمرّون على كلب أجرب. قلنا: الصبر. ثم قلنا: الرب يرى. لكن أن يهدموا كنيستنا الوحيدة؟ أن يدخلوا بأحذيتهم إلى الهيكل؟ أن يسحقوا المذبح كأنهم يسحقون ذبابة؟ هل هذا دينهم؟ أم قسوتهم؟ أم نحن، نحن مَنْ صرنا بلا وزن، بلا معنى، حتى صار الرب يُهان فينا ولا أحد يلتفت؟».
واختتم كلامه بقوله:
«إذا كانت كنيسةُ الربّ تُهدَم هكذا، فواجبُنا أن نعيد البناء، لا بالحجارة، بل بالمقاومة وعدم الاستسلام».
سكنت الغرفة.. لا من الصمت، بل من ثِقل الحقيقة التى سقطت فجأة، كحجرٍ على صدرٍ عليل. تململ بعض الرجال فى أماكنهم، لا لأنهم لم يعرفوا، بل لأنهم عرفوا.. لكنهم لم يجرأوا يومًا أن يُسمّوا الأشياء بأسمائها. كأن كلمات شمعون أيقظت فيهم جرحًا قديمًا، كانوا يظنونه مات، فإذا به يتنفس.
السؤال القديم
كل واحد فيهم، فى تلك اللحظة، كان يسمع صدى شىء دفنه منذ سنوات: الخوف. والعار. والسؤال القديم الذى لم يجرؤ أحد أن يسأله: إلى متى؟ قال عجوز منهم يُدعى ميشيل، يملأ صوته التجاعيد قبل أن تملأ وجهه:
«وإن صرخنا، فمَن ذا الذى سيسمعنا؟ لعلّ صلاتنا هى الصرخة الأخيرة المتبقية. نحن، لا نشبههم فى شىء.. لا لغتهم لغتنا، ولا ربهم ربنا. هم يقولون للمسيح: اثنان فى واحد، ونحن نقول: واحد لا ينقسم. حتى فى الإله نُطرَد لأننا نؤمن بوحدته! ألا يُشبه هذا الاضطهاد ما فعله نيرون بالرومان؟».
ثم تنهد بحرقة، وهمس لنفسه وكأنها لا تسمعه:
«لا تتركنى وحدى يا نور، فالظلمة ثقيلة!».
كان شمعون يحدق فى الحائط كمَن يراه للمرَّة الأولى، كمن يرى العالم من زاويةٍ لم يعهدها، كما لو أن الحائط نفسه أصبح أكثر وضوحًا من القلوب التى حوله. ثم قال بصوتٍ منخفض، كأنه يصرخ فى صمتٍ لا ينتهى: «الفرق يا سيدى.. أن نيرون لم يتظاهر بأنه مؤمن. أما هؤلاء، فيضطهدوننا باسم الرب. أى كفرٍ هذا الذى يختبئ فى عباءة الدين؟».
ثم عمّ الصمت. لم يكن صمتهم هروبًا، بل كان كل واحد فى الجالسين ينصت لصوتٍ داخله لا يُسمع إلا عندما يسكت العالم حوله، صوتٍ أعمق من كل الكلمات التى قد تنطق. اقترب حنَّا، أحد شيوخ أنصنا المسالمين، وضع يده على كتف شمعون، وحين أدرك المدى الذى قطعه هدم الكنيسة فى قلب أهل أنصنا، قال بخفوت:
«نرفع الشكوى إلى المقوقس، ربما لم يعلم بما حدث».
ضحك شمعون ضحكة قصيرة، يابسة، كأنها نُزعت من فم لم يعرف إلا الصمت:
«المقوقس؟ ذاك الذى يقيم قداسه فى القسطنطينية بينما مذابحنا تُداس؟ لا يسمعنا. وإن سمع، فاللغة الوحيدة بيننا وبينه هى سوط الجباية ومراسيم الذل».
كان صوته كالماء العميق، لا يترك أثرًا على السطح، لكنه يحرّك قيعانًا راكدة منذ زمن. لم تكن الكلمات تُقال، بل تُنزف.
وفجأة، ومن حيث لم ينتظر أحد، تكلم إلياس، هذا الرجل الذى لم ينسَ أبدًا وجه والده فى أيامه الأخيرة، بعد أن نكّل به جنود الروم، صادروا محاصيله، واستولوا على ماشيته، وتركوه يواجه القهر وحيدًا. يتذكر أن والده مات مكسورًا، لا لأنه خسر رزقه، بل لأنه لم يجد من يقف إلى جانبه فى وجه الظلم. نهض إلياس كأنه كان قابعًا فى الزاوية لقرون، ثم نطق، لا بصوت، بل بقرار قال:
«بعد اليوم، لا ضرائب. لا قمح. لا ولاء لحاكم لا يعرف حتى أسماء قرانا. نموت كل يوم ولا أحد هناك يعرف أننا كنا أحياء».
عيناه لم تريا أحدًا، بل طافتا فى مدى خفى، كأنهما تفتشان عن وجه غائب أو عهد مكسور. ثم أردف، أقرب إلى الهمس منه إلى الخطاب: «كل مَن باع صوته، مَن زرع الولاء فى أرضنا بدل القمح.. سيرحل. إن بقى بيننا رجل يحب الإمبراطور ونائبه فى مصر أكثر من أمه، فليذهب إليه».
ثم التفت، ببطء كمن أُنهك من الانتظار، إلى الجميع: الوجهاء، الفلاحين، الصامتين، الحائرين.. ونظر بعينٍ لم تكن تغضب، بل تشهد.
«لسنا نتمرد.. نحن فقط نفتح نافذة لنعيش. بعيدًا عن الذل الذى صار طقسًا».
دخلت ماريا تحمل الشراب. لم تسمع كل الكلمات، لكنها سمعت ما لا يُقال. شىء فيها اهتز. لم تكن تفهم السياسة، لكنها رأت ما يكفى لتفهم شيئًا واحدًا: أن أباها رجل نقى. والنقاء، فى عالم كهذا، يُعاقب عليه بالموت.. لا مرة واحدة، بل كل يوم.
جلس الجميع فى صمتٍ ثقيل، يتبادلون أنفاسهم أكثر مما يتبادلون الكلمات. كان الصمت شهادةً على انهيار داخلى لا يُرى، لكن الدمار الذى يبدأ فى الداخل لا يمكن إخفاؤه طويلًا. وكل واحد فيهم كان يعرف أن لا ثورة ستندلع اليوم، ولا سلاح سيُحمل غدًا. لكنهم، فى أعماقهم، كانوا يشهدون انهيارًا. تحت الأنقاض، التى لن تُرى، كانت هناك بذرة. صغيرة جدًا.. اسمها: الاحتراق الداخلى. والاحتراق.. هو بداية النور.
أصوات الجنود
فى صباحٍ قاتم، ضاع بين الغيوم التى تراكمت فوقها عتمة الجبال، وصل الخبر إلى القرى المجاورة كالعاصفة التى تكتسح السكون، تحمل معها رائحة الخوف التى لا تنطق، لكنها تملأ الصدور بالثقل. الجنود الرومان، الذين يملكون كل شىء إلا القدرة على النسيان، علموا عن اجتماع شمعون، عن البيت الذى صار معبدًا للصمت، عن الكلمات التى تمردت على الجدران لتتساقط كزَخَّات المطر على القلوب قبل أن تهز الأرض نفسها.
كانوا يراقبون تحركات القرية منذ شهور: كل حركة، كل همسة، لا يرحمون ضعفًا، ولا يتركون فرصة لتمزيق الحلم الوحيد الذى ما زال يعلّق فى الهواء كخيط يتشبث بالحياة.
اتهموا شمعون بالتمرد. لكنه تمرد لا يرفع السيوف، بل يهاجم الحقيقة نفسها. لا يحتاج إلى سلاح، بل إلى صمتٍ مستمرٍّ يضرب الأرض من تحتها. قالوا:
«قائد فِتْنَوى، يشعل النار فى القلوب»
أما أهل القرية، فالكلمات التى نطقوها فى تلك الليلة التى غرقت فيها الأشجار فى صمتٍ عميق، كانت توقيعًا على وثيقة مصيرهم. جريمة يعاقبون عليها بالموت البطىء.
عندما انتشر الخبر، كان الليل قد أُلقى بثقله على قرية أنصنا كما يُلقى سِكِّين الجلاد على جسد الضحية، ثقيلًا وعميقًا.
فى تلك اللحظات، كانت أصوات الجنود تتساقط كأمطار غريبة على أسطح البيوت الطينية، تتوالى ضرباتهم على الأبواب والقلوب، كما لو كانوا يطرقون باب القدَر نفسه. كان الهجوم غير معلن.. بل هو هجوم على الإنسان الذى ما زال يتشبث بشىء من الأمل فى ظل الخراب.
أصدر القائد الرومانى أمره:
«مصادرة الممتلكات، واعتقال شمعون ومن معه».
كانوا يعلمون أن شمعون ليس مجرد رجل، بل رمز يتجسد فيه حُلْم لا يندثر رغم الموت. لم يريدوا إخضاعه فقط، بل إطفاء الشعلة التى قد تضىء دربًا لا نهاية له.
لكن الهجوم لم يكن لإخماد تمرد فقط؛ كان لطمس كل أثر إنسانى، كل أمل يزهر فى زوايا الأرض المظلمة. أرادوا سرقة تلك البذرة التى نبتت فى صمتهم، البذرة التى قد تصير حريقًا يلتهم الظلام، فى تلك اللحظة، كان شمعون يقف على عتبة بيته، عيناه غارقتان فى الأفق، فى مكان لا تسكنه إلا أسئلة بلا إجابة.
كان يرى قريةً تُستباح، حياةً تُستأصل، لكنه، ككل من فقد شيئًا عظيمًا فى داخله، كان يعرف أن الكرامة لا تُحرق، ولا تُسجن. الكرامة تبقى كامنة فى الذين لا يسيرون مع الجماهير، بل فى طريقهم الخاص، المَارّ عبر ظلال الحياة. الجنود قادمون. لكن شمعون، مثل من رأوا الموت مرارًا فى عيونهم، كان قد قرر منذ زمن أن يقف وحده ضد الموج الذى لا يهدأ.