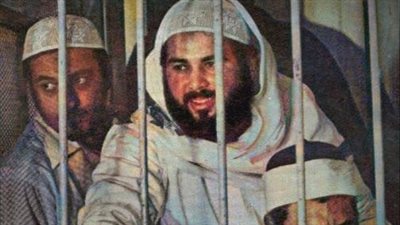طه حسين والشيخ.. فصل من رواية «المغاربة» لـ «عبدالكريم جويطى»

- كان يريد أن يُسحر الحشود ويقودهم وأن تكون له الكلمة الفصل فى كل شىء
- لم يغفر له أبدًا كونه أسكن روحه الحرّة الهائمة فى جسد معطوب تحت رحمة الآخرين
- ليس من الهين على رجل كبشار قد منحه الله هذا كله أن يحتمل آفة العمى راضيًا بها
«عليك أن تختار: إما ستسير فى طريق طه حسين أو طريق سيدى الصاحب؟» قالها لى بكلمات سريعة، شبه غاضبة، وألقى فى حجرى كتابًا كبيرًا كما يُلقى الواحد حجرًا، وانسحب يجرجر رجليه بتثاقل شديد. قلبتُ الكتاب، فألفيته سيرة طه حسين الذاتية: الأيام.
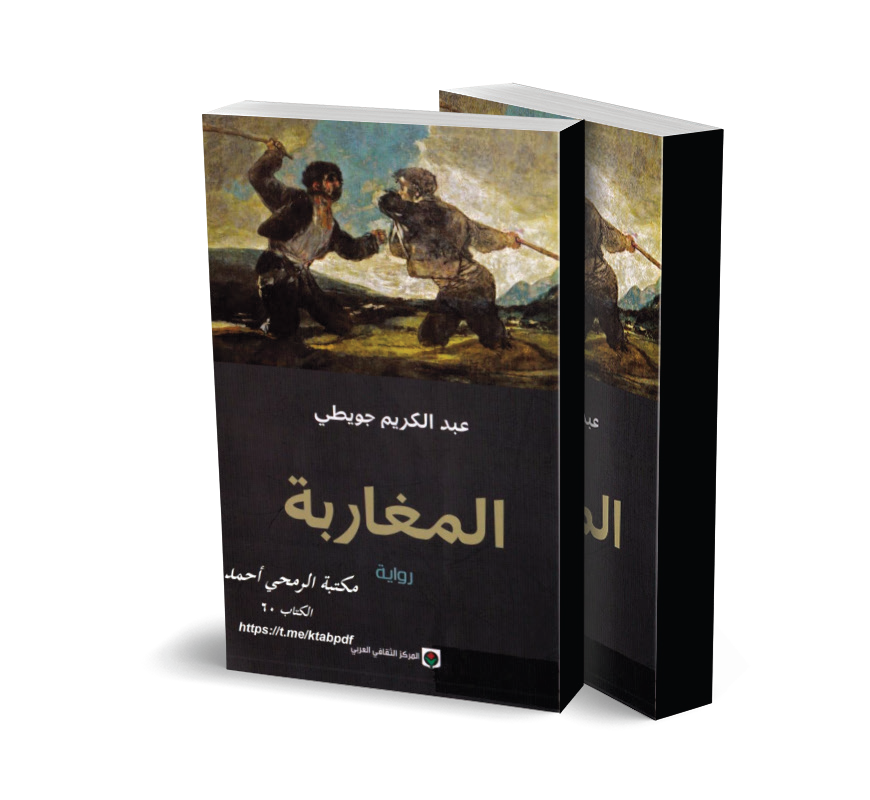
كان مشهدًا شبه ختامى لمحاولات حثيثة قام بها لتجنيبى الآفة.
وحين ابتعد ببطء عنى، كان ينأى أيضًا عن إيمانه بإمكانية شفائى، لذا بكيت يومها بحرقة واختناق وأنا أضع يدى على الكتاب البارد، كأننى أضعها على صك إعدام، كانت جملته حاسمة، قاطعة، لا تستدعى أى لبس. أنا على وشك دخول نادى الشقاء الذى يتزعمه طه حسين هذا، قاهر الظلام على ما يقولون، عميد الأدب العربى الذى رفع منديل التحدى عاليًا جدًا فى وجه العميان البسطاء الذين لم يدرسوا فى السوربون، ولم يلتقوا بفرنسية تكاد تكون رسالة سماوية، ولم يعينوا عمداء لكلية، ومن بعدها وزراء للثقافة، ولم يكتبوا، ما لا يُحصى من كتب فى النقد الأدبى والتاريخ والسيرة والرواية، ولم يخوضوا عشرات المعارك الأدبية والسياسية، وحازوا شهرة تكاد تكون عالمية. كانت قراءتى لـ «الأيام» مضنية، متعثرة، ومقلبة للمواجع، ولم أنجح أبدًا فى جعلها طبيعية متسقة.
كنت أبدأ القراءة، وأضطر لقفز عشرات الصفحات للتخفيف من الحزن الذى يمسك بتلابيبى ويخنقنى، ومراوغته. تتجمع السطور بأساها كغيوم تدفعها ريح عاتية لتلد برقًا ورعدًا ووابل المطر. «ليس من السهل أن تكون أعمى» قالت لى الأيام، ستُعيَّر وتُزدَرى وتنقص بعاهتك، وعليك أن تشق بالأظافر الأحجار الصلدة لتدرك نورك الخاص، وعدا أنها حركت فى فضيلة تحدى العجز وانتزاع الاعتراف من الآخرين، فإنى عرفتُ بأن على أن أكون ماكرًا، وعدوانيًا أحيانًا، ومتحفزًا فى كلّ الأحوال للدفاع عن النفس.

والأهم من كل هذا أن أتلفّع بكبرياء جسور، وأن تكون لى تلك الوقاحة النبيلة: وقاحة تحدى الكاملين، لكن هل ما حكاه طه حسين هو ما عاشه بالضبط؟ وهل ما عشناه هو ما نتذكره؟ أم أنه لا سبيل أبدًا لاسترجاع ما عشناه إلّا عبر مصفاة للذاكرة تنحل فيها الأحداث، ويُعاد نسجها وفق سياقات التذكر والنسيان؟ على الأعمى أن يكون حالمًا كبيرًا». قالت لى الأيام أيضًا، وبحلمه هذا يمكنه أن يعنف العالم القبيح الذى أساء إليه.
فهذا العالم فى كل الأحوال عابر ومتقلب ينفلت من النظر والأصابع. لا شىء يبقى على حاله، لا الشروق ولا تفتح وردة ولا قطرة ماء رقراقة تنزلق من فوق حصاة، ولا بسمة طفل أو يد إيخاء تمتد فى لحظة ضيق، وحدهم العميان لديهم القدرة هم الذين يحتاجون إلى مرتكزات ثابتة من حولهم على إنقاذ العالم من سعار الزوال الذى يفتك به، لأنهم يعيشونه حاضرًا كثيفًا، بلا أطلال، ولا دمن، ولا معالم دارسة. كتاب الأيام تركيب تجريدى لجزئيات حياة تكللت بانتصار أو بتوهم انتصار. إنها استعراض إنشائى لشخصية صارت مرموقة، وإفراغ لحياة الأعمى من حسّها التراجيدى، إذ إن مشكلته الأساس، لا تكمن فى أشخاص يزدرونه، أو مؤسسات تتحامل عليه أو تقاليد بالية تخنقه، بل فى الحياة نفسها بوصفها عاهرة لعوب، لا تهب نفسها إلا للقوى الشديد. كل صفحات كتاب الأيام لا تتسع لكثافة التقاط دقيق وعميق للحظة واحدة من حياة أعمى قلق وضائع ومرتبك. كتب طه حسين أيامه وهو يقارب الأربعين من العمر «الجزآن الأول والثانى» بعنفوان وإقدام وبراءة نبى تنقصه الخبرة بالزمن والناس، وما يمكن أن يفعله بالنوايا، والأحلام والانتصارات، تراه لو كتبها فى غسق العمر بعد استيلاء العسكر على الحكم فى مصر والنكبة المشينة والصعود المظفر للأصوليات، لو كتبها وهو يحسّ اندحار قواه، وتحلّل ملكاته وحواسه، وخيانة بعض ممن حوله، وادعائهم بأنهم كانوا يشاركونه كتابة أعماله، لو كتبها وهو يسمع الشكوك تحوم كالذباب حول معتقده الدينى وصدق رسالته ونواياه التحديثية، ومواقفه السياسية. ليس هناك أكثر فجاجة من حياة تُقدَّم على أنها ناجحة وممتلئة.
ولو أننى عرفت مبكرًا بأن السير- بما فيها هاته- مليئة بالثرثرة والعشوائية والتعمية على بؤس الوجود وعبثيته، كأن ليل العمى ليس كافيًا، فإننى انشغلت كثيرًا بسيرة طه حسين وقرأتُ بدموع فى العينين كتبًا كثيرة له وعنه. إنّ الكتابة عن حياة عشناها باسترجاعات مختلطة ومختلقة تشبه الكتابة عن بيت سكناه لمدة طويلة، وهجرناه فى النهاية بغصة فى الحلق، قد نتذكر بدقة الأبعاد الهندسية، ومساحة كل حيز، وألوان الجدران والأثاث، وكل ما كان يحيط بنا، لكن ما السبيل لتذكر الأحاسيس التى شكلتنا، وعبرتنا وما لا قدرة لنا للإمساك به أبدًا ولو عبر كلمات بئيسة: نزواتنا وشهواتنا وأحلامنا، ولحظات جزعنا ومسراتنا وضيقنا. لم أعرف يومها هل سيكون بالنسبة لى ملهمًا، شريعة ونبيًا أم مسيحًا دجالًا، لكن ما هو هذا الطريق الذى مشى فيه طه حسين؟ هل هو عدم تقديم أى تنازلات لمجتمع يحتقر ذوى العاهات؟ أم هى الشهرة وتسلق المراتب الاجتماعية والوصول إلى مناصب عليا؟ أم هو طريق العرق والجهد والدموع وبناء الذات من الصفر والانتصار عليها فى كل مرة؟ ولكن ما سرّ الكآبة التى كانت تعتصر قلبه فى أواخر أيام عمره ما سر قلقه، وتدخينه، المفرط، وليالى الأرق التى كان يعيشها هو الذى حقق كل هذا، بل ما سر تلك الجملة السوداء الساخرة والمدمرة لكل هذه الحياة المتوجة، والتى قالها لسوزان وهو يحتضر: «أية حماقة؟ هل يمكن أن نجعل من الأعمى قائد سفينة؟» أخيرًا، وهو ممدد فى فراش الموت، وقد تخلّص من أعشاب الحياة الطفيلية: المباهاة، الكبرياء، الاعتداد الزائد بالنفس، صار بإمكانه أن يقتل بداخله الحاجة لأتباع ومريدين ومعجبين، وأن يستعيد ماضيه بطريقة ساخرة ويرى، وهو فى المنحدر الأخير قمة الجبل التى صعدها بضيق فى التنفس، وتنمل فى الأرجل، وزهو كبير، ولما استوى فوقها عرف بأن الرحلة كانت أجمل من الهدف وأن الغنيمة بخسة وباهتة، فالسفينة جنحت وهى الآن عالقة بين الصخور بعد أن مزقت أشرعتها وهجرتها الجرذان، لكن هل قاد الأعمى حقًا السفينة؟ أم أنه يتحدث عن عميان عتاة غلاظ بأجهزة دعاية ضخمة، وأجهزة أمنية سرية وعلنية رهيبة وحشود تُساق لعبادتهم، والهتاف لهم، القادة الضرورة، الملهمون، الخالدون؟ لكنهم، يا للحماقة! عميان يسوقون سفن شعوبهم إلى حتفها. فتح طه أبوابًا، وحرك موجًا، وتجاوز بكثير تخوم ما هو متاح لرجل مثله. وقدم حياته، ودمه قربانًا ليصل للآخرين. تحدث وأملى وخطب طويلًا، وفى كلّ شىء تقريبًا، مخافة أن ينسى من هذا الآخر الذى وصل إليه.

لم يكن يكتفى بالطلبة فى الجامعة وبقرّاء كتبه، ومقالاته كان يريد أن يُسحر الحشود ويقودهم، وأن تكون له الكلمة الفصل فى كل شىء. لم يغفر للمجتمع: تخلفه الذى أفقده نور عينه وعاش، هو الذى بحث عن نور خارج بلده، يطلب الثأر بعناد صعيدى من المنيا، ويطالب بدفع الثمن. لقد أراد، وخصوصًا فى شبابه أن يكون شريرًا ومقوّضًا، وحَفَرَ الدعائم ليسقط البنيان على من فيه، وخسر، وعاود الكرة من جديد وخسر، واستجمع قواه وهجم من جديد وخسر، وخسر. لم يحمد ربه على نعمة العمى مثلما فعل بشار- ادعاء- لأنه أراحه من كل الوجوه القبيحة التى كان سينظر إليها، بل عاش معذبًا بهذه العاهة التى لم يفهم كيف أصابته هو بالذات. كانت حياته مرثية طويلة، ونقمة على الأسباب التى قادته إليها، والتى لو كانت رجلًا لقتله رأى أن فخر بشار بالعمى وحمده الله عليه خدعة، والأصح - كما فى حالته - هو أنه ليس من الهين على رجل كبشار، قد منحه الله هذا كله أن يحتمل آفة العمى راضيًا بها، مطمئنًا إليها، وإنما المعقول أن يُحدث ذلك فى نفسه سخطًا شديدًا على الحياة، والأحياء لما يجر عليه من حرمان عاش طه معذبًا بالزمن بالصيرورة لذا سمّى سيرته الأيام، بهذه الأشياء التى تتبرعم، وتشتد، وتُزهر وتُثمر، وتنضج، ثم تذوى، وتموت، لكن بعيدًا عنه. لم يملك غير نفسه لملاحظة تحولاتها، وهنا مصدر عذابه. نفس لا تهدأ ولا تستكين، تجد راحتها فى المنافسة والتحدى، وفى النسف والتخريب والتسفيه تحديدًا، وغبار المعارك، والمداد المراق فى الخصومات «ربما سمى الأيام لمعناها الجاهلى أى الحروب المخاضة». كان عنيفًا مع الآخرين، ومع نفسه، متقلبًا، تتعاقب بداخله أحاسيس متناقضة ولأنه لم يرد أن يقف وجهًا لوجه مع الخالق الذى يقف خلف القدر الظالم الذى أصابه هو بالذات، فإنه خاض وطيلة حياته حربًا تنكرية ضده. لم يغفر له أبدًا كونه أسكن روحه الحرّة الهائمة فى جسد معطوب تحت رحمة الآخرين. كان طه مكتئبًا كبيرًا. تعتصر قلبه بشكل دورى، أحزان عاصفة. تجعله يعتزل الناس تمامًا، ورغم انتصاراته العابرة، وأمجاده المشهودة، فإن عقدة نقص مزمنة كانت تحفر عميقًا بداخله ما أكثر ما أعجب من نفسى، وما أسرع ما يستحيل هذا العجب إلى سخرية منها أول الأمر ثم إلى رثاء وعطف عليها. ذكرت سوزان بأن طه كان يحب كثيرًا الوقوف بجانب البحيرات، الماء الهادئ، الطبع، السجين الذى لا يجرى ويمكنك أن تستحم فيه مرتين وأكثر، الماء الذى لا يلد موجًا وعواصف وأنواء، ولا يرحل مع الريح والغيم، أحب فى البحيرات ما كان يفتقده فى نفسه.
بعد قرابة ستة أشهر قال لى: «عرفتَ مَن هو طه حسين، هيا معى لتعرف من هو سيدى الصاحب». خرجنا من الدار فأشار لسيارة أجرة، وأمره أن يأخذنا إلى المقبرة روعت، وفطن لذلك، فطفق طيلة الطريق يربت على كتفى ويقول لى ببسمة ساخرة: لا تخف. ترجلنا وسحبنى من يدى اجتزنا البوابة الكبيرة، فأشار إلى شيخ بلحية بيضاء مشعثة، يتفيأ ظلال شجرة كاليبتوس، ويبدو من نحافته الشديدة، وأسماله المرقعة تجميعًا وتكثيفًا لسطوة الموت فى المكان. كان نشازًا فى الضراعة الملتهبة من حوله، لا يتطلع لأحد، ولا يستجدى أحدًا يشدّ على عكازه بكلتا يديه كأنه يحتمى به، ويطرق غير مكترث لا بالموت المسجى من حوله، ولا بمن يقتعدون الظلال، ويستثمرون حُزن وخوف الزوار. اقتربنا منه، فذهلت لضموره ويبوسته كأن ما يجرى فى عروقه ليس دمًا، وإنما انتظارًا ويأسًا. بادره أخى بعد تردُّد:
- السلام عليكم سيدى. كيف الحال؟
بقى صامتًا، لم يدر رأسه نحونا حتى. ثم ردّ بصوت واهن، كأنه يصعد من جوف بئر:
- كما ترى.
- لا أرى شيئًا.
- لن ترى بعينيك طبعًا. انظر بقلبك. وأعرض عنا.
كرّر أخى كأنه مصمم على أن يغيظه:
- لا أرى شيئًا.
- يا بنى لا يحتاج الذل والانكسار والضعة إلى عينين، بل إلى قلب يحس ويأسى. أترى القبور أمامك؟ هذا، وأشار بيده إلى صدره، هذا قبر آخر.

وعاد لوجومه الصخرى انتبهت لعينيه المنطفئتين فبهت. وكما يفعل دائمًا. سحبنى بفظاظة وخرجنا. انتظرنا سيارة أجرة أعادتنا إلى الدار. بعد ذلك سيحكى لى بأن هذا اللا شىء تقريبًا له تاريخ عظيم، فمنذ عشرين سنة فتن الناس، وقاد الجموع، وكان هناك من هو مستعد للموت من أجله، بل إن قول الناس: «كل ذى عاهة جبار»، تبدو وكأنها قيلت فيه بالضبط. بدأ من الصفر، لم يكن يمتلك إلا معرفة دقيقة بخريطة الأولياء الصالحين ومواقيت مواسمهم. كان يسير من موسم إلى آخر ومن ولى إلى آخر. وهنا وهناك، عرف ببكائه والزبد المتطاير من فمه، وبسبحته الخشبية الهائلة المتدلية حتى أسفل بطنه، والعصابة الخضراء التى تشدّ رأسه، وتترك شعره الأسود الفاحم ينسدل على كتفيه. يقتسم خبزه مع الجميع، ويقوم بتأوهات وحركات استعراضية تثير الانتباه. يُزاحم الفقهاء ومرددى الأذكار والأوراد، ويُبدى حماسة فى أداء شعائر الزيارة أكثر من الآخرين. وأينما حلّ ادعى بأن الراقد شيخه وحافظه وملهمه. كاد أن يقتل نفسه وهو يعبر حجرة مولاى بوعزة ونطحه ثور تعرقيبة مولاى عبد الله أمغار، وكاد أن يغرق وهو يغتسل فى وادى أم الربيع قرب سيدى محمد مع الله، وشجّ رأسه فى سيدى على بوحمدوش، وكسرت يده فى جبل العلم، وكاد يموت تحت الأرجل فى موسم بوعبيد الشرقى حين انفجر برميل بارود بين خيام الفرسان ولا يجد نفسه حقًا إلا حين يغشى عليه، فتتعهده أيدى النساء البضة المخصبة بالحناء، وترشه بماء الزهر. تفقه فى آداب زيارة الأولياء، وأخلاق المريد. وما زال يترقى ومن المنن الربانية والنفحات الزكية يتلقى، كما كان يردد، حتى صار معروفًا جدًا، يأتيه الناس للسؤال عن موعد موسم ويطلب منه بعضهم، وبعضهن أن يسيروا فى ركابه. بدأ بركب صغير لا يتعدى أصابع اليد يحمل علمه الأبيض بيده، ويتدبر أمر المركوب والهدية. كبر ركبه شيئًا فشيئًا حتى صار له مكلف بشئونه الخاصة وحامل العلم وصاحبة الصندوق وصاحب المؤونة ومكلفة بأخبار أتباعه. كان يقص على أتباعه مناماته ورؤاه وكيف وقف عليه هذا وذاك الولى، ودعوه لزيارته أو أخبروه بحادث ما سيقع، وحملوا له بشارة تخص أحد أتباعه. وانتبه، وهو فى بدايات مساره، لأهمية وجود مخلصين من حوله يأتمرون بأمره، ويُظهرون أمام الناس ولاءً مطلقًا له. فالناس يخضعون بالتبعية ويركنون للقطيع. اختار ثلاثة رجال سماهم أصحاب السرّ، وثمانية نساء سمّاهن أهل الدار. وكان يعتبر عصاه التى سماها المباركة هبة ربانية وضعت بجانبه حين كان نائمًا قرب ضريح مولاى بوعزة يتعامل معها كعنصر من المقربين منه، ويحدث أتباعه عن كراماتها فهى تشع نورًا فى الظلمة الحالكة وتتضوع مسكًا وسط الرائحة الكريهة، وتقدر على تمييز الطيب من الخبيث، ولا تطيعه حين يهم بالسير فى طريق محفوف بالمهالك والمخاطر. جملة، أودع الله فى المباركة أسرارًا لا يعلمها إلا هو، لعل أهمها هو أن لا أحد من العارفين بالأشجار اهتدى إلى نوع الشجرة التى اقتطعت منها، ولو أن أصحاب السرّ كانوا يهمسون بأنها من أشجار الجنة. كثر أتباعه، وصار بعضهم يشفى على يديه، وتقضى بعض حوائجهم، لأنه مسهم أو تفل فى أفواههم أو دعا لهم. وتحدث أصحاب السر عن كرامات عظيمة يتستر عليها، ولا يريد ذكرها مخافة أن تحدث فتنة بين الناس اشترى دارًا كبيرة، وفتحها لمريديه يأكلون ويشربون، ويُقيمون حلقات الذكر، ويعتكفون. وخصص يوم الأحد لشفاء الناس من كلّ عللهم البدنية والروحية، فتداعى عليه الناس من كل المدن والقرى المجاورة. سمى ما يهبه الزوار فتوحًا. يقبض باستحياء، ويدس ما قبضه تحت الهيدورة التى يقتعدها، ورغم أنه تسبب فى موت عديدين، لأنه أمرهم بالإقلاع عن أخذ الدواء، وبرر ذلك بأنه اختار لهم شفاء الآخرة، وفاقم أمراض آخرين، واتهمهم بفساد الطوية ووهن التوكل، وتسبب فى بتر رجل أحد أتباعه، وقال له بأنّ الله إذا أحب عبدًا ابتلاه، فإنّ المتشوقين للشفاء على يده كانوا يتزايدون، وصيته ينتشر، والهالة النورانية التى يرونها فى وجهه تشع وتبهر. ولأنّ ربك يضع أحيانًا أسراره فى أتفه أشياء هذا العالم فقد أنهى بقهقهة مجلجلة، أسطورة من كان يقول بأن بصيرته أقوى من بصر، تابعيه بفضيحة كبرى، وأخرجه من يومها من زاويته الكبيرة العامرة إلى المقبرة كان قد تزوج بنت تاجر مواد بناء التمس البركة من الشيخ فازدهرت تجارته، وكبر اسمه فى السوق. ولعطاياه الكثيرة كان الشيخ يُمازحه أمام المريدين قائلًا: أنت عثمان بن عفان الزاوية قوية عزيزة النفس، تعتصر تقاسيم وجهها كآبة من يوجد فى المكان الخطأ، عصبية تسبقها يدها فى كلّ خصومة أو شنآن بسيط تمكنت خلال أيام، من السيطرة على الرجل فتخلى أمامها عن وقاره وهيبته، وخضع لقانون سنته الطبيعة يقضى بأن لا عظمة لأحد فى اليومى المبتذل حين يكون الإنسان غددًا وأمعاء وعظامًا وغرائز داخل الدور تتبدّى فاضحة هشاشة وحدود وتفاهة الكائن. كان يتعذر لها بدعوات مريدين مخلصين للعشاء ويسير إلى إحدى خليلاته، ويعود متأخرًا أحيانًا حتى صلاة الفجر. حتى اليوم الذى تحسّس فيه السرير كالعادة وخلع جلبابه وتشاميره، لأمر ما صحت وأشعلت النور فرأته يلبس تبانًا أحمر مشبكًا فعوت من الذهول والغضب، وغرَسَت أظافرها فى عنقه وحشت رأسه بالمباركة، ونادت الناس، فتداعى بعض المريدين الذين كانوا يتهجدون تحت. دهشوا لرؤيته عاريًا ومجمعًا على نفسه، فحاولوا ستره، لكنها منعتهم بقوة. سابقت الفضيحة سعة ونفاذ نور الشمس إلى المدينة. قال الشيخ المُريد أراد أن يهون عليه: كيف لمن لا يعرف بماذا ستر عورته أن يهديكم انتهى الأمر يا بنى وانتهى الأمر فعلًا، كما قال طلق البنت وتذكر ما فعلته لالة رقية تحديًا للباشا بوزكرى وسار إلى المقبرة.

فكرتُ فى الرجلين كثيرًا. وجدتُ أن كليهما «ولو أن طه سيُعتبر مقارنته بنكرة إهانة كبيرة»، وفوق أنه كتب عليه أن يواجه ظلامه الخاص أخذ على عاتقه أيضًا مواجهة ظلام الآخرين. تصدّى طه حسين لحجب التخلف والجهل، وأراد هو المحتاج دومًا إلى يد تهديه سواء السبيل، أن يأخذ بيد أمة نحو نور العصر. وتصدّى الشريف لحجب الغيب وأراد أن يشارك الله فى تدبيره لأمور الناس، وكلاهما عاش، تمزقات ومرارات، وشكوك الاضطلاع بمهمة قيادة الناس. آمَنَ طه بالعقل جعله سيدًا وقائدًا وملهمًا، وآمن الشريف بالقلب، ورأى بأنه إن ملئ بالتسليم المطلق للشيخ، فإن صاحبه سيعيش طمأنينة لا يعرف حلاوتها إلا الفائزون، غير أن الشريف وبوازع من حياء الذات «شرحه طه حسين نفسه، وبدقة، فى روايته أديب..» تمكّن من أن ينقلب على نفسه. ويتخلى عن كل شىء، بل إنه قتل نفسه رمزيًا وسار برجله إلى المقبرة. فضَّل أن يعيش بين أناس تحت التراب لن تُزحزح صمتهم الثقيل غوايات العالم التى يتفنن فى بناء شركها الخطباء والقادة والساسة. قام بما من شأنه إنهاء كل صرح دينى، حطّم صنمه واختار بشطحة سخرية ملهمة الاحتماء بالأموات. بعد اليوم لن يتدخل فى حياة الآخرين، لن يستثمر مآسيهم لبناء فزاعة قداسة فارغة، ولن يتلذذ بسم التبرك والمديح والرجاء الذى يلوثون به حياته. سيعيش، بعيدًا عن المواسم والأضرحة والبخور والأدعية والغبار نقاء العزلة والصمت والاكتفاء من العالم بإطراقة متأملة. ربما وهو يهترئ فى هذه النهاية الطويلة التى اختارها لنفسه، أدرك المادة الأصلية للقداسة: خرق العادة، تحدى الناس، واجتراح ما يُذهلهم ويُبلبلهم. وسيجد حتمًا من يعظمه ويتبرك به بعد موته.