أنا ومؤلفاتى 2
«لمــاذا!».. عندما كتبت قصة حياتى دون أن أدرى

- قامت الفكرة الأساسية للرواية على أساس علم الجبر أن س لا تساوى أبدًا س زائد واحد
- أغلب فلاسفة العالم والمفكرين قد توصلوا إلى أفكارهم الأساسية فى عمر التاسعة عشرة
وضعت لفافة من الورق تحت إبطى وسرت نحو محلات الترزية فى شارع الميدان بالإسكندرية، المكان ضيق والمحلات مفتوحة ويمكن لأصحابها أن يروا اللفافة التى معى، تبرق عينا كل منهم وهم يتوقعون أننى أحمل لهم قطعًا من القماش لتفصيلها، وهنا تداخلت الأمور معًا فهذا الترزى يعتقد أن بداخلها ما يصلح لتفصيل قميص أو بنطال، وسرعان ما توصلت إلى الفكرة التى صارت خالدة بالنسبة لىّ، أن بداخل قطعة اللفافة قطعة واحدة من القماش والترزية ينظرون إليها كل حسبما يريد أن تكون، بمعنى أن هذه اللفافة صارت أكثر من ألف لفافة حسب عدد الترزية.
على الفور بدأت فى كتابة روايتى الجديدة تحت عنوان «لماذا!»، إنها لماذا التعجبية وليست الاستفهامية، بمعنى أننى من خلالها لا أريد أن أعرف إجابة، ولكننى أبحث عن مفهوم جديد خاص بى، وبالفعل فإن العبارة المكتوبة على غلافها الأخير فى الطبعة المحدودة بالإسكندرية ١٩٨٢، لدى الناشر «المكتب الحديث»، جاءت كالآتى:
«أنا لا أسأل أحدًا فكلنا لا يعرف الجواب».
الزمن هو صيف عام ١٩٦٨ وهو الزمن الذى التحقت به بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أما تلك المنطقة فكانت تسكنها إحدى زميلاتى، كانت شاعرة متميزة وقد همت حبًا بها، أردت أن أجعل من هذه الفتاة بطلة لروايتى الجديدة، قامت الفكرة على أساس أن الراوى قد قام باستخراج وطبع عدد من النسخ من صورة فوتوغرافية للفتاة التى أحبها وهى فى عمرها، وعلى طريقة الفانتازيا قدم الراوى هذه الصور إلى عدد من الأشخاص الذين قابلهم بشكل عشوائى وطلب منهم أن يكتبوا عن انطباعاتهم الكاملة، ماذا تمثل لهم هذه الصورة؟، وراح يلاحقهم كى يأخذ منهم ما كتبوه عن هذه الفتاة، حيث تعامل بعضهم باستخفاف ولم يكتبوا شيئًا، وفى النهاية وصلته سبع كتابات من سبعة أشخاص هم، تلميذ فى العاشرة وكتب أن هذه الصورة تذكره بالمُدرسة التى تتولى أمره والتى أحبها باعتباره ولدًا، أما الشخص الثانى فهو طالب فى الجامعة رأى أن الصورة هى لزميلته التى يحبها وهى أيضًا شاعرة لكنها صدته فى موقفها، بينما الشخص الثالث هو شاب فى الثلاثين راح يبحث عن فتاة لها نفس السمات الشكلية كى يتزوج منها، بينما الرجل الناضج فى الأربعين كتب أن الصورة لفتاة تعمل معه سكرتيرة، بينما حكى الرجل الخمسينى أن هذه الصورة لابنته الوحيدة التى كانت معه فى رحلة قطار يتحرك بين القاهرة والإسكندرية، أما الرجل الستينى المحال لتوه على المعاش قد تحدث عن أنها ممرضته الفاتنة التى زادت معاناته بعد إحالته إلى المعاش، وهى امرأة تعطى من جسدها بلا حدود، أما الصورة التى كتب عنها الرجل السبعينى فهى فتاة انتهت من سن المراهقة، إنها حفيدته، حيث يدخل الاثنان فى خلافات فكرية فالجد يودها أن تكون فتاة ملتزمة، أن تود أختها، وأن تعرف أختها من خلال الجد، وقد امتلأت بالبهجة والقبول على الحياة وهى تقول: باى باى يا جدو.
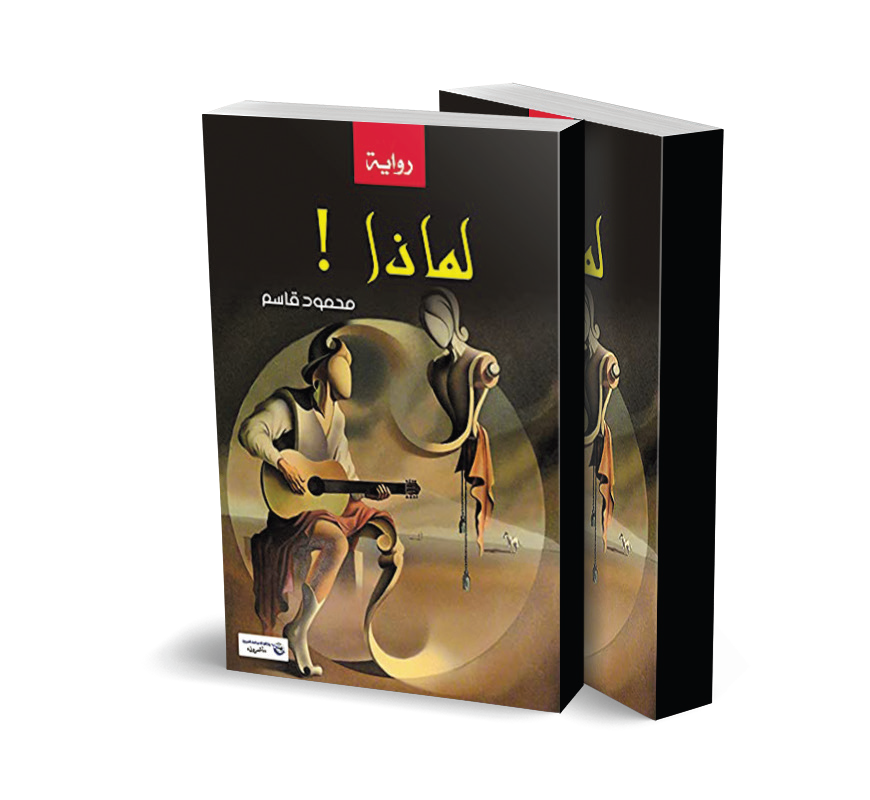
تحتوى الرواية على مدح «مفتتح»، وأيضًا مشهد «الخاتمة» يقوم فيه الراوى بتجميع الأشخاص السبع، وأن هؤلاء الأشخاص هم لشخص واحد وليس عددًا كبيرًا من الأناس، ربما واحدة ربما خمس فتيات، من هنا جاءت تسمية «لماذا» التعجبية. لم أقل فى روايتى إن هؤلاء الأشخاص هم نفس البطل فى سبع مراحل بعينها من حياتى، بل تركت القارئ أمام لماذا المفعمة بالتعجب.
قامت الفكرة الأساسية للرواية على أساس علم الجبر، أن س لا تساوى أبدًا س زائد واحد هنا يعنى التجربة الإنسانية لشخص واحد فى وقت ما.
مثلًا لو قرأت هذه الرواية فقد صرت س زائد واحد بعد أن كنت س، وإذا كان هؤلاء الأشخاص فى حوار أو جدل سوف يختلفون حتمًا حسب قيمة التجربة التى عشتها لاسم واحد، وقد تأثرت كثيرًا بالفكر الوجودى فيما يخص مسألة الصيرورة فى التجربة، فإن الإنسان يصير شخصًا آخر، أى أنك لا تختلف فقط مع غيرك كلما صرت، فبالتالى تختلف مع نفسك مع تراكم الزمن والتجربة.
أى كل منا هو: س + ١، س + ٢، س + ٣، س + ٤، س + ٥، س + ٦، س + ٧... وحتى س + ما لا نهاية من التجربة الإنسانية.
تعلمت من قراءاتى أن أغلب فلاسفة العالم والمفكرين قد توصلوا إلى أفكارهم الأساسية فى عمر التاسعة عشرة، ومن لقاءاتى مع يحيى حقى، وهو المثقف الكبير جدًا، تيقنت من صحة هذه المعلومة، وفى هذه السن توصلت إلى جوهر فكرتى حول الصيرورة، وهو المصطلح الذى قرأته فى مرحلة إعجابى بالفيلسوف الفرنسى جان بول سارتر. لكن الصيرورة التى توصلت إليها تعنى الإنسان وما يحدث له، وأنه دائم التغير فى جسده وأفكاره ومشاعره. وأرقتنى هذه الفكرة عند البشر. فأنا أختلف مع من هم حولى حتى الأقربين، والجديد هو أننى أختلف عبر الزمن مع نفسى، ومثلما حدث فى الرواية فإن أى إنسان سيقابل نفسه فى مرحلة زمنية أخرى وجلسا للنقاش فإنهما سيختلفان بشدة حسب المساحة الزمنية بين الرجلين، وقد تنبهت إلى هذا دومًا، واليوم أكتب هذه السطور وقد تجاوزت الرابعة والسبعين، لكن فكرتى عن الصيرورة لم تتغير أبدًا عن الزمن الذى بلغت فيه التاسعة عشر، لقد وضعت فكرتى فى هذه الرواية بشكل بسيط للغاية وصاحبتنى هذه السطور وسعيت لطباعتها من وقت لآخر، قد حدث هذا فعلًا لكن لا أحد يقرأ.
ظلت الرواية الى جوارى حتى التحقت بالقوات المسلحة مجندًا، وفى معسكرات الجيش توقفت عن الكتابة، لكننى أبدًا لم أكف عن القراءة، وفى معسكر الغردقة صادقت مجموعة الضباط الاحتياط المجندين، وكانت تجمعنا المسامرات والأحاديث الجادة، وفى إحدى الأمسيات حدثتهم عن هذه الرواية وتفاصيلها، وكان الإعجاب الشديد هو ثمرة الحوار، وأذكر أن النقيب حاتم قد أعجبته الرواية كثيرًا إلى أعلى درجات الدهشة، وكما أشرت فى المقدمة فإننى أشعر بالسعادة حين يعجب أحدهم بأفكارى وكتاباتى، لكن إلى حد بعينه، وذلك حتى لا يتملكنى فكر ما أننى متميز، وبعد خروجى من الجيش وفى الطريق إلى المنزل قابلت فى القطار إحدى زميلاتى فى كلية الزراعة، ودار بيننا حوار ألهمنى فكرة روايتى الجديدة باسم «أوديسانا»، التى تصورت بها نفسى البطل القديم أوديسيوس العائد من الحرب، بعد عشرين عامًا من الغربة، فوجد زوجته بينولوبى تنتظره وهى تقاوم كل الإغراءات أن تتزوج من رجل آخر، لقد عاد البطل من الحرب كى يحصل على ثمرة النصر، لكن بطل روايتى الثانية وجد نفسه أمام عقبات اجتماعية كثيرة، فلا يوجد مسكن مناسب يليق بطموحه أو عمل يتناسب مع موهبته، فوجدت نفسى أسكن فى شقة مفروشة فى حى فقير مجاور للجامعة، وقريب من الدقى حيث أعمل، هكذا أصبحت بطلًا مضادًا لا يحمل أى سمات من البطولة، وكانت تحيطنى مجموعة من الشابات الزميلات الجميلات، وأمامى طموح أن أحقق فى القاهرة حلم أى كاتب مغترب، وصار أوديسيوس الذى يسكن فيه شخصًا بائسًا، فشلت فى التواصل مع المؤسسات الثقافية فى القاهرة رغم عملى فى مجال الثقافة كجزء من نشاط التعليم العام، وطوال عامين سرت تائهًا، بلا أرض أو امرأة، ففشلت فى تجربة خطبة اقترحتها علىّ أمى التى رحلت عام ٧٧، وأجبرتنى التجربة على أن أعود مرة أخرى إلى الإسكندرية أملًا فى الرجوع يومًا ما إلى القاهرة، وبالفعل فبعد سبعة أعوام رجعت مرة أخرى إلى نفس الشقة تاركًا ورائى الكثير من المرارة وأمامى المزيد من الطموح، لكن هذه الفترة لم تضع هباء، فعلى نفقتى الخاصة طبعًا «لماذا بطريقة الماستر»، ونشرت مقالاتى الأولى فى الصحف المصرية والعربية وتزوجت وأنجبت، لقد صارت «لماذا؟» كتابًا طُبع بأخطائه الإملائية، وكانت هذه سمة لكتبى الثلاثة الأولى، حيث لم يراجعها مصحح لغوى، ودعونى أكتب عن هذه التجربة بالتفصيل فى مكان آخر من خلال روايتى الثالثة التى نُشرت تحث اسم «الثروة».
أما «لماذا؟» فقد أهملتها لسنوات طويلة ولم أعد إليها إلا عام ٢٠٠٧، حين سمحت لناشر غير محترف بطبعها ضمن الكتب الإلكترونية، مسكينة هذه الرواية التى تضم أكثر أفكارى عمقًا، وكم شعرت بأننى ظلمت نفسى فى هذا العالم حيث مارست الكتابة فى أكثر من مجال مثل النقد السينمائى وأدب الأطفال والمسرحيات، لكننى فى هذا العمر العجوز بدوت كأننى أعيد اكتشاف هذه الرواية، فبطلها هو أنا، سواء الطالب الذى أحب زميلته وهو فى سن العشرين أو ذلك المسن الذى أصبحت له حفيدته تنتقل الآن من الطفولة إلى المراهقة، وتدور بيننا نقاشات تنتهى منها بنفس الجملة التى قالتها الشابة لجدها فى آخر الفصل السابع من الرواية: «باى باى يا جدو»، لقد عشت نفس القصة التى كتبتها دون أن أدرى عن إنسان فى مراحل عمره السبع دون أن يكون لبطلى أى علاقة بالأدب بل هو مجرد إنسان يتغير من خلال نظرية س + ١، لم يتزوج سوى مرة واحدة ولم ينجب سوى ابنة واحدة، لكن الاختلاف بين الواقع والرواية أن ابنتى أنجبت حفيدًا وهذا الأمر غير موجود فى الرواية.
نعم، أنا واثق أن هذه السطور التى تخيلتها هى واقع من حياتى، وكم أتمنى لو قام أحد النقاد بإعادة الكتابة عنها، وأنا لا أنسى كيف أقام لها الزملاء فى ثقافة مرسى مطروح ندوة أعلنوا عنها فى شوارع المدينة إعلانات قماشية، وكانت ليلة الندوة هى إحدى أمسيات العرس فى حياتى، لكن النسيان سرعان ما يأتى ويتراكم فوق ركام المعرفة.



