«جنة البرابرة».. سرير عمره ثمانية آلاف عام

- زعيم التكفيريين أمر سائق شاحنة صغيرة بأن يلقى بجثث الضبّاط الثلاثة فى أقرب حاوية للقمامة
- مئات الأشرطة الملغومة تتكدّس فى اليوتيوب تفوح منها رائحة الكراهية والدم والتخوين
مذبحة طازجة على الشاشة، فى غزوة مضادة إلى قرى الساحل، انتهت إلى خطف مئة وعشرين فتاة إلى مكانٍ مجهول بوصفهنَ سبايا، ومشهد إحراق ثلاثة أكراد أحياء، فى الشمال، على يد تكفيريين، وانفجار سيارة مفخّخة فى جرمانا، وطيران حربى فوق ريف دمشق، وسبع عشرة قذيفة تستهدف موكب الرئيس فى طريقه إلى صلاة العيد. وليمة كاملة ليوم حار من آب. بلاد لم تعد بلادًا، حتى فى الخرائط المدرسية. مهاجرون وأنصار يتبادلون الاتهامات فوق أشلاء بلاد ممدّدة فوق سرير عمره ثمّانية آلاف عام. فى المنام، أرى وحشًا أسطوريًا، يتجوّل بين الخرائب، وقد ابتلع ألواح إيبلا، وفخاريات مارى، وأبجدية أوغاريت، وأديرة معلولا، والجسر المعلّق فى دير الزور، وتمثال عشتار فى المتحف الوطنى. وحش بأربع قوائم، وكتاب فتاوى، وأقبية تعذيب، وثأر قديم، وقرابين. وحش جائع على هيئة رجل كهف استيقظ على رائحة دم، وعطر عذراوات، وثمّار بريّة، وحش يشعل نارًا بأصابع يديه، يحرق أكداس القمح، والجسور، وعجلات السيارات، وأشجار المشمش والكينا والتفاح، وأعمدة الكهرباء، يلقى الجثث من فوق أسوار قلعة دمشق، فيهتزُّ ضريح صلاح الدين الأيوبى، وتتداعى جدران الجامع الأموى، ويتطاير سقف سوق الحميدية. حشود من النساء يتناهبنَ جثث المفقودين، كما يحدث فى رواية «الأرامل» لأرييل دورفمان، كل واحدة منهن تدّعى أن الجثة التى بين يديها تخص زوجها أو والدها أو ابنها، رغم تشوّه ملامحها. لا طائرات فى المنام، لكننى سأستيقظ على صوت طائرة حربية تخترق سكينة الصباح، ترتطم يمامة بريّة بشبك النافذة، ثمّ تطير بصعوبة، كما لو أنها فقدت جناحيها. أسراب من السنونو تحلّق فى الفضاء بارتباك، جيئةً وذهابًا، وصوت مشروخ لمؤذن جامع أنس الأنصارى. لا اتصالات إلى مدن الأطراف، كنت أرغب بأن أسمع صوت أمى، بعد غياب. يوم خميس مضجر. سجائر دينفر ألمانية، بدلًا من الجيتان الفرنسى، معكرونة باللبن. حبّة من «موتيفال» كل يوم، بأمر من الطبيب، لأصحاب القلق الاكتئابى المتوسط. قبل ثلاثة أيام، سألنى الطبيب: هل هناك سبب محدّد لارتفاع ضغط الدم لديك؟ أجبته متفلسفًا: إنها مسألة تراكمات، وحطام وقت، وخراب بلاد. فى ظهيرة مقهى الروضة، كنت أحاول تقشير طبقات الألم، أدخلُ أرشيفًا ضخمًا يزدحم بصور القتلى والمخطوفين والمعتقلين، واللصوص والطغاة والمافيات. هويّات منسيّة، وقبائل متناحرة، ودم يسيل فى الممرات. أُبعد قدمىّ عن مسيل الدم تحت الطاولة، ينسفح فنجان قهوتى دمًا وبقايا رائحة هال، أنهض باتجاه المغسلة، آثار خطواتى على الرخام مختومة بالأحمر. أصطدم بكتف ابن خلدون فى الممرِّ، تتناثر أوراق كتابه «المقدمة» على الأرض، يربت على كتفى، وهو يحاول تهدئة فزعى، ثمّ يقول بصوتٍ رخيم «العرب أمة وحشية، أهل نهب وعَبَث، وإذا تغلّبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، يهدمون الصروح والمبانى ليأخذوا حجارتها أثافىَّ للقدور، ويخرّبون السقوف ليعمّروا بها خيامهم، وليست لهم عناية بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد، وأنهم أبعد الناس عن العلوم و الصناعات».
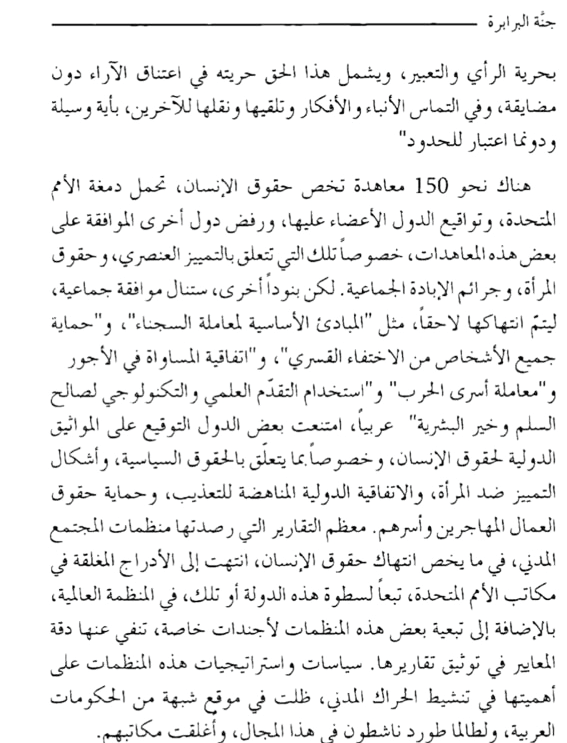
كنتُ أفكّر بمريم. ج، حين ظهر اسمها على شاشة هاتفى المحمول، مرفقًا بعزف منفرد على العود من منير بشير، قالت إنها ستنتظرنى فى مقهى الداون تاون فى الشعلان. اعتذرتُ من فيلسوف الأمل الذى ارتطمتُ بكتفه لحظة خروجى من باب المقهى مسرعًا، فأطلق ضحكة صاخبة، فى تأويل أسباب مغادرتى مقهى المازوت على عجل، إلى مقهى البنزين (شيفرة نتبادلها فى الإشارة إلى الفرق بين أماكن المواعيد العمومية، والمواعيد الخصوصية). قلتُ: كنتُ أفكّر بمريم، ولكنها، فى الواقع، لم تغب عن تفكيرى، منذ أن تعرّفت إليها، قبل أسابيع. أستحضر فى وحدتى صورتها، وطريقتها فى الإغواء، وصناعة اللذة. فى المقهى، أخبرتنى مباشرة بأنها لم تعد ترغب بأن نستمر معًا كعاشقين. لم يكن لديها مبررات مقنعة. قالت «أنا مجنونة، ولن تحتمل نزوات جنونى، ولكننى لن أتخلى عن صداقتنا». لم يكن ما بيننا حبًا، بقدر ما هو اشتهاءات متبادلة، لذلك لم أناقشها طويلًا بالأمر، وفى المقابل لم أشعر بالخذلان، ربما لأننى شخص ضجر أيضًا، أو أننى خشيت من تصرّف غير لائق، قد تلجأ إليه، فى لحظة طيش، فى سياق فهمها الخاص لحريتها الشخصية، فهى، على وجه العموم، لا تتردّد فى إعلان رغباتها وتنفيذها، لحظة التفكير بها. طلبتْ منى أن أرافقها إلى غرفتها فى المهاجرين، هززت رأسى موافقًا ونهضتُ على الفور. فى شارع فرعى معتم، أرخت طرف فستانها من الكتف، كى أرى وشمها الجديد. كان الوشم على هيئة قدمين حافيتين، وهو شعار ماركة ملابس معروفة. سألتنى بإغواء: هل أعجبك؟ أجبتها بنعم. طوال الطريق كانت تقنعنى بأنها عاهرة، وحين احتججتُ على الفكرة، قالت «أنا عاهرة، ولست مومسًا، وهناك فرق واضح بين المفردتين»، ثمّ أضافت، وهى تعانقنى عند مدخل الزقاق المعتم الذى يقود إلى غرفتها «لا تنسَ أن تفتّش فى المعجم عن الفرق بين العين والميم».

قرّرت أن أتسكعَ وحيدًا، من دون هدفٍ محدّد، محاذرًا المرور بالحواجز. عبرتُ سوقًا شعبيًة للفاكهة، فى ساحة الجسر الأبيض، تذكّرت أن مريم تحب الخوخ. أتجاهل دعاء شحاذ عجوز يفترش الرصيف. أمشى فى المسافة الضيّقة التى تفصل بين باعة الألبسة المستعملة، والسيارات المسرعة: هل هذه الثياب لقتلى حروب بعيدة، ومن كان يرتدى هذا المعطف، قبل أن يصل إلى هذه البلاد، وهل رقصت إحداهنَّ أمام مرآتها بقميص النوم هذا؟ أستحضر وجوهًا لا أعرفها لثياب مرميّة بإهمال وفوضى فوق طاولات مرتجلة. بائع أسطوانات مدمجة لأفلام مستوردة يركن بضاعته على جدار مرحاض عمومى. لم أتوقّع أن أجدَ فيلم «حجر الصبر» للأفغانى عتيق رحيمى، بين هذا الركام من الأفلام السطحية. وتذكّرت بأننى أحضرت نسخة من الرواية منذ سنة، من دون أن أقرأها إلى الآن، لعلها اختفت بين أكداس الكتب الجديدة، أو أن أحدًا استعارها منى، ولم يعدها لى، وهو ما يحصل غالبًا. كنت أراكم قناعة غائمة بأننى أفغانى مؤجل، وأن ما كنت أشاهده عن أفغانستان فى نشرات الأخبار، أو الأفلام، أو التقارير، بدهشة وباستنكار، ثمّ بلا مبالاة، هاأنذا أعيشه الآن بنسخة مطابقة تقريبًا، فكل ما يحدث هنا، كان قد حدث هناك. استوحى عتيق رحيمى فيلمه من خبر مقتل الشاعرة الأفغانية ناديا انجومان على يد زوجها، بعد أن قرأ كتابًا شعريًا لها، وقد اُعتقل الرجل، ثمّ سقط مريضًا، ونُقل إلى المستشفى ليدخل فى غيبوبة طويلة.
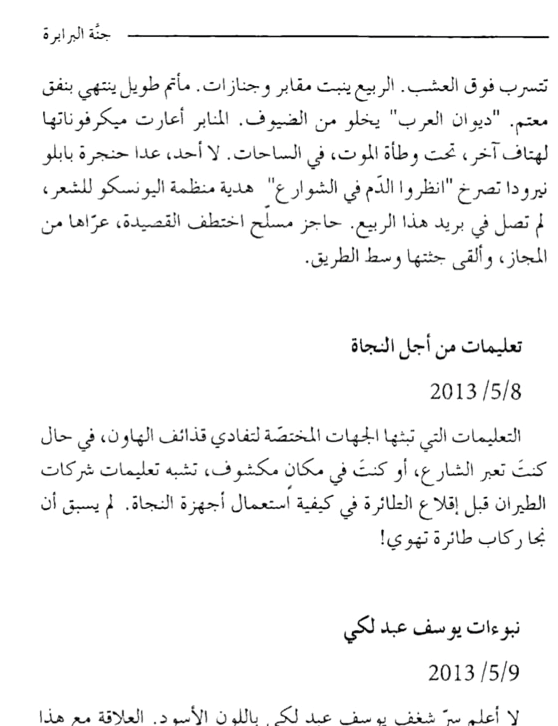
وفقًا لأسطورة محليّة على المرأة أن تحكى آلامها وعذاباتها، مناجية «حجر الصبر»، الحجر السحرى الذى يلجأ إليه أصحاب المواجع لكى يبثونه أوجاعهم وأحزانهم وأسرارهم، وعندما يصلون إلى ذروة الأسى، ينفجر الحجر ويتفتت، فتزول الأحزان. ترتفع وتيرة الألم إلى درجة الغليان، لتفصح المرأة تدريجيًا، أمام زوجها الذى فقد الوعى، بعد إصابته فى الحرب، وإهمال الجهاديين له، بمونولوج طويل عن عذابات وأشواق ورغبات جسدها، غير عابئة بالمحظورات. اعترافات جريئة عن تقلّبات حياتها، ولحظات الحب المسروقة، ونصيحة بائعة هوى لها بأن تشفى جسدها بالحب المحرّم «فالرجال الذين يلجأون إلى الحرب، لا يعرفون كيف يمارسون الحبَّ». هنا، فى أفغانستانى المتخيّلة، الحكايات مبتورة، والكراهية شجرة مثقلة بالثمّار، والبلاد تتأرجح بكرسى متحرّك إلى هاوية اليأس، وحكواتى الحرب يخترع قصصًا لا تقنع أحدًا، فالأهوال أكبر من أن تُروى فى كتاب.
فى أرشيفى الشخصى، أحتفظ بمجموعة كبيرة من صور الحرب، بينها صورة لصبى يقف إلى جانب هيكل سيارة دمّرتها قذيفة فى أحد شوارع مدينة حلب، وقد فرش بضاعته من ثمّار البندورة الطازجة، على ما تبقى من واجهة السيارة، فيما تظهر فى خلفية الصورة بقايا أبنية مهدّمة، وثياب منشورة على حبل غسيل فى شرفة أحد البيوت. لطالما فكّرت بأن تكون هذه الصورة لقطة فى فيلم، من دون أن أفكّر بتركيب اللقطات اللاحقة، يكفى، بالنسبة لى، أن تدور الكاميرا، حتى أجد تتمة الحكاية، فى الفناء المجاور، أو وراء الستائر المرقّعة التى تحجب لاعبى نرد فى زقاق مكشوف، عن عدسة بندقية قنّاص. فى هذه اللحظة، ألقيتُ نظرة أفقية إلى الأسطح المجاورة، خشية وجود قنّاص، أتوهمه، فى أكثر الأوقات فزعًا، ثمّ أتجاهل حضوره بالإنصات إلى ما يرويه أحدهم بصوتٍ عال، داخل ورشة للخياطة، تقع فى الطبقة الرابعة من البناية المقابلة، عن ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والزيوت، وأجور النقل فى الحافلات العمومية.

مئات الأشرطة الملغومة، تتكدّس فى اليوتيوب، تفوح منها رائحة الكراهية والدم والتخوين، فيما تغيب القصص الحقيقية بسبب زحام المقاولين على بيع بضائعهم المرغوبة لمحطات تلفزيونية عطشى للعنف. فى شريط قصير لإعدام ثلاثة ضباط فى إحدى ساحات مدينة الرقة، شمال البلاد، على يد رجال ملثمّين، بدا المشهد، وكأنه من إحدى ساحات روما القديمة، كان أحد الرجال الملثمّين يقرأ من ورقة بيده، قرار الإعدام، وسط تعطّش الجمهور إلى ساعة تنفيذ الحكم إذ انشغل المتفرجون بتصوير لحظة تنفيذ الإعدام بهواتفهم النقّالة، من دون أن يعبأ أحد منهم إلى مصير هؤلاء الضباط المتهمين بالخيانة العظمى، لكن ما لم يظهر فى هذا الفيديو، حسب أقوال شهود، أن زعيم التكفيريين أمر سائق شاحنة صغيرة بأن يلقى بجثث الضبّاط الثلاثة فى أقرب حاوية للقمامة، لكن سائق الشاحنة انطلق بالجثث إلى خارج المدينة، وقام بدفنها فى الصحراء، وحين علمت قيادة جبهة النصرة بما حدث، أمرت باعتقال السائق وإعدامه فى الساحة نفسها، بسبب رفضه تنفيذ الأوامر المقدّسة للجبهة.
تربكنى هذه الهشاشة فى تفسير ما يحدث على الأرض، وتفسير كيف انزلقنا إلى هذا المستنقع، أو إلى سجّادة الظلام، كما لو أننا ذاهبون فى نزهة، نزهة «الموت ولا المذلّة»، ذلك الهتاف الذى تلاشى بتأثير الرصاص وازدياد عدد القتلى فى ساحات التظاهرات. الموت، أرجوحة الرغبات، والدراجة الهوائية التى انحدرت إلى الهاوية بسببٍ من عجلاتها المعطّلة. فى مستهل النزهة، أضعنا طريق العودة. متاهة فى غابة وحوش، وهناك أيضًا، هذا التشبّث الطحلبى الزائف، بما لم يعد شعرًا، أو هتافًا، أو شعارًا. وحدهم المقاولون، صيارفة بلاغة الاستبداد، يزيّنون النوم فى مقبرة جماعية بخطب مستعارة من أرشيف طغاة الأمس.
«ملكُ أم كتابة؟»، كانت عبارة أمل دنقل تطاردنى منذ أن دخلت مقهى الروضة. سألنى رجل عجوز فى الطاولة المجاورة، كان منهمكًا فى حلّ الكلمات المتقاطعة فى صحيفة محليّة عن اسم شاعر مصرى راحل مؤلف من سبعة حروف. لا أعلم ما الذى أتى بأوراق الشاعر الجنوبى عن أبى نواس إلىَّ، ربما بسبب ارتطام قطعة العملة المعدنية فوق الرخام، بعد أن وقعت من يد النادل: ملكُ أم كتابة؟ لا فرق يا صاحبى بين مقاولين يرِثون البلاد وأهلها، ومقاولين يسعون إلى أن يمتلكوا البلاد وأهلها، فنحن فى نهاية المطاف، سنلتقى ذات ليل على مائدة دم، ذات ليل «كنتُ فيه: نديم الرشيد، بينما صاحبى.. يتولى الحجابة».

كما إننى لستُ صيرفيًا يا صاحبى، كى تسألنى هاتفيًا، من مدينتك القصية، وسط ضجيج المقهى، عن أسعار العملات، وما هى نصيحتى لك، هل تحوِّل ما تبقى لديك من أموال تعويض نهاية الخدمة، إلى الدولار، أم تحتفظ بها بالليرة السورية؟ كنت أرغب بأن أسألك عمّا حل بقبائل مسقط الرأس، وهل استعاد فرسانها هيبة الغزو مجدّدًا، كورثة نموذجيين لقطّاع الطرق، وهل لازلت تشرب الفودكا، كآخر ما تبقى لك من ميراث ستالين، أم أنك تفضّل اليوم، القهوة المرّة فى مضافة عشيرتك، على أمل اقتناص حصتك من الغنائم، وأموال الجزية؟

هاهم بدو الصحراء يستعيدون إرثهم من الدم المؤجل، الدم المدفون تحت طبقات الرمل، على هيئة زيت أسود، فيغرقون بنعمة الغنيمة، غير عابئين بغيوم السرطان، يكدّسون العملة الورقية بالقبّان، إذ لا وقت لديهم للعدِّ، فهذا قوتهم اليومى من تعطيل قوانين الدولة، واحتضار شهامة الأسلاف الكاذبة. يستبدلون الكلاشينكوف، ببنادق البرنو الصدئة، كى يحرسوا الزيت المبارك، ويشكرون الرب فى الصلوات الخمس على هذا النعيم الأرضى، الذى أنساهم النظر إلى السماء، حتى تيبّست أذرعهم من الدعاء، على أمل أن تهطل غيمة ضالة فوق حقولهم من القمح والشعير والعدس.
ليست هذه البلاد جمهورية موز، ولا إمارة متمرّدة عند أطراف الثغور، أو طروادة محاصرة، إنها مزيج من كل هذه الجغرافيات: أقوام، وطوائف، وإثنيات، تخوض حروب إبادة بأقصى درجات اللذة، وكأنها لم تنم يومًا، فوق سرير عمره ثمّانية آلاف عام.








