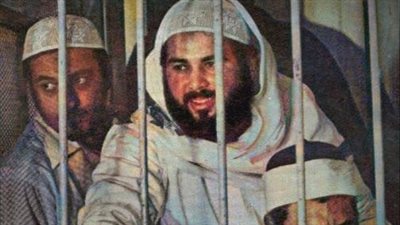حادث النصف متر.. صبري موسى وحافلة المكاشفة النفسية

في تاريخ الأدب، ثمة نصوص تُكتب بالحبر، ونصوص أخرى تُكتب بالأعصاب العارية. وإذا كان الروائي المصري الكبير صبري موسى (الذي تحل ذكرى ميلاده لتنكأ فينا جراح الفقد والتقدير المؤجل) قد شيد في رائعته «فساد الأمكنة» معماراً كونياً يمتد بين الجبل والصحراء، فإنه في نوفيلا «حادثة النصف متر» قد فعل النقيض تماماً؛ لقد حشرنا جميعاً في زاوية ضيقة، خانقة، لا تتجاوز الخمسين سنتيمتراً، ليمارس علينا أقسى أنواع "المكاشفة النفسية" التي عرفها السرد العربي في ستينيات القرن الماضي.

إن قراءة «حادثة النصف متر» اليوم، بعد عقود من صدورها، لا يجب أن تكون قراءة استعادية لعمل كلاسيكي فحسب، بل هي أشبه بفتح "ملف طبي" لحالة نفسية واجتماعية عاشها جيل كامل؛ جيل وقف في منتصف الطريق بين وعود ثورة يوليو 1952، وبين صدمة نكسة يونيو 1967. هذه الرواية، التي وصفها النقاد بأنها "هجاء لأخلاقيات المدن"، لم تكن مجرد قصة حب فاشلة، بل كانت نبوءة مبكرة بالكارثة، وإعلاناً عن هزيمة الإنسان من الداخل قبل أن تقع الهزيمة العسكرية على الحدود.
المأزق الوجودي: تشريح البطل "الضد"
يضعنا صبري موسى منذ اللحظة الأولى أمام "أحمد" (أو صبحي الحلوجي)، وهو نموذج لما يمكن تسميته في علم النفس الأدبي بـ "البطل الإشكالي" أو المضاد. إنه شاب ثلاثيني من الطبقة الوسطى، يبدو في مظهره الخارجي ابناً شرعياً للحداثة وللمدينة الجديدة، لكنه في الحقيقة يحمل في لاوعيه "تاريخاً سرياً" ومشوهاً يجعله كائناً ممزقاً.
تشير الدراسات النقدية إلى أن التركيبة الجينية والنفسية لهذا البطل هي بحد ذاتها "شفرة" للصراع؛ فهو ينحدر من أب ذي أصول تركية (رمز السلطة القديمة والتعالي)، وأم جاءت نتيجة "سر اغتصاب فرنسي" لامرأة مصرية فقيرة. هذا التاريخ العائلي الملوث بالعنف والقهر ليس مجرد خلفية درامية، بل هو الجذر النفسي لما يعانيه البطل من "انشطار" في الهوية. إنه يحمل في دمائه الجلاد والضحية معاً، الشرق والغرب، الرغبة والتحريم. وكأن صبري موسى يخبرنا أن هذا الجيل ولد "معطوباً" سلفاً، مثقلاً بأرواح الأساطير والمعتقدات التي كبلته بالمخاوف، وجعلت عقله الواعي الحديث قشرة هشة تغطي بركاناً من الخرافات والعقد القديمة.
يختار الكاتب "الحافلة" مسرحاً لحدثه المحوري. والحافلة هنا ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي "معادل موضوعي" للمدينة المزدحمة التي تنتهك الخصوصية. في هذا الحيز الضيق -النصف متر- تتساقط الأقنعة الاجتماعية.
من منظور التحليل النفسي، تمثل لحظة التلامس الجسدي بين البطل والفتاة "وفاء" انتصاراً لحظياً للـ "هو" -مستودع الغرائز البدائية والشهوة- على الـ "أنا العليا" التي تمثل ضوابط المجتمع. يصف النقاد هذه اللحظة بأنها صرخة "البدائي الكامن فينا".
في هذا الزحام، يتوهم البطل أنه تحرر، أنه يمارس حريته الفردية في التواصل، لكن الحقيقة التي يكشفها السرد ببراعة هي أن هذا التواصل "مبتور" ومشوه. إن المسافة الضئيلة (النصف متر) تصبح رمزاً للمسافة الهائلة بين العوالم النفسية المتقابلة؛ المسافة بين الذات والآخر، وبين الرغبة المعلنة والخوف الدفين.
لعل أخطر ما تطرحه الرواية، والذي يستدعي وقفة نقدية متأملة، هو ميكانزم الدفاع النفسي الذي يتبناه البطل تجاه شريكته "وفاء". فالعلاقة التي بدأت بشرارة غريزية، سرعان ما تتحول إلى مأساة تعري هشاشة الرجل الشرقي.
عندما تستجيب "وفاء" لنداء الجسد، وتتجاوز التابوهات لتمنح نفسها له، لا يرى البطل في ذلك فعلاً من أفعال الحب أو التحرر المشترك. بدلاً من ذلك، يستيقظ "الرقيب الداخلي" المتسلط. إنه يعيش صراعاً داخلياً لم ينجح فيه في رأب الصدع بين رغبات جسده وتسامي عقله. وهنا، يلجأ العقل الباطن للبطل إلى حيلة نفسية قاسية تُعرف بـ "الإسقاط"؛ فهو يسقط عقده وشعوره بالذنب عليها هي.
تصل الرواية إلى ذروتها النفسية القاسية حين يكتشف البطل في قرارة نفسه أن "كل ما فعله مع حبيبته أنه حولها إلى مجرد داعرة". هذه الجملة المرعبة ليست حكماً أخلاقياً موضوعياً، بل هي اعتراف ضمني بفشله هو. إنه فشل في أن يرى المرأة ككيان إنساني مساوٍ له في الرغبة والمصير. لقد حولها إلى "شيء" يفرغ فيه كبته، ثم يحتقره ليتطهر هو من الذنب. إنها، باختصار، أزمة "التحرر الزائف" الذي وسم المدن وساكنيها في تلك الفترة؛ تحرر يقف عند حدود المتعة العابرة، وينهار فوراً أمام استحقاقات المسؤولية والشراكة.
لا تكتفي الرواية برصد الفشل العاطفي، بل تذهب أبعد من ذلك لتلمس التخوم الخطرة بين "دافع الحياة" و"دافع الموت". ففي غمرة علاقته بوفاء، وبدلاً من أن يسعى للالتحام بها لبناء حياة، نجد البطل مدفوعاً برغبة دفينة في "وأد جسده داخل جسد من يحبها". هذه الرغبة التدميرية تشير إلى نزوع لاواعي نحو الفناء.
ويتجلى هذا الدافع التدميري بوضوح في المشهد الختامي -أو الافتتاحي وفقاً للزمن السردي- حيث يقود البطل حبيبته نحو مصير مأساوي فيما يشبه محاولة القتل. إنه يريد التخلص منها لأنها الشاهد الحي على ضعفه، ولأن وجودها (خاصة بعد حملها منه) يضعه أمام مرآة لا يطيق النظر فيها. لقد تحول الحب إلى عبء، والجسد الذي كان وطناً للذة أصبح منفى للاغتراب والعذاب، مصداقاً لمقولة سارتر "الآخرون هم الجحيم".
لا يمكن الحديث عن المضمون النفسي دون الإشادة بالشكل الفني الذي اختاره صبري موسى. لقد كتب "نوفيلا" مكثفة، مقتصدة لغوياً، تشبه في بنائها "اللقطة السينمائية" الطويلة. استخدام تقنية "الاسترجاع الفني" والبدء من النهاية (مشهد الحادث)، يخدم الغرض النفسي تماماً؛ فهو يضع القارئ في حالة من التوتر والترقب، ويجعل النص كله يبدو وكأنه "شريط ذكريات" يمر أمام عين شخص يحتضر أو يغيب عن الوعي.

لغة صبري موسى هنا ليست لغة وصفية استطالة، بل هي لغة "مشرط الجراح"؛ جمل قصيرة، حادة، مشحونة بالسخرية المبطنة، وأحياناً تقترب من العامية لتعكس نبض الشارع وواقعية الحوار. هذا الأسلوب هو الذي مكنه من تعرية نفاق الطبقة الوسطى دون الوقوع في فخ الخطابة والمباشرة.
في الختام، قد يسأل سائل: ما جدوى العودة لنص كُتب في الستينيات؟ الإجابة تكمن في أن «حادثة النصف متر» ليست مجرد وثيقة تاريخية. إنها مرآة لا تزال صالحة لتعكس تشوهاتنا المعاصرة. لقد كانت هذه الرواية -وكما ذهب بعض النقاد- "مشروعاً تنويرياً" سبق عصره، وتجلى تأثيره في السينما العربية عبر فيلمين (سوري ومصري)، مما يؤكد أن الأسئلة التي طرحها صبري موسى حول الجنس، والحرية، والجسد، والسلطة الأبوية، لا تزال أسئلة حارقة وملحة.
إن صبري موسى في هذا النص الصغير حجماً، الهائل تأثيراً، لم يكتب فقط عن أحمد ووفاء؛ بل كتب عنا جميعاً. كتب عن تلك المسافة الضئيلة والخطرة التي تفصل بين ما ندعيه وبين ما نحن عليه حقاً. وفي ذكرى ميلاده، تظل هذه "الحادثة" مستمرة، وتظل الحافلة تسير بنا، ونحن لا نزال نبحث عن مخرج من مأزق "النصف متر" الذي يفصلنا عن حقيقتنا الإنسانية.