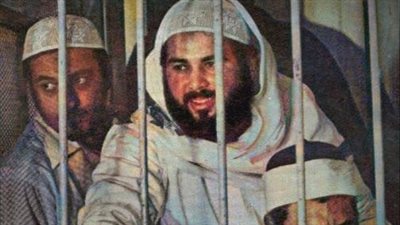محمد سلماوى يلقى محاضرة فى ذكرى ميلاد أحمد بهاء الدين
الريادة المنسية.. عن الأدب المصرى القديم الذى سبق الإلياذة والأوديسة بعشرة قرون

- مسرحية أبيدوس أقدم نص مسرحى فى تاريخ الإنسانية
افتتح الأديب الكبر محمد سلماوى سلسلة محاضرات أحمد بهاء الدين التذكارية لهذا العام، وذلك فى تقليد سنوى جديد لأنشطة جمعية «أصدقاء أحمد بهاء الدين» بإلقاء محاضرات تذكارية فى ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الذى يوافق ١١ فبراير.
واختص سلماوى «حرف» بنص محاضرته التى ألقاها مساء الثلاثاء الماضى بمكتبة القاهرة الكبرى، والتى تناول فيها الأدب المصرى القديم الذى لا نعرفه رغم ثرائه وغزارته، ورغم أنه سبق الأدب الإغريقى والرومانى بقرون، وطالب فى المحاضرة بضرورة الاهتمام بهذا الأدب والعمل على إحيائه كجزء من تراثنا الثقافى، كما نهتم بالآثار الحجريّة ونبنى لها أكبر المتاحف.

حين نذكر آداب الحضارات القديمة، يتبادر إلى الذهن على الفور الأدب الإغريقى والأدب الرومانى، بما تركاه من ملاحم ومسرحيات ونصوص فلسفية ما زالت تُقرأ وتُدرس حتى يومنا هذا باعتبارها أصل الآداب الحديثة فى العالم. غير أن هذه الصورة على شيوعها، تظل ناقصة ما لم نُعيد للأدب المصرى القديم مكانته الحقيقية فى تاريخ الإبداع الإنسانى. فمصر لم تكن فقط مهد الحضارة فى العمارة والفنون والعلوم، بل كانت أيضًا من أوائل الأمم التى عرفت الأدب المكتوب بوصفه تعبيرًا جماليًا وفكريًا عن الحياة وتجسيدًا وجدانيًا لمشاعر الإنسان.
إن أى قراءة منصفة لتاريخ الأدب الإنسانى لا يمكن أن تتجاهل الأدب المصرى، فهو الذى أسس مبكرًا لأشكال التعبير الشعرى والسردى والدرامى التى ظنها البعض حكرًا على الحضارات اللاحقة، فقد سبق الأدب المصرى نظيريه الإغريقى والرومانى بقرون طويلة، ففى الوقت الذى كانت مصر تدون نصوصها الأدبية على البرديات وفى المعابد وعلى جدران المقابر منذ الألف الثالث قبل الميلاد، لم يكن الأدب الإغريقى قد تبلور بعد، فلم تظهر الملاحم الهوميرية فى اليونان القديمة إلا فى أواخر الألف الثانى وبدايات الألف الأول قبل الميلاد، بينما جاء الأدب الرومانى لاحقًا متأثرًا بالآداب الإغريقية.
لقد عرف المصرى القديم الشعر العاطفى فى أرقى صوره، كما نراه فى قصائد الحب التى يعود بعضها إلى عصر الدولة القديمة، حيث يتغنى العاشق بحبيبته بلغة شاعرية شفافة، تجمع بين المشاعر الحسية والعواطف الإنسانية، ولا تقل جمالًا وعمقًا عن شعر Sapho سافو الإغريقية التى عادة ما يضرب بها المثل فى شعر الحب، وقد جاءت بعد أشعار الحب المصرية بقرون. كما عرف المصريون أيضًا الشعر الوطنى الذى عبّر عن الارتباط بالأرض وبالنيل، وجسد الانتماء للوطن، وهو ما نجده جليًا فى نصوص الانتصارات العسكرية والمراثى الوطنية.
ولم يقف الأدب المصرى عند حدود الشعر، بل قدّم قصصًا سردية متكاملة، مثل قصص «سنوحى» أو «الأخوين» أو «الملاح المنكوب»، وهى نصوص تجمع بين الحبكة الدرامية، والتحليل النفسى، والمبادئ الأخلاقية، وتعد بحق من أقدم نماذج الفن القصصى فى تاريخ الإنسانية. هذه النصوص سبقت الرواية الإغريقية واللاتينية، وعالجت القضايا الإنسانية الكبرى، مثل الغربة، والقدر، والوفاء، والخيانة، والبحث عن العدالة.

قصص المبادئ النبيلة
بدأت النصوص الأدبية المصرية فى الظهور بوضوح منذ عصر الدولة القديمة، وبلغت ذروتها فى عصر الدولتين الوسطى والحديثة «نحو ٢٠٠٠- ١٢٠٠ ق. م»، أى قبل هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسة، بما لا يقل عن سبعة إلى عشرة قرون، وقبل ازدهار الأدب الرومانى بأكثر من ألف عام، وقد جسدت تلك النصوص المبادئ الإنسانية الكبرى، من الهوية والحنين للوطن إلى التعاليم الأخلاقية والمبادئ السامية.
لنأخذ مثلًا قصة سنوحى «نحو ١٩٠٠ ق. م، الدولة الوسطى»، والتى تُعَد من أعظم النصوص السردية فى تاريخ الآداب القديمة، وقد تُرجمت إلى معظم لغات العالم، وتروى سيرة موظف مصرى كان يعمل فى بلاط أمنمحات الأول، لكنه بعد اغتيال الملك يفرّ خارج البلاد ويحقق فى منفاه نجاحًا كبيرًا، لكنه يعانى من الغربة والقلق ويشعر بالحنين للوطن، فيعيش صراعًا داخليًا يعذبه، خاصة وقد تقدم فى العمر وبدأ يشعر بدنو أجله، فماذا يحدث لو وافته المنية ولم يدفن فى مصر؟ لقد كان المصرى القديم يؤمن بأنه لو لم يدفن فى أرض المصرى فلن يعرف الحياة الآخرة، لأن الروح لا تعود إلا لهذه الأرض المقدسة، لذا يكتب للحاكم ذلك الخطاب الملحمى البليغ الملىء بحب الوطن طالبًا الصفح والمغفرة ومنحه الأمان فيما لو عاد لأرض الوطن، ومن أشهر مقاطعها:
«إن مصر تعيش فى قلبى،
والنيل يسرى فى دمى،
لم أنسَ موضع قدمى على أرضها،
ولا هواءها حين يهبّ على صدرى».
هذه القصة لا تقل عمقًا عن الأوديسة لهوميروس، بل تسبقها زمنيًا، وتطرح مبكرًا فكرة الهوية والانتماء والعودة، لكنها تكتسب معانى تتعلق بطبيعة الإنسان المصرى وبعقيدته المرتبطة بالأرض السوداء، وتلك طبيعة إنسانية ما زالت حاضرة فى الوجدان المصرى حتى اليوم.
أما حكاية البحار المنكوب، وهى أيضًا من عصر الدولة الوسطى، فتدور حول بحار مصرى ينجو من غرق سفينته خلال رحلة بحرية، ويجد نفسه وحيدًا على جزيرة غامضة، وهناك يواجه ثعبانًا عملاقًا يخبره بأنه حاكم الجزيرة، ويشرح له أنه فقد عائلته بأكملها عندما سقط نجم من السماء فقتل كل من فى الجزيرة وتركه وحده، ويطمئن الثعبان البحار، واعدًا إياه بأنه سيعود بأمان إلى وطنه، ويحذره من الخوف أو فقدان الأمل، وبعد فترة من الوقت، تصل سفينة إلى الجزيرة، ويعود البحار بالفعل إلى أرض الوطن حاملًا هدايا ثمينة قدمها له الثعبان.
وكما فى الحيل السردية الحديثة يتضح فى نهاية القصة أن البحار كان يروى هذه الحكاية ليطمئن ويشجع رئيسه الذى كان خائفًا لأنه على موعد للقاء الملك، متذكرًا رسالة الثعبان: «إذا كنت شجاعًا وسيطرت على خوفك، فستعود لبيتك، وترى أولادك، وتقبل زوجتك». والقصة تكتسب معناها على المستويين الواقعى والرمزى، فهى مغامرة مثيرة من أجل البقاء على قيد الحياة، كما أنها سرد أدبى بليغ يجسد مبادئ نبيلة وحِكَمًا سامية، والبحار الذى يجد نفسه وحيدًا على الجزيرة المهجورة هو استعارة لأى فرد يواجه محنة ساحقة فيصل إلى الحكمة من خلال التجربة، والثعبان ليس وحشًا بل رمزًا للحكمة من خلال المعاناة والألم، وهكذا تتحول الجزيرة من سجن موحش إلى مهبط إلهام وحكمة وأمل، ويمثل الثعبان سلطة إلهية رحيمة، ووعد بالإنقاذ، ثم يتضح الغرض من القصة كلها، وهو تهدئة الزعيم الخائف بأن «اضبط قلبك» قبل لقاء الفرعون، وفى ذلك أسلوب آخر من أساليب السرد الحديثة، فالمغامرة بأكملها عبارة عن قصة داخل القصة، يرويها البحار لرئيسه القلق، مستخدمًا تجربته الخاصة «التى قد تكون خيالية» ليقدّم له نموذجًا للشجاعة والحكمة، تمامًا كما فعل الثعبان معه، والهدايا التى يعود بها البحار ليست مجرد كنوز مادية، بل هى رمز للكنز الأعظم المتمثل فى الدرس الذى غيّر حياته.
وأما قصة «الأخوين» فيعود تاريخها إلى عصر الدولة الحديثة، وهى مدونة بالكامل على بردية محفوظة بالمتحف البريطانى، وتتميز بأنها موقعة باسم الكاتب «عِنانة»، فهل هو الأديب الذى ألّفها، أم الكاتب الذى نسخها؟ وتقدم القصة أقدم معالجة لموضوع تردد كثيرًا فى كتابات تالية جاءت على مر العصور، وهى قصة الأخوين اللذين حاولت زوجة أكبرهما غواية أخو زوجها، فلما رفضها ادّعت لزوجها أنه هو الذى حاول غوايتها وأنها رفضته، لكن بالرجوع للأحداث التاريخية المصاحبة لفترة كتابة القصة، وهى نهاية الأسرة التاسعة عشر نتبين بُعدًا رمزيًا ذا دلالات سياسية تتعلق بشقى الدولة المصرية، العليا فى الجنوب والسفلى فى الشمال، فبعد وفاة ميرنبتاح فى نهاية القرن الـ١٣ قبل الميلاد كان سيتى الثانى فى الشمال هو الوريث الشرعى للحكم، لكن نشب بينه وبين آمنميس حاكم الجنوب صراع حول العرش.

نصوص الحكمة
وقد عرف المصريون أيضًا ما يُسمى بأدب التعاليم أو نصوص الحكمة، مثل تعاليم بتاح حتب «حوالى ٢٤٠٠ ق. م»، وتعاليم أمنمحات لابنه سنوسرت، وهى نصوص أخلاقية وفلسفية سبقت كتابات أفلاطون وأرسطو بزمان، وتدعو إلى العدل، والاتزان، واحترام الإنسان، ومن تعاليم بتاح حتب:
«إن العدل شامخ عظيم/ هو ثابت لا يتزعزع،
ولا يختل توازنه/ منذ زمن أوزوريس
وحتى غروب النهاية/ فويل لمن يعبث به»
وهذا التصور الأخلاقى الكونى يوازى ما سيعرف لاحقًا بالقانون الطبيعى فى الفلسفة الرواقية.
أما قصة الفلاح الفصيح «الدولة الوسطى» فتعتبر من أبلغ نصوص الأدب الاحتجاجى فى التاريخ، ويروى النص قصة فلاح بسيط يُسلب حقه، فلا يجد سلاحًا للتعبير عن الظلم الذى وقع عليه إلا الكلمة، فيُلقى تسع خطب بليغة أمام القاضى مطالبًا بالعدل، ومن أقواله الشهيرة:
«إن العدالة هى نسيم الحياة،
ومن حُرم منها مات وهو حى».
هذه النصوص لا تعبر فقط عن رسوخ مفهوم الحق والعدل فى مصر القديمة، وإنما تكشف أيضًا عن وعى مبكر بقوة الكلمة وبقيمة الخطابة والبلاغة، وتُعد نموذجًا فريدًا للأدب الاجتماعى والسياسى، سبق الخطب الإغريقية الكلاسيكية بقرون.
شعر الحب
عرفت مصر القديمة شعر الحب الغنائى فى جميع عصورها، وقد ازدهر بشكل خاص فى عصر الدولة الحديثة «حوالى ١٣٠٠ ق. م»، وهو من أرقّ ما كُتب فى العاطفة الإنسانية، ومن إحدى القصائد التى ترجمها جون فوستر فى كتابه «أناشيد الحب فى المملكة الحديثة»:
«حبيبى جاء/ فامتلأ قلبى فرحًا،
أخذ يدى فى يده/ فتوحد العالم،
وصار البشر جميعًا/ أحبابًا وعشاقًا».
وفى موضع آخر:
«صوتك مذاقه نبيذا/ طيفك رفيف طائر
يغرد عند الفجر/ وذكراك تعيد قلبى للحياة».
وفى بردية محفوظة بمتحف تورين بإيطاليا يقول العاشق الذى فقد حبيبته:
«كالنخلة الباسقة التى ترفع أذرعها إليك فى السماء،
أتضرع إليك يا إلهى أن تعيدها إلىّ،
فأنت القادر على كل شىء.
بدونها تذبل الزهور اليانعة،
وينضب النهر العظيم».
وما زلت أذكر كيف توقفت منذ سنوات عند شقفة من الخزف فى المتحف المصرى بالتحرير، كتبت عليها أبيات من الشعر تناجى فيها فتاة حبيبها الذى وعدها باللقاء عند شاطئ النهر:
«لمَ تتوانى يا حبيبى؟
هلم إلى موعدنا عند الشاطئ.
سأنزل معك إلى النهر
ردائى من الكتان الملكى الرقيق
وعطرى زكى فواح.
سأغوص فى الماء الرقراق
وأتى إليك بسمكة حمراء».
الملاحم الوطنية وأبو الفنون
وفى مجال الشعر الوطنى، تبرز ملحمة معركة قادش فى عهد رمسيس الثانى «القرن ١٣ ق. م»، وهى من أقدم النصوص الحربية التى عرفها الإنسان، ويقول النص على لسان رمسيس:
«أنا وحدى/ لا قائد معى ولا جندى،
لكن آمون إلى جانبى/ وقوتى من قلبى».
هذا النص يجمع بين البطولة الفردية والتدخل الإلهى، ويقول كينيث كيتشن فى كتابه Pharaoh Triumphant «الفرعون المنتصر»، إنّ ملحمة قادش تعد أقدم نموذج للملحمة البطولية التى ستظهر لاحقًا فى الإلياذة.
ثم نأتى إلى المسرح «أبو الفنون» فنجد أدبيات التاريخ المسرحى تؤكد على مدى القرون الماضية أن نشأة المسرح كانت فى اليونان القديمة بالتراجيديا الإغريقية، إلى أن قام عالم المصريات الفرنسى أوجست مارييت أثناء تنقيبه فى مدينة أبيدوس فى منتصف القرن الـ١٩ باكتشاف لوحة من الحجر الجيرى ارتفاعها حوالى متر مدون عليها ما يبدو أنه الجزء الأكبر من مسرحية مصرية قديمة تحكى قصة إيزيس وأوزوريس التى تجسد الصراع الأبدى بين الخير والشر، وهى موجودة الآن بمتحف برلين وتعرف باسم لوحة إخيرنوفريت، ثم وجدت بعد ذلك النصوص المكملة للمسرحية فى نقوش بعض المقابر الملكية وفى متون الأهرام، وهو ما مكن الباحثين من استكمال البنية الدرامية للمسرحية، وتعتبر مسرحية أبيدوس أقدم نص مسرحى فى تاريخ الإنسانية، وقد كانت تُعرض فى إطار احتفالى تمثيلى يجمع بين الحوار والحركة والرمز، وكان ذلك قبل نشأة المسرح الإغريقى على يدى إسخيلوس وصوفوقل ويوريبيدس، بحوالى ألف وخمسمائة عام. وهو ما يؤكد أن فكرة التمثيل المسرحى لم تكن حكرًا على الإغريق، بل كانت لها أصولها هنا على ضفاف النيل.
إعادة الاعتبار
إن الأدب المصرى القديم ليس مجرد أثر لغوى، بل هو ذاكرة إنسانية مكتوبة. وإذا كنا نقيم أضخم المتاحف لآثارنا العظيمة من تماثيل ومعابد، فإن من واجبنا الوطنى والعلمى أن نُقيم للأدب المصرى متاحفه الفكرية، وذلك بإعادة إحيائه عن طريق التوسع فى ترجمته ونشره، وقبل ذلك كله بإدماجه فى الوعى العام، وكما يدرس الطلبة فى الخارج الإلياذة والأوديسة، لما لا يدرس طلبتنا النصوص والأشعار المصرية القديمة؟ وكما يتم تقديم التراجيديا الإغريقيّة والكوميديا الرومانية على المسارح، لماذا لا نقدم عروضًا لقصة إيزيس وأوزوريس كما جسدتها مسرحية أبيدوس؟ فمصر لم تسبق العالم فى البناء والتشييد فقط، بل سبقته أيضًا فى الكلمة، والمعنى، والوجدان، وعلينا أن نعيد لهذه الريادة اعتبارها.
وختامًا فإن الأدب فى جوهره هو صوت الإنسان عبر الزمن. وإذا كنا نفخر بالأحجار المصرية القديمة التى بهرت العالم، فإن من حق الكلمة المصرية القديمة، شعرًا كانت أو نثرًا، أن تستعيد مكانتها، وأن تُقرأ وتُفهم وتُقدَّر، بل وأن تخلب الألباب كبقية آثارنا، لأنها تشهد على أن مصر لم تُعلّم العالم كيف يبنى فحسب، بل كيف يشعر، ويحكى، ويغنى، ويفكر، فالأدب المصرى القديم لا يقل قيمة وجمالًا عن الآثار الحجريّة التى نُقيم لها أكبر المتاحف.