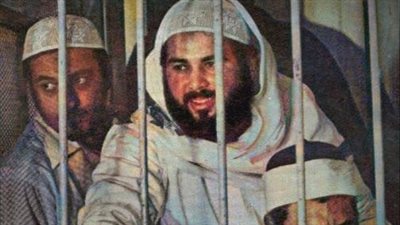الدروز.. قراءة هادئة فى ملف ساخن

- الدعوة الدرزية خرجت من رحم الدولة الفاطمية فى زمن كان فيه الدين شديد التداخل مع السلطة
- العقل عند الدروز البوابة الوحيدة لفهم الدين حيث لا مكان للإيمان بالنيابة
- «أخى الصادق اعلم أن التوحيد لا يدرك بالسمع، ولا ينال بالتقليد، وإنما يعرف بالعقل، ويحفظ بالفهم، ويثبت باليقين»
- «احفظ ما عرفت، ولا تبده لغير أهله، فإن إظهار الحكمة فى غير موضعها إضاعة، وصونها نجاة»
- «أخى البار إن للدين حدودًا، ولكل حد مقامه، ولا يؤتى العلم إلا من بابه، ولا يعطى إلا لأهله»
- التقية كانت إحدى وسائل حفظ الدعوة
- الدروز شكلوا علاقة واقعية مع الدولة تقوم على قبول الإطار العام للنظام مقابل الحفاظ على استقلال البنية الداخلية
- «أخى البار لزوم النظام نجاة، ومخالفته هلاك»
- «كونوا إخوانَ صدقٍ، تعرفون بعضكم ببعض، ولا تُظهروا ما خُصِص بكم»
- عند الدروز يولد الفرد داخل جماعة دينية مكتملة البنية ويتعلّم منذ الطفولة أن الدين ليس مجالًا مفتوحًا للقول ولا موضوعًا للعرض بل إطار يُعاش ويُحترم
- «ليس كل ما يُعرف يُقال، ولا كل ما يُقال يُعمل به»
- «وفّوا ما خُصّص لكم من الحكمة، ولا تُظهروا ما هو خاصّ بأهلها»
- «المعرفة ليست لمن سمع، بل لمن وعى، وليس كل من عرف أدرك المصير»
«أخى البار، اعلم أن ما خوطبت به ليس لكل أحد، ولا يُقال على الملأ. فاحفظ ما أُودعك، ولا تطلب له ظهورًا، فإن الحكمة لا تُعطى إلا لمن عرف حدّه، وصان ما عرف به»- رسائل الحكمة.
بهذا النداء تبدأ الرسالة الأولى من رسائل الحكمة (الكتاب الدينى الأساسى عند الدروز). نداء فردى، مشروط، لا يحمل وعدًا بالانتماء ولا دعوة إلى الظهور، بقدر ما يضع منذ اللحظة الأولى حدًا واضحًا بين مَن يسمح له بالاقتراب، ومن يظل خارج الدائرة. لا يخاطب القارئ هنا بوصفه جزءًا من جماعة، ولا يطلب منه إعلان موقف، بل يختبر فى قدرته على الاحتمال، وعلى فهم أن ما يُقال له ليس مما يذاع، وأن المعرفة التى تُمنح فى الخفاء لا تُقاس بقابليتها للانتشار.
هذا الاختيار المبكر للكتمان لا يبدو خيارًا روحيًا مجردًا، ولا نزعة زهدية معزولة عن الواقع. فالرسالة تُكتب فى سياق زمنى كان فيه القول الدينى شديد القرب من السلطة، وكانت الكلمة المعلنة قابلة لأن تستدرج إلى صراعات لا تتحكم فى مسارها.. لا يصبح الصمت انسحابًا، بل معرفة، ولا يتحول الاختفاء إلى ضعف، بل إلى شكل محسوب من أشكال البقاء.
بهذا المعنى، يمكن النظر إلى الرسالة الأولى من رسائل الحكمة بوصفها لحظة تأسيس، لا مجرد افتتاح نصى. فهى تحمل منذ بدايتها اللبنة الأولى لمذهب سيتشكل لاحقًا على فكرة الاختفاء بوصفه شرطًا للانتماء، لا عارضًا طارئًا عليه.
الرسالة لا تعرف الطائفة، ولا تقدم عقيدته فى صيغة مكتملة، لكنها تضع القاعدة التى سيُبنى عليها كل شىء بعد ذلك: المعرفة ليست مشاعًا، والانتماء لا يقاس بالظهور، والحكمة لا تصان إلا إذا بقيت خارج التداول.
لذلك، لم يأت مسار الموحدين الدروز لاحقًا مفاجئًا أو منفصلًا عن نصه الأول.
فالرسالة التى بدأت بنداء فردى، وبشرط صارم للأهلية، كانت تمهد منذ البداية لتجربة دينية ستعرف نفسها بالحدود أكثر مما تعرفها بالانتشار، وبالداخل أكثر مما تعرفها بالخارج. ومن هنا، يصبح الاختفاء ليس علامة ضعف، بل يصبح اختيارًا تأسيسيًا، وامتدادًا طبيعيًا للحظة الميلاد الأولى.
نحن هنا لا نتعامل مع الرسالة بوصفها خطابًا إيمانيًا موجهًا للقارئ، بل بوصفها نصًا تأسيسيًا يمكن من خلاله قراءة الكيفية التى تشكل بها المذهب، وحدود العلاقة التى رسمها منذ البداية بين الانتماء والاختفاء. ومن خلال العودة إلى نصوص أخرى من رسائل الحكمة، نقترب من تحولاته الاجتماعية، وطبيعة علاقته بالسلطة والزمن، كما تعاش وتفهم فى سياقات لاحقة. هذه القراءة لا تسعى إلى الحسم أو التفسير النهائى، بل إلى مقاربة هادئة تحاول تفكيك التجربة بقدر من الحياد.

التوحيد الدرزى: إعادة تعريف خارج منطق الشعائر
لا تأتى الرسالة بوصفها تعريفًا لفضيلة عقلية عامة، ولا باعتبارها موقفًا فلسفيًا مجردًا، إنما شرط تأسيسى للدخول فى التجربة الدينية ذاتها. فالتوحيد، كما تصوغه رسائل الحكمة، لا ينطلق من الإيمان الموروث، أو من الطاعة، لكن من خلال معرفة لا تلقن، ولا تختزل فى نص أو شريعة، وإنما تُبنى تدريجيًا عبر الفهم والتمييز.
هنا- وفقًا للطرح الدرزى- يصبح العقل البوابة الوحيدة لفهم الدين، حيث لا مكان للإيمان بالنيابة، أو للاطمئنان الذى تمنحه الجماعة، ولا للانخراط الذى يسبق الوعى. التوحيد ليس انتماء، بل مسار لا يُقاس بمدى الامتثال، بل بقدرة الفرد على الإدراك.
يضع هذا التصور المذهب منذ لحظته الأولى خارج منطق الأديان الجماهيرية، لا لأنه يحتكم إلى العقل، بل لأنه يجعل المعرفة العقلية شرطًا سابقًا على الانتماء، دون أن يقرنها بدعوة عامة أو شريعة ظاهرة تعيد إنتاج الجماعة. فى هذا السياق، لا يعد غياب الاتساع العددى موقفًا دفاعيًا، بل نتيجة بنيوية لتجربة دينية لا تسعى إلى التبسيط أو التعميم، ولا ترى فى الانتشار غاية فى ذاته.
فى قراءته للتوحيد الدرزى، يلفت سامى مكارم فى كتابه «رسائل الحكمة» (نصوص الستر والكتمان) إلى أن هذا التوحيد لا ينتمى إلى منظومة «الشريعة» بقدر ما ينتمى إلى منظومة «الحكمة». والفرق بينهما جوهرى: فالشريعة تنظم الجماعة، بينما الحكمة تخاطب الفرد. الأولى تحتاج إلى الإعلان، والثانية لا تصان إلا بالكتمان. ومن هنا، يصبح العقل ليس فقط مدخل التوحيد، بل أيضًا أداة فرز تحدد من يقترب، ومن يبقى خارج الدائرة.
ربما يفسر هذا الشرط المعرفى الصارم كثيرًا من الأسئلة التى طرحت لاحقًا حول المذهب: لماذا لم يسع إلى الانتشار؟ لماذا أغلقت الدعوة؟ ولماذا تحولت المعرفة إلى أمانة لا تتداول؟ فالعقل، حين يصبح أساس الانتماء، لا يمكن تعميمه، ولا يصلح أن يكون قاعدة لجماعة واسعة بلا أن يفقد معناه. لكن هذا الخيار المعرفى لا يمكن عزله عن سياقه التاريخى. فالتوحيد الدرزى تشكل داخل لحظة فاطمية شديدة التداخل بين الدين والسلطة، حيث كانت الأفكار الدينية عرضة للاستدعاء السياسى، وكانت العقيدة تستخدم أداة للشرعنة أو الإقصاء. وتحت وطأة هذا الظرف، يصبح التشديد على العقل، لا بوصفه أداة احتجاج، بل كشرط داخلى، نوعًا من الانسحاب المحسوب من منطق الصراع.
هنا، لا يطرح المذهب نفسه كبديل سياسى، أو مشروع سلطوى، بل يتشكل داخل مسار أكثر حذرًا، يفصل بين التجربة الدينية وبين منطق الحكم. دين لا يتجسد فى دولة، ومعرفة لا تدار عبر خطاب عام، وتوحيد لا يقاس بحجم الجمهور. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم لماذا بقى الوعى الداخلى، لا النص الظاهر ولا الطقس الجماعى الضامن الوحيد لاستمرار التجربة؟
بهذا المعنى، يفهم حضور العقل فى التوحيد الدرزى بوصفه شرط بقاء. فالجماعة التى لا تستند إلى شريعة معلنة، ولا إلى طقوس جامعة، لا يحفظها سوى وعيها الداخلى بذاتها، وقدرتها على حماية المعنى من الابتذال، ما يجعل من العقل، منذ البداية، نقطة الارتكاز، ليس فقط كمدخل للتوحيد، بل أساس البناء كله.
الجماعة التى لا تقوم على شريعة معلنة أو طقوس جامعة، يعتمد تماسكها على وعى داخلى مشترك، وعلى قدرة مستمرة على صون المعنى من الابتذال. ومن هنا، يتخذ العقل منذ البداية موقعًا مركزيًا، لا باعتباره مدخلًا للتوحيد فحسب، بل كأحد الأسس التى قام عليها البناء كله.
فى الفهم الإسلامى التقليدى، يرتبط التوحيد بالإيمان بالله ثم بالالتزام بشريعة تنظم علاقة الإنسان بربه وبالجماعة، حيث تتجسد العبادة فى أفعال ظاهرة تتكرر وتمارس علنًا. أما فى التجربة الدرزية، فيعاد تعريف التوحيد بوصفه معرفة عقلية داخلية، تزاح فيها الطقوس إلى الخلف، ويصبح الالتزام الأخلاقى والمعرفى هو التعبير الأساسى عن القرب من الله. هنا يلتقى المساران فى مركزية التوحيد، ويفترقان فى الطريقة التى يترجم بها هذا التوحيد إلى ممارسة وانتماء.
وهنا، لا نسعى إلى تبرير هذا الخيار أو الدفاع عنه، بقدر ما نقرأه بوصفه عنصرًا تأسيسيًا، أسهم فى تشكيل المذهب وحدد مساره اللاحق، ما سيظل حاضرًا، بأشكال مختلفة، فى بقية محاور الطرح.

بين الاختيار والضرورة: السر والتقية
بهذه الصيغة لا يقدم الخوف بوصفه دافعًا أوليًا، ولا تطرح التقية كحيلة بقاء، بل كطريقة لإدارة المعرفة وحدود ظهورها، ما يعنى أن الكتمان فى رسائل الحكمة ليس نتيجة طارئة لاضطهاد لاحق، ولا استجابة ظرفية لعنف السلطة، بل جزء من تصور أوسع للمعرفة: ما لا يقال علنا ليس لأنه محرّم، بل لأنه غير صالح للتداول.
من هذه الزاوية، لا تفهم التقية باعتبارها نقيض الصدق ولكن تنظيم للقول. فالكلمة، حين تخرج من سياقها، لا تفقد معناها فقط، بل قد تنقلب على صاحبها، أو تستدعى فى صراع لم تكتب له. وهنا، يصبح الصمت ليس غيابًا عن المجال العام، بل وعى بكلفته.
ومع ذلك، تاريخيًا، لا يمكن فصل هذا التصور عن اللحظة التى تشكل فيها المذهب. فالدعوة الدرزية- فى كل الأحوال- خرجت من رحم الدولة الفاطمية، فى زمن كان فيه الدين شديد التداخل مع السلطة فى مثل هذا السياق لا يبدو الإعلان الدينى بالتزام التقية فعلًا بريئًا، ولا يكون خيار الكتمان مجرد توصية نصية، لكنه أفق عملى لإدارة العلاقة مع الواقع.
بعد إغلاق باب الدعوة، اكتسب السر وظيفة إضافية. لم يعد حماية للمعرفة فحسب، بل وسيلة لتنظيم الوجود العام. الجماعة التى قررت عدم التوسع، احتاجت إلى مسافة واضحة بينها وبين المجال السياسى، لا عبر المواجهة، إنما عبر تقليل الظهور. التقية، بهذا المعنى، ليست نقيضًا للانتماء، بل إحدى طرق الحفاظ عليه.
فى قراءة تاريخ الدروز، يلفت كمال الصليبى النظر إلى أن هذا الميل إلى السرية لم يمنعهم من التفاعل السياسى حين اقتضت الضرورة، لكنه جعل هذا التفاعل محسوبًا، وغير قائم على خطاب دينى معلن. فالسياسة هنا تدار من موقع الجماعة، لا من موقع العقيدة المعلنة، ما يفسر قدرتهم على التكيف مع سلطات متعاقبة دون ذوبان كامل أو تمرد شامل. فقد كان حضورهم قائمًا على البراجماتية والحذر، لا على الاصطدام أو الذوبان. سياسة بلا شعارات دينية، ومشاركة محسوبة لا تعرف الجماعة من خلالها نفسها.
قد يكون من الإنصاف هنا، التمييز هنا بين التقية بوصفها خيارًا تأسيسيًا، وبينها بوصفها ضرورة تاريخية. ففى لحظات الضغط والاضطهاد، تحول الكتمان إلى أداة حماية مباشرة، لكن هذا التحول لم يكن قطيعة مع الأصل، بل امتداد له. فالمذهب الذى قام منذ بدايته على فكرة أن المعرفة لا تقال لكل أحد، كان مهيأ لتحويل هذا المبدأ إلى سياسة بقاء حين تغيرت الظروف.
فى الطرح الإسلامى الشائع، يقوم الإعلان بالدعوة، والجهر بالشعائر، بدور أساسى فى تثبيت الهوية الدينية وبناء الجماعة، حيث ينظر إلى إظهار الانتماء بوصفه فعلًا إيجابيًا. أما فى التجربة الدرزية، فيعاد تعريف العلاقة بين الدين والظهور؛ إذ لا يعد الكتمان نقيضًا للإيمان، بل أصبح جزءًا من تنظيمه. هنا يلتقى المساران فى مركزية الدين فى حياة الفرد، ويفترقان فى طريقة حضوره فى المجال العام: حضور يبنى على الإعلان، وآخر يدار عبر الانسحاب المحسوب.
فى المحصلة، لا يمكن اختزال السر والتقية فى التجربة الدرزية فى كونهما حيلتين دفاعيتين، ولا فى كونهما تعبيرًا عن خوف دائم. إنهما، فى جوهرهما، خياران تشكلا عند تقاطع الفكر بالتاريخ: فكر يرى أن المعرفة تصان بالحد، وتاريخ يعلم أن الظهور غير المحسوب قد يكون كلفة لا ضرورة لطائفة اختارت أن تدير وجودها العام من موقع الحذر، لا من موقع المواجهة.
لا نسعى هنا، إلى تبرير هذا الخيار أو تحميله قيمة أخلاقية مطلقة، لكن إلى قراءته بوصفه أحد المفاتيح التى تساعد فى فهم علاقة المذهب بالسلطة، وبالزمن، وبفكرة البقاء نفسها، ما سيمهد الطريق للانتقال إلى السؤال التالى: كيف تدار الطاعة حين لا تكون هناك دولة دينية، ولا مشروع حكم؟

الحدود من الفكرة إلى التنظيم
لا يتحدث النص الدرزى هنا عن حدود بالمعنى الفقهى أو القانونى، ولا عن مراتب اجتماعية تنتج سلطة ظاهرة، لكنه يعبر عن نظام داخلى للمعرفة. فـ«الحدود» فى رسائل الحكمة ليست حواجز إقصاء، بقدر ما هى شروط وصول، وآلية تضبط حركة الاقتراب من المعرفة الدينية، وتحدد متى تقال، ولمن، وبأى استعداد.
منذ هذه اللحظة، تتحول المعرفة الدينية، كالتوحيد مثلًا من فكرة مجردة إلى بنية منظمة. فالمعرفة التى لا توزع بالتساوى، ولا تعطى دفعة واحدة، تحتاج إلى نظام يحكم انتقالها، وإلى مراتب تضمن ألا تستدعى قبل أوانها. بذلك، لا يعود الحد قيدًا، بل آلية حماية، ولا تتحول المرتبة إلى امتياز، بل إلى مسئولية معرفية.
ضمن هذا الإطار، لا تفهم «الحدود» بوصفها سلطة تمارس من أعلى، بل باعتبارها تنظيمًا للمعرفة قبل أن تكون تنظيمًا للجماعة. فالدخول ليس مفتوحًا، والاقتراب ليس متاحًا للجميع، لا لأن المعرفة نخبوية بالمعنى الاجتماعى، بل لأنها، فى هذا التصور، قابلة للتشوه إذا خرجت من سياقها أو قدمت بلا استعداد.
هنا تبدأ ملامح التحول من تجربة فكرية إلى جماعة ذات تنظيم داخلى. فحين تحاط المعرفة بالحدود، يصبح لا بد من بنية تحفظ هذا التدرج، وتميز بين من يعرف، ومن يمهد له أن يعرف، ومن يظل خارج الدائرة. عند هذه اللحظة، يبدأ الاجتماع الدينى فى التشكل، لا بوصفه تجمعًا بشريًا واسعًا، بل كجماعة معرفة.
يشير سامى مكارم إلى أن فكرة الحدود فى التوحيد الدرزى لا تهدف إلى إنتاج سلطة دينية بالمعنى التقليدى، بل إلى منع تحول المعرفة إلى خطاب عام قابل للتداول أو التوظيف. فالمعرفة، حين تفصل عن شرطها، تفقد معناها، وحين تتاح بلا حدود، تتحول إلى رأى، لا إلى يقين. وتفقد قدرتها على توجيه السلوك أو حفظ الجماعة.
ومن هنا، يمكن فهم كيف مهدت الحدود لانتقال المذهب من فكرة توحيدية باطنية إلى جماعة ذات تنظيم مغلق نسبيًا. فالجماعة هنا لا تقوم على وحدة الطقس، ولا على شريعة ظاهرة، بل على تدرج معرفى يجعل الانتماء نتيجة لمسار، لا شرطًا مسبقًا له. وهكذا، يصبح التنظيم امتدادًا طبيعيًا للفكرة، لا انحرافًا عنها.
ولا يمكن فصل هذا التنظيم عن الظرف السياسى الأوسع، حيث كانت المعرفة المعلنة تتحول بسرعة إلى أداة صراع، شكلت الحدود وسيلة لضبط العلاقة مع الخارج. لم يكن الهدف بناء سلطة موازية، بل تجنب التحول إلى طرف فى صراع لا يملك السيطرة عليه.
وإذا قورنت هذه البنية بما هو شائع فى الممارسة الدينية الإسلامية، سنجد أن الجماعة الدينية تنظم عبر الشريعة والفقه، حيث تحدد الأدوار والمراتب على أساس العلم بالأحكام، وتدار العلاقة بين الفرد والجماعة من خلال منظومة ظاهرة من الواجبات والالتزامات. أما فى المعتقد الدرزى، فتقوم «الحدود» بدور مختلف؛ إذ تنظم المعرفة قبل أن تنظم الجماعة، ويبنى التماسك من الداخل، عبر ضبط الوصول والتدرج، لا عبر الإلزام العلنى.. هنا يلتقى المساران فى الحاجة إلى التنظيم، ويفترقان فى طبيعته: تنظيم يدار بالظاهر، وآخر يبنى على التدرج المعرفى.
بهذا المعنى، لا تمثل الحدود قطيعة مع الفكرة الأولى للتوحيد، بل تحولها إلى نظام قابل للاستمرار. فالفكرة التى لا تتحول إلى بنية، تذوب أو تُستدعى فى غير موضعها. ومن هنا، تصبح الحدود أحد الأعمدة التى قام عليها المذهب، لا باعتبارها أداة ضبط اجتماعى فقط، بل كآلية لحماية المعنى، وتنظيم العلاقة بين المعرفة، والانتماء، والجماعة.

دين بلا دولة: إدارة العلاقة مع السلطة
تحيل رسائل الحكمة فى أكثر من موضع إلى قيم الصدق والولاء، وحفظ الجماعة، والالتزام بالنظام بوصفه شرطًا للاستمرار. لا تأتى هذه الإشارات فى سياق تنظير سياسى، ولا تطرح باعتبارها فقه حكم أو تصورًا للسلطة، فهى لا تتناول السلطة بوصفها موضوعًا دينيًا، بقدر ما تحذّر من كلفة الفوضى حين تفقد الجماعة قدرتها على ضبط وجودها العام، وتتحول إلى طرف فى صراع مفتوح لا تملك أدواته.
من هذا المدخل، لا يمكن قراءة علاقة الدروز بالسلطة باعتبارها علاقة طاعة نصية، ولا موقفًا عقديًا من الحكم. فالدين، فى هذا التصور، لا يتقدم ليصوغ دولة، ولا ينتج خطابًا يشرعن السلطة أو ينازعها، بل يختار مسارًا عمليًا أكثر حذرًا: البقاء داخل المجال السياسى دون الذوبان فيه، ودون تحويل العقيدة إلى برنامج مواجهة.
هذا الخيار لم يكن انعزالًا عن السياسة، ولا انسحابًا من التاريخ، بل نتيجة إدراك مبكر لكلفة تسييس الدين. فحين يتحوّل الدين إلى لغة حكم، يصبح عرضة للاستدعاء القسرى إلى صراعات تتجاوز حدود الجماعة وقدرتها على الاحتمال؛ لذلك، تشكّلت علاقة واقعية مع الدولة، تقوم على قبول الإطار العام للنظام، مقابل الحفاظ على استقلال البنية الداخلية وعدم فتح العقيدة على المجال العام.
فى قراءة تاريخية لمسار الدروز، يشير كمال الصليبى إلى أن هذا الأسلوب فى التعامل مع الحكم أتاح لهم العبور بين سلطات متعاقبة، من دون أن يتحوّلوا إلى أداة فى يدها، ولا إلى خصم دائم لها. حضور عام بلا شعارات دينية، وسياسة تُدار من دون استدعاء العقيدة إلى الواجهة، إلا فى لحظات الضرورة القصوى، وبالقدر الذى يحفظ تماسك الجماعة.
ولا يعنى ذلك غياب الفعل العام أو القبول الدائم بالأمر الواقع. فالطائفة، عبر تاريخها، دخلت فى تحالفات، وواجهت سلطات، وغيّرت مواقعها السياسية بحسب الظروف. غير أن هذا الحضور لم يتحوّل إلى مشروع دينى معلن، ولم يُصغ فى قالب فقهى يبرّر الحكم أو يعارضه باسم العقيدة. السياسة هنا تُمارَس كضرورة ظرفية، لا كامتداد للنص. وعند وضع هذا المسار فى مقارنة مع المنظور الإسلامى التقليدى، تظهر فروق واضحة فى ترتيب العلاقة بين الدين والدولة. ففى التجربة الإسلامية السائدة، نشأ فقه سياسى واسع ينظّم شئون الحكم، ويبحث فى شرعيته، وحدود الطاعة، وأشكال المعارضة. الدين هناك دخل مبكرًا فى سؤال السلطة، وأنتج خطابًا يرافق الدولة أو ينازعها. أمّا فى المتصوّر الدرزى، فقد بقى هذا السؤال خارج النص، وتُرك ليُدار عبر الخبرة التاريخية والميزان السياسى، لا عبر التقعيد النظرى.
ووفقًا لذلك، لا ينظر إلى مفاهيم مثل النظام أو الالتزام باعتبارها تعبيرًا عن خضوع، بل كوسائل لتجنّب التفكك. فالسلطة تُقبل بقدر ما تحافظ على الإطار العام، وتُقاوَم فقط حين تهدّد الوجود ذاته. وبين القبول والمواجهة، ظلّت مساحة واسعة للتكيّف، هى التى سمحت للجماعة بالبقاء داخل تحوّلات سياسية عنيفة، من دون أن تفقد هويتها أو تتحوّل إلى مشروع صراع دائم. بهذه الطريقة، لا يبدو خيار «الدين بلا دولة» انسحابًا من السياسة، بل أسلوب مختلف فى إدارتها. دين لا يسعى إلى الحكم، لكنه يدرك كلفته. ولا يرفع شعارات، لكنه يعرف كيف يحمى حضوره العام، ويؤجّل الصدام حين يكون استنزافًا بلا أفق.
لا يُقدَّم هذا المسار بوصفه نموذجًا معياريًا يُحتذى أو حالة استثنائية تُدان، بل تجربة تاريخية تشكّلت عند تقاطع الدين بالسياسة، واختارت أن تفصل بينهما بوصف ذلك خيار بقاء، لا تعبيرًا عن ضعف ولا ادّعاء تفوّق.

من العقيدة إلى الهوية: حين يتحوّل الدين إلى إطار وجودى
لا يظهر التحوّل من العقيدة إلى الهوية فى الحالة الدرزية كقفزة مفاجئة، أو كنتيجة قرار واعٍ اتُّخذ فى لحظة بعينها، بل كمسار تراكمى فرضته شروط التاريخ وطبيعة التنظيم الداخلى. فالمذهب الذى بدأ بوصفه تصورًا معرفيًا خاصًا، ومعرفة مشروطة بالكتمان والتدرّج، وجد نفسه مع الوقت أمام سؤال مختلف: كيف يستمر من دون توسّع؟ وكيف يحافظ على نفسه من دون دعوة مفتوحة؟
مع إغلاق باب الدعوة، لم يعد الانتماء مسألة اختيار فردى قائم على الاقتناع وحده، بل صار مرتبطًا بالميلاد والجماعة. هنا، لم تختفِ العقيدة، لكنها انسحبت من المجال العام، وراحت تعمل بوصفها إطارًا ناظمًا للحياة أكثر من كونها خطابًا معلنًا. الدين لم يعد محل جدل، بل صار خلفية ثابتة تُشكّل السلوك، وتضبط العلاقات، وتحدّد من هو داخل الدائرة ومن خارجها.
وقد لعب التنظيم الداخلى دورًا حاسمًا فى هذا الانتقال. فالمعرفة التى تُنقل بالتدرّج، والحدود التى تضبط الاقتراب، والكتمان الذى يحمى ما لا يُقال، كلّها عناصر أسهمت فى تحويل العقيدة إلى هوية معيشة. الانتماء غير معلن، ولا يُبرهَن عليه بالشعائر، لكنه يُفهم ضمنيًا، ويُمارَس فى تفاصيل الحياة اليومية، من الزواج إلى التضامن الاجتماعى، ومن إدارة الخلاف إلى العلاقة مع الخارج.
كما يوضح أنيس فريحة فى دراساته عن الدروز والمجتمع القروى اللبنانى، فإن الانتماء فى هذه الجماعات لا يتشكّل عبر الدعوة أو الخطاب العقائدى، بل عبر الاستمرارية الاجتماعية، ونقل أنماط العيش وقواعد الانتماء داخل الجماعة بوصفها ممارسة يومية مستقرة. لافتًا، إلى أن هذا النمط من التحوّل ليس فريدًا، لكنه فى الحالة الدرزية أكثر وضوحًا بسبب غياب الدعوة واستقرار الجماعة فى بيئات محددة. فالهوية هنا لا تُبنى على الإقناع أو الاستقطاب، بل على الاستمرارية، وعلى نقل نمط العيش من جيل إلى جيل بوصفه أمرًا بديهيًا لا يحتاج إلى شرح دائم.
ومع مرور الزمن، أصبحت الجماعة هى الحاضنة الأساسية للعقيدة، لا النص وحده. فالانتماء لم يعد مرتبطًا بالمعرفة التفصيلية بالمذهب، بقدر ما ارتبط بالاندماج فى شبكة اجتماعية مغلقة نسبيًا، تقوم على القرابة، والذاكرة المشتركة، وتجربة تاريخية واحدة. وبهذا، تحوّلت العقيدة من مركز ظاهر إلى نواة صامتة تدور حولها الهوية.
هذا التحوّل لم يكن خاليًا من التوتر. فحين يصير الدين هوية، تتغيّر علاقته بالآخر. لم يعد الآخر مخاطَبًا بالدعوة، بل مُعرَّف بوصفه خارج الجماعة. لا خصومة بالضرورة، أو سعيًا إلى صدام، لكن ثمّة حدودًا واضحة لا تُكسر. الهوية هنا تعمل بوصفها آلية حماية، لا أداة توسّع، وتعيد إنتاج نفسها عبر الانغلاق النسبى وليس الانتشار.
وعند النظر إلى هذا المسار بالمقارنة مع التجربة الإسلامية العامة، يظهر اختلاف جوهرى. ففى السياق الإسلامى السائد، ظلّ الدين يحمل طابعًا كونيًا، ودعوة مفتوحة، وهوية قابلة للاتساع. الانتماء هناك يُكتسب، ويمكن أن يتغيّر، ويُعرَّف أساسًا عبر الإيمان والممارسة. أمّا فى الحالة الدرزية، فقد تحوّل الانتماء إلى رابطة وجودية واجتماعية، تُورَّث بقدر ما تُعاش، وتُحاط بسياج من الأعراف والتنظيمات غير المكتوبة.
لكن ذلك لا يعنى أن العقيدة تلاشت أو فقدت معناها، بل إنها غيّرت موقعها. من خطاب يُقال، إلى إطار يُعاش. من نص يُستشهد به، إلى هوية تُمارَس. وفى هذا الانتقال، كسبت الجماعة قدرة عالية على الاستمرار، لكنها دفعت فى المقابل ثمن الانغلاق، والالتباس الدائم فى علاقتها بالعالم الخارجى.
إذن لا يمكن تفسير الدروز بوصفهم مجرد جماعة دينية، أو اختزالهم فى هوية اجتماعية صلبة. هم نتاج تداخل معقّد بين عقيدة اختارت الكتمان، وتنظيم فرض التدرّج، وتاريخ علّم الجماعة أن البقاء لا يتحقّق دائمًا عبر الظهور. ومن هذا التداخل، تشكّلت هوية لا تبحث عن الاعتراف، بقدر ما تسعى إلى الحفاظ على ذاتها.

النشأة والطقوس: العقيدة الدرزية من الداخل
لا تدار النشأة الدينية فى التجربة الدرزية بوصفها انتقالًا تدريجيًا إلى العقيدة، فهى لا تبدأ بتعليم منظّم للنصوص أو الطقوس، لكن تنطلق من إدراك مبكّر لوجود حدّ. يولد الفرد داخل جماعة دينية مكتملة البنية، ويتعلّم منذ الطفولة أن الدين ليس مجالًا مفتوحًا للقول، ولا موضوعًا للعرض، بل إطار يُعاش ويُحترم.
فى هذا السياق، لا يُقدَّم الدين للأطفال بوصفه منظومة اعتقاد جاهزة، بل سلوكًا يوميًا. حيث تُنقل الهوية قبل المعرفة الدينية، ويُرسَّخ الإحساس بالانتماء قبل السؤال. ومع الوقت، يتكوّن وعى ضمنى بأن هناك مستويات داخل الدين نفسه، وأن ما يُطلب من الجميع ليس ما يُطلب من القلّة. فالصمت هنا ليس نقصًا فى التعليم، بل جزء من التربية.
يقوم البناء الدينى الدرزى على تراتبية واضحة، لا اجتماعية بل معرفية وروحية. ينقسم المجتمع دينيًا إلى عُقّال وجهال، من دون أن يحمل هذا التقسيم حكمًا أخلاقيًا أو قيمة تفضيلية بالمعنى الشائع. الغالبية تعيش الدين بوصفه هوية وسلوكًا عامًا، بينما يختار العُقّال الدخول إلى مستوى آخر من الالتزام والمعرفة، وفق شروط صارمة تتعلّق بنمط الحياة والانضباط الأخلاقى، لا بالمكانة أو الوراثة.
الدخول إلى موقع «شيوخ العقل» ليس حقًا مكتسبًا بالميلاد، ولا مسار إلزامى، بل خيار فردى واعٍ، تُفهم المعرفة فيه بوصفها مسئولية لا امتيازًا. لهذا، لا يُدفع الأفراد إلى هذا الطريق، ولا يُقاس التدين بالاقتراب منه. الدين هنا يقبل التفاوت، ويعترف بأن حمل المعرفة ليس مطلوبًا من الجميع.
تلعب الخلوة دورًا مركزيًا فى هذا البناء، لا بوصفها فضاء عبادة جماعية مفتوحة، بل كحيّز داخلى تُدار فيه المعرفة، ويُحفظ فيه التدرّج. ليست الخلوة بديلًا عن المسجد، ولا مؤسسة دعوية، بل مساحة خاصة للانضباط والتعلّم، مرتبطة بالمرتبة الدينية لا بالانتماء العام. الطقس هنا مرتبط بالموقع داخل البناء، لا بإعلان الهوية.
من هذه الزاوية، يمكن فهم الغياب النسبى للشعائر العلنية فى الحياة الدرزية. فالدين لا يُقاس بما يُؤدّى أمام الآخرين، بل بما يُلتزم به فى الداخل. الصوم، على سبيل المثال، ليس منفيًا ولا مرفوضًا، لكنه غير مفروض جماعيًا ولا مُعلَن اجتماعيًا. هناك من يصوم، ومن لا يصوم، دون أن يتحوّل ذلك إلى معيار انتماء أو أداة تصنيف. الشعيرة تُنزَع عنها وظيفتها الإعلانية، وتُعاد إلى نطاقها الفردى.
كذلك الأمر مع بقية الممارسات. العبادة لا تُختبر بالتكرار، ولا تُقاس بالظهور، بل تُفهم كالتزام أخلاقى وسلوكى. ولهذا، كثيرًا ما يُساء تفسير الصمت الطقسى بوصفه غيابًا للدين، بينما هو فى الواقع تعبير عن ترتيب مختلف للعلاقة بين الإيمان والمجال العام.
وفى مقابل هذا الصمت، يبرز حضور رمزى واضح لشخصية النبى شعيب فى الوعى الدينى الدرزى. لا يُفهم هذا الحضور بوصفه تقديسًا خارج التوحيد، ولا تعظيمًا منفصلًا عن السياق النبوى العام، بل كاستدعاء لنموذج أخلاقى يرتبط بالحكمة والعدل والصبر. مقامه يحظى بمكانة رمزية، وزيارته تُقرأ باعتبارها تواصلًا مع معنى أخلاقى، لا ممارسة شعائرية بديلة.
هذا الترتيب الداخلى للدين ينعكس مباشرة على النشأة. فالطفل ينشأ وهو يدرك أن الدين له داخل وخارج، وأن المعرفة ليست متاحة للجميع بالطريقة نفسها. لا يُدفع إلى السؤال، ولا يُمنع منه، لكنه يتعلّم أن الاقتراب مشروط، وأن الانتماء لا يُقاس بالفضول بل بالضبط. هكذا، يتكوّن وعى دينى يقوم على احترام الحدّ قبل تجاوزَه.
وعند مقارنة هذا البناء بالفهم الإسلامى التقليدى، يظهر اختلاف جوهرى فى منطق التديّن. ففى الإسلام، تقوم الشعائر بدور مركزى فى إعلان الانتماء، وتُمارَس علنًا بوصفها جزءًا من الهوية الجماعية. النص متاح، والعبادة مفروضة، والعلم الدينى فضيلة مفتوحة لكل من يسعى. أمّا فى المتصوّر الدرزى، فالدين يقوم على التخصيص لا العموم، وعلى التدرّج لا الإعلان، وعلى المسئولية المعرفية لا الممارسة الجماعية.
ومع ذلك، لا يمكن قراءة النشأة والطقوس فى التجربة الدرزية بوصفهما نقصًا أو استثناءً، بل كجزء من اختيار أوسع: نقل الدين من الساحة العامة إلى الداخل، ومن الشعيرة إلى السلوك، ومن الإعلان إلى العيش. اختيار لا يسعى إلى الغموض لذاته، بل إلى حماية الدين من أن يتحوّل إلى عادة، أو أن يُستدعى فى غير موضعه.

الدروز فى الدولة الوطنية: التفاوض مع الزمن والسلطة
يضع هذا النص إطارًا أخلاقيًا عامًا لا يتعلّق بزمن بعينه، لكنه يفتح باب القراءة على مسألة أساسية: إدارة الظهور فى عالم متغيّر. فالحكمة هنا لا تُقدَّم بوصفها معرفة تُعلن، بل مسئولية تُحفظ، ويُعاد تقدير توقيت إظهارها بحسب السياق. ومن هذا المنظور، يمكن فهم علاقة الدروز بالدولة الوطنية الحديثة، لا كموقف عقائدى ثابت، بل كمسار تفاوض طويل مع واقع سياسى متحوّل.
مع تشكّل الدولة القومية فى المشرق، تغيّرت شروط الوجود العام جذريًا. الحدود الصلبة، والمواطنة القانونية، ومركزية السلطة، كلّها عناصر فرضت نفسها على جماعات اعتادت العمل ضمن توازنات محلية وعلاقات غير مباشرة مع الحكم. بالنسبة للدروز، لم يكن هذا التحوّل امتدادًا طبيعيًا لتجربتهم التاريخية، التى تشكّلت فى الغالب داخل أنظمة إمبراطورية مرنة، أو فى فضاءات محلية تقوم على التوازن أكثر مما تقوم على الدمج الكامل. ومع ذلك، لم يُقابَل بخطاب رفض أو مواجهة أيديولوجية. ما ظهر بدلًا من ذلك كان سلوكًا سياسيًا براجماتيًا، يختبر حدود الدولة من الداخل، ويعيد التموضع بحسب ما يتيحه الزمن.
فى لبنان، شكّلت الدولة الوطنية مساحة تفاوض مفتوحة. شارك الدروز فى الحياة السياسية بوصفهم مكوّنًا تاريخيًا فى الجبل، لا جماعة دينية تحمل مشروعًا خاصًا. دخلوا البرلمان والحكومة، وأسهموا فى بناء النظام الطائفى نفسه، لا من موقع الهيمنة، بل من موقع الشريك الحذر. حتى خلال الحرب الأهلية، لم يتحوّل الخطاب الدرزى إلى خطاب دينى تعبوى، بل ظل سياسيًا محليًا، مرتبطًا بالأرض والتمثيل والميزان الداخلى. وبعد الحرب، عاد الاندماج فى الدولة لا بوصفه انتصارًا أيديولوجيًا، بل تسوية ضرورية.
لكن فى سوريا، بدت المعادلة أشدّ حساسية. الدولة المركزية، ثم النظام الأمنى، فرضا نمطًا من الاندماج القسرى المشروط. لم يكن هناك مجال لخطاب طائفى علنى، ولا إمكانية لمشروع سياسى مستقل. ومع ذلك، لم تُمحَ الجماعة، بل أعادت تنظيم وجودها عبر ولاء عام للدولة، يقابله احتفاظ صارم بالخصوصية الاجتماعية والدينية فى الداخل. وخلال العقود الطويلة من حكم البعث، ظلّ الوجود الدرزى محكومًا بمعادلة دقيقة: اندماج سياسى شكلى، مقابل استقلال اجتماعى غير مُعلَن ومع اندلاع الصراع السورى، ظهر هذا التوازن بوضوح فى تردّد الجماعة بين الانخراط الكامل والانسحاب الحذر، وتفضيل حماية الداخل على خوض صراع مفتوح لا تملك أدواته.
أمّا فى إسرائيل ، فقد وُضع الدروز أمام اختبار مختلف. دولة تُعرّف نفسها على أساس قومى/دينى، وتطالب الأقليات بتحديد موقعها بوضوح داخل مشروعها. هنا، لم يكن التكيّف اختيارًا حرًا، بل استجابة لواقع مفروض. ومع ذلك، لم يتحوّل الانخراط فى مؤسسات الدولة إلى إعلان عقائدى أو دينى. جرى التفاوض بلغة المواطنة والحقوق والخدمة المدنية، لا بلغة الدين أو الدعوة. ظلّت العقيدة فى الخلفية، حاضرة فى الداخل، غائبة عن التعبئة أو المواجهة الأيديولوجية.
ربما ما يجمع هذه المسارات المتباينة هو غياب أى محاولة لتحويل الدين إلى برنامج سياسى أو أداة تعبئة. لم يظهر مشروع درزى عابر للحدود، ولا خطاب دينى يسعى إلى توحيد الجماعة خلف شعارات كبرى. ظلّ الدين عنصرًا منظّمًا للداخل، لا راية تُرفع فى المجال العام. السياسة، فى المقابل، أُديرت بلغة الواقع وتوازن القوى، لا بلغة النص أو العقيدة.
وعند وضع هذا المسار فى مقاربة مع تجارب إسلامية معاصرة داخل الدولة الوطنية، يتضح الفارق. ففى حالات كثيرة، تحوّل الدين إلى لغة احتجاج أو مشروع حكم، وارتبطت الهوية الدينية بخطاب أيديولوجى صدامى مع الدولة. أمّا فى الحالة الدرزية، فقد جرى اختيار طريق آخر: التفاوض بدل المواجهة، والتكيّف بدل التعبئة، والحضور الهادئ بدل الخطاب العالى. ليس لأن السياسة غائبة، بل لأن استدعاء العقيدة إلى الصراع كان يُنظر إليه كخسارة مؤكدة.
بالتالى لا ينظر إلى حضور الدروز فى الدولة الوطنية على أنه اندماج كامل أو عزلة متعمّدة، إنما كاستراتيجية بقاء تشكّلت على وعى بتاريخ طويل من التحوّلات. الدولة مرحلة، لا نهاية. والسلطة طور، لا قدرًا ثابتًا. ومن هذا الإدراك، جاء الحرص على عبور الأزمنة بأقل قدر من الصدام، والحفاظ على الجماعة خارج منطق الأيديولوجيا، وداخل منطق الزمن.

هل الدروز دين أم مصير؟
لا تقدم الرسالة هنا إجابة جاهزة، بقدر ما تضع القارئ أمام سؤال مفتوح: أين تقف المعرفة من المصير؟ وهل يكفى الإيمان أو الانتماء لفهم ما تؤول إليه الجماعات عبر الزمن؟ عند هذا الأفق المفتوح يمكن الاقتراب من الإشكالية التى ظلّت تلاحق الدروز طويلًا، وتعود للظهور كلما أُعيد طرح موقعهم فى التاريخ والدين والسياسة.
هل الدروز مذهب دينى؟
من زاوية النص والعقيدة نعم، فالتجربة الدرزية تقوم على تصور توحيدى خاص، وبنية معرفية مغلقة، ومرجعية نصية تتمثّل فى رسائل الحكمة، التى لا تُقدَّم بوصفها كتابًا مقدسًا متداولًا، بل كنص مؤسِّس للمعنى، يُقرأ فى الداخل ويُدار بمنطق التدرّج والكتمان. هذه الرسائل لا تضع عقيدة جاهزة للعرض، ولا ترسم نظامًا شعائريًا جامعًا، لكنها تؤسس لفهم مختلف للعبادة والانتماء، يقوم على المعرفة المشروطة أكثر مما يقوم على الإعلان.
ومع ذلك، لا يكفى هذا البعد الدينى وحده لشرح المسار الدرزى بكامله. فالدين هنا لا يعمل كدعوة مفتوحة، ولا كخطاب يسعى إلى الاتساع، بل كمعرفة تُحفظ أكثر مما تُعلن، وتنتقل بالتدرّج لا بالانتشار. من هذا الموقع، تصبح رسائل الحكمة أقل حضورًا كنص يُستشهَد به علنًا، وأكثر فاعلية كنظام مرجعى صامت، يضبط الداخل، ويحدّد شكل العلاقة بين النص والجماعة والزمن.
وهل هم جماعة تاريخية؟
الإجابة أيضًا نعم. فالتجربة الدرزية لا يمكن فصلها عن الجبل، وعن الذاكرة الجماعية، وعن شبكة علاقات اجتماعية تشكّلت عبر قرون من العيش المشترك والصراع والتكيّف. التاريخ هنا ليس خلفية محايدة، بل عنصر فاعل فى تشكيل الهوية، وفى إعادة تعريف معنى الانتماء وحدوده. الجماعة لم تُبنَ فقط على النص، بل على التجربة، وعلى ما علّمه الزمن من كلفة الظهور والمواجهة.
لكن السؤال الأعمق يظل: هل يمكن فهم الدروز بوصفهم استراتيجية بقاء طويلة المدى؟
السؤال لا يحمل اتهامًا ولا مديحًا، لكنه محاولة لقراءة مسار اختار، منذ لحظته الأولى، تقليل الخسائر بدل البحث عن الغلبة. كتمان المعرفة، غياب الدعوة، تحييد العقيدة عن الصراع السياسى، التفاوض مع السلطة بدل مواجهتها، تحويل الدين إلى إطار عيش لا خطاب تعبئة.. كلّها اختيارات لا تُفهم بمعزل عن هاجس الاستمرار. هنا، لا يعود البقاء نتيجة عشوائية، بل نتاج وعى مبكر بأن التاريخ لا يرحم الجماعات التى ترفع نفسها إلى الواجهة فى كل لحظة.
فى هذا الإطار، لا يبدو السؤال عن كون الدروز دينًا أو جماعة أو مصيرًا سؤالًا قابلًا لإجابة واحدة. فهم دين فى بنيتهم المعرفية، وجماعة فى تكوينهم الاجتماعى، ومصير فى الطريقة التى أعادوا بها إنتاج أنفسهم عبر الزمن. لا يُختزلون فى عقيدة خالصة، ولا فى هوية اجتماعية صمّاء، أو فى مناورة سياسية عابرة، بل فى تداخل معقّد بين الثلاثة.
وهنا تحديدًا يتبدّد كثير من إشارات سوء الفهم. فالغموض الذى يُنسب إلى الدروز ليس غموض عقيدة بقدر ما هو غموض تجربة اختارت أن تعيش على الهامش لا خارجه، وأن تحضر من دون ضجيج، وأن تفاوض الزمن بدل أن تتحدّاه. هذا الاختيار قد يُقرأ بوصفه تحفظًا، أو حذرًا مفرطًا، لكنه فى الوقت نفسه يفسّر قدرة الجماعة على عبور قرون من التحوّلات من دون أن تفقد ذاتها. ومن ثم لا يسعى الطرح إلى حسم السؤال، بل إلى تفكيكه. لا ليقول ما يجب أن يكون عليه الدروز، بل ليشرح كيف صاروا ما هم عليه اليوم. فالمسألة فى النهاية ليست تصنيفًا دينيًا ولا حكمًا سياسيًا، لكنها محاولة لفهم تجربة إنسانية عاشت عند تقاطع معقد من الدين والتاريخ والسلطة، وخرجت من هذا التداخل بهوية لا تبحث عن الاعتراف، بقدر ما تسعى إلى النجاة.
ربما يكون السؤال الأدق، بعد كل ما سبق، ليس: هل الدروز دين أم جماعة أم مصير؟ بل: كيف نجحت جماعة صغيرة، ذات عقيدة مغلقة، فى تحويل الحذر إلى أسلوب حياة، والمعرفة إلى سياج، والزمن إلى حليف؟
هنا، لا تنتهى الحكاية بإجابة قاطعة، بل تُترك مفتوحة.. كما أرادتها التجربة نفسها.