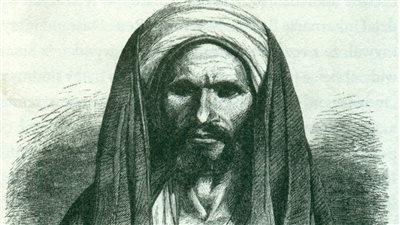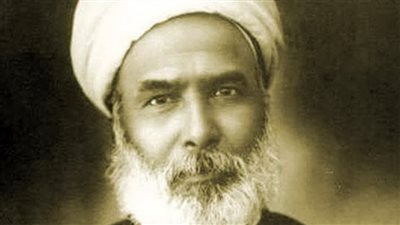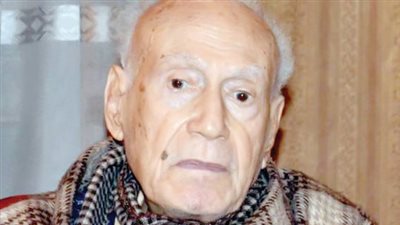القصة القصيرة.. التحولات والأنساق الجديدة

- مع تصاعد أدوات الذكاء الاصطناعى بدأت تظهر قصص مكتوبة جزئيًا أو كليًا عبر خوارزميات
تُعدّ القصة القصيرة أحد الأشكال الأدبية التى عرفت تحولات جوهرية منذ نشأتها الحديثة فى القرن التاسع عشر، غير أن جذورها تضرب فى أعماق التراث السردى العالمى. لقد مثّلت دائمًا جنسًا أدبيًا مرنًا، يتشكل وفق الحوامل الثقافية والتقنية التى تحيط به. فهى شكل سردى يُبنى على الاقتصاد اللغوى، والتكثيف الدلالى، والانحياز للحظة الشعورية أو الحدث المفصلى. ومع التحولات المعاصرة فى وسائط التعبير والقراءة، عادت القصة القصيرة إلى صدارة المشهد بوصفها الشكل الأكثر قدرة على التكيف مع إيقاع العصر.
القصة القصيرة ليست فنًا عابرًا ولا صيغة أدبية ثانوية، بل هى مرآة حية لتحولات الذائقة الإنسانية. لقد أثبتت قدرتها على التكيّف والانتقال من الورق إلى الشاشة، من الواقعى إلى الهجينى. وفى عالم يتجه إلى اللا مركزية فى التلقى والإنتاج، يبدو أن القصة القصيرة هى الشكل الأمثل لسرد هشاشة اللحظة، وتكثيف الغياب، واقتناص ما لا يُقال.
مفاهيم القصة القصيرة: هل نحن بإزاء جنس أدبى أم متحول؟
ليست القصة القصيرة مجرّد جنس أدبى قائم على الإيجاز والتكثيف فحسب، بل هى تمظهر ثقافى متعدد الدلالات، يتقاطع فيه الأدبى بالاجتماعى، والتاريخى بالفنى، والأنطولوجى بالمؤقت. وعلى الرغم من مرور أكثر من قرن ونصف على تبلورها بوصفها شكلًا حديثًا، ما زال مفهوم القصة القصيرة موضع مساءلة. هل نحن إزاء جنس أدبى استقرّت معالمه؟ أم أن القصة القصيرة لا تزال وربما بطبيعتها جنسًا متحوّلًا، يرفض التعريفات الحاسمة ويقاوم التصنيف؟
كل محاولة لتعريف القصة القصيرة ارتبطت بسياقها التاريخى والثقافى، الأمر الذى يجعل من المفهوم ذاته بنية مفتوحة أكثر من كونه إطارًا مغلقًا. وفى هذا السياق، يشير تودوروف إلى أن الأجناس الأدبية «ليست كيانات أبدية بل أنساق متحوّلة»، ويبدو أن القصة القصيرة تمثل ذلك بجلاء.
سمات جوهرية أم ممكنات مفتوحة؟
فى معظم أدبيات النقد، تظهر مجموعة من السمات التى توصف بأنها «جوهرية» للقصة القصيرة: الإيجاز، الكثافة، وحدة الحدث، انغلاق النهاية، الاقتصاد اللغوى. غير أن هذه السمات باتت، فى الممارسة الإبداعية المعاصرة، موضع مراجعة:
«الإيجاز»، على سبيل المثال، لم يعد غاية جمالية فى ذاته، بل وسيلة تنبنى أحيانًا على الغموض أو التلميح أو تفكيك الحدث؛ و«الكثافة» لم تعد فقط تكثيفًا سرديًا، بل باتت تعنى كثافة شعورية أو فكرية أو لغوية؛ أما «انغلاق النهاية»، فقد تراجع لصالح النهايات المفتوحة واللا متوقعة، التى تُشرِك القارئ فى إنتاج المعنى.
ومن هنا، فإن سمات القصة القصيرة لم تعد تصوغ جنسًا ثابتًا، بل تفتح بابًا على تعددية داخلية، تجعل من القصة القصيرة جنسًا منسوجًا من الطفرات، أكثر من كونه مبنيًا على قواعد، فقد شهد مفهومها تحوّلات جذرية عبر الزمن، ولا يزال استقراره بوصفه شكلًا أدبيًا قائمًا بذاته موضع نقاش. فعلى الرغم من وجود خصائص جوهرية تُميّز هذا الجنس السردى، إلا أن حدوده وتوقعات تلقيه تواصل التبدّل تحت تأثيرات ثقافية وتاريخية وفنية متنوعة.
وتميل بعض النصوص المعاصرة إلى تسييل الأجناس، مثل الشعر النثرى، والسيرة الذاتية والمتخيلة، ومع تقويض السرديات الكبرى فى ما بعد الحداثة، وتمجيد التقطيع والتشظى، حدثت تحولات كبرى فى بنية القصة القصيرة تحديًا للبنية التقليدية لها.
تحولات السياق.. تحولات المفهوم
لا يمكن فهم القصة القصيرة دون ربطها بسياقات إنتاجها، فالتحوّلات التى شهدتها الصحافة، ثم النشر الرقمى، ثم الوسائط التفاعلية، قد أثرت فى بنيتها، بل وفى علاقتها بالقارئ.
فى زمن الصحافة الورقية، كانت القصة القصيرة مرتبطة بمساحة العمود اليومى أو الأسبوعى، وهذا ما أنتج شكلًا سرديًا مكثفًا وسهل التلقى؛ أما فى زمن شبكات التواصل الاجتماعى، فقد ظهرت أنماط مثل «القصة الومضة»، أو «الحكاية المصوّرة»، أو «سرد التغريدة»، وكلها أجبرت القصة على التنازل عن بعض خصائصها التقليدية مقابل البقاء؛ بل ظهرت نصوص هجينة يصعب تصنيفها، تجمع بين القص والشعر، أو بين السرد والمشهد السينمائى، أو بين الحكاية والتحليل الذاتى.
هذا يعنى أن القصة القصيرة لم تعد فقط تحوّلًا فى الشكل، بل فى المفهوم نفسه. لم تعد القصة ما يحدث على الورق فقط، بل ما يُبنى أيضًا فى فضاء الوسيط، وما يتولّد بفعل التلقى.
تأثير الوسائط الرقمية والوسائط المتعددة
تدفع منصات التواصل الاجتماعى مثل «تويتر، إكس، وإنستجرام» نحو أشكال سردية فائقة القصر، وتعيد القصص التفاعلية والنصوص الفائقة، فمع تسارع الإيقاع الحياتى وتراجع الزمن المخصص للقراءة التقليدية، برزت أنماط جديدة من القصة القصيرة كـ«القصة الومضة» flash fiction و«القصة الميكرو» microfiction، التى تُبنى على المفارقة أو المفاجأة أو التلميح الوجودى. وقد أسهمت هذه الأنماط فى تحديث بنية القصة وتوسيع جمهورها.
كذلك أدت المنصات الرقمية إلى نشوء أشكال سردية جديدة: القصة المسموعة عبر البودكاست، القصة المصوّرة على إنستجرام، والقصص القصيرة التى تُروى عبر فيديوهات قصيرة. هذه الوسائط أفرزت تحوّلات جمالية تشمل التمثيل الصوتى، والصورة الرمزية، والإيقاع الزمنى المتسارع، مع الحفاظ أحيانًا على عناصر الحكى التقليدى.
ويتجه المستقبل نحو ما يمكن تسميته بـ«جماليات الاختزال» أو «اقتصاد السرد»، حيث تتنازع القصة القصيرة بين الإيجاز والتجريب، وبين السرد المتماسك والتفكيك المفتوح. فالمتلقى اليوم بات أكثر ميلًا للنصوص السريعة والتفاعلية، وهو ما يدفع كتّاب القصة إلى إعادة التفكير فى آليات الإمساك بالانتباه، لكن أدى ذلك إلى التفريط بالعمق.
ومع تصاعد أدوات الذكاء الاصطناعى، بدأت تظهر قصص مكتوبة جزئيًا أو كليًا عبر خوارزميات. هذا يطرح أسئلة حول الإبداع والملكية والأسلوب، وقد يفتح المجال أمام أشكال قصصية جديدة تعتمد على التوليد التفاعلى أو المخصص حسب شخصية القارئ.
يشهد المستقبل تزاوجًا بين القصة القصيرة وألعاب الفيديو، أو الحكايات التفاعلية، أو تقنيات الواقع الافتراضى، مما يعيد تعريف «النص» بوصفه تجربة متعددة الحواس، يشارك فيها المتلقى فى خلق المعنى، لا فى تلقيه فقط.
ما يمكن الخروج به هو أن التجريب لا يُقوّض القصة القصيرة، بل يُعيد تشكيلها وفق شروط جديدة. وربما يُعد التجريب نفسه هو الضامن الوحيد لاستمرارها، بشرط أن يُنتج «جماليات جديدة، لا مجرد أشكال غرائبية». فالقصة اليوم لا تُقاس بطولها، ولا بشخصياتها، بل «بقدرتها على أن تُحدث أثرًا سرديًا مركّبًا» فى زمن عابر، وبواسطة شكل مفكك. وهكذا، فإن مستقبل القصة القصيرة لا يكمن فى المحافظة على ماضيها، بل فى انفتاحها على كل ما لم يكن يُحسب فى عُدّة الأدب سابقًا.
القصة القصيرة كتجريب فلسفى وجمالى
ثمة رهان جمالى يؤكد أن التجريب يمكن أن يكون تجربة فلسفية، فالقصة لم تعد تُكتب لتكون «حكاية»، بل لتكون «تجربة لغوية وجودية»، تستثمر فى كل ما هو مهمل أو هامشى، وتستبدل المنطق السببى بمنطق الإدهاش والاختزال، حيث تُجسد بعض القصص القصيرة ما يمكن تسميته بـ«السرد ما بعد الإنسانى»، حيث يُروى العالم من موقع الموجودات المهمّشة، فتصبح القصة القصيرة هنا «أداة لإعادة توزيع مركزية التجربة»، لا أداة لمحاكاتها فقط. ومثل هذه الكتابات لا تؤسس لجنس جديد، بل تؤكد أن التجريب هو الذى يُطيل عمر الأجناس الأدبية، ويحميها من التكلس.
ما نستخلصه من النصوص التجريبية المعاصرة أن القصة القصيرة لم تعد مقيدة بمفهوم الشكل، ولا بالمضمون التقليدى. لقد تحررت من شرط المحاكاة، ومن شرط الامتثال، لتصبح مختبرًا للأفكار، والصيغ، والأنساق الجديدة.
بالتالى فإن مستقبل القصة القصيرة هو ألا يكون لها شكل واحد، ولا معيار قارّ، بل أن تُكتب باستمرار بوصفها «احتمالًا مفتوحًا»، لا «قالبًا مكتملًا».
التلقى الجديد: قارئ ما بعد الحداثة
التجريب فى بنى وأشكال القصة القصيرة لا يتم فى معزل عن التحوّل فى موقع القارئ، الذى لم يعد يطلب «قصة ذات بداية ووسط ونهاية»، بل يتفاعل مع التشظى، والانقطاع، والتعدد. وقد أصبح القارئ المعاصر، المتصل بالشبكة الرقمية، قارئًا لحظويًا، يقرأ ضمن سياقات متداخلة «بين الشاشة، والمقطع الصوتى، والوسم». وهذا يدفع الكتّاب إلى طرح أشكال سردية مختزلة، أو موجهة للتلقى السريع، ما يُعيد تشكيل مفهوم «القصة» نفسها.
ومع نظرية التلقى «ياوس، إيزر» أصبح التركيز على دور القارئ فى إنتاج المعنى، وهو ما يفسر ظاهرة النصوص المفتوحة التى تترك مساحات تأويلية واسعة.
القصة القصيرة كوسيط ثقافى
وفى ظل تفاقم الأزمات النفسية والاجتماعية، بدأت القصة القصيرة تُستخدم فى ممارسات مثل الطبّ السردى أو الببليوثيرابيا، بوصفها وسيلة للتفريغ والتشافى، أو للمساءلة الذاتية. هذا يعزز من بعدها الوظيفى ويعيدها إلى جذورها الإنسانية.
النظرية السردية فى العصر الرقمى
أدت الثورة الرقمية إلى ظهور مفاهيم جديدة:
- السرد التشعبى:
الذى يحوّل القارئ إلى مشارك فى صنع المسار السردى.
ـ القصص التوليدية:
حيث ينتج الذكاء الاصطناعى نسخًا لا حصر لها من القصة نفسها.
ـ التناص الرقمى:
الذى يجمع بين النصوص المكتوبة والمرئية والصوتية فى بنية واحدة.