شهر صاحب نوبل..
«الأحدب».. الغزال الذى رفض نجيب محفوظ اصطياده

- كتبها فى سن السادسة عشرة وباحثون وأصدقاء وأسرة الأديب الكبير: «لا نعرفها»
- أديب نوبل اعترف: كنت ألخص روايات معروفة وأكتب عليها «بقلم نجيب محفوظ»!
نشر الكاتب الصحفى الكبير منير مطاوع تفاصيل ما وصفه بأنه «أول رواية كتبها نجيب محفوظ»، مشيرًا إلى أنها تحمل اسم «الأحدب»، وكتبها عميد الرواية العربية فى عام 1927، وهو فى الـ16 فقط من عمره.
«مطاوع» نشر اكتشافه فى مقال، ضمن عدد مجلة «صباح الخير» الصادر بتاريخ 29 يوليو الماضى. ولم تكن هذه أول مرة ينشر فيها تلك القصة، فقد سبق أن نشرها فى مجلة «الهلال»، وتحديدًا فى عدد أغسطس عام 2014.
وقال الكاتب الصحفى الكبير عن «الرواية»: «كتب الطالب نجيب محفوظ، فى عمر 16 عامًا، الرواية بخط يده، فى كراسة مدرسية صغيرة الحجم، تعود- كما هو مكتوب على غلافها بالحبر الأحمر وبخط يد نجيب محفوظ- إلى العام 1927، إنها مخطوطة رواية (الأحدب)»، معتبرًا إياها «البداية المبكرة جدًا لمؤلفها، الذى تصفه دراسات نقدية وبحثية أكاديمية مصرية وعربية وعالمية بأنه مؤسس وبانى عمارة الرواية العربية الحديثة، ومجددها وراسم مجراها ومنجز أهم إنتاجاتها».
ولم يكن منير مطاوع أول من يكتشف عملًا لم يُنشر لـ«أديب نوبل»، فقد حقق حسين عيد عملًا لعميد الرواية العربية تحت عنوان: «ما وراء العشق»، قبل أن يصدر عن الدار المصرية اللبنانية. ونشرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى عام 2016، كتاب «قصص نجيب محفوظ التى لم تنشر». كما أصدرت الدكتورة عزة بدر كتاب «قصص نجيب محفوظ المجهولة»، عن سلسلة «الكتاب الذهبى» بـ«روز اليوسف».
«حرف» تحقق فى السطور التالية: هل يمكن تصنيف «الأحدب» باعتبارها «أول رواية لنجيب محفوظ»؟ ولماذا أنكرها «محفوظ» ولم ينشرها، هى والكثير من أعماله الأولى؟
ابنته أم كلثوم: كل الأعمال التى لم ينشرها اعتبرها «دون المستوى»

الحقيقة ليست لدى فكرة عن رواية «الأحدب»، لكنى أعرف أن والدى كان يكتب منذ الإعدادية، وبالتالى هناك بعض الأعمال الروائية التى كتبها فى فترة مبكرة من حياته قبل أن يصدر روايته الأولى التى نشرها بنفسه، ومعنى أنه لم ينشرها أنه كان يرى أنها لا تليق.
هناك مَن نشر بعض القصص والأعمال التى لم يكن والدى يقبل بنشرها، كان يراها دون المستوى. كان ينشر فقط ما يراه مناسبًا لأن يكون جزءًا من مشروعه. لذا يجب أن تحترم رغبته، وألا ينشر أى شخص أى عمل لوالدى، لأنه ببساطة لم يكن يقبل بنشر هذه الأعمال.
هيئة الكتاب نشرت مجموعة قصص قصيرة لوالدى، وتعليقات الناس عليها كانت أنها «دون المستوى»، وكان من المفترض أن يستأذنوا الورثة قبل النشر، وحينها كنت سأرفض نشرها تمامًا، فما وافق عليه فى حياته فقط هو ما يُنشر.
من الممكن طبعًا أن يكون والدى قد كتب الكثير فى كراسات خاصة قبل أن يفكر فى النشر، ولو أن ما كتبه هذا فى يدى فلن أنشر منه شيئًا. ما نُشر فى دار «الساقى» كتبه والدى فى الفترة من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٤، وكان قد نشره سابقًا فى مجلة «نصف الدنيا»، ولو لم ينشره فى حياته لما وافقت على نشره.
كان هناك الكثير من المخطوطات لأعمال لم تُنشر لوالدى من قبل فى شقتنا بحى العباسية، و«شخصية عامة» هى التى استولت عليها، وهو ما أكده المخرج والكاتب توفيق صالح، والذى قال إن هذه «الشخصية» عثرت على قصص قصيرة فرعونية لوالدى، الذى تكلم عنها، وغالبًا لم ينشرها، لأنه كما قلت لا يقبل نشرها؛ لأنها لا تمثل جزءًا من مشروعه الأدبى.
والدى قرأ كثيرًا فى التاريخ، وكان مُغرمًا بالحضارة المصرية القديمة، وكتاباته الأولى كان يكتب فيها كثيرًا عن الفراعنة، لكنه نشر ٣ روايات منها فقط، رغم أن معظم ما كتبه فى بداياته كان عن الفراعنة، سواء قصص أو روايات، وهى أعمال لم تكن فرعونية فقط، كانت تدور فى التاريخ الفرعونى، لكنها تعالج جزءًا من الحاضر، أو توجه رسالة للتاريخ الحالى.
محمد بدوى: تجاربه الأولى ليست مهمة إبداعيًا
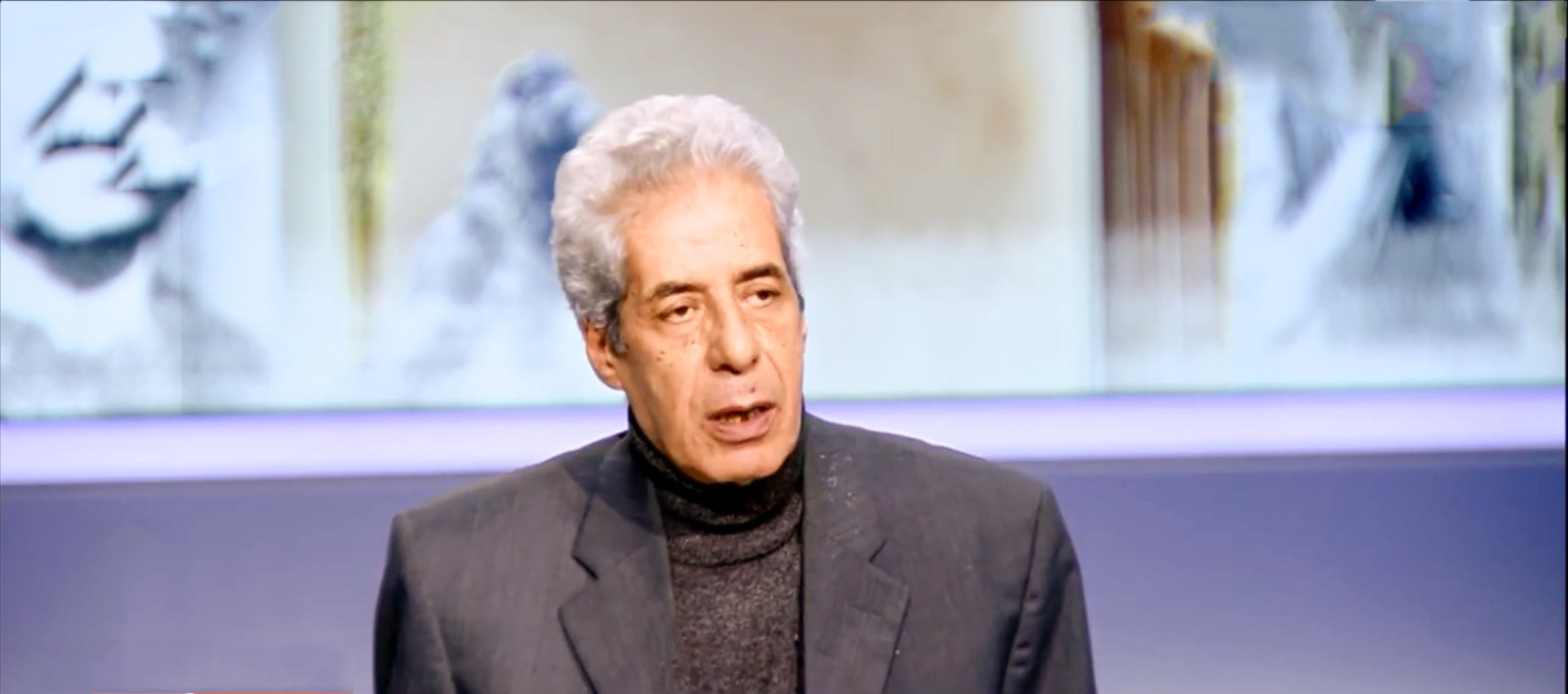
ليست لدى أى فكرة عن رواية «الأحدب»، ولم أسمع بها من قبل، لكننى أعرف أن التجارب الأولى لنجيب محفوظ ليست مهمة على المستوى الإبداعى، و«محفوظ» نفسه لم يذكرها ضمن أعماله، لأن الكُتاب دائمًا يحتاجون إلى ما يمكن تسميته «فترة التدريب على الكتابة».
«محفوظ» حين كان يبلغ من العمر ١٥ عامًا كان يحاول تقليد رواية «الأيام» لطه حسين، وكتب بالفعل عملًا أطلق عليه اسم «الأعوام»، كان يقلد فيه فقط، لكنه لم يكن ذا أهمية على المستوى الإبداعى، وغالبًا رواية «الأحدب» التى اكتشفها منير مطاوع من هذا المستوى.
الحقيقة أن نجيب محفوظ لم يبلغ نضجه الأدبى إلا بعد أن كف عن كتابة الرواية التاريخية، وكتب الروائع الواقعية التى عُرف بها: «زقاق المدق» و«بداية ونهاية» و«الثلاثية»، هذه انعطافة مهمة جدًا فى حياته، أجل فيها الكتابة التاريخية إلى حين، قبل أن يستخدمها بعد ذلك بشكل آخر كما فى «الحرافيش».
يمكن دراسة الأعمال الأولى لنجيب محفوظ على سبيل دراسة التطور الذى مرت به تجربته بصفة عامة، كأن نرى ما كتبه فى هذه الفترة مثل «الأعوام». لكن على المستوى الإبداعى «لا معنى لهذه الأعمال»، حتى «عبث الأقدار» ساذجة جدًا، كان وقتها ولدًا صغيرًا يتعلم الكتابة الروائية وإشكالياتها، وكيفية استخدام اللغة.
كل الكُتّاب غالبًا هكذا، يوسف إدريس له مجموعة قصص قصيرة قبل «أرخص ليالى» كانت مضحكة، وقصص كثيرة جدًا لنجيب محفوظ فى البدايات «ساذجة». كما سبق أن قلت، تقتصر أهمية هذه الكتابات فى التأريخ لنجيب محفوظ وكتابته، وإن ظلت ليست مهمة فى مسيرته الإبداعية. يمكن أن تُنشر هذه الأعمال بالطبع ويقرأها الجميع، إن كانت فعلًا تنتمى إلى نجيب محفوظ وليست منحولة عليه، وثبت أنه هو الذى كتبها، حتى يقرأها المهتم بالتأريخ.
مشكلة نجيب محفوظ أنه نشر مبكرًا، حتى قبل أن يفهم كل ما يكتبه، هو فوجئ بأن سلامة موسى ينشر له «عبث الأقدار»، وحكى كثيرًا أنه كتب فى موضوعات عديدة آنذاك، وهذا لا يتعلق بـ«محفوظ» وحده، بل بكل الكُتّاب. فى كل الأحوال، طبيعى جدًا أن ولدًا فى سن الـ١٦ سيكتب كلامًا مضحكًا، فى محاولة للتدرب على الكتابة.
محمد سلماوى: مهمة فى إطار دراسة تاريخ وتجربة «أديب نوبل»

أى وثيقة تتعلق بشخصياتنا التاريخية الكبيرة لها أهميتها، حتى لو كانت فاتورة بعض المشتريات، أو خطابًا شخصيًا، أو إيصالًا باستلام مبلغ، فلا ندرى كيف يمكن أن يكون لمثل هذه الوثيقة فائدة لباحث يدرس جانبًا معينًا من حياة تلك الشخصية.
ينطبق هذا على كتابات نجيب محفوظ السابقة على البداية التى ارتضاها وحددها لمسيرته وإنتاجه الأدبى. لدى مثلًا الأعداد شبه الكاملة لمجلة «المدرسة»، التى كان ينشر فيها الطالب نجيب محفوظ القصص بشكل شبه منتظم.
وهناك مخطوطات لكتابات أخرى لا شك فى أصالتها، فهى مكتوبة بخط نجيب محفوظ نفسه، وكثيرًا ما كان يعترف بأنه كتبها، لكنه لم يكن يعتبرها جزءًا من مشروعه الأدبى، الذى استمر من ١٩٣٩ حتى ٢٠٠٦، وتضمن ما يزيد على ٤٠ رواية، و٣٥٠ قصة قصيرة، و١٠ مسرحيات من فصل واحد، وهى بالمناسبة من أجمل ما كتب لهذا النوع المسرحى، لكن النقاد لم يتلفتوا إليها ولم يولوها الاهتمام الذى تستحق.
أنتهز هذه الفرصة لدعوة المسرحيين أو القائمين على المسرح، الذين يشكون مما يطلقون عليه «ندرة فى النصوص المسرحية»، إلى تقديم هذه المسرحيات، وبعضها لم يُقدَم أبدًا، لأنها تمثل جانبًا مهمًا من الإنتاج الأدبى لنجيب محفوظ، ويغلب على الكثير منها طابع مسرح العبث، الذى كان سائدًا فى أوروبا وقت كتابتها.
أما بالنسبة لرواية «الأحدب»، فأنا أشكر الكاتب الصحفى منير مطاوع لإصراره على إلقاء الضوء على هذا العمل، الذى يكتسب أهمية تاريخية وبحثية كبيرة، رغم أنه لا يدخل رسميًا ضمن المكتبة الأدبية لنجيب محفوظ، ويمثل نتاج مرحلة التدريب التى يتمرس فيها الكاتب على التأليف الروائى، فالكاتب لا يولد وموهبته مصقولة، وأول رواية يكتبها لا تكون أول ما خطه قلمه على الورق، وإنما يتدرب على الكتابة طوال سنوات، حتى يصل إلى صوته المميز فى الرواية.
هذا النص الذى كتبه نجيب محفوظ وهو ما زال فى سن المراهقة يثبت أن ولعه بالكتابة أصيل، بدأ فى سنواته المبكرة، ليس فقط بهذه الرواية، وإنما أيضًا بالقصص التى كتبها ونشرها فى مجلة «المدرسة» وهو ما زال فى المرحلتين الإعدادية والثانوية. نشرت إحدى هذه القصص منذ عدة سنوات، فى ملحق جريدة «الأهرام»، ليس كاكتشاف أدبى يغير من نظرتنا لأدب نجيب محفوظ، وإنما كتدريب على الكتابة كان يجريه بشكل دورى وهو ما زال صبيًا.
إذا نظرنا إلى مجال الموسيقى مثلًا، نجد أن بعض المؤلفين الموسيقيين الكبار قد ألفوا ما يسمى بـ«التمارين»، ومنهم كارل تشيرنى على سبيل المثال، الذى أصدر مجلدين من التدريبات للعازف الموسيقى أو المؤلف، للتدريب على كيفية التعامل مع النوتة والتأليف الموسيقى. ومثل هذه الاكتشافات الخاصة بنجيب محفوظ أو غيره، هى مثل تلك التدريبات التى أوصلت نجيب محفوظ فى النهاية؛ لأن يكتب رواياته الفرعونية الثلاث، قبل انتقاله إلى الواقعية بـ«القاهرة الجديدة» و«خان الخليلى» و«الثلاثية».. إلخ.
وتثبت هذه الرواية ولع نجيب محفوظ بالتاريخ المصرى القديم منذ صباه، والسبب فى ذلك- كما أخبرنى- كان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام ١٩٢٢، الذى خلق اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بالتاريخ المصرى القديم، ليس فى مصر وحدها وإنما فى العالم كله، فتنبه «محفوظ» لذلك، وبدأ يهتم بدراسة هذا التاريخ القديم، حتى إن أول كتاب أصدره كان ترجمة لكتاب إنجليزى عن مصر القديمة.
أطلعنى ذات مرة على كراسة لديه كتب فيها وصفًا مختصرًا لروايات كان يريد إنجازها، بعد رواياته الثلاث عن مصر القديمة، تدور أحداثها كلها فى مصر القديمة، وكان يقتدى فى ذلك بالكاتب الأسكتلندى الكبير السير والتر سكوت، الذى كتب تاريخ أسكتلندا كله فى صيغة أعمال أدبية. لكن الواقعية غلبت نجيب محفوظ، واهتمامه بالواقع المعيش غلب اهتمامه بالتاريخ.
وللعلم، هناك رواية اكتشفها حسين عيد لنجيب محفوظ، وأصدرها عن الدار المصرية اللبنانية، وكتب عنها دراسة، اسمها «ما وراء العشق»، ومع ذلك لم تُعتَبر جزءًا من روايات نجيب محفوظ أو أعماله الكاملة. لكن دراسة أدب نجيب محفوظ لا تكون فقط بدراسة إنتاجه الرسمى والمعترف به، وإنما أيضًا بدراسة إرهاصات هذه الكتابات، التى منها رواية «الأحدب» محل الحديث، ومن هنا تأتى أهميتها، فى إطار دراسة تاريخ وتجربة «أديب نوبل».
إبراهيم عبد العزيز: غضب بشدة من كتاب جمع قصصه غير المنشورة

هذا نفس ما حدث مع المفكر توفيق الحكيم، فـ«الحكيم» له محاولات مسرحية قبل مسرحيته الشهيرة «أهل الكهف»، منها «المرأة الجديدة» و«الضيف الثقيل» وغيرهما الكثير، لكن حين يأتى على ذكر مؤلفاته يسقط هذه الأعمال من حساباته، ويعتبر أن «أهل الكهف» هى بدايته الأولى وميلاده الأدبى، معتبرًا ما سبقها لا يرقى إلى المستوى الأدبى الذى يشرف به.
الكثير من الكُتّاب يظل يكتب كبدايات، وهى محاولات لا ترقى للنشر أحيانًا، ولا تليق بالمستوى الأدبى الذى يصل إليه بعد ذلك. الكثير منهم كانت له بدايات شبيهة، محاولات بدائية وأحيانًا ساذجة. لذا بعض الكُتاب حين تذكر له أعمال قديمة يقول لك: لا تذكرنى بها، لأنه يعتبرها محاولات ليست موفقة، ومن بينهم نجيب محفوظ، الذى أسقط كل هذه المحاولات، لحساب البداية التى رأى أنها تصلح لأن تكون بدايته، البداية التى تستحق أن تُكتب بالفعل.
الدكتور رمسيس عوض كتب كتابًا عن المحاولات الأولى لتوفيق الحكيم فى كتابة المسرحية، وكتب نقدًا لها أيضًا، وبعد أن انتهى من ذلك ذهب به سعيدًا إلى «الحكيم» ليخبره، فتناول صاحب «أهل الكهف» المخطوط ونظر فيه، ثم طلب منه عدم نشره، مؤكدًا له أن هذه المسرحيات لا يعتبرها ضمن تاريخه الأدبى، ونشره لها «يضره»، وهو ما أغضب رمسيس عوض غضبًا كبيرًا، خاصة أن توفيق الحكيم قال له: «أحذرك أن تنشره فى أى دار نشر»، وبالفعل أغلقت كل دور النشر أبوابها فى وجه رمسيس عوض، فطبع الكتاب على حسابه الخاص.
توفيق الحكيم أيضًا له مسرحية نشرت وكتبت عنها، لم يشر إليها أبدًا، ولم يذكرها فى الفهرس الذى يضعه خلف كل عمل له كما اعتاد. بصفة عامة، الأديب يحب أن يظهر بصورة مثالية على الدوام، حتى لو كان نجيب محفوظ أو توفيق الحكيم.
وبالعودة إلى نجيب محفوظ، الروائى محمد جبريل جمع قصصًا لـ«أديب نوبل»، ونشرها بعنوان «فتوة العطوف»، فغضب نجيب محفوظ بشدة، وكأن نشرها كان مسيئًا له، لأنه يريد أن يظهر نجيب محفوظ الذى عرفناه من الأعمال القيمة التى نشرها، وليس من الأعمال التى لم يقبل بنشرها. أراد أن يظل «نجيب» الكاتب العملاق، لا يقرأ القارئ له قصصًا تافهة أو محاولات بدايات، أراد أن تظل الصورة جميلة ولا تشوش بأعمال بدائية، رغم أن هذه الأعمال جزء من التطور الأدبى الطبيعى، وهو ما يهم النقاد، لكن الأدباء يعتبرون هذا كسرًا للصورة التى هم عليها.
بالتأكيد هناك أعمال أخرى ستظهر لنجيب محفوظ، لأنه كان يكتب منذ الابتدائية، حين قرأ رواية بوليسية أجنبية فأعجبته وبدأ يكتب، تجارب وقصص كثيرة كتبها قبل «عبث الأقدار»، كلها أعمال تمهيدية، أى أديب له أعمال كثيرة حتى يصل إلى عمله الأول الذى يقبل بنشره.

حسين حمودة: إتاحتها للقراء ولو بشكل محدود ضرورة

لم أطلع على رواية «الأحدب»، التى كتبها نجيب محفوظ فى سن الـ١٦، ولا أستطيع أن أحكم على قيمتها، وإن كنت أقدّر طبعًا أن هناك حكمًا صائبًا على هذه القيمة، هو حكم الأستاذ نجيب محفوظ نفسه.
وعلى ذلك، أسمح لنفسى، وأرجو أن يسمح لى الكاتب والمبدع الأستاذ منير مطاوع الذى اكتشف هذه «الرواية»، أن أشير إلى بعض الحقائق، وكلها تُبنى على تقدير كبير لما ذكره الأستاذ «منير»، ومن ذلك عبارته المهمة: «لم يرد ذكر رواية (الأحدب) فى أى من أحاديث نجيب محفوظ)»، بما يعنى أنها لم تعد جزءًا من أعماله التى يستطيع الإشارة إليها. ومن ذلك أيضًا تمييز الأستاذ «منير» الضمنى، الواضح مع ذلك، بين ما يمكن أن ينشر لعموم القراء منسوبًا إلى قلم نجيب محفوظ، وما يجب أن تقتصر قراءته على الباحثين المتخصصين فى أدبه.
من هذه الحقائق أن الأستاذ نجيب محفوظ نشر عددًا من القصص القصيرة فى بعض الدوريات، لكنه سرعان ما تجاوزها، واختلف مع مستواها الفنى، واستبعدها من المجموعة التى اختار أن ينشرها فى نهاية الأربعينيات تحت عنوان «همس الجنون»، وقد أشار الأستاذ «منير» إلى هذا. وأنا شاهد على إحساس الأستاذ نجيب بالضيق عندما نشرت مجموعة له، فى فترة متأخرة من حياته، وضمت بعض قصص له كان قد استبعدها عند اختيار مجموعاته القصصية.
وعلى ذلك، فعدم نشر الأستاذ «محفوظ» هذه الرواية يعنى عدم رضاه عنها من الناحية الفنية، ورؤيته لها كمرحلة قد تخطاها، ومن ثم لا يجب نشرها. وفى حالة إتاحتها الآن، على نطاق محدود، يجب أن تتصدرها إشارات واضحة إلى هذا المعنى: «هذا نص كتبه محفوظ وهو فى الـ١٦ من عمره، ولم ير أنه عمل يستحق النشر». بذلك يمكن إتاحتها للدارسين المتخصصين فحسب، ليتعرفوا كيف كان نجيب محفوظ يفكر فى هذه السن المبكرة، أو كيف كانت مرحلة تكوينه أو تدريبه على الكتابة، أو ما إلى ذلك.
يتصل بهذه الحقيقة إمكان تأمل عبارة الأستاذ «منير»: «تبقى لها (لهذه الرواية) القيمة التاريخية المتعلقة بتطور الأدب والأديب نفسه». فهذه القيمة يمكن أن تتصل بتطور «تكوين» نجيب محفوظ نفسه أكثر مما ترتبط بتطور أدبه، خاصة أن هذه «الرواية» تنتمى إلى ما قبل بداية هذا الأدب الروائى بوجه خاص.
ومن هذه الحقائق أن نجيب محفوظ، فى أكثر من حوار، تطرق إلى مرحلة التدريب على الكتابة التى مر بها خلال مرحلة تكوينه الأول، وأنه كان أحيانًا يلخص بعض الروايات المعروفة، ليس أكثر من تلخيص، ويكتب هذا التلخيص فى بعض الكراريس، ويكتب على غلافها بخط مرسوم منمّق: «بقلم نجيب محفوظ»! وكأنه بذلك كان يستعيد صورة الصياد البدائى القديم، الذى كان يرسم نفسه على جدران الكهف وهو يطعن غزالًا فيصطاده، وذلك قبل حدوث هذا الصيد بالفعل، وكأن الرسم الخيالى وسيلة سحرية لتحويل المشهد المتخيل إلى فعل ملموس، أو طريقة لاستدعاء هذا الفعل الملموس!
هذه «الرواية» وغيرها مما كتبه نجيب محفوظ ولم ينشره، لم تكن، على الأرجح، أكثر من خطوة أو وسيلة خيالية، على سبيل الوصول إلى فعل حقيقى، ونستطيع أن نقول، فى مجال التشبيه نفسه، إن هذه «الرواية» كانت غزالًا عدل نجيب محفوظ عن اصطياده! وهو ما استطاع أن يقوم به عند نشر روايته الأولى التى رآها تستحق النشر: «عبث الأقدار».
ولعله أشار، فى غير حديث من أحاديثه، إلى رواية كتبها ولم يرض عنها أستاذه سلامة موسى فلم ينشرها. كما أنه كتب رواية عن الريف وتخلص منها، لأنه اكتشف بعد كتابتها أنه قد كتب عن عالم لا يعرفه معرفة كافية. كل هذه «الروايات» كانت غزلانًا لم يصطدها.. كل هذه الروايات ليست محسوبة على نتاج «محفوظ»، لأنه ببساطة لم ينشرها ولم يفكر فيها على أنها جزء من هذا النتاج.
ومن هذه الحقائق أيضًا أن نجيب محفوظ، فى نطاق العمر المبكر الذى كتب فيه هذه الرواية، وتحديدًا بعد كتابتها بسنوات قليلة جدًا، ترجم كتاب جيمس بيكى «مصر القديمة»، والترجمة عمل مقنن، واضح المعايير، ولا يحتاج إلى موهبة تساوى الموهبة التى تحتاجها كتابة رواية، وبالتالى يسهل الحكم عليه. وعلى ذلك كله، نشر نجيب محفوظ هذا الكتاب فى عمر مبكر، وهو لا يزال فى مرحلة الدراسة الثانوية «البكالوريا»، وقد كان يقول لنا وهو يضحك: «على فكرة أنا جايز أكون أول طالب مصرى يدخل الجامعة وفى إيده كتاب!».
ولعل أجواء هذا الكتاب، حول مصر القديمة، تتصل بالأجواء نفسها التى ارتبطت بها هذه «الرواية»، أو بعبارة أخرى لعل هذه «الرواية» اتصلت بالأجواء التى تحرك فيها هذا الكتاب، وطبعًا نجيب محفوظ قرأ الكتاب قبل أن يترجمه، وطبعًا استغرقت ترجمته وقتًا، بما يقارب بين زمن كتابة هذه «الرواية» وزمن التعرف على عالم هذا الكتاب.. المهم أن نجيب محفوظ نشر الكتاب ولم ينشر الرواية.
ومن هذه الحقائق، أن هذه «الرواية»، وما يشبهها من مخطوطات «محفوظ» التى اُكتشفت أو لم يتم اكتشافها، تلوح وكأنها تدخل ضمن دائرة يهتم بها بعض دارسى الأدب، فيما يسمى «النقد الجينى» أو «التكوينى»، وتتمثل فى تتبع مسيرة المخطوطات أو المسودات لبعض النصوص، وهى دائرة يمكن أن تكون مفيدة على مستوى ما، لكنها تظل قائمة على التمييز بين المخطوطات والمسودات غير المنشورة، من ناحية، والنصوص التى نشرت بعد ذلك، من ناحية أخرى. الأولى تندرج فيما يمكن أن يقال له: «الغرفة السرية المظلمة» للكاتب، والثانية هى ما كتبه وراجعه ورأى أنه يستحق النشر أو الخروج للنور. و«الأحدب»، التى لخصها الأستاذ «منير»، ليست مسودة لرواية من روايات «محفوظ» التاريخية، وبالتالى فتناولها من منظور هذا الاهتمام النقدى يظل غير مجد كثيرًا.
والمهم، مرة أخرى، أن إتاحة هذه الرواية للقراءة الآن، حتى على نطاق محدود، خارج ما أراده نجيب محفوظ، وهو عدم نشرها، يجب أن يحاط بهذا المعنى الذى يجب تحديده بوضوح، كما يجب ألا تخرج من دائرة المتخصصين المحدودة إلى دوائر أوسع، حتى وإن انضم إلى هؤلاء المتخصصين المحدودين بعض الفضوليين الذين يريدون أن يعرفوا كيف كان يفكر نجيب محفوظ فى فن الرواية وهو شاب صغير فى الـ١٦ من عمره.







