عودة العمائم.. محمد جمال على: الأزهر لم يحسم «معركة التدين» مع الإسلاميين حتى الآن

- المنهج الأزهرى ظهر كطوق نجاة للشباب فى «زمن الاستقطابات» قبل 30 يونيو
- الشيخان على جمعة وأحمد الطيب أعادا «البراند الأزهرى» من خلال «الأروقة المستقلة»
تحولات جذرية كبيرة شهدها المشهدان الدينى والمجتمعى فى مصر بعد عام 2011، كان أبرز تجلياتها عودة الأزهر الشريف إلى الساحة بقوة بعد فشل مشروع جماعة الإخوان فى الحكم وقيام ثورة 30 يونيو.
وجاء كتاب «عودة العمائم» للدكتور محمد جمال الصادر حديثًا عن دار «تمهيد» ليقدم قراءة دقيقة ومعمقة لدور الأزهر الشريف فى هذه المرحلة المفصلية، ويعيد طرح الأسئلة الجوهرية حول موقع المؤسسة فى الحياة العامة، بعدما تراجع خطاب جماعات الإسلام السياسى والسلفيين، ليجد المواطن المصرى نفسه أمام مؤسسة تاريخية تستعيد دورها كضامن للوسطية والاعتدال، وكمتنفس روحى وفكرى فى آن واحد.
حاورت «حرف» الدكتور محمد جمال، للوقوف على خلفيات هذا الطرح الذى كان فى الأساس رسالته للحصول على درجة الماجستير قبل أن يتحول إلى كتاب تأسيسى يعيد شرح دور «الأزهر» فى الحياة الاجتماعية المصرية.
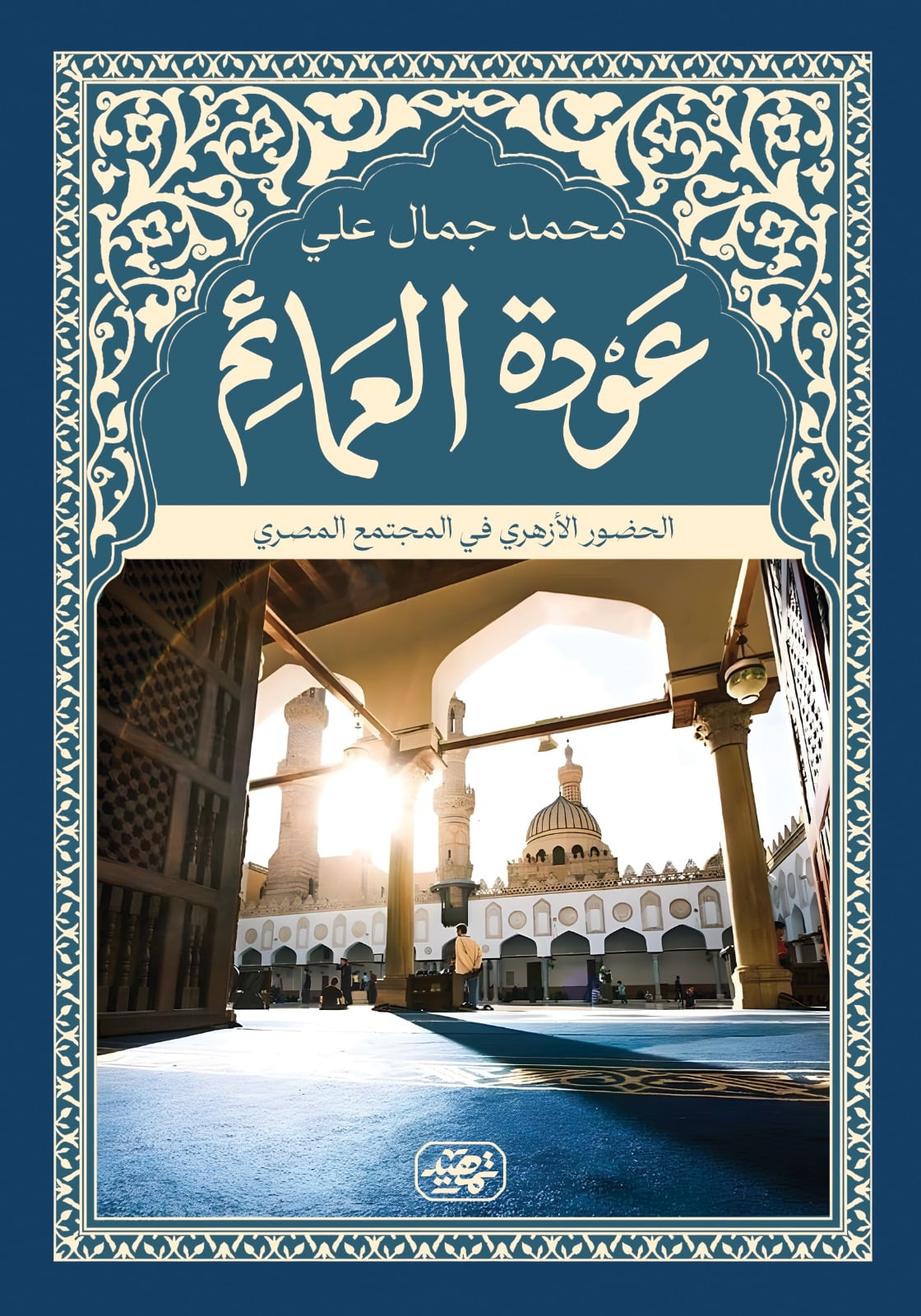
■ «عودة العمائم» كان رسالتك للماجستير.. هل الكتاب هو نفسه نص الرسالة؟
- بالفعل، كان رسالتى للماجستير عام ٢٠١٩ فى العلوم السياسية، لكن عند نشره فى كتاب، أزلت أجزاء تاريخية ونظرية وغيّرت بعض الأساليب فى الكتابة والصياغة، واخترت عنوان «عودة العمائم» أو ألهمنى الله العنوان لأنه يعبر عن فكرة الكتاب الحقيقية، وهو عنوان للجمهور بخلاف عنوان الرسالة، والفكرة قائمة على أنه من بعد ٢٠١١ يعزز «الأزهر» حضوره الاجتماعى والسياسى والعلمى على مستويات عدة.
■ ناقشت عودة العمائم ليس من واقع غيابها ولكن من باب المشاركة المجتمعية.. إلى أى مدى تؤثر هذه المشاركة فى تعزيز أدوار «الأزهر»؟
- عنيت بـ«العمائم» النخبة الأزهرية، والحقيقة أن «الأزاهرة» كانوا مغيبين لفترة، وغيابهم هنا لا يعنى أنهم غير موجودين، ولكن وجودهم كان أقل فاعلية مما كان عليه الأمر، كانوا فى حالة عدم رضا، ولم تكن هناك رغبة منهم للعودة لأن المجال الدينى كان تحت سيطرة تيارات إسلامية من سلفيين وإسلام سياسى، وبالتالى أى شاب يرغب فى التدين كان يتوجه لقنوات السلفيين أو مواقع الإنترنت، وعمومًا الحالة السلفية كانت هائلة ومسيطرة بشكل لا توجد معه أى منافسة من «الأزهر»، حتى داخل الجامعة الأزهرية كانت هناك سيطرة للسلفية، وما حدث بعد ٢٠١١ جعل الأمور مختلفة بشكل كبير، على المستوى الفكرى ومستوى النظر للدين نفسه ومستوى السلوك الاجتماعى ومستويات كثيرة جدًا.
وكان لا بد أن نستعيد هذا الدور ومن هنا حدثت حالة من التنافسية وصراع كبير داخل المجال الدينى، ولم يكن الأمر مقتصرًا على الأزهر كمؤسسة، ولكن كان هناك بعض الجهود المجتمعية من أزاهرة مستقلين أسسوا بعض المدارس والمؤسسات وغيرها لاستقطاب الشباب أو تعليم الشباب الدين على المنهج الأزهرى المختلف عن السلفية.
ومن هنا عرف شباب كثر معنى المذاهب، وما الذى يعنيه «شافعى وحنفى وحنبلى» ومعنى عقيدة «أشعرية وماتريدية»، وأنه ليس كل ما يقدمه السلفيون هو الإسلام وأن الإسلام لديه تراث كبير جدًا من المعرفة والعلوم.
■ قلت إن «الأزهر» شهد الكثير من التحولات منذ ٢٠١١ ودخل صراعًا كبيرًا مع الجماعات الإسلامية.. هل ترى أن المؤسسة استثمرت فشل جماعات الإسلام السياسى فى مصر؟
- «الأزهر» استثمر لحظة ٢٠١١ استثمارًا عظيمًا، كانت هناك تحولات رهيبة تحدث فى المجتمع، وكان من الممكن أن يقف «الأزهر» موقف المتفرج، لكنه لم يفعل ذلك، بل عزز موقعه على المستوى السياسى والاجتماعى والدستورى والقانونى، وكانت لهذا الاستثمار أبعاد سياسية قد يختلف الناس معها أو يتفقون، لكن الجزء الذى أحب أن أركز عليه هو الجانب المجتمعى، فـ«الأزهر» قدّم نفسه، على الأقل، كأحد البدائل، كمصدر من مصادر المعرفة الدينية، وأثبت أن المعرفة الدينية لا تقتصر فقط على ما يقدمه السلفيون أو الإسلاميون، الذين يقدمون خطابًا يدفع إلى الصدام والعزلة.
وعندما مارس «الأزهر» دوره الحقيقى، وحضوره، لم يكن ذلك على المستوى السياسى فقط، بل اختار الانخراط والتواصل مع المجتمع، خاصة فيما يتعلق بأنماط التدين، فعاد «الأزهر» للواجهة مرة أخرى.

■ هل معنى ذلك أنه حسم الأمر لصالحه بشكل كلى؟
- لا يمكن القول إنه قد انتصر انتصارًا كاملًا أو حسم المعركة لصالحه، فالسلفيون لا يزال لهم وجود كبير، لكن الأزهر أصبح حاضرًا، وأصبح الناس إذا أرادوا معرفة الدين من خلاله، يستطيعون ذلك. يمكنهم الآن الانضمام إلى الأروقة، والتعرف على علمائه الذين أصبحوا أكثر حضورًا، وأصبح الوصول إليهم أسهل، لم يعد من الضرورى أن تكون دارسًا داخله لتتعلم التدين على الطريقة الأزهرية، ولم يعد مطلوبًا منك أن تكون لك توجهات سياسية معينة للالتحاق به، وهذه نقطة مهمة للغاية.
فى النهاية، «الأزهر» أصبح منفتحًا، وأصبح يُنظر إليه كنمط للمعرفة الدينية، لا كنمط للتوجه السياسى، وهذه التفرقة كانت مهمة جدًا، لأنها جذبت عددًا كبيرًا من الناس، الذين أصبح لديهم استعداد للالتحاق به، لا لدراسة السياسة، بل لدراسة الدين، ثم يفكرون فى السياسة كيفما شاءوا، أصبحوا يتعرفون على مصادر الدين، ويدرسون التراث الإسلامى، وعلوم الفقه والمذاهب.
ويكتشفون أن الإسلام أوسع بكثير مما كان يُعرض عليهم، وأنه يمكنهم التعرف على هذا من خلال «الأزهر»، بدلًا من أن يكون مصدر معرفتهم الدينية الوحيد هو القنوات السلفية، أو الخطيب السلفى فى المسجد المجاور، صاروا يتجهون نحو الكتب التى كتبها العلماء القدامى، ويدرسون المذاهب وآراءها، ليروا ما يقوله هذا التراث العظيم.

■ متى وكيف بدأت ظاهرة «عودة العمائم» على مستوى التعليم الشرعى الحر غير النظامى؟
- تعود بداية هذه الظاهرة إلى عام ٢٠٠١، عندما قرر الشيخ على جمعة أن يُدرّس الناس المنهج الأزهرى، من خلال دروس حرة توصل إليهم الفكر الأزهرى. استهدفت هذه الجهود، منذ بدايتها، ليس الناس العاديين فحسب، بل حتى «الأزاهرة» أنفسهم، الذين كانوا يعانون من هيمنة الفكر السلفى، حتى داخل جامعة الأزهر.
بدأ الشيخ على جمعة مبادرة «الأروقة المستقلة»، وكان الشيخ أحمد الطيب- حتى قبل أن يتولى مشيخة الأزهر - جزءًا من هذا المشروع، داعيًا إلى تعليم الناس التراث الإسلامى والمنهج الأزهرى، وإعادة إحياء الشكل الأزهرى حتى فى اللباس. فشيوخ الأزهر كانوا قد بدأوا فى إهمال الجبّة والعمامة، وكان اللباس السلفى، مثل الغترة والعباءة الخليجية، هو السائد حينها. كانت استعادة المظهر الأزهرى خطوة مهمة فى استعادة «البراند الأزهرى»، وهى عملية بدأت قبل عام ٢٠١٠ بعقد من الزمن على الأقل.
منذ عام ٢٠١٥، بدأ الأزهر فى تنظيم أنشطة مستقلة، وفتح «الأروقة» أمام الشباب، ودعاهم إلى دراسة الدين من منظور أزهرى، بعيدًا عن الاستقطابات الأيديولوجية السائدة آنذاك، سواء الإسلامية أو العلمانية. أنشأ الأزهر أروقته التى فتحها للجمهور، وأنا شخصيًا شاركت فى بعضها، ودرست فيها، وتحدثت مع الشباب، ورأيت مدى الإقبال من مختلف الفئات والجهات.
■ لعب الشيخ أحمد الطيب دورًا كبيرًا فى إنهاء المصالحات الثأرية فى الصعيد من خلال «بيت العائلة»، وتدخل الأزهر فى برنامج «تكافل وكرامة» وغيرها.. كيف ترى هذا الدور؟
- دعنا نعترف بأن للدكتور أحمد الطيب دورًا كبيرًا فى ذلك على المستوى الشخصى، نحن نتحدث عن أن القيادة الأزهرية تصنع فارقًا، ولو كانت القيادة مختلفة، ربما كانت النتائج ستكون مختلفة كذلك، فالشيخ أحمد الطيب، بطبيعة تفكيره وشخصيته، لعب دورًا فى هذه العودة الأزهرية، كان مهتمًا جدًا بفكرة أن على «الأزهر» أن يكون له دور فعّال أكثر، سواء على المستوى الاجتماعى، كما تحدثنا، أو على المستوى الفكرى والمنهجى الأزهرى.
وهو، بطبيعة دراسته للعقيدة والفلسفة، كان مهتمًا جدًا بمسألة ضرورة وضع حدود للهيمنة السلفية، واستعادة المنهج الأزهرى وحضوره، وعلى المستوى الاجتماعى، ورغم أننى للأسف لم أكن أملك القدرة ولا الوقت لتحليل كل هذه المظاهر بدقة- مثل بيت العائلة، والمصالحات، وغيرها- وقد أشرت إليها بإشارات سريعة، إلا أننى ركزت فقط على «بيت الزكاة والصدقات»، وهذا فى حد ذاته يستحق عملًا أكبر من ذلك، لما له من دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.

■ تحدثت عن السلفيين وهجراتهم الجماعية التى عادت بـ«تعاليم الوهابية» ومحاولاتهم تطبيقها على المصريين برغم اختلاف الثقافات والرؤى والسمات.. هل كان «الأزهر» مقصرًا فى مواجهة ذلك؟
- ما حدث منذ السبعينيات هو أن مصر كدولة تراجعت بشكل عام، ولا تزال كذلك للأسف، بسبب موازين القوى الاقتصادية التى تؤثر فى الفكر أيضًا، فمن سافروا للعمل فى الخليج بدافع المال والتحولات التى طرأت عليهم شىء طبيعى، عندما يسافر الإنسان ويعيش فى بيئة معينة، وخاصة عندما تكون هى مصدر الرزق، خصوصًا فى ظل وضع اقتصادى متردٍّ فى مصر، حيث أستاذ الجامعة فى «الأزهر» لا يكفيه راتبه.
والحقيقة أن التبادل الفكرى والثقافى فى العموم ليس شيئًا سيئًا، بل أمر محمود. ولكن، المشكلة تكمن فى موازين القوى المختلة تمامًا، عندما تستثمر دول معينة فى منهج فكرى بعينه، وتحاول أن تعززه وتنشره لعقود، عبر قنوات إعلامية وأموال طائلة، وهذا أمر مفهوم، فكل دولة تسعى إلى تعزيز قوتها الناعمة، ولكن نحن -المنهج الأزهرى، والتراث الأزهرى، والمعرفة الأزهرية- يجب أن يكون ذلك هو مصدر قوتنا الناعمة. والخطأ هنا خطؤنا نحن، كدولة وكمجتمع، أننا لم نهتم بقوانا الناعمة كما يجب، فى الخمسينيات والستينيات كنا نهتم جدًا بالقوة الناعمة لـ«الأزهر»، ونرسل بعثات إلى إفريقيا، وما زالت هذه الممارسات مستمرة، لكنها ضعفت كثيرًا، ولم تعد مصر تولى الثقافة والتعليم والبحث العلمى والعلماء الاهتمام الكافى. وبدأ الناس يبحثون عن مصادر رزق فى الخليج، حيث كانت تُعزّز أنماط تدين وأفكار مختلفة، وهذا ليس خطأ الدول الأخرى، بل خطؤنا المشترك -بين الدولة والمجتمع، والقيادات الأزهرية نفسها- التى أهملت قوتها الناعمة.
■ فى رأيك.. إلى مَن تميل الكفة بين الأزهر والسلفيين بين المصريين؟
- الأزهر متجذر فى الثقافة المصرية، منهجيته، مذهبه، علاقته الخاصة بالتصوف وأهل البيت والموالد. نحن لا نحمل تلك النظرة السلفية المتطرفة التى تنبذ كل ذلك، ولدينا علاقة تاريخية وخاصة مع أهل البيت والتصوف، واقترابنا من المذهب السنى يختلف كثيرًا عن التصور السلفى أو الوهابى، فنحن أكثر حبًا وتقديرًا لأهل البيت، واقترابنا أكثر تصالحًا ورحمة.
نحن، كمصر، حالة مختلفة فى العالم الإسلامى، والأزهر جزء أصيل من هذه الحالة، والتراث الأزهرى كذلك. ورغم أنه تم إهمال هذا المنهج، منذ السبعينيات وحتى ٢٠١٠، بفعل موازين القوى الاقتصادية، بدأت الأمور تتغير، والأزهر يستعيد رونقه وقوته الناعمة، خاصة فى الـ١٥ سنة الماضية.

■ ماذا عن ثورة ٣٠ يونيو ودورها فى جعل «الأزهر» متنفسًا حقيقيًا للمواطن بعيدًا عن جماعات «الإسلام السياسى»؟
- فى الحقيقة، من قبل عام ٢٠١٣، بل لنقُل من قبل ٢٠١١، ومع تصاعد حدة الصراعات والاستقطابات الأيديولوجية، بين «العلمانيين» و«الإسلاميين» وغيرهما، بدأ المنهج الأزهرى يظهر كمتنفس حقيقى لكثير من الشباب الذين يرغبون فى التديّن، لكن دون الانخراط فى صفوف «الإسلاميين»، أو تحميل تدينهم طابعًا سياسيًا صداميًا غريبًا.
كثير من الناس لجأوا إلى المنهج الأزهرى، ليس بالضرورة من خلال مؤسسة الأزهر نفسها، بل إلى المنهج الأزهرى عمومًا، لكونه أوسع بكثير من مجرد كونه مؤسسة. ومع مرور الوقت، استمر هذا التوجه بعد عام ٢٠١٣ على نفس المنوال. لقد كانت هذه ظاهرة ملحوظة.
■ هل هناك كتب مُقبلة تتعلق أو تستكمل ما بدأته فى «عودة العمائم»؟
- ناقشت أطروحة «الدكتوراه» الخاصة بى مؤخرًا، وحصلت على تقدير «امتياز»، وكانت عن «العلاقة بين الدين والدولة فى مصر وتونس»، امتدادًا لهذا الخط البحثى. درست جامعة «الزيتونة» فى تونس، وكيف تحاول أن تستعيد دورها، فى مقارنة مع الأزهر، مع تركيز أكبر على الجوانب السياسية والقانونية، وسياسات إدارة المساجد، وغيرها. الرسالة مكتوبة بالإنجليزية، وأحتاج وقتًا لإعادة تطويرها ونشرها باللغة العربية لاحقًا. وإن شاء الله، يكون كتاب «عودة العمائم» هو بداية لسلسلة أعمال أخرى.






