أحمد أبوخنيجر: لو أُملى على الروائى ما يكتُب لتحول نصه إلى «موضوع تعبير»

-أسمى «شق الريح» بـ«رواية جَملى» لأننى أخذت سنوات كثيرة فى كتابتها
-ما يعتبره غيرى من الكُتاب «أسطورة» هو جزء من عالمى المعيش
-النيل يجعل صحراءنا المصرية مختلفة تمامًا عن صحراء عبدالرحمن منيف وإبراهيم الكونى
-تعمقت فى الكتابة التوثيقية لأننى أحببت فهم جماعتى بشكل أفضل وأعمق
فى أحدث تجلياته السردية، يعود الروائى والقاص الكبير أحمد أبوخنيجر بروايته «شق الريح» الصادرة عن دار غايا للنشر والتوزيع، ليخوض مغامرة جديدة تسبر أغوار سيرة مركب حمل اسمها وتحوّلت من وسيلة نقل إلى رمزية غنية بالتحولات الإنسانية والمكانية.
ورغم ابتعاده فى هذه الرواية عن العالم الذى دار فيه معظم أعماله السابقة، من حيث اللغة والفضاء السردى، ظل «أبوخنيجر» وفيًّا لمفردات أسوان، حارسًا لذاكرتها وموسيقاها وألوانها المتعددة.
هذا التحوّل السردى فى «شق الريح» لا يُعد قطيعة، بل هو انفتاح على أفق جديد فى الكتابة، يستند إلى تجربة ناضجة ومخيلة متجددة، عبر لغة جديدة تمامًا ومستوى سردى مختلف عن سابقه.
«حرف» التقت أحمد أبوخنيجر فى حوار خاص، للغوص معه فى تفاصيل الرواية، وتحولات الكتابة، وسحر الجنوب الذى لم يغادره يومًا، فكان هذا اللقاء.
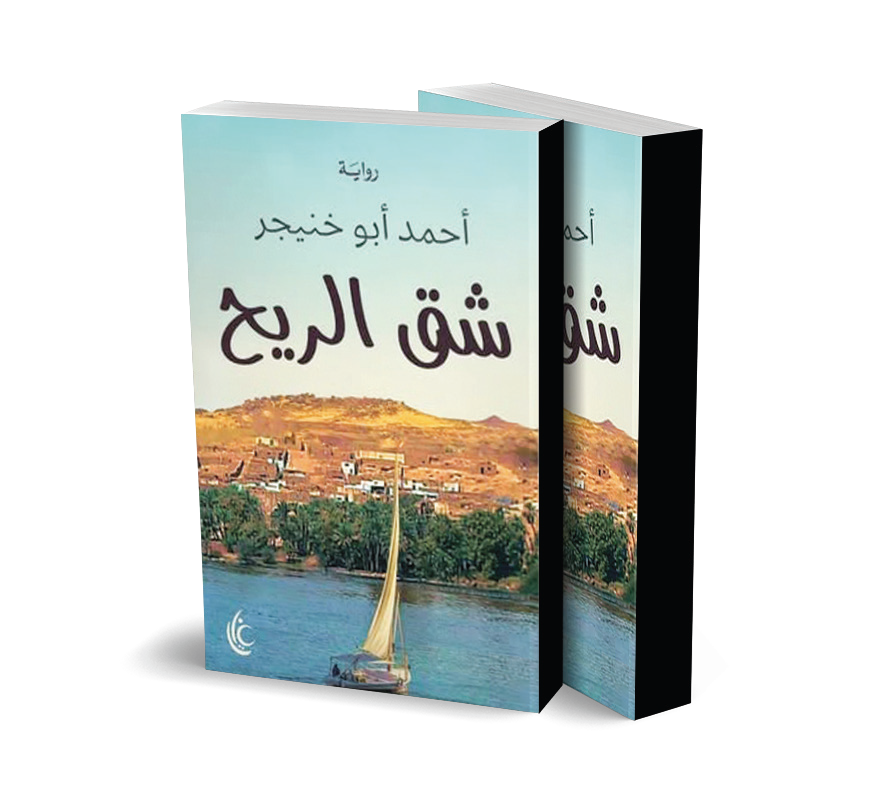
■ «شق الريح» أرخت لسيرة المراكب فى نهر النيل.. حدثنا عن ذلك؟
- رواية «شق الريح» تستطيع أن تقول عنها «رواية جملى»، أخذت سنوات كثيرة فى الكتابة. توقفت أثناء كتابتها لأسباب خارجة عن إرادتى، ثم كتبت روايتى «تلك النظرة» التى صدرت عن دار الربى، وعدت بعدها لأكملها.
«شق الريح» هو اسم المركب الذى تحول من مركب كبير لنقل التجارة والأخشاب والناس والأحجار إلى مركب أصغر أو «فلوكة»، ثم أصبح يعمل فى القطاع السياحى. لذلك اهتممت بالتحولات الأخيرة فى تاريخ المراكب.
والحقيقة أننى كنت مشغولًا أكثر بهذه التحولات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، ولم أكن معنيًا بتاريخ المراكب تحديدًا؛ سيَرِد ذكرها كنوع من التوثيق التاريخى، ولكن كان اهتمامى منصبًّا على الحاضر، وتحديدًا عند غياب «شق الريح» واختفائها واختفاء رُبانها، كإشارة لانتهاء هذه المهنة.
كما تعرّضت الرواية للتحولات الاجتماعية والأخلاقية؛ فقد وقعت جريمة قتل فى أسوان؛ نتيجة شجار بين بعض المراكبية، وكانت كارثة. المهم أن «شق الريح» لا تزال تحمل الطابع الأسوانى المسيطر.
والرواية تناقش التحولات التى طرأت على نهر النيل، بدءًا من فترة ما قبل بناء السد العالى، وتهجير النوبيين، وصولًا إلى السنوات الأخيرة بكل ما تحمله من تغييرات تاريخية.
■ عن ماذا تتحدث الرواية؟
- تبدأ الحكاية فى «شق الريح» باختفاء المركب وريسه، ولعل العناصر الأسطورية التى تنسج خيوط القصة قد تلعب دورًا خفيًا يتكشف للقارئ تدريجيًّا، إلا أن جوهر الرواية لا يكمن فى الغموض وحده، بل فى بعدها الوجودى العميق: فوجود المركب بلا عمل هو غرق، وربطه إلى البر دون إبحار هو غرق أيضًا، حتى محاولة ابن الريس بيعه غرق آخر.
الأنين الذى ما زال يتردد فى جنباته، وانتقاله عبر الحقب مع بقائه شاهدًا، هو غرق رمزى لكل ما يحمله «شق الريح» من تاريخ وقيم، هو نهاية لعصر. وعند العودة فى ختام الرواية، حين يرجع «شق الريح»، لا يرجع الريس؛ ليظل المركب بلا قائد، ويغرق مرة أخرى، فى الحقيقة والرمز.
■ تطرقت لذكر الأسطورة.. هل صحيح أن ما يسميه البعض أسطورة هو واقع معيش رأيته فى حياتك؟
- بالفعل، الأسطورة جزء لا يتجزأ من العالم الذى أكتب فيه وعنه، وهى جزء من طبيعة الجماعة الشعبية التى أتناولها.
فى الحقيقة، إحدى المشكلات التى تواجه الكتاب فى الجنوب أنّ القارئ البعيد قد يظن أن الكاتب يختلق الأسطورة أو يصنعها، لكنها فى الأساس جزء من نسيج التكوين الأساسى لهذه الجماعات الشعبية. التفكير الأسطورى، بكل ما فيه من خيالات وما يتيحه من تفسير للكون والعالم، موجود بقوة لدى هذه الجماعة، وموجود بغزارة، بحيث لا يمكن تنحيته جانبًا.
فكرة الأسطورة ليست حكاية يتم اختلاقها، على العكس تمامًا، هى جزء أصيل من هذا العالم وتكوينه، وتضفى على العمل قدرًا من الخيال. والحقيقة أن الكتابة بدون خيال، أعتقد أنها ينقصها الكثير.
■ هل رواية «شق الريح» تمثل تجديدًا ما فى مشروع أحمد أبوخنيجر؟
- فى الحقيقة دعنى أقول إنه على الكاتب أن يعيد النظر كل فترة فيما يكتبه، وما كتبه قبل هذا وما سيكتبه بعد ذلك، وما الذى يمكن أن يتغير فى كتابته، أنا أشبه هذه الفكرة بالتائه فى الصحراء، هو شخص مشى كثيرًا، وهو يظن تمام الظن أنه يسير على الدرب الصحيح، لكن الطريق يأخذه لأماكن لا يعرفها فيتوه، فلكى يسلك الدرب الصحيح مرة أخرى عليه أن يغير الحالة التى هو عليها، أن يقوم بعمل تنشيط لعقله ويستطيع تحديد الاتجاهات بشكل يخالف ما هو عليه.
أنا أقول هذا لأن الكاتب بعد فترة أحيانًا يمكن أن يقع فى فخ تكرار أعماله، وهو طوال الوقت يكتب نفس الأحداث، نفس الرؤى، هو فخ، وعند تعرض القارئ لأعمال هذا الكاتب سوف يظن- القارئ- أنه يكرر عوالمه، فيشعر القارئ بالضيق أو أن الكاتب غير جيد وغير متمكن، وهنا على الكاتب أن يتوقف ويعيد النظر ويستعيد بوصلته من جديد ليبدأ فى منطقة جديدة، عليه أن يغير فى مستوى اللغة أو العالم أو الشخوص أو البناء، كل فترة عليه أن يعيد النظر فى تفكيره والكتابة ستتغير، وأنا طوال الوقت أفعل هذا، لغة المجموعة القصصية «غواية الشر الجميل» لا تشبه أبدًا لغة المجموعة القصصية «متاهة الذئب» مثلًا، أو «فتنة الصحراء»، أو «العمة أخت الرجال».
■ ما الذى تفعله لتغير اللغة من عمل لآخر؟
- أنت ككاتب تُركّز فى صياغة جملك وتقول: «عرفتها»، فلا تنساق خلفها، وتقرر ألا تكتبها بهذا الشكل. فى البداية، تمرّ بمعاناة أو صعوبة وتعسر، وغالبًا ما يكون كل ذلك مجرد «دشت».
هذه المرحلة الانتقالية بين اللغة والتدريب و«الدشت» لا تُكتب فى أى عمل، لكنها ضرورية، الأهم أن تكسر هذا القالب، وتبتعد، وتنطلق نحو منطقة أخرى، وعندها، حين يتغير الكثير، تجد أن الأمور تسير بهدوء.
اللغة، على سبيل المثال، فى المجموعة القصصية «مشاهد عابرة لرجل وحيد» لا يمكن أن تكون هى نفسها لغة «متاهة الذئب». فالمجموعتان مختلفتان تمامًا: الأولى تسرد مشاهدات لرجل فى قلب المدينة ووحدته، وتأثير ذلك عليه.
أما فى المجموعة التالية، فقد تحوّلت المدينة إلى الصحراء، ولم تعد المدينة المعروفة، بل أصبحت الصحراء بأجوائها، بمواجهاتها، وبطبيعة أهلها. وهذا استتبع أن تكون الجملة مختلفة، والرؤية مختلفة، والتعبير مختلفًا كذلك.
■ ذكرت الصحراء وهى حاضر بقوة فى أعمالك.. لكنها صحراء خاصة جدًا لا تشبه ما تناوله عبدالرحمن منيف وإبراهيم الكونى.. كيف فعلت ذلك؟
- نحن أمام عالمين صحراويين متمايزين: الصحراء الشرقية التى عالجها عبدالرحمن منيف، والصحراء الغربية التى أبدع فيها إبراهيم الكونى. الأول تناول التكوين البدوى الصحراوى وتحولاته الاجتماعية، خاصة مع بروز النفط وانعكاساته على الحياة. أما الثانى، فغاص فى أسطورة الصحراء الكبرى، بكل ما فيها من طوارق وأمازيغ، وأساطير وعقائد، وحيوات بشرية وحيوانية تتشابك فى سرد شديد الخصوصية.
فى هذا السياق، تبدو الصحراء المصرية مختلفة تمامًا فى تكوينها. فهى ليست ممتدة أو منفردة كما فى الصحراء الكبرى أو صحراء الخليج، بل محصورة بين النيل من جهة، والبحر الأحمر من جهة أخرى. البشر فيها لا يعيشون عزلة صحراوية، بل تربطهم علاقات بالوادى والسواحل، ما يجعلها صحراء مركّبة: فى جغرافيتها، وعادات قبائلها، وحتى فى رؤيتها من قبل أبنائها.
وبالنسبة لى، الصحراء ليست مفصولة عن تكوينى الشخصى. إنها ذلك الأفق الواسع بعد اتساع المساحات الخضراء، خلف القرى والبلاد، حيث تمتد المخاوف والقلق، وحيث الذئاب والضباع والقوافل. لذلك لا تظهر الصحراء فى أعمالى ككيان منفصل أو خالص، بل متداخلة دائمًا مع الريف، ومتنازعة معه فى مشهدية مستمرة.
فى روايتى «شق الريح»، النيل هو العنصر المركزى، والماء هو المحور. أما فى «تلك النظرة» و«خور الجمال»، فتتداخل الصحراء مع الوادى، وتظهر التبدلات واضحة، وتتماهى الحكايات بين ضفتى الحياة: اليابسة والماء، الصراع والتلاحم، الريف والصحراء.
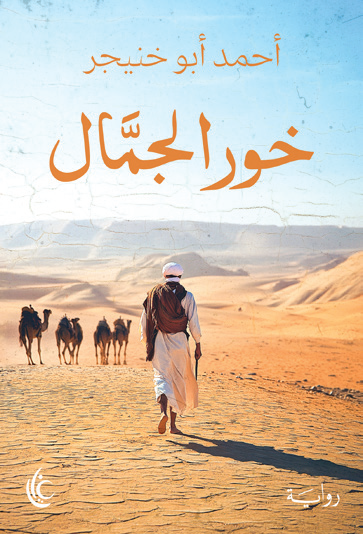
■ هل معنى ذلك أنك تؤمن بالمقولة التى تقول إن الكاتب ابن عالمه وتجربته؟
- لا، بالطبع، الكتابة اختيار، أنت من يختار. ولذلك، جملة «الكاتب ابن تجربته المباشرة» يمكن أن تعنى أن تجربته مرتبطة بمكانه وتكوينه الشخصى، ويمكن أن يكون كذلك ابن تجربته العقلية وقراءاته. بالنسبة لى، لم أكن مهتمًّا كثيرًا بتكوينى الذاتى داخل الكتابة أو بحضورى الشخصى، إلا فيما ندر. الموجود فعليًّا هو البيئة التى تربيت فيها، وعشتها بين حرّها وبردها ورائحتها.
كان من الممكن أن تكون هذه تجربة مغايرة لو خصصتها لكتابة أخرى، كما فعلت فى رواية «حرفوف»، أمير أسوان، وهى رواية كتبتها من التاريخ الفرعونى حول أول مستكشف للنيل. حتى حينما ابتعدت عن العصر الحاضر، اخترت الكتابة من أسوان، من نفس البيئة التى أعرفها، وأدرك مفرداتها.
بعض الكتّاب قد يخلص للمدينة، بطبيعتها وعلائقها وتطوّرها. وبعضهم يكتب من زاوية مختلفة تمامًا. كل كاتب ابن تجربته الذاتية، ولذلك هو من يختار. فالاختيار جزء جوهرى فى الكتابة، لأنه إن أُملِى عليك ما تكتب، صار الأمر أقرب إلى «موضوع تعبير»، وليس إبداعًا. الفكرة، أو البذرة الأساسية، هى ملكك.
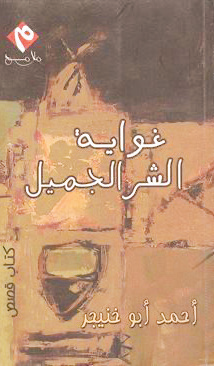
■ لماذا اتجهت للكتابة التوثيقية؟ هل لتؤكد أنك تنتمى لهذا المكان؟
- نعم، لأننى أحببت فهم جماعتى بشكل أفضل وأعمق، أحببت فهم بيئتى بشكل أوسع، فكان علىّ أن أراها فى العناصر التى تتبدل فيها الثقافة بشكل واضح، فى الفنون وعاداتها وتقاليدها وتدينها، هذه أكبر المظاهر التى تبين الجماعة، لهذا اهتممت بالحكايات والأغانى والتصوف والإنشاد الدينى، كل هذا عبارة عن جزء من محاولات الفهم.
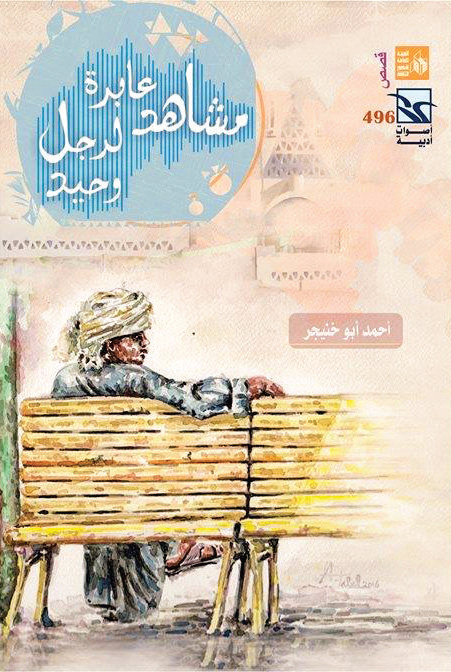
■ كتابك عن «الكف والأدب الشعبى والأفراح».. ماذا عنه؟
- الطقوس والفنون هى التى تكشف عن المعين الثقافى الذى يستند إليه أبناء الجماعة، فهى التى شكّلت منظومة قيمهم، وصاغت رؤيتهم للعالم فى حكاياتهم، وأمثالهم، وأغانيهم، وطريقة رقصهم، وحتى فى نمط بناء بيوتهم. كل هذا لم يكن وليد صدفة، بل فرضته الطبيعة بكل ما تحمله من تحديات وخصوصيات.
وحين اختار الإنسان شكل البناء، اختاره بما يتوافق مع معطيات بيئته وطبيعته، فى حوار طويل وعميق مع الأرض والسماء. وكذلك الأمر فى الأزياء واللباس، فهى لم تُصمَّم على عجل، بل جاءت لتؤدى وظيفة حيوية: تحميه من حرارة الشمس فى الصيف، وتقيه برد الشتاء، حتى استقرت على صورتها النهائية عبر تاريخ ممتد من التجربة والتفاعل المستمرين مع البيئة.
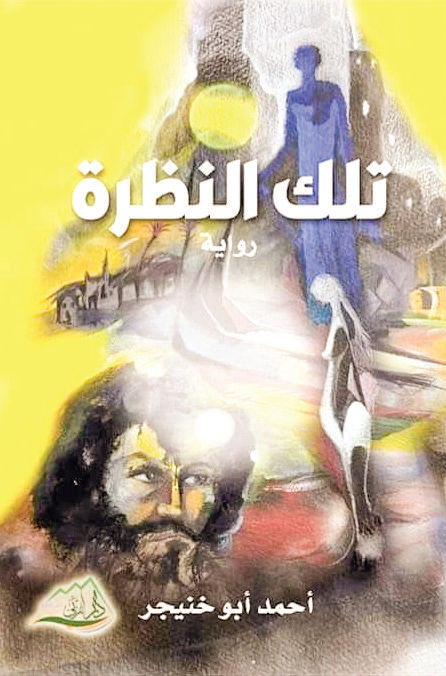
■ انتهيت من «شق الريح» منذ عام وبدأت فى عمل آخر.. ما تفاصيله؟
- لدىّ عدة مشاريع مؤجَّلة، يمكننى القول إنها أربعة، بعضها يتطلب بحثًا وسفرًا، وقد وضعته جانبًا حاليًّا، على أمل أن أعود إليه بعد انتقالى الوشيك إلى المعاش. من بينها روايتان تنتميان لنفس الإطار، بالإضافة إلى موضوعات أخرى من المفترض أن أبدأ فيها. لكننى لا أكتب عملين فى الوقت نفسه، فلا بد لى أن أُنحى أحدهما جانبًا، فأنا أميل إلى الإخلاص لعمل واحد حتى أنجزه بلا ارتباك. حاليًا، يشغلنى التصوير الفوتوغرافى؛ فالصور التى ألتقطها جزء من شغفى بهذا الفن، والرواية الجديدة تدور حول الفوتوغرافيا ذاتها، تلك التى كانت فى يوم من الأيام حلمًا لشخص ما، ثم تحوّلت إلى ممارسة رقمية فى يد الجميع. اليوم، يستطيع أى طفل أن يصوّر نفسه، بينما كانت الصورة سابقًا تحتاج إلى الكثير من الترتيبات والطقوس لتُنجز. هذه التحولات وغيرها أرغب فى تناولها فى العمل الجديد، دون أن أستعرض شكل الكتابة مسبقًا، آمِلًا أن يتجلى فيه تطوّر فى الأسلوب والطريقة. لقد كتبت بعض الصفحات بالفعل، بعضها مرضٍ، والبعض الآخر لم يصل إلى ما أريده تمامًا، وما زلت أواصل الكتابة. أتمنى أن يأتى العمل فى صورته التى أتمناها. صحيح أن الشكل الطباعى سيكون تحدّيًا بسبب وجود الصور، لكننى أفضّل أن أترك الأمور تتكشّف فى وقتها.







