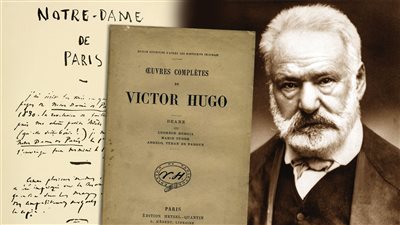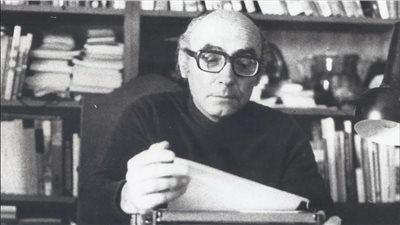«خناقة سلوى بكر وإبراهيم فتحى».. مبالغات «جلطة» صبرى موسى

صاحب مدرسة «لا تؤجل غضب اليوم إلى الغد» و«لا تحمل زعل العمل إلى البيت» لن تصيبه جلطة لاشتباك اثنين ولو كانت «خناقة شوارع»
أشك أن مشادة سلوى بكر وإبراهيم فتحى وراء إصابة صبرى بـ«جلطة»
شهدت مع الأستاذ ما هو أشد وقعًا.. مؤامرة حزبية لفصله من الجريدة التى عمل بها محبة لصديق واجهها بالسخرية والتجاهل
استمتعت كثيرًا بقراءة كتاب الصديق العزيز أيمن الحكيم «صبرى موسى.. ساحر الكتابة»، الذى صدر قبل أسابيع عن دار «ريشة للنشر والتوزيع»، كما استمتعت بالصفحات الخاصة التى نشرت بالعدد السابع من جريدة «حرف» الرقمية، عن الكتاب احتفالًا بالأستاذ، لكننى تحفظت على أحد العناوين الواردة بالعدد على لسان مؤلف الكتاب، وعلى بعض تفاصيل القصة التى جاء ذلك العنوان منها، سواء ما ورد منها بالكتاب، أو ما تم تفصيله فى الحوار..

والحقيقة إن أسباب متعتى بذلك الكتاب القيم كثيرة ومتعددة. منها ما هو شخصى يخص علاقتى بالأستاذ صبرى موسى، رحمة الله عليه، والتى استمرت لسنوات طويلة، وكانت بمثابة البوابة التى دخلت منها إلى عالم الصحافة والأدب ومحبة الحياة، إذ كان هو أول من استقبلنى فى بلاط صاحبة الجلالة، وكنت قبلها مفتونًا بأعماله الروائية والقصصية، وسيناريوهات الأفلام، فتتلمذت على يديه، وعشت بالقرب منه سنوات المهنة الأولى والأهم فى حياتى، تعلمت منه خلالها الكثير والكثير، وامتد أثره معى إلى كل تفاصيل حياتى، الشخصية والعملية.
ومنها ما هو عام، يخص كتابات الأستاذ، ورحلته مع التجريب الأدبى فى اتجاهاته كلها، فى القصة القصيرة، والرواية، والسيناريو والمقال، وغيرها من حكايات تخص إبداعه المتنوع والفريد، وحضوره الذى يستعصى على النسيان، وإن كنت بحكم القرب شاهدًا على جزء كبير منها، وبحكم المحبة مطلعًا على كثير من المواقف والحكايات التى كان يأتمننى عليها، ويخصنى بها.
أما العنوان الذى أثار حفيظتى، فنصه كما جاء بالعدد «خناقة سلوى بكر وإبراهيم فتحى أصابت صبرى موسى بجلطة أودت بحياته»، وهو العنوان الوارد فى حوار الحكيم مع الزميل بيجاد سلامة فى مقدمة ملف «حرف» عن الأستاذ، حيث يقول ردًا على سؤال «كيف كانت نهاية صبرى موسى؟» ما نصه: «الحقيقة من الأشياء التى توقفت عندها، الجلطة التى حدثت لسبب عبثى، تكلمت عنها فى الكتاب، ولكن دون تفاصيل، إذ كان مقرر لجنة القصة فى المجلس الأعلى للثقافة، وكان هناك اثنان من أعضاء اللجنة، الأديبة الكبيرة سلوى بكر، والناقد الكبير الراحل إبراهيم فتحى، قد تشاجرا أمامه، وتبادلا بعض الألفاظ، وهو لم يتصور أن اثنين من المبدعين يمكن أن يصل بينهما الخلاف لهذا المستوى، فعاد إلى بيته فى نفس اليوم، ولم يتحمل هذا المستوى، فأصيب بجلطة فى المخ»، ويضيف: «أظن أن الأستاذة سلوى بكر، ربنا يديها الصحة، مدينة باعتذار لصبرى موسى.. وأتمنى أن تسدد هذا الدين».

وهى الحكاية التى وردت فى صفحة ٢٣٨ من كتاب «ساحر الكتابة»، حيث يقول أيمن ما نصه: «لا تتعجب عندما تعرف أنه أصيب بجلطة غيرت حياته، ودمرتها، طيلة ١٥ سنة مريرة مع المرض، لأنه لم يتحمل مشادة فى حضرته بين أديبة معروفة وناقد كبير، تطورت إلى «خناقة شوارع»، تعالت فيها الأصوات والألفاظ النابية، فلم يستوعب ما يجرى أمامه، وانفجر عقله»!
ويضيف: «حدث ذلك فى العام ٢٠٠٣، حين كان صبرى موسى يرأس اجتماع لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة باعتباره مقررها، وفوجئ بالاشتباك بين الروائية والناقد، فحاول أن يفضه بحكمة، ولكنهما تماديا، فأخرجهما من الاجتماع، ولما سمح لهما بالرجوع عادا إلى الاشتباك، بل ووصل التلاسن إلى «ردح» كان وقعه صادمًا على رجل مثله تؤذيه حتى الأصوات العالية العادية.. ولما وصل إلى البيت كانت علامات الإعياء بادية عليه، ثم سقط على الأرض فاقدًا الوعى، فنقلته أسرته إلى أقرب مستشفى لبيته وقتها فى «المبتديان»، وهو مستشفى «الحكمة»، وأمام تدهور الحالة نقلوه إلى مستشفى قصر العينى «الفرنساوى»، حيث اكتشف الأطباء إصابته بجلطة فى المخ.. أدت إلى شلل نصفى بالجانب الأيمن لتبدأ سنوات المحنة، استقبلها صبرى موسى بصبر ورضا وكبرياء وتحدٍ، ومع جلسات العلاج الطبيعى المستمرة بدأت حالته فى التحسن، واستعاد المشى بمساعدة عكاز».
والحقيقة أننى أظن أن تلك الواقعة التى وردت فى الكتاب بدون ذكر أسماء أطرافها، وتم تفصيلها فى الحوار وتحديد تلك الأطراف، طالها الكثير من المبالغات، إن لم يكن الخيال الصحفى قد لعب دورًا فى نسج بعض خيوطها، حتى أن أيمن نفسه يقول عن الواقعة فى الحوار أنها «عبثية»، أو أنه تعجب منها ومن إصابته بالجلطة بسببها، باعتباره «سببًا عبثيًا»، وهو كذلك بالفعل، فبحسب رواية الكتاب قد أخرجهما الأستاذ من الاجتماع عندما بدأ الاشتباك بينهما، وهو أمر يتسق تمامًا مع شخصيته التى عرفتها عن قرب، فهو، كما رأيته وعرفته، لا يؤجل غضب اليوم إلى الغد، ولا يتردد فى الكشف عن امتعاضه أو رفضه لأى فعل خارج أو عمل أو حديث دون المستوى، وانتهاج السلوك المناسب للرد عليه فى التو واللحظة، لا يتحرك وفى قلبه «زعل»، أو «ضغينة»، بل إن عبارته التى كررها لى مرات ومرات «لا تأخذ زعل الشغل معك إلى البيت»، ما زالت تتردد فى رأسى بنص كلماته، كلما حدث معى أى أمر من أمور العمل التى تستوجب الزعل، وهو لم يقلها كما ذكرتها نصًا بالطبع «لأننا لا نتحدث الفصحى فى حياتنا العادية».. فمن أين جاء تصور أن تلك المشادة كانت سببًا فى إصابته بالجلطة ليلتها؟! هو بالتأكيد «تصور عبثى»، وكيف كانت الجلطة التى أصابته فى ٢٠٠٣، سببًا فى نهاية حياته بعدها بنحو خمسة عشر عامًا؟! لا أعتقد أن ذلك من الحقيقة فى شىء، وأغلب الظن أنه مجرد تصور، أو اجتهاد، لا أساس له، فلا يوجد فيما عرفته وراقبته إلى حد «المذاكرة» من سيرة الأستاذ، وحياته، وطريقة تعامله مع طوارئ الأمور، ما يوحى بهذا السبب «العبثى»، والاستنتاج «الخيالى».
ما أعرفه، من خلال معرفتى الشخصية بالأستاذ والتصاقى به لسنوات طويلة، أنه لم يكن ليؤجل رد فعله، ولا يقبل أن يتطاول أحدهم على أى شخص فى حضرته، فما بالك باثنين من كبار المثقفين والكتاب؟
ما أعرفه أن الأستاذ صبرى موسى كان دائمًا حاضر البديهة بصورة مذهلة، لا يعجزه «إفيه»، ولا يجد أفضل من السخرية اللاذعة ردًا على أى حماقة تصادفه، أيًا كان مرتكبها.. حدث ذلك قدام عينى مرات ومرات، بل إننى شهدت مع الأستاذ ما هو أشد وقعًا، وربما إيلامًا لنفسه.. مؤامرة حزبية لفصله من الجريدة التى عمل بها محبة لصديق، واجهها بالسخرية والتجاهل والإشفاق على أطرافها، فقد كنت شاهدًا على تفاصيل مؤامرة كانت تحاك ضده خلال فترة عمله بجريدة «العربى» الناصرية، وكان يعلم بتفاصيلها كلها، وبأطرافها أيضًا، وبعضهم كان من صغار الصحفيين، يقودهم أفراد من كوادر «الحزب» المالك للصحيفة، ورغم أنه وافق على العمل بالجريدة مجاملة لصديقه الراحل الكبير محمود المراغى، رئيس تحرير العدد الأسبوعى وقتها، لكنه لم ينفعل عندما علم بالأمر، ولم يبلغ به الانفعال أى مبلغ.. ربما لم ينس الأمر، ولم يتسامح مع بعض التفاصيل، لكنه لم ينفعل بها بتلك الطريقة العاطفية أو الانفعالية.
ربما آلمته حملة الهجوم تلك التى شنها ضده بعض من محررى الجريدة، منتصف العام ١٩٩٤، واتهامهم له بالتطبيع، أو بمساندة المطبعين، لمجرد أنه لم يستل قلمه، أو لم يمرر مقالات لهم، ولم يسهم فى حملة قتل الكاتب المسرحى الراحل على سالم، بعد زيارته الأولى لإسرائيل، وربما آلمه لجوؤهم إلى جمع التوقيعات لتقديمها إلى المؤتمر العام للحزب، والمطالبة بإبعاده عن «العربى»، لكنه رغم فشل الحملة، واتضاح تفاصيلها كاملة أمام الجميع، لم يزد فى التعليق على الأمر عن وصفه بحالة طيش وتمرد لشبابٍ غاضب، لا تستدعى التنكيل بهم، أو حتى استبعادهم من القسم، رغم أنهم كانوا يرون فى أنفسهم مُلاكًا للصحيفة، وعليه أن ينشر ما تجود به قريحتهم، حتى ولو لم تكن له أى صلة بالمهنة التى يريدون الالتحاق بنقابة العاملين بها، ولم يكن هو ممن يستجيبون لأى ضغوط، أو وساطات.. إن جاءوا بأخبار أو تقارير، أو حتى حوارات، فأهلًا وسهلًا، أما ما كانوا يلقون به من مقالات، فلم يكن لها مكان فى الصفحات التى يشرف عليها، حتى بدأوا فى شن حرب ضروس ضده، بحجة الاختلاف فى الرؤية.. وقتها اخترت الانحياز لمن أعرف من هو، وما قيمته.
وقتها حدثت واقعة طريفة، ربما سبق أن حكيت طرفًا منها، فبدون مقدمات بدأ أفراد فريق «الاختلاف فى الرؤية» يرتدون النظارات، بمعدلات لافتة للنظر، فلم يبق من فريق القسم ممن لا يرتدون النظارات سواى وعدد من المحظوظين بالقرب منه، وفى ليلة كنا نعد فيها لرسم صفحتى الفن والثقافة، وكنت أنا وهو وحدنا، عندما جاء أحدهم يسأل إذا ما كنا قد أخذنا مقاله أم لا، وكان يعدل نظارته بمعدلات متسارعة، وهو يحكى عن رؤيته العرض المسرحى الذى كتب عنه، ورؤية المخرج، والمؤلف، والتى يجب أن نساندها باعتبارها متسقة مع رؤية الحزب، وإذا بالأستاذ يسألنى، فى إحدى مرات السخرية التى كانت سلاحه فى مواجهة كوميديا الحياة: «إيه حكاية النضارات دى؟! ما تجيب لك واحدة يا عبدالوهاب، أحسن تكون دى نضارات الرؤية».
أخيرًا.. ربما كانت رواية الصديق الكاتب الصحفى أيمن الحكيم صحيحة، من حيث إن الأستاذ أصيب بجلطة عند عودته للمنزل فى ذات اليوم الذى شهد مشادة الكاتبة الكبيرة سلوى بكر، مع الراحل الكبير إبراهيم فتحى، لكننى أشك، لدرجة اليقين، فى استنتاج أن سببها كان هو تلك المشادة، وإن وصلت «لخناقة شوارع».
أتفق معه فى أنه كانت تحركه أسباب إنسانية وأخلاقية فى ردود أفعاله، كلها، وكان رقيقًا مهذبًا فى التعامل مع الجميع، لكنه أيضًا، كان صلبًا، عنيدًا، خبر الحياة فى أسوأ تجلياتها، ومر بصعوباتها على اختلاف درجاتها، وواجه مشاكل أكبر من ذلك الحدث بكثير.