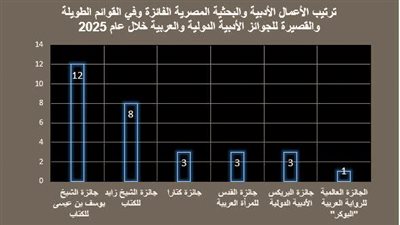فى مديح الراحلين.. محمد هاشم وصابر عرب وجلال الحسيني

- جمع بين صناعة الكتاب وصناعة الوعى.. وصنع أجيالًا من المبدعين عبر «ميريت»
- حمل مشعل الثقافة من محراب الأزهر إلى قمة إدارة المشهد الثقافى
- أحد أبرز الأسماء فى الحركة التشكيلية المصرية الحديثة
إنه «أسبوع الحزن»، لمَ لا، وهو يشهد رحيل 3 من كواكب الثقافة المصرية.. الأول محمد هاشم، صاحب ومدير دار «ميريت»، والثانى الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة السابق والمؤرخ الكبير، والثالث الفنان التشكيلى جلال الحسينى. 3 من أعمدة الثقافة والإبداع والفن، أثروا المشهد الأدبى والفنى فى مصر على مدار عقود، بكل الجمال والاختلاف والتفرد، فاستحقوا أن تحزن عليهم مصر ويتألم لفقدهم مثقفوها ومبدعوها.
محمد هاشم.. الأب الروحى

فى عام ١٩٥٨، شهدت مدينة طنطا شمال دلتا النيل، مولد محمد هاشم، الذى سيصبح لاحقًا واحدًا من أبرز الشخصيات الثقافية فى مصر والعالم العربى. لم يكن «هاشم» مجرد مؤلف أو ناشر، بل كان حركة ثقافية متكاملة، جمع بين صناعة الكتاب وصناعة الوعى، وبين الفن والنضال، ليصبح اسمه مرادفًا للحرية والإبداع المستقل.
بدأ محمد هاشم مشواره المهنى كصحفى وكاتب، قبل أن يتجه إلى عالم النشر الذى شكل محور حياته المهنية. وفى أواخر السبعينيات، انخرط فى الحركة الشيوعية المصرية، الأمر الذى عرّضه للملاحقة والسجن خلال حكم الرئيس الأسبق أنور السادات بتهم تتعلق بالنشاط السياسى المعارض.
بعد خروجه من السجن، كانت المنطقة تشهد أحداثًا تاريخية مفصلية، أبرزها التدخل العسكرى الإسرائيلى فى لبنان عام ١٩٨٢، ما أثر على مشاعره، ودفعه إلى مغادرة مصر لتجربة العيش فى الخارج، وتحديدًا الأردن، حيث عمل فى مهن متعددة، وبدأ كتابة القصص القصيرة التى شكّلت أولى خطواته فى التعبير الأدبى.
عاد «هاشم» إلى مصر نهاية عام ١٩٨٦، وعمل لمدة ١٢ عامًا فى دار «المحروسة» للنشر، قبل أن يتخذ خطوة حاسمة عام ١٩٩٨ بتأسيس دار «ميريت» للنشر المستقل فى القاهرة، على اسم أميرة فرعونية.
لم تكن «ميريت» مجرد دار نشر، بل منصة ثقافية مفتوحة للأصوات الجديدة، تحولت إلى واحدة من أهم الدور المستقلة فى مصر، بفضل دورها فى نشر الأعمال الروائية والقصصية، خاصة للكُتاب الشباب غير المعروفين. وصف الأدباء «ميريت» بأنها مائدة ثقافية رحبة، تستقبل الجميع دون تمييز، وتتيح مساحة للنقاش والمراجعة الفكرية، بما يشبه صالونًا ثقافيًا مستمرًا فى قلب القاهرة.
بعيدًا عن دوره كناشر، نشر محمد هاشم أعماله الأدبية، وأبرزها روايته الأولى «ملاعب مفتوحة» (٢٠٠٤)، التى أضافت قيمة مهمة لإرثه الأدبى. كما حصل على عدة جوائز دولية تقديرًا لدوره فى حرية النشر ودعم الكلمة الحرة، من بينها جائزة «جيرى لابير» لحرية النشر من اتحاد الناشرين الأمريكيين عام ٢٠٠٦، وجائزة «هيرمان كستن» الألمانية التى يمنحها مركز القلم الألمانى التابع لنادى القلم الدولى عام ٢٠١١.
لم يقتصر تأثير محمد هاشم على المجال الثقافى فحسب، بل امتد إلى النشاط السياسى والاجتماعى. ففى ٤ ديسمبر ٢٠٠٤، شارك فى حركة «كفاية» ضد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانضم إليه عدد من المثقفين والسياسيين، ما عزز دوره كمثقف منخرط فى الواقع الاجتماعى.
كما كان له حضور فعال فى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، بعد أن تحولت دار «ميريت» وقتها إلى قاعدة للناشطين والمتظاهرين لقربها من ميدان التحرير. وتعرضت دار «ميريت» للإغلاق أكثر من مرة، مع مصادرة كتبها ومنشوراتها، لكن «هاشم» ظل مثابرًا فى الدفاع عن حرية التعبير، محافظًا على مكانته كرمز للثقافة المستقلة. برحيله يوم الجمعة الماضى ١٢ ديسمبر الجارى، ترك محمد هاشم فراغًا كبيرًا فى المشهد الثقافى المصرى والعربى، ونعاه الأدباء والمثقفون باعتباره صوتًا للحرية وداعمًا للأجيال الجديدة من الكتاب. لكن يستمر إرثه، ليس فقط فى الكتب التى نشرها والمؤلفين الذين دعمهم، بل فى روح الثقافة المستقلة التى أسهم فى ترسيخها، وفى المكانة التى احتلتها «ميريت» كمنصة حقيقية للإبداع والنقد والنقاش فى قلب القاهرة.
محمد صابر عرب.. حارس التراث

الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب «١٩٤٨- ٢٠٢٥» واحد من أبرز الأسماء فى المشهد الثقافى المصرى والعربى، حيث جمع بين الأكاديمية والسياسة، بين البحث التاريخى وإدارة الثقافة الوطنية، ليترك بصمة واضحة فى كل مؤسسة ثقافية أو أكاديمية تولى قيادتها.
بدأ «عرب» مسيرته الأكاديمية كمعيد فى قسم التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر عام ١٩٧٤، ليواصل الصعود الأكاديمى حتى أصبح أستاذًا لتاريخ العرب الحديث، وعمل كذلك فى معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، وعلى مدار أربعة عقود، أشرف على مئات رسائل الماجستير والدكتوراه، مسهمًا فى تكوين جيل من المؤرخين والباحثين فى مصر والعالم العربى.
ولم تقتصر إسهامات د. عرب على التدريس، بل امتد أثره إلى إدارة المؤسسات الثقافية الكبرى؛ حيث تولى رئاسة دار الوثائق القومية من ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٥، ثم ترأس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من يناير ٢٠٠٥ حتى ديسمبر ٢٠١١، وأصبح رئيسًا للهيئة المصرية العامة للكتاب من أكتوبر ٢٠٠٩ حتى مارس ٢٠١١.
كما شغل منصب وزير الثقافة منذ مايو ٢٠١٢ وحتى يونيو ٢٠١٤، ليكون أحد أبرز المسئولين الذين مزجوا بين الخبرة الأكاديمية والرؤية الثقافية الواسعة، ويعد واحدًا من أكثر المفكرين إنتاجًا علميًا وأدبيًا فى مصر، حيث نشر عشرات الكتب والدراسات، منها: «المتغيرات الاجتماعية فى المجتمع المصرى خلال الحرب العالمية الثانية»، و«دولة اليعاربة بين الوحدة الوطنية والانتصارات الخارجية»، و«العرب فى الحرب العالمية الأولى»، و«الحقوق التاريخية لدولة الإمارات العربية فى الجزر الثلاث»، و«الدين والدولة فى الفكر الإباضى».
كما أسهم فى تدوين تاريخ الحركة الوطنية المصرية، وتاريخ عمان والوثائق العربية، وقدم رؤى نقدية مهمة حول مفكرين مثل عباس العقاد وطه حسين.
ولم يقتصر نشاطه على الكتابة، بل امتدت جهوده لتشمل تطوير المؤسسات الثقافية. فقد عمل على تطوير دار الوثائق بقاعدة بيانات إلكترونية ومركز ترميم للوثائق، ورفع كفاءة دار الكتب بباب الخلق، محولًا هذه المؤسسات إلى مراكز جذب ثقافى ومراجع مهمة للباحثين.
كما كان له دور بارز فى تنظيم معرض القاهرة الدولى للكتاب، والإشراف على مشاريع التحول الرقمى للوثائق، وترشيح القاهرة لتكون عاصمة عالمية للكتاب.
وكانت مشاركاته فى المؤتمرات العلمية والثقافية المحلية والدولية واسعة، حيث حضر وألقى المحاضرات فى أكثر من ٥٠ مؤتمرًا وندوة فى عواصم مثل باريس، مدريد، الجزائر، دبى، مسقط، والرياض، تناولت موضوعات الثقافة العربية، الأرشيف، التاريخ الحديث، والدراسات الإسلامية.
كما شغل عضويات متعددة فى هيئات علمية وثقافية، بينها المجلس الأعلى للثقافة، المجلس الأعلى للآثار، المجمع العلمى المصرى، ولجان اليونسكو، إضافة إلى عضويته فى لجان متخصصة فى تطوير الثقافة والمخطوطات والأرشيف الرقمى.
ولجهوده الأكاديمية والإدارية، حاز على العديد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل رسالة دكتوراه فى الجامعات المصرية عام ١٩٨٣، وجائزة الدولة التقديرية عام ٢٠١٢، كما تم تكريمه شخصية العام الثقافية فى معرض الشارقة الدولى للكتاب ٢٠١٧، وحصل على درع الكمال الثقافى من الحكومة الجزائرية عام ٢٠١٨.
جلال الحسينى.. يا حمام يا مروّح

يُعد الفنان التشكيلى والمعمارى جلال الحسينى «٢٨ ديسمبر ١٩٣٥- ٩ ديسمبر ٢٠٢٥» أحد أبرز الأسماء فى الحركة التشكيلية المصرية الحديثة، حيث جمع فى أعماله بين رؤية معمارية دقيقة وحس فنى رقيق متأثر بجمال الطبيعة المصرية.
وتخرج جلال الحسينى فى كلية الفنون الجميلة قسم العمارة عام ١٩٦٠، قبل أن يحصل على دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية عام ١٩٨٣، وعلى الرغم من ارتباطه الطويل بالهندسة المعمارية، ظل الرسم هوايته الأولى، وخصوصًا ممارسة الألوان المائية التى أصبح فيما بعد علامة مميزة فى مسيرته الفنية.
وبدأ مسيرته التشكيلية بالألوان الزيتية عام ١٩٦٧، وكان لارتباطه المبكر بالطبيعة المصرية أثر بالغ على رؤيته الفنية؛ فقد كانت لوحاته تعكس مشاهد درامية حزينة، متأثرة بأحداث الحياة ومشاهدها اليومية.
ومع مرور الوقت، تحول أسلوبه الفنى إلى المزيد من التفاؤل والألوان الدافئة، وبدأت شخصياته الطبيعية والزهرية تتناغم مع خطوط رومانسية تعكس تفاؤلًا بهجة الحياة، مستفيدًا من أسلوب الواقعية الحديثة التى اختارها لنقل تفاصيل الحياة المصرية على اختلاف أماكنها ومجتمعاتها.
وشكلت الألوان المائية محورًا رئيسيًا فى أعماله، لما تتميز به هذه الخامة من شفافية ورقة تتطلب تمرسًا ودقة عالية، فالأخطاء فيها غير قابلة للتصحيح، واستطاع عبر هذه التقنية أن يصنع عالمًا حالمًا، حيث تتشابك عناصر الطبيعة المصرية فى لوحاته: المراكب الشراعية على نيل القاهرة، والنخيل الشامخ، وطيور الحمام التى شكلت جزءًا من رؤيته الفنية كرمز للسلام والمحبة، وقد أشار إلى أن عشقه للحمام دفعه لتربية أزواج منه فى منزله، ليكون مصدر إلهام يومى لأعماله.
واعتمد «الحسينى» على تجربته المعمارية فى بناء لوحاته، حيث تميزت أعماله بتركيبها المتقن، ما بين الأرضية والخطوط، وبين الظل والنور، لتكون لوحات نابضة بالحياة، تجمع بين البعد الجمالى والدقة التقنية، ورغم ارتباطه بالعمارة، لم يرَ أى تعارض بين عمله المهنى وهوايته الفنية، بل كان يعتبر أن العمارة فن من الفنون التشكيلية، وأن دراسته لها أضافت قيمة حقيقية لإحساسه بالتركيب والتوازن فى اللوحة.
على مدى عقود، أقام عشرات المعارض الخاصة، كان من أبرزها معارضه فى أتيليه القاهرة، وجاليرى دروب، وخان المغربى، ودار الأوبرا المصرية، حيث قدم من خلالها لوحات مستوحاة من كل أرجاء مصر، من واحات سيوة وصحراء الفرافرة إلى أسوان والنوبة، مع استكشاف المشاهد الطبيعية والثقافية المختلفة للبلاد.
وتنوعت موضوعات أعماله بين الطبيعة الصامتة، والزهور، والنخيل، والبيوت الشعبية، وصولًا إلى الإنسان والحيوان فى حواريات هادئة، تُبرز التعايش والتناغم مع البيئة، وكانت لوحاته المائية لا تقتصر على نقل المشهد الطبيعى فحسب، بل كانت تعبيرًا روحيًا عن بهجة الحياة، وسعى الإنسان للسلام، وحبه للطبيعة، حيث أسس لنمط خاص من الرومانسية البصرية، تمزج بين الخطوط الدقيقة والألوان المتدفقة، مع لمسات شاعرية تجعل كل لوحة قصيدة بصرية مستقلة.
وامتد تأثيره إلى الأجيال الشابة، وترك بصمة واضحة بين فنانى الألوان المائية فى مصر، إلى جانب الإشادة المستمرة بأسلوبه الفريد الذى يجمع بين العمق الفنى والشفافية التعبيرية.